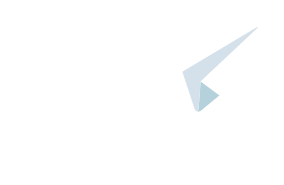تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير الاية (1-15) من سورة الشمس
المؤلف:
اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
3-5-2020
10120
قال تعالى : {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا} [الشمس : 1 - 15] .
{والشمس وضحاها} قد تقدم أن لله سبحانه أن يقسم بما يشاء من خلقه تنبيها على عظيم قدره وكثرة الانتفاع به ولما كان قوام العالم من الحيوان والنبات بطلوع الشمس وغروبها أقسم الله سبحانه بها وبضحاها وهو امتداد ضوئها وانبساطه عن مجاهد والكلبي وقيل هو النهار كله عن قتادة وقيل حرها عن مقاتل كقوله تعالى في طه {ولا تضحى} أي لا يؤذيك حرها .
{والقمر إذا تلاها} أي إذا أتبعها فأخذ من ضوئها وسار خلفها قالوا وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور وقيل تلاها ليلة الهلال وهي أول ليلة من الشهر إذا سقطت الشمس رؤي القمر عند غيبوبتها عن الحسن وقيل في الخامس عشر يطلع القمر مع غروب الشمس وقيل في الشهر كله فهو في النصف الأول يتلوها وتكون أمامه وهو وراؤها وفي النصف الأخير يتلو غروبها بالطلوع .
{والنهار إذا جلاها} أي جلى الظلمة وكشفها وجازت الكناية عن الظلمة ولم تذكر لأن المعنى معروف غير ملتبس وقيل أن معناه والنهار إذا أظهر الشمس وأبرزها سمي النهار مجليا لها لظهور جرمها فيه {والليل إذا يغشاها} أي يغشى الشمس حتى تغيب فتظلم الآفاق ويلبسها سواده {والسماء وما بناها} أي ومن بناها عن مجاهد والكلبي وقيل والذي بناها عن عطاء وقيل معناه والسماء وبنائها مع إحكامها واتساقها وانتظامها {والأرض وما طحاها} في ما وجهان كما ذكرناه أي وطحوها وتسطيحها وبسطها ليمكن الخلق التصرف عليها {ونفس وما سواها} هو كما ذكرناه وسواها عدل خلقها وسوى أعضاءها وقيل سواها بالعقل الذي فضل به سائر الحيوان ثم قالوا يريد جميع ما خلق من الجن والإنس عن عطاء وقيل يريد بالنفس آدم ومن سواها الله تعالى عن الحسن .
{فألهمها فجورها وتقواها} أي عرفها طريق الفجور والتقوى وزهدها في الفجور ورغبها في التقوى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وقيل علمها الطاعة والمعصية لتفعل الطاعة وتذر المعصية وتجتني الخير وتجتنب الشر {قد أفلح من زكاها} على هذا وقع القسم أي قد أفلح من زكى نفسه عن الحسن وقتادة أي طهرها وأصلحها بطاعة الله وصالح الأعمال .
{وقد خاب من دساها} بالعمل الطالح أي أخملها وأخفى محلها وقيل أضلها وأهلكها عن ابن عباس وقيل أفجرها عن قتادة وقيل معناه قد أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس دساها الله أي جعلها قليلة خسيسة وجاءت الرواية عن سعيد بن أبي هلال قال كان رسول الله إذا قرأ هذه الآية {قد أفلح من زكاها} وقف ثم قال ((اللهم آت نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وزكها)) وأنت خير من زكاها وروى زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) في قوله {فألهمها فجورها وتقواها} قال بين لها ما تأتي وما تترك وفي قوله {قد أفلح من زكاها} قال قد أفلح من أطاع {وقد خاب من دساها} قال قد خاب من عصى وقال ثعلب قد أفلح من زكى نفسه بالصدقة والخير وخاب من دس نفسه في أهل الخير وليس منهم .
ثم أخبر سبحانه عن ثمود وقوم صالح فقال {كذبت ثمود بطغواها} أي بطغيانها ومعصيتها عن مجاهد وابن زيد يعني أن الطغيان حملهم على التكذيب فالطغوى اسم من الطغيان كما أن الدعوى من الدعاء وقيل أن الطغوى اسم العذاب الذي نزل بهم فالمعنى كذبت ثمود بعذابها عن ابن عباس وهذا كما قال فأهلكوا بالطاغية والمراد كذبت بعذابها الطاغية فأتاها ما كذبت به {إذ انبعث أشقاها} أي كان تكذيبها حين انبعث أشقى ثمود للعقر ومعنى انبعث انتدب وقام والأشقى عاقر الناقة وهو أشقى الأولين على لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) واسمه قدار بن سالف قال الشاعر وهو عدي بن زيد :
فمن يهدي أخا لذناب لو *** فأرشوه فإن الله جار
ولكن أهلكت لو كثيرا *** وقبل اليوم عالجها قدار
يعني حين نزل بها العذاب فقال لو فعلت وقد صحت الرواية بالإسناد عن عثمان بن صهيب عن أبيه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) من أشقى الأولين قال عاقر الناقة قال صدقت فمن أشقى الآخرين قال قلت لا أعلم يا رسول الله قال : الذي يضربك على هذه وأشار إلى يافوخة وعن عمار بن ياسر قال كنت أنا وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) في غزوة العسرة نائمين في صور(2) من النخل ودقعاء من التراب فو الله ما أهبنا إلا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) يحركنا برجله وقد تتربنا من تلك الدقعاء فقال أ لا أحدثكما بأشقى الناس رجلين قلنا بلى يا رسول الله قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك بالسيف يا علي على هذه ووضع يده على قرنه حتى تبل منها هذه وأخذ بلحيته وقيل أن عاقر الناقة كان أشقر أزرق قصيرا ملتزق الحلق .
{فقال لهم رسول الله} صالح {ناقة الله} قال الفراء : حذرهم إياها وكل تحذير فهو نصب والتقدير احذروا ناقة الله فلا تعقروها عن الكلبي ومقاتل كما يقال الأسد الأسد أي احذروه {وسقياها} أي وشربها من الماء أو ما يسقيها أي فلا تزاحموها فيه كما قال سبحانه لها شرب ولكم شرب يوم معلوم {فكذبوه} أي فكذب قوم صالح صالحا ولم يلتفتوا إلى قوله وتحذيره إياهم بالعذاب بعقرها {فعقروها} أي فقتلوا الناقة {فدمدم عليهم ربهم} أي فدمر عليهم ربهم عن عطاء ومقاتل وقيل أطبق عليهم بالعذاب وأهلكهم {بذنبهم} لأنهم رضوا جميعا به وحثوا عليه وكانوا قد اقترحوا تلك الآية فاستحقوا بما ارتكبوه من العصيان والطغيان عذاب الاستئصال {فسواها} أي فسوى الدمدمة عليهم وعمهم بها فاستوت على صغيرهم وكبيرهم ولم يفلت منها أحد منهم وقيل معناه سوى الأمة أي أنزل العذاب بصغيرها وكبيرها فسوى بينها فيه عن الفراء وقيل جعل بعضها على مقدار بعض في الاندكاك واللصوق بالأرض فالتسوية تصيير الشيء على مقدار غيره وقيل سوى أرضهم عليهم {ولا يخاف عقباها} أي لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد والجبائي والمعنى لا يخاف أن يتعقب عليه في شيء من فعله فلا يخاف عقبى ما فعل بهم من الدمدمة عليهم لأن أحدا لا يقدر على معارضته والانتقام منه وهذا كقوله لا يسأل عما يفعل وقيل معناه لا يخاف الذي عقرها عقباها عن الضحاك والسدي والكلبي أي لا يخاف عقبى ما صنع بها لأنه كان مكذبا بصالح وقيل معناه ولا يخاف صالح عاقبة ما خوفهم به من العقوبات لأنه كان على ثقة من نجاته .
________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج10 ، ص369-372 .
2- الصور : المجتمع من النخل . والدقعاء : التراب الدقيق على وجه الارض .
أقسم سبحانه في هذه السورة بالضياء وبالظلمة ، وبكواكب السماء وإحكامها ، والأرض وتمهيدها ، والنفس واستعدادها ، أقسم بذلك كله ان التقي هو الرابح الناجح ، والمجرم هو الخائب الخاسر ، والتفصيل فيما يلي :
{والشَّمْسِ وضُحاها} . أقسم سبحانه بالشمس من حيث هي ظهرت أم احتجبت لأنها خلق عظيم ، وأيضا أقسم بضيائها لأن المراد بالضحو هنا الظهور والوضوح ، فإذا أضيف إلى الشمس كان معنى ضحاها ضياءها {والْقَمَرِ إِذا تَلاها} .
ضمير تلاها يعود إلى الشمس ، والمعنى ان اللَّه سبحانه أقسم بالقمر حين يتصل ضوءه بضوء الشمس بحيث لا تفصل الظلمة بينهما ، وذلك في الليالي البيض :
الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة {والنَّهارِ إِذا جَلَّاها} . أيضا الهاء في جلاها تعود إلى الشمس ، والمعنى انه تعالى أقسم بالنهار الذي أظهر الشمس وأبرزها للعيان جلية واضحة ، والغرض من القسم بالضياء التنبيه إلى فوائده العظمى لنشكر اللَّه ونحمده .
{واللَّيْلِ إِذا يَغْشاها} . أيضا الهاء تعود إلى الشمس ، واقسم ، جلت حكمته ، بالليل حين يغطي ضوء الشمس ، ولا يبقى لها من أثر ، لا مباشرة كما هي الحال في النهار ، ولا بواسطة ضوء القمر المستفاد من الشمس ، وذلك في الليلة الأولى والأخيرة من الشهر الهلالي حيث لا يظهر الهلال للعيان أو يظهر ضعيفا . . ولليل منافع كما للنهار ، ومن منافع الليل السكينة والراحة .
{والسَّماءِ وما بَناها} أي وبنائها لأن {ما} هنا مصدرية ، والمراد بناء ما فيها من الكواكب السابحة في أفلاكها ، وشد بعضها بعضا برباط الجاذبية . وتقدم مثله في الآية 47 من سورة الذاريات و6 من سورة ق و12 من سورة النبأ {والأَرْضِ وما طَحاها} أي وطحوها ، وفي الآية 31 من سورة النازعات :
{والأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها} والدحو والطحو بمعنى واحد ، وهو البسط والتمهيد .
وتقدم مثله في العديد من الآيات منها الآية 22 من سورة البقرة .
النفس وتسويتها :
{ونَفْسٍ وما سَوَّاها} أي وتسويتها ، والنفس شيء يكون به الإنسان إنسانا ، والحيوان حيوانا ، ولا نعرف هذا الشيء بحقيقته بل بآثاره كالنمو والحركة والسمع والبصر والشعور بالألم في الإنسان والحيوان ، وكعلم الإنسان بالكليات . والمراد بالنفس هنا نفس الإنسان فقط لقوله تعالى : {فَأَلْهَمَها فُجُورَها وتَقْواها} فإن الفجور والتقوى من صفات الإنسان لا الحيوان ، وعليه يكون معنى تسوية نفس الإنسان ان اللَّه سبحانه خلق فيها الاستعداد التام لعمل الخير والشر معا بحيث تكون قدرته على أحدهما مساوية لقدرته على الآخر ، ثم نهاه عن الشر ، وأمره بالخير ، والذي يدلنا على إرادة هذا المعنى قوله تعالى : {إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وإِمَّا كَفُوراً} - 3 الإنسان . وانما خلق سبحانه في نفس الإنسان الاستعداد للفجور والتقوى معا لأن الإنسان انما يكون إنسانا بحريته وإرادته ، وبقدرته على الحسن والقبيح ، ولو قدر على أحدهما دون الآخر لكان كريشة في مهب الريح لا يستحق مدحا ولا ذما ، ولا ثوابا ولا عقابا على ما يفعل ويترك .
{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها وقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها} . هذا جواب القسم ، والفلاح الفوز ، والزكاة الطهارة ، والخيبة الخسران ، والتدسية النقص . . بعد أن أقسم سبحانه بالضياء والظلمة والكواكب وبنائها ، والأرض وتمهيدها ، والنفس واستعدادها بعد هذا قال : من اختار الخير على الشر وطهر نفسه من دنس الآثام فهو الفائز الرابح ، ومن اختار الشر على الخير ولوث نفسه بالذنوب والقبائح فهو الخائب الخاسر .
{كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها} . مفعول كذبت محذوف أي كذبت ثمود نبيها صالحا ، وثمود اسم قبيلة ، ولا ينصرف للتأنيث والتعريف ، وطغوى مصدر بمعنى الطغيان {إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها} . انبعث أي أسرع إلى عقر الناقة ، وهذا الأشقى يضرب المثل بشقائه منذ آلاف السنين {فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وسُقْياها} .
رسول اللَّه هو صالح ، وناقة اللَّه ناقته التي جعلت معجزة له ، وسقياها إشارة إلى ما جاء في الآية 155 وما بعدها من سورة الشعراء : {قالَ} - صالح لقومه - {هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ ولَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ولا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ} ج 5 ص 511 .
{فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها} . قال سبحانه عقروها مع ان العاقر واحد لأنهم رضوا عن فعله ، بل حرضوه عليه كما في الآية 29 من سورة القمر {فَنادَوْا صاحِبَهُمْ فَتَعاطى فَعَقَرَ} . ودمدم عليهم أي أطبق عليهم العذاب . فسواها أي دمر مساكنها على أهلها أجمعين ولم يفلت منهم كبير ولا صغير {واتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} - 25 الأنفال . وتقدم الكلام عن ثمود ونبيهم صالح مرات ، آخرها في الآية 9 من سورة الفجر .
{ولا يَخافُ عُقْباها} . قال أكثر المفسرين : الضمير المستتر في يخاف يعود إليه تعالى أي ان اللَّه سبحانه أهلك ثمود ولا يخاف عاقبة إهلاكهم ، وقال البعض :
يعود الضمير إلى أشقاها ، وفي الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير {إذا انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها فقال لهم رسول اللَّه الخ . ويجوز أن يعود الضمير إليه تعالى على معنى ان اللَّه سبحانه لا معارض له ولا منازع في أمره {قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ} - 154 آل عمران .
_____________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج7 ، ص569-572 .
تذكر السورة أن فلاح الإنسان – وهو يعرف التقوى والفجور بتعريف إلهي وإلهام باطني - أن يزكي نفسه وينميها إنماء صالحا بتحليتها بالتقوى وتطهيرها من الفجور ، والخيبة والحرمان من السعادة لمن يدسيها ، ويستشهد لذلك بما جرى على ثمود من عذاب الاستئصال لما كذبوا رسولهم صالحا وعقروا الناقة ، وفي ذلك تعريض لأهل مكة ، والسورة مكية بشهادة من سياقها .
قوله تعالى : {والشمس وضحاها} في المفردات ، : الضحى انبساط الشمس وامتداد النهار وسمي الوقت به انتهى .
والضمير للشمس ، وفي الآية إقسام بالشمس وانبساط ضوئها على الأرض .
قوله تعالى : {والقمر إذا تلاها} عطف على الشمس والضمير لها وإقسام بالقمر حال كونه تاليا للشمس ، والمراد بتلوه لها إن كان كسبه النور منها فالحال حال دائمة وإن كان طلوعه بعد غروبها فالإقسام به من حال كونه هلالا إلى حال تبدره .
قوله تعالى : {والنهار إذا جلاها} التجلية الإظهار والإبراز ، وضمير التأنيث للأرض ، والمعنى وأقسم بالنهار إذا أظهر الأرض للأبصار .
وقيل : ضمير الفاعل في {جلاها} للنهار وضمير المفعول للشمس ، والمراد الإقسام بحال إظهار النهار للشمس فإنها تنجلي وتظهر إذا انبسط النهار ، وفيه أنه لا يلائم ما تقدمه فإن الشمس هي المظهرة للنهار دون العكس .
وقيل : الضمير المؤنث للدنيا ، وقيل : للظلمة ، وقيل : ضمير الفاعل لله تعالى وضمير المفعول للشمس ، والمعنى وأقسم بالنهار إذا أظهر الله الشمس ، وهي وجوه بعيدة .
قوله تعالى : {والليل إذا يغشاها} أي يغطي الأرض ، فالضمير للأرض كما في {جلاها} وقيل : للشمس وهو بعيد فالليل لا يغطي الشمس وإنما يغطي الأرض وما عليها .
والتعبير عن غشيان الليل الأرض بالمضارع بخلاف تجلية النهار لها حيث قيل : {والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها} للدلالة على الحال ليكون فيه إيماء إلى غشيان الفجور الأرض في الزمن الحاضر الذي هو أوائل ظهور الدعوة الإسلامية لما تقدم أن بين هذه الأقسام وبين المقسم بها نوع اتصال وارتباط ، هذا مضافا إلى رعاية الفواصل .
قوله تعالى : {والسماء وما بناها والأرض وما طحاها} طحو الأرض ودحوها بسطها ، و{ما} في {وما بناها} و{ما طحاها} موصولة ، والذي بناها وطحاها هو الله تعالى والتعبير عنه تعالى بما دون من لإيثار الإبهام المفيد للتفخيم والتعجيب فالمعنى وأقسم بالسماء والشيء القوي العجيب الذي بناها وأقسم بالأرض والشيء القوي العجيب الذي بسطها .
وقيل : ما مصدرية والمعنى وأقسم بالسماء وبنائها والأرض وطحوها ، والسياق - وفيه قوله : {ونفس وما سواها فألهمها} إلخ - لا يساعده .
قوله تعالى : {ونفس وما سواها} أي وأقسم بنفس والشيء ذي القدرة والعلم والحكمة الذي سواها ورتب خلقتها ونظم أعضاءها وعدل بين قواها .
وتنكير {نفس} قيل : للتنكير ، وقيل : للتفخيم ولا يبعد أن يكون التنكير للإشارة إلى أن لها وصفا وأن لها نبأ .
والمراد بالنفس النفس الإنسانية مطلقا وقيل : المراد بها نفس آدم (عليه السلام) ولا يلائمه السياق وخاصة قوله : {قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها} إلا بالاستخدام على أنه لا موجب للتخصيص .
قوله تعالى : {فألهمها فجورها وتقواها} الفجور - على ما ذكره الراغب - شق ستر الديانة فالنهي الإلهي عن فعل أوعن ترك حجاب مضروب دونه حائل بين الإنسان وبينه واقتراف المنهي عنه شق للستر وخرق للحجاب .
والتقوى - على ما ذكره الراغب - جعل النفس في وقاية مما يخاف ، والمراد بها بقرينة المقابلة في الآية بينها وبين الفجور التجنب عن الفجور والتحرز عن المنافي وقد فسرت في الرواية بأنها الورع عن محارم الله .
والإلهام الإلقاء في الروع وهو إفاضته تعالى الصور العملية من تصور أو تصديق على النفس .
وتعليق الإلهام على عنواني فجور النفس وتقواها للدلالة على أن المراد تعريفه تعالى للإنسان صفة فعله من تقوى أو فجور وراء تعريفه متن الفعل بعنوانه الأولي المشترك بين التقوى والفجور كأكل المال مثلا المشترك بين أكل مال اليتيم الذي هو فجور وبين أكل مال نفسه الذي هومن التقوى ، والمباشرة المشتركة بين الزنا وهو فجور والنكاح وهومن التقوى وبالجملة المراد أنه تعالى عرف الإنسان كون ما يأتي به من فعل فجورا أو تقوى وميز له ما هو تقوى مما هو فجور .
وتفريع الإلهام على التسوية في قوله : {وما سواها فألهمها} إلخ للإشارة إلى أن إلهام الفجور والتقوى وهو العقل العملي من تكميل تسوية النفس فهومن نعوت خلقتها كما قال تعالى : {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ } [الروم : 30] وإضافة الفجور والتقوى إلى ضمير النفس للإشارة إلى أن المراد بالفجور والتقوى الملهمين الفجور والتقوى المختصين بهذه النفس المذكورة وهي النفس الإنسانية ونفوس الجن على ما يظهر من الكتاب العزيز من كونهم مكلفين بالإيمان والعمل الصالح .
قوله تعالى : {قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها} الفلاح هو الظفر بالمطلوب وإدراك البغية ، والخيبة خلافه ، والزكاة نمو النبات نموا صالحا ذا بركة والتزكية إنماؤه كذلك ، والتدسي - وهومن الدس بقلب إحدى السينين ياء - إدخال الشيء في الشيء بضرب من الإخفاء ، والمراد بها بقرينة مقابله التزكية : الإنماء على غير ما يقتضيه طبعها وركبت عليه نفسها .
والآية أعني قوله : {قد أفلح} إلخ جواب القسم ، وقوله : {وقد خاب} إلخ معطوف عليه .
والتعبير بالتزكية والتدسي عن إصلاح النفس وإفسادها مبتن على ما يدل عليه قوله : {فألهمها فجورها وتقواها} على أن من كمال النفس الإنسانية أنها ملهمة مميزة - بحسب فطرتها - للفجور من التقوى أي إن الدين وهو الإسلام لله فيما يريده فطري للنفس فتحلية النفس بالتقوى تزكية وإنماء صالح وتزويد لها بما يمدها في بقائها قال تعالى : {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ} [البقرة : 197] وأمرها في الفجور على خلاف التقوى .
قوله تعالى : {كذبت ثمود بطغواها} الطغوى مصدر كالطغيان ، والباء للسببية .
والآية وما يتلوها إلى آخر السورة استشهاد وتقرير لما تقدم من قوله {قد أفلح من زكاها} إلخ .
قوله تعالى : {إذ انبعث أشقاها} ظرف لقوله : {كذبت} أو لقوله : {بطغواها} والمراد بأشقى ثمود هو الذي عقر الناقة واسمه على ما في الروايات قدار بن سالف وقد كان انبعاثه ببعث القوم كما تدل عليه الآيات التالية بما فيها من ضمائر الجمع .
قوله تعالى : {فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها} المراد برسول الله صالح (عليه السلام) نبي ثمود ، وقوله : {ناقة الله} منصوب على التحذير ، وقوله : {وسقياها} معطوف عليه .
والمعنى فقال لهم صالح برسالة من الله : احذروا ناقة الله وسقياها ولا تتعرضوا لها بقتلها أو منعها عن نوبتها في شرب الماء ، وقد فصل الله القصة في سورة هود وغيرها .
قوله تعالى : {فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها} العقر إصابة أصل الشيء ويطلق على نحر البعير والقتل ، والدمدمة على الشيء الإطباق عليه يقال : دمدم عليه القبر أي أطبقه عليه والمراد شمولهم بعذاب يقطع دابرهم ويمحو أثرهم بسبب ذنبهم .
وقوله : {فسواها} الظاهر أن الضمير لثمود باعتبار أنهم قبيلة أي فسواها بالأرض أو هو تسوية الأرض بمعنى تسطيحها وإعفاء ما فيها من ارتفاع وانخفاض .
وقيل : الضمير للدمدمة المفهومة من قوله : {فدمدم} والمعنى فسوى الدمدمة بينهم فلم يفلت منهم قوي ولا ضعيف ولا كبير ولا صغير .
قوله تعالى : {ولا يخاف عقباها} الضمير للدمدمة أو التسوية ، والواو للاستئناف أو الحال .
والمعنى : ولا يخاف ربهم عاقبة الدمدمة عليهم وتسويتهم كما يخاف الملوك والأقوياء عاقبة عقاب أعدائهم وتبعته ، لأن عواقب الأمور هي ما يريده وعلى وفق ما يأذن فيه فالآية قريبة المعنى من قوله تعالى : {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } [الأنبياء : 23] .
وقيل : ضمير {لا يخاف} للأشقى ، والمعنى ولا يخاف عاقر الناقة عقبى ما صنع بها .
وقيل : ضمير {لا يخاف} لصالح وضمير {عقباها} للدمدمة والمعنى ولا يخاف صالح عقبى الدمدمة عليهم لثقته بالنجاة وضعف الوجهين ظاهر .
_________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج20 ، ص268-271 .
أكبر عدد من القسم القرآني تتضمّنه هذه السّورة ، هو في حساب «أحد عشر» ، وفي حساب آخر «سبعة» أقسام . . . ويبيّن أن السّورة تتعرض لموضوع خطير هام . . موضوع عظيم كعظمة السماء والأرض والشمس والقمر . . . موضوع حياتي مصيري .
لنبدأ أولاً بشرح ما جاء في السّورة من قَسم ، لنتعرض بعد ذلك إلى الموضوع الآية الاُولى تقول : {والشمس وضحاها} .
ولقد ذكرنا آنفاً أن القسم في القرآن يستهدف مقصدين :
الأوّل : بيان أهمية ما جاء القسم من أجله .
والثّاني : أهمية ما أقسم به القرآن ، لأنّ القسم عادة يكون بالمهم من الاُمور من هنا تعمل هذه الأقسام على تحريك الفكر في الإنسان كي يمعن النظر في هذه الموضوعات الهامّة من عالم الخليقة ، وليتخذ منها سبيلاً إلى اللّه سبحانه وتعالى .
«الشمس» ذات دور هام وبنّاء جدّاً في الموجودات الحية على ظهر البسيطة فهي إضافة إلى كونها مصدراً للنور والحرارة ـ وهما عاملان أساسيان في حياة الإنسان ـ تعتبر مصدراً لغيرهما من المظاهر الحياتية ، حركة الرياح ، وهطول الأمطار ، ونمو النباتات ، وجريان الأنهر والشلالات ، بل حتى نشوء مصادر الطاقة مثل النفط والفحم الحجري . . . كل واحد منها يرتبط ـ بنظرة دقيقة ـ بنور الشمس .
ولو قُدر لهذا المصباح الحياتي أن ينطفيء يوماً لساد الظلام والسكوت والموت في كل مكان .
«الضحى» في الأصل انتشار نور الشمس ، وهذا ما يحدث حين يرتفع قرص الشمس عن الاُفق ويغمر النور كل مكان ، ثمّ يطلق على تلك البرهة من اليوم اسم «الضحى» ، والقسم بالضحى لأهميته ، لأنّه وقت هيمنة نور الشمس على الأرض .
والقسم الثّالث بالقمر : (والقمر إذا تلاها) . وهذا التعبير ـ كما ذهب إلى ذلك جمع من المفسّرين ـ إشارة إلى القمر حين يكتمل ويكون بدراً كاملاً في ليلة الرابع عشر من كلّ شهر ، ففي هذه الليلة يطل القمر من اُفق المشرق متزامناً مع غروب الشمس . فيسطع بجماله النّير ويهيمن على جو السماء ، ولجماله وبهائه في هذه الليلة أكثر من أيّة ليلة اُخرى جاء القسم به في الآية الكريمة .
واحتمل بعضهم أن يكون في تعبير الآية إشارة إلى تبعية القمر بشكل دائم للشمس ، واكتساب النور من ذلك المصدر المشعّ ، غير أن عبارة {والقمر إذا تلاها} تكون في هذه الحالة قيداً توضيحياً .
وثمّة احتمالات اُخرى ذكرت في تفسير الآية لا تستحق الذكر .
والقسم الرابع بالنهار : {والنهار إذا جلّها} .
و«التجلية» هي الإظهار والإبراز . واختلف المفسّرون في مرجع الضمير في «جلاّها» قال أكثرهم يعود إلى الأرض أو الدنيا ، أي : قسماً بالنهار إذا أظهر الأرض بضوئه . وليس في الآيات السابقة إشارة إلى الأرض ، ولكنها تتّضح من قرينة المقام .
وبعضهم قال إن الضمير يعود إلى الشمس ، ويكون القسم بالنهار حين يجلّي الشمس ، صحيح أنّ الشمس تُظهر النهار ولكن يمكن أن نقول مجازاً إنّ النهار يجلّي الشمس . غير أنّ التّفسير الأوّل أنسب .
على كلّ حال ، القسم بهذه الظاهرة السماوية الهامّة ، يبيّن أهميتها الكبرى في حياة البشر وفي جميع الأحياء ، فالنهار رمز الحركة والحياة ، وكلّ الفعاليات والنشاطات ومساعي الحياة تتمّ عادة في ضوء النهار .
والقَسَم الخامس بالليل : {والليل إذا يغشاها}(2) .
بالليل بكلّ ما فيه من بركة وعطاء . . . إذ هو يخفّف من حرارة شمس النهار ، ثمّ هو مبعث راحة جميع الموجودات الحية واستقرارها ، ولولا ظلام الليل لما كان هناك هدوء واستقرار ، لأنّ استمرار سطوع الشمس يؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة وتلف كلّ شيء ، ونفس هذه المشكلة تحدث لو اختل الوضع الحالي لنظام الليل والنهار ، فعلى ظهر القمر ، حيث ليله يعادل اسبوعين من كرتنا الارضية ونهاره يعادل أيضاً اسبوعين ، ترتفع درجة الحرارة إلى ما يقارب ثلاثمائة درجة مئوية في وسط النهار ، ومعها لا يبقى موجود حي نعرفه ، على قيد الحياة ، وفي وسط الليل تنخفض درجة الحرارة كثيراً تحت الصفر بحيث يتجمد حتماً أي موجود حيّ لو قدّر له أن يكون هناك .
ويلاحظ أن الأفعال المذكورة في الآيات السابقة وردت بصيغة الماضي بينما وردت في هذه الآية بصيغة المضارع ، ولعل هذا الاختلاف يشير إلى أنّ ظهور الليل والنهار من الحوادث التي لا تختص بزمان معين ، بل تشمل الماضي والحاضر . من هنا كانت الأفعال ماضية تارة ومضارعة اُخرى لبيان عمومية هذه الحوادث في مجرى الزمان .
وفي القسمين السادس والسابع تحلّق بنا الآية إلى السماوات وخالق السماوات : {والسماء وما بناها} .
أصل خلقة السماوات بما فيها من عظمة مدهشة من أعظم عجائب الخليقة .
وبناء كلّ هذه الكواكب والأجرام السماوية وما يحكمها من أنظمة أعجوبة اُخرى . . . وأهم من كلّ ذلك . . . خالق هذه السماوات .
ويلاحظ في عبارة «وما بناها» أنّ «ما» تستعمل في العربية لغير العاقل ، ولا يصح استعمالها في موضع الحديث عن الباري العليم الحكيم سبحانه . ولذا ذهب بعض إلى أنّها مصدرية لا موصولة ، وبذلك يكون معنى الآية الكريمة : «والسماء وبنائها» غير أنّ الآيات التالية : {ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها} ، لا يدع بما لا للشك أن «ما» موصولة ، وتعود إلى اللّه سبحانه خالق السماوات ، وورد في مواضع اُخرى من القرآن الكريم استعمال «ما» للعاقل ، كقوله سبحانه : {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} .
من المفسّرين من قال إنّ «ما» استعملت هنا لتطرح مسألة المبدأ بشكل مبهم كي يستطيع البشر بالدراسة والنظر أن يتوصلوا إلى علم بالمبدأ سبحانه وحكمته ، ليتبدل بعد ذلك «ما» إلى «من» أي من الشيء المجهول الذي يعبّر عنه بـ «ما» إلى معلوم ، غير أن التّفسير الأوّل أنسب .
القسم الثامن والتاسع بالأرض وخالق الأرض : {والأرض وما طحاها} . بالأرض التي تحتضن حياة الإنسان وجميع الموجودات الحيّة . . . الارض بجميع عجائبها : بجبالها ، وبحارها ، وسهولها ، ووديانها ، وغاباتها ، وعيونها ، وأنهارها ، ومناجمها ، وذخائرها . . . وبكلّ ما فيها من ظواهر يكفي كلّ واحد منها لأن يكون آية من آيات اللّه ودلالة على عظمته .
وأعظم من الأرض وأسمى منها خالقها الذي «طحاها» و «الطحو» بمعنى البسط والفرش ، وبمعنى الذهاب بالشيء وإبعاده أيضاً . وهنا بمعنى «البسط» ، لأنّ الأرض كانت مغمورة بالماء ، ثمّ غاض الماء في منخفضات الأرض ، وبرزت اليابسة ، وانبسطت ، ويعبّر عن ذلك أيضاً بدحو الأرض ، هذا أوّلاً .
وثانياً : كانت الارض في البداية على شكل مرتفعات ومنخفضات ومنحدرات شديدة غير قابلة للسكن عليها . فهطلت أمطار مستمرة سوّت بين هذه التعاريج ، وتسطحت الأرض فكانت صالحة لمعيشة الإنسان وللزراعة .
يرى بعض المفسّرين أنّ في الآية إشارة عابرة إلى حركة الأرض ، لأنّ من معاني «الطحو» الدفع الذي يمكن أن يكون إشارة إلى حركة الأرض الإنتقالية حول الشمس ، أو إلى حركتها الوضعية حول نفسها ، أو إلى الحركتين معاً .
وأخيراً القسم الحادي عشر والقسم الثّاني عشر بالنفس الإنسانية وبارئها : {ونفس وما سوّاها} .
قيل إنّ المراد بالنفس هنا روح الإنسان ، وقيل إنّه جسمه وروحه معاً .
ولوكان المراد من النفس الروح ، «سواها» تعني إذن نظمها وعدّل قواها ابتداء من الحواس الظاهرة وحتى قوّة الإدراك ، والذاكرة ، والانتقال ، والتخيل ، والابتكار ، والعشق ، والإرادة ، والعزم ونظائرها من الظواهر المندرجة في إطار «علم النفس» .
ولوكان المراد من النفس الروح والجسم معاً ، فالتسوية تشمل أيضاً ما في البدن من أنظمة وأجهزة يدرسها علم التشريح وعلم الفسلجة .
وفي القرآن الكريم وردت «نفس» بكلا المعنيين ، بمعنى الروح ، كقوله سبحانه في الآية (42) من سورة الزمر : { اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر : 42] وبمعنى الجسم ، كقوله سبحانه في الآية (33) من سورة القصص : {قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ } [القصص : 33] .
والأنسب هنا أن يكون معنى النفس هنا شاملاً للمعنيين لأن قدرة اللّه سبحانه تتجلى في الإثنين معاً .
ويلاحظ أن الآية ذكرت كلمة «نفس» نكرة وفي ذلك إشارة إلى ما في النفس من عظمة تفوق قدرة التصوّر وإلى ما يحيطها من إبهام ، يجعلها موجوداً مجهولاً . وهذا ما حدا ببعض العلماء المعاصرين أن يتحدث عن الإنسان في كتابه تحت عنوان : «الإنسان ذلك المجهول» .
الآية التالية تتناول أهم ظاهرة في الخليقة وتقول : {فألهمها فجورها وتقواها} .
نعم ، حين اكتملت خلقة الإنسان وتحقق وجوده ، علّمه اللّه سبحانه الواجبات والمحظورات . وبذلك أصبح كائناً مزيجاً في خلقته من «الحمأ المسنون» و«نفخة من روح اللّه» ، ومزيجاً في تعليمه من «الفجور» و«التقوى» . أصبح بالتالي كائناً يستطيع أن يتسلق سلّم الكمال الإنساني ليفوق الملائكة ، ومن الممكن أن ينحط لينحدر عن مستوى الأنعام ويبلغ مرحلة (بل هم أضلّ) . وهذا يرتبط بالمسير الذي يختاره الإنسان عن إرادة .
«ألهمها» من الإلهام ، وهو في الأصل بمعنى البلع والشرب ، ثمّ استعمل في إلقاء الشيء في روع الإنسان من قِبل اللّه تعالى ، وكأن الإنسان يبتلع ذلك الشيء ويتشرّبه بجميع وجوده .
وجاء بمعنى «الوحي» أيضاً . بعض المفسّرين يرى أن الفرق بين «الإلهام» و«الوحي» ، هو إنّ الفرد الملهم لا يدري من أين أتى بالشيء الذي ألهم به ، وفي حالة الوحي يعلم بالمصدر وبطريقة وصول الشيء إليه .
«الفجور» من مادة «فجر» وتعني ـ كما ذكرنا سابقاً ـ الشق الواسع وسمّي بياض الصبح بالفجر لأنّه يشقّ ستار الظلام . ولما كانت الذنوب تهتك ستار الدين فإنّها سمّيت بالفجور .
المقصود بالفجور في الآية طبعاً الأسباب والعوامل والطرق المؤدية إلى الذنوب .
و«التقوى» من الوقاية وهي الحفظ ، وتعني أنّ يصون الإنسان نفسه من القبائح والآثام والسيئات والذنوب .
ويلزم التأكيد أنّ الآية الكريمة : {فألهمها فجورها وتقواها} لا تعني أنّ اللّه سبحانه قد أودع عوامل الفجور والتقوى في نفس الإنسان ، كما تصوّر بعضهم ، واستنتج من ذلك دلالة الآية الكريمة على وجود التضاد في المحتوى الداخلي للإنسان! بل تعني أنّ اللّه تعالى علّم الإنسان هاتين الحقيقتين وألهمه إيّاهما ، وبيّن له طريق السلامة وطريق الشرّ ، ومثل هذا المفهوم ورد في الآية (10) من سورة البلد : {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} [البلد : 10] .
بعبارة اُخرى ، إنّ اللّه سبحانه قد منح الإنسان قدرة التشخيص والعقل ، والضمير اليقظ بحيث يستطيع أن يميّز بين «الفجور» و«التقوى» عن طريق العقل والفطرة ، لذلك ذهب بعض المفسّرين إلى أنّ الآية تشير في الحقيقة إلى مسألة «الحسن والقبح العقليين» وقدرة الإنسان على إدراكهما .
ومن بين النعم الطائلة التي أسبغها اللّه على الإنسان تركز هذه الآية على نعمة الهام الفجور والتقوى ، وإدراك الحسن والقبح ، لأنها من أهم المسائل المصيرية التي تواجه حياة الإنسان .
بعد هذه الأقسام المهمّة المتتالية يخلص السياق القرآني إلى النتيجة فيقول : {قد أفلح من زكّاها} .
والتزكية تعني النمو ، «والزكاة» في الأصل بمعنى النمو والبركة ، وورد عن علي(عليه السلام) قوله : «المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق»(3) .
ثمّ استعملت الكلمة بمعنى التطهير ، وقد يعود ذلك إلى أن التطهير من الآثام يؤدي إلى النمو والبركة ، والآية الكريمة تحتمل المعنيين .
نعم ، الفلاح لمن ربّى نفسه ونمّاها ، وطهّرها من التلوّث بالخصائل الشيطانية وبالذنوب والكفر والعصيان .
والمسألة الأساسية في حياة الإنسان هي هذه «التزكية» ، فإن حصلت سعد الإنسان وإلاّ شقى وكان من البائسين .
ثمّ يعرج السياق القرآني على المجموعة المخالفة فيقول : {وقد خاب من دسّاها} .
«خاب» : من الخيبة ، وهي فوت الطلب ، كما يقول الراغب في المفردات والحرمان والخسران .
«دسّاها» من مادة «دس» وهي في الأصل بمعنى إدخال الشيء قسراً ، وجاء في الآية (59) من سورة النحل قوله سبحانه : {أم يدسّه في التراب} ، إشارة إلى عادة الجاهليين في وأد البنات ، أي إدخالهن في التراب كرهاً وقسراً ومنه «الدسيسة» التي تقال للأعمال الخفية والضارة .
وما هي المناسبة بين معنى الدسّ ، وقوله سبحانه : {وقد خاب من دسّاها} .
قيل : إنّ هذا التعبير كناية عن الفسق والذنوب ، فأهل التقوى والصلاح يظهرون أنفسهم ، بينما المذنبون يخفونها ، ويذكر أنّ العرب الكرماء جرت عادتهم على نصب خيامهم على المرتفعات ، وإشعال النيران قربها في الليل ، لتكون بادية للمارّة ليل نهار ، بينما أهل البخل واللؤم يقبعون في المنخفضات كي لا يأتيهم أحد .
وقيل : إنّ المقصود اندساس المذنبين بين صفوف الصالحين .
وقيل : إنّ المذنب يدس نفسه أو هويته الإنسانية في المعاصي والذنوب .
وقيل : إنّه يخفي المعاصي والذنوب في نفسه .
والتعبير ـ على كل حال ـ كناية عن التلوث بالذنوب والمعاصي والخصائل الشيطانية ، وبذلك يقع في المنطقة المقابلة للتزكية .
والآية تحتمل في مفهومها الواسع كلّ هذه المعاني .
وبهذا المعيار يتمّ تمييز الفائزين عن الفاشلين في ساحة الحياة . «تزكية النفس وتنميتها بروح التقوى وطاعة اللّه» أو «تلوثها بأنواع المعاصي والذنوب» .
الإمامان الباقر والصادق(عليهما السلام) قالا في تفسير الآية الكريمة : «قد أفلح من أطاع وخاب من عصى»(4) .
وعن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) قال حين تلا الآية : «اللّهم آت نفسي تقواها ، أنت وليها ومولاها ، وزكّها أنت خير من زكّاها»(5) .
وهذا الحديث يدل على أن اجتياز تعاريج المسيرة الحياتية والعبور من العقبة لا يتيسّر حتى لرسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) إلاّ بتوفيق اللّه تعالى ، أي لا يتيسّر إلاّ بعزم العبد وتأييد الباري ، ولذلك ورد في حديث آخر عن الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم) في تفسير الآيتين قوله : «أفلحت نفس زكّاها اللّه وخابت نفس خيبها اللّه من كلّ خير» (6) .
وقوله تعالى : {كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَآ (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَهَا (12) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيهِم رَبُّهُم بِذَنْبِهِم فَسَوَّاهَا (14) وَلاَ يَخَافُ عُقْبَهَا}
عاقبة مرّة للطغاة :
عقب التحذير الذي اطلقته الآية السابقة بشأن عاقبة من ألقى بنفسه في أوحال العصيان ، قدمت هذه الآيات مصداقاً تاريخياً واضحاً لهذه السنّة الإلهية ، وتحدثت عن مصير قوم «ثمود» بعبارات قصيرة قاطعة ذات مدلول عميق .
«الطغوى» و«الطغيان» بمعنى واحد وهو تجاوز الحد ، وفي الآية تجاوز الحدود الإلهية والعصيان أمام أوامره(7) .
«قوم ثمود» من أقدم الاقوام التي سكنت منطقة جبلية بين «الحجاز» و«الشام» . كانت لهم حياة رغدة مرفهة ، وأرض خصبة ، وقصور فخمة ، غير أنّهم لم يؤدوا شكر هذه النعم ، بل طغوا وكذبوا نبيّهم صالحاً ، واستهزأوا بآيات اللّه ، فكان عاقبة أمرهم أن أبيدوا بصاعقة سماوية .
ثمّ تستعرض السّورة مقطعاً بارزاً من طغيان القوم وتقول : {إذا انبعث اشقاها} .
و«أشقى» ثمود ، هو الذي عقر الناقة التي ظهرت باعتبارها معجزة بين القوم ، وكان قتلها بمثابة إعلان حرب على النّبي صالح .
ذكر المفسّرون أنّ اسم هذا الشقي «قدار بن سالف»
وروي أنّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي بن أبي طالب(عليه السلام) : من أشقى الأولين؟
قال : عاقر الناقة .
قال : صدقت ، فمن أشقى الآخرين؟
قال : قلت لا أعلم يا رسول اللّه .
قال : الذي يضربك على هذه ، وأشار إلى يافوخه(8)
في الآية التالية تفاصيل أكثر عن طغيان قوم ثمود :
{فقال لهم رسول اللّه ناقة اللّه وسقياها}
المقصود من «رسول اللّه» نبيّ قوم ثمود صالح(عليه السلام) ، وعبارة «ناقة اللّه» إشارة إلى أنّ هذه الناقة لم تكن عادية ، بل كانت معجزة ، تثبت صدق نبوة صالح ، ومن خصائصها ـ كما في الرّواية المشهورة أنّها خرجت من قلب صخرة في جبل لتكون حجة على المنكرين .
«الناقة» منصوبة بفعل محذوف ، والتقدير «ذروا ناقة اللّه وسقياها» ، ويستفاد من مواضع اُخرى في القرآن الكريم أنّ النّبي صالحاً(عليه السلام) كان قد أخبرهم أنّ ماء القرية يجب تقسيمه بينهم وبين الناقة ، يوم لهم ويوم للناقة :
{وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ } [القمر : 28] .
وحذّرهم من أن الإساءة إلى الناقة : {وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ } [الشعراء : 156] .
الآية التالية تقول : {فكذبوه فعقروها} ، و«العقر» ـ على وزن كفر ـ معناه الأساس والأصل والجذر ، و«عقر الناقة» قطع أساسها وإهلاكها .
وقيل : «العقر» بتر أسافل أطراف الناقة ، ممّا يؤدي إلى سقوطها وهلاكها .
ويلاحظ أنّ قاتل الناقة شخص واحد أشارت إليه الآية بأشقاها ، بينما نسب العقر إلى كلّ طغاة قوم ثمود : «فعقروها» ، وهذا يعني أنّ كلّ هؤلاء القوم كانوا مشاركين في الجريمة ، وذلك أوّلاً : لأنّ مثل هذه المؤامرات يخطط لها مجموعة ثمّ ينفذها فرد واحد أو أفراد .
وثانياً : لأنّ هذه الجريمة تمّت برضا القوم فهم شركاء في الجريمة بهذا الرضا ، وعن أمير المؤمنين علي(عليه السلام)قال : «إنّما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اللّه بالعذاب لما عموه بالرضى ، فقال سبحانه : {فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ }» [الشعراء : 157] (9)
وعقب هذا التكذيب أنزل اللّه عليهم العقاب فلم يترك لهم أثراً : {فدمدم عليهم ربّهم بذنبهم فسواها} .
«دمدم» تعني أهلك ، وتأتي أحياناً بمعنى عذّب وعاقب وأحياناً بمعنى سحق واستأصل ، وبمعنى سخط أو أحاط(10) .
و «سوّاها» من التسوية وهي تسوية الأبنية بالأرض نتيجة صيحة عظيمة وصاعقة وزلزلة ، أو بمعنى إنهاء حالة هؤلاء القوم ، أو تسويتهم جميعاً في العقاب والعذاب ، حتى لم يسلم أحد منهم .
ومن الممكن أيضاً الجمع بين هذه المعاني .
الضمير في «سوّاها» يعود إلى قبيلة ثمود ، وقد يعود إلى مدنهم وقراهم التي سوّاها ربّ العالمين مع الارض .
وقيل إنّ الضمير يعود إلى مصدر «دمدم» أي إنّ اللّه سوّى غضبه وسخطه على القوم ليشملهم جميعاً على حدٍّ سواء ، والتّفسير الأوّل أنسب .
ومن الآية نستنتج بوضوح أنّ عقاب هؤلاء القوم كان نتيجة لذنوبهم وكان متناسباً مع تلك الذنوب ، وهذا عين الحكمة والعدالة .
في تاريخ الاُمم نرى غالباً بروز حالة الندم فيهم حين يرون آثار العذاب ولجوءهم إلى التوبة ، أمّا قوم ثمود ، فالغريب أنّهم حين رأوا علامات العذاب طفقوا يبحثون عن نبيّهم صالح ليقتلوه(11) . وهذا دليل على ارتكاسهم في العصيان والطغيان أمام اللّه ورسوله . لكن اللّه نجّا صالحاً وأهلك قومه شرّ إهلاك .
وتختتم السّورة الحديث عن هؤلاء القوم بتحذير قارع لكل الذين يتجهون في نفس هذه المسيرة المنحرفة فتقول : {ولا يخاف عقباها} .
كثيرون من الحكّام قادرون على انزال العقاب لكنّهم يخشون من تبعات عملهم ، ويخافون ردود الفعل التي قد تحدث نتيجة فعلهم ، ولذلك يكفّون عن المعاقبة . قدرتهم ـ إذن ـ محفوفة بالضعف وعلمهم ممزوج بالجهل . لا يعلمون مدى قدرتهم على مواجهة التبعات . بينما اللّه سبحانه قادر متعال ، علمه محيط بكّل الاُمور وعواقبها ، وقدرته على مواجهة النتائج لا يشوبها ضعف ، فهو سبحانه وتعالى لا يخاف عقباها ، ولذلك فإنّ مشيئته في العقاب نافذة حازمة .
فالطغاة ـ إذن ـ عليهم أن يتنبّهوا ويحذروا غضب اللّه وسخطه ونقمته .
والضمير في «عقباها» يعود إلى «الدمدمة» والهلاك .
____________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج15 ، ص342-356 .
2 ـ وفي ضمير «يغشاها» ذهب المفسّرون إلى اتجاهين ، منهم من قال : إنّه يعود إلى «الأرض» لأنّ الليل يسدل استاره على الأرض . ومنهم من قال إلى «الشمس» إذ الليل يحجب وجه الشمس ، والمعنى هذا مجازي طبعاً ، لأنّ الليل لا يحجب الشمس حقيقة ، بل يظهر بعد غروب الشمس . والواقع أنّ الضمير في الآية السابقة إن عاد إلى «الأرض» فهنا يعود إليها أيضاً . وإن عاد إلى الشمس يعود إليها هنا أيضاً .
3 ـ نهج البلاغة ، الكلمات القصار ، الكلمة 147 .
3 ـ مجمع البيان ، ج10 ، ص 498 .
4 ـ المصدر السابق .
5 ـ الدر المنثور ، ج6 ، ص357 .
6 ـ ذكر بعض علماء اللغة أن «الطغوى» مشتقّة من مادة ناقص واوي (طغَوَ) و«الطغيان»
من مادة ناقص يائي (طَغَيَ) .
7 ـ مجمع البيان ، ج10 ، ص499 ، ووردت الرّواية باختصار في تفسير القرطبي ، ج6 ، ص7168 .
8 ـ نهج البلاغة ، الخطبة 201 .
9 ـ مفردات الراغب ، ولسان العرب ، ومجمع البيان .
11 ـ روح البيان ، ج20 ، ص446 .
 الاكثر قراءة في سورة الشمس
الاكثر قراءة في سورة الشمس
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)