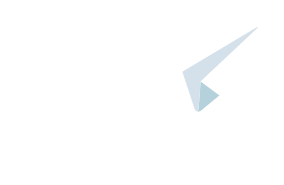التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته


صفات الله تعالى


الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه


العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة


النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

مواضيع متفرقة

القرآن الكريم


الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم ومودتهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة


المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة


فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية


شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية


أسئلة وأجوبة عقائدية


التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد


القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة


الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم


أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات


احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة


أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات


اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة


الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة
تنزيه الأئمة عليهم السلام
المؤلف:
أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي (الشريف المرتضى)
المصدر:
تنزيه الانبياء
الجزء والصفحة:
131 - 183
5-12-2017
2551
(مسألة) : ان قال قائل : إذا كان من مذهبكم يا معشر القائلين بالنص ان النبي صلى الله عليه وآله نص على علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام بالخلافة بعده ، وفوض إليه امر أمته ، فما باله لم ينازع المتآمرين بعد النبي في الامر الذي وكل إليه وعول في تدبيره عليه أوليس هذا منه اغفالا لواجب لا يسوغ اغفاله؟
فإن قلتم انه لم يتمكن من ذلك فهلا اعذر وأبلى واجتهد ، فإنه إذا لم يصل إلى مراده بعد الاعذار والاجتهاد كان معذورا.
أوليس هو عليه السلام الذي حارب اهل البصرة وفيهم زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وطلحة والزبير ، ومكانهما من الصحبة والاختصاص والتقدم مكانهما ، ولم يحشمه ظواهر هذه الاحوال من كشف القناع في حربهم حتى اتى على نفوس اكثر أهل العسكر ، وهو المحارب لأهل صفين مرة بعد أخرى مع تخاذل اصحابه وتواكل أنصاره ، وانه (عليه السلام) كان في اكثر مقاماته تلك وموقفه لا يغلب في ظنه الظفر ولا يرجو لضعف من معه النصر.
وكان عليه السلام مع ذلك كله مصمما ماضيا قدما لا تأخذه في الله لومة لائم ، وقد وهب نفسه وماله وولده لخالقه تعالى ، ورضي بأن يكون دون الحق اما جريحا أو قتيلا ، فكيف لم يظهر منه بعض هذه الامور مع من تقدم والحال عندكم واحدة ، بل لو قلنا انها كانت اغلظ وافحش لأصبنا لأنها كانت مفتاح الشر واس الخلاف وسبب التبديل والتغيير؟
وبعد ، فكيف لم يقنع بالكف عن التفكير والعدول عن المكاشفة والمجاهرة حتى بايع القوم وحضر مجالسهم ، ودخل في آرائهم وصلى مقتديا بهم ، وأخذ عطيتهم ونكح من سبيهم وانكحهم ، ودخل في الشورى التي هي عندكم مبنية على غير تقوى ، فما الجواب عن جميع ذلك اذكروه ، فإن الامر فيه مشتبه والخطب ملتبس؟
(الجواب) : قلنا أما الكلام على ما تضمنه هذا السؤال فهو مما يخص الكلام في الامامة ، وقد استقصيناه في كتابنا المعروف بالشافي في الامامة ، وبسطنا القول فيه في هذه الابواب ونظائرها بسطا يزيل الشبهة ويوضح الحجة ، لكنا لا نخلي هذا الكتاب من حيث تعلق غرضه بهذه المواضع من اشارة إلى طريقة الكلام فيها.
فنقول : قد بينا في صدر هذا الكتاب ان الائمة عليهم السلام معصومون من كبائر الذنوب وصغائرها ، واعتمدنا في ذلك على دليل عقلي لا يدخله احتمال ولا تأويل بشئ ، فمتى ورد عن احدهم عليهم السلام فعل له ظاهر الذنب ، وجب ان نصرفه عن ظاهره ونحمله على ما يطابق موجب الدليل العقلي فيهم ، كما فعلنا مثل ذلك في متشابه القرآن المقتضي ظاهره ما لا يجوز على الله تعالى ، وما لا يجوز على نبي من انبيائه عليهم السلام. فإذا ثبت ان أمير المؤمنين عليه السلام إمام فقد ثبت بالدليل العقلي أنه معصوم عن الخطأ والزلل ، فلابد من حمل جميع افعاله على جهات الحسن ونفي القبيح عن كل واحد منها.
وما كان له منها ظاهر يقتضي الذنب علمنا في الجملة انه على غير ظاهره ، فإن عرفنا وجهه على التفصيل ذكرناه ، وإلا كفانا في تكليفنا ان نعلم ان الظاهر معدول عنه ، وأنه لابد من وجه فيه يطابق ما تقتضيه الادلة. وهذه الجملة كافية في جميع المشتبهة من افعال الائمة عليهم السلام واقوالهم ، ونحن نزيد عليها فنقول : ان الله تعالى لم يكلف انكار المنكر سواء اختص بالمنكر أو تعداه إلى غيره الا بشروط معروفة ، اقواها التمكن.
وان لا يغلب في ظن المنكر ان إنكاره يؤدي إلى وقوع ضرر به لا يحتمل مثله ، وأن لا يخاف في انكاره من وقوع ما هو افحش منه واقبح من المنكر. وهذه شروط قد دلت الادلة عليها ووافقنا المخالفون لنا في الامامة فيها وإذا كان ما ذكرناه مراعي في وجوب انكار المنكر ، فمن اين أن أمير المؤمنين عليه السلام كان متمكنا من المنازعة في حقه والمجادلة ، وما المنكر من ان يكون عليه السلام خائفا متى نازع وحارب من ضرر عظيم يلحقه في نفسه وولده وشيعته ، ثم ما المنكر من ان يكون خاف من الانكار من ارتداد القوم عن الدين وخروجهم عن الاسلام ونبذهم شعار الشريعة ، فرأى ان الاغضاء اصلح في الدين من حيث كان يجر الانكار ضررا فيه لا يتلافى.
فان قيل : فما يمنع من ان يكون انكار المنكر مشروطا بما ذكرتم ، إلا انه لابد لارتفاع التمكن وخوف الضرر عن الدين والنفس من امارات لايحة ظاهرة يعرفها كل احد ، ولم يكن هناك شئ من امارات الخوف وعلامات وقوع الفساد في الدين. وعلى هذا فليس تنفعكم الجملة التي ذكرتموها لان التفصيل لا يطابقها.
قلنا : أول ما نقوله ان الامارات التي يغلب معها الظن بأن انكار المنكر يؤدي إلى الضرر ، انما يعرفها من شهد الحال وحضرها واثرت في ظنه ، وليست مما يجب ان يعلمها الغائبون عن تلك المشاهدة. ومن اتى بعد ذلك الحال بالسنين المتطاولة.
وليس من حيث لم تظهر لنا تلك الامارات ولم نحط بها علما ، يجب القطع على من شهد تلك الحال لم تكن له ظاهرة ، فإنا نعلم ان للمشاهد وحضوره مزية في هذا الباب لا يمكن دفعها ، والعادات تقتضي بأن الحال على ما ذكرناه.
فإنا نجد كثيرا ممن يحضر مجالس الظلمة من الملوك يمتنع من انكار بعض ما يجري بحضرتهم من المناكير ، وربما أنكر ما يجري مجراه في الظاهر ، فإذا سئل عن سبب اغضائه وكفه ذكر أنه خاف لأمارة ظهرت له ، ولا يلزمه ان تكون تلك الامارة ظاهرة لكل أحد ، حتى يطالب بأن يشاركه في الظن والخوف كل من عرفه.
بل ربما كان معه في ذلك المقام من لا يغلب على ظنه مثل ما غلب على ظنه من حيث اختص بالأمارة دونه. ثم قد ذكرنا في كتابنا في الامامة من أسباب الخوف وامارات الضرر التي تناصرت بها الروايات ، ووردت من الجهات المختلفة ما فيه مقنع للمتأمل ، وانه (عليه السلام) غولط في الامر وسوبق إليه وانتهزت غرته ، واغتنمت الحال التي كان فيها متشاغلا بتجهيز النبي صلى الله وآله عليه ، وسعى القوم إلى سقيفة بني ساعدة ، وجرى لهم فيها مع الانصار ما جرى ، وتم لهم عليهم كما اتفق من بشير بن سعد ما تم وظهر ، وانما توجه لهم من قهرهم الانصار ما توجه ان الاجماع قد انعقد على البيعة ، وأن الرضا وقع من جميع الامة وروسل امير المؤمنين عليه السلام. ومن تأخر معه من بني هاشم وغيرهم مراسلة من يلزمهم بيعة قد تمت ووجبت لا خيار فيها لاحد ، ولا رأي في التوقف عنها لذي رأي ثم تهددوه على التأخر ، فتارة يقال له لا تقم مقام من يظن فيه الحسد لابن عمه ، إلى ما شاكل ذلك من الاقوال والافعال التي تقتضي التكفل والتثبت ، وتدل على التصميم والتتميم. وهذه امارات بل دلالات تدل على ان الضرر في مخالفة القوم شديد. وبعد ، فان الذي نذهب إليه من سبب التقية والخوف مما لابد منه ، إذا فرضوا ان مذهبنا في النص صحيح ، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله قد نص على امير المؤمنين (عليه السلام) بالإمامة في مقام بعد مقام وبكلام لا يحتمل التأويل ، ثم رأى المنصوص عليه اكثر الامة بعد الوفاة بلا فصل ، اقبلوا يتنازعون الامر تنازع من لم يعهد إليه بشئ فيه ، ولا يسمع على الامامة نصا لان المهاجرين قالوا نحن احق بالأمر ، لان الرسول صلى الله عليه وآله منا ولكيت وكيت. وقال الانصار نحن آويناه ونصرناه فمنا امير ومنكم أمير. هذا ، والنص لا يذكر فيما بينهم. ومعلوم ان الزمان لم يبعد فيتناسوه ومثله لا يتناسى ، فلم يبق إلا أنه عملوا على التصميم ووطنوا نفوسهم على التجليح ، وأنهم لم يستيجزوا الاقدام على خلاف الرسول صلى الله عليه وآله في اجل اوامره واوثق عهوده ، والتظاهر بالعدول عما اكده وعقده ، إلا لداع قوي وامر عظيم يخاف فيه من عظيم الضرر ، ويتوقع منه شديد الفتنة. فأي طمع يبقى في نزوعهم بوعظ وتذكير؟ وكيف يطمع في قبول وعظه والرجوع إلى تبصيره وارشاده من رآهم لم يتعظوا بوعظ يخرجهم من الضلالة وينقذهم من الجهالة؟ وكيف لا يتهمهم على نفسه ودينه من رأى فعلهم بسيدهم وسيد الناس أجمعين فيما عهده وأراده وقصده؟ وهل يتمكن عاقل بعد هذا ان يقول اي امارة للخوف ظهرت؟ اللهم الا ان يقولوا ان القوم ما خالفوا نصا ولا نبذوا عهدا ، وإن كل ذلك تقول منكم عليهم لا حجة فيه ، ودعوى لا برهان عليها ، فتسقط حينئذ المسألة من اصلها ، ويصير تقديرها إذا كان أمير المؤمنين (عليه السلام) غير منصوص عليه بالإمامة ولا مغلوب على الخلافة ، فكيف لم يطالب بها ولم ينازع فيها؟ ومعلوم انه لا مسألة في ان من لم يطالب بما ليس له ، ولم يجعل إليه ، وإنما المسألة في ان لم يطالب بما جعل إليه. وإذا فرضنا ان ذلك إليه ، جاء منه كل الذي ذكرناه. ثم يقال لهم إذا سلمتم ان وجوب انكار المنكر مشروط بما ذكرناه من الشروط ، فلم انكرتم ان يكون امير المؤمنين عليه السلام انما أحجم عن المجاهدة بالإنكار ، لان شروط انكار المنكر لم تتكامل ، إما لأنه كان خائفا على نفسه أو على من يجري مجرى نفسه ، أو مشفقا من وقوع ضرر في الدين هو اعظم مما انكره. وما المانع من ان يكون الامر جرى على ذلك؟. فان قالوا أن امارات الخوف لم تظهر. قلنا : وأي امارة للخوف هي اقوى من الاقدام على خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله في اوثق عهوده واقوى عقوده ، والاستبداد بأمر لاحظ لهم فيه. وهذه الحال تخرج من ان يكون امارة في ارتفاع الحشمة من القبيح إلى ان يكون دلالة ، وإنما يسوغ أن يقال لا امارة هناك تقتضي الخوف وتدعو إلى سوء الظن إذا فرضنا ان القوم كانوا على أحوال السلامة متضافرين متناصرين متمسكين بأوامر الرسول صلى الله عليه وآله ، جارين على سنته وطريقته. فلا يكون لسوء الظن عليهم مجال ولا لخوف من جهتهم طريق. فأما إذا فرضنا انهم دفعوا النص الظاهر وخالفوه وعملوا بخلاف مقتضاه ، فالأمر حينئذ منعكس منقلب وحسن الظن لا وجه له ، وسوء الظن هو الواجب اللازم. فلا ينبغي للمخالفين لنا في هذه المسألة ان يجمعوا بين المتضادات ، ويفرضوا ان القوم دفعوا النص وخالفوا موجبه ، وهم مع ذلك على أحوال السلامة المعهودة منهم التي تقتضي من الظنون بهم أحسنها وأجملها على أنا لا نسلم انه (عليه السلام) لم يقع منه إنكار على وجه من الوجوه ، فإن الرواية متظافرة بأنه عليه السلام لم يزل يتظلم ويتألم ويشكو أنه مظلوم ومقهور في مقام بعد مقام وخطاب بعد خطاب. وقد ذكرنا تفصيل هذه الجملة في كتابنا الشافي في الامامة واوردنا طرفا مما روي في هذا الباب ، وبينا ان كلامه (عليه السلام) في هذا المعنى يترتب في الاحوال بحسب ترتبها في الشدة واللين ، فكان المسموع من كلامه عليه السلام في أيام أبي بكر لا سيما في صدرها ، وعند ابتداء البيعة له ما لم يكن مسموعا في أيام عمر ، ثم صرح عليه السلام وبين وقوى تعريضه في أيام عثمان ، ثم انتهت الحال في أيام تسليم الامر إليه إلى انه (عليه السلام) ما كان يخطب خطبة ولا يقف موقفا الا ويتكلم فيه بالألفاظ المختلفة والوجوه المتباينة ، حتى اشترك في معرفة ما في نفسه الولي والعدو والقريب والبعيد. وفي بعض ما كان (عليه السلام) بيديه ويعيده اعذار وافراغ للوسع ، وقيام بما يجب على مثله ممن قل تمكنه وضعف ناصره. فأما محاربة أهل البصرة ، ثم أهل صفين ، فلا يجري مجرى التظاهر بالإنكار على المتقدمين عليه (عليه السلام) ، لأنه وجد على هؤلاء اعوانا وانصارا يكثر عددهم ويرجي النصر والظفر بمثلهم ، لان الشبهة في فعلهم وبغيهم كانت زايلة عن جميع الاماثل وذوي البصائر ، ولم يشتبه امرهم إلا على اغنام وطغام ولا إعتبار بهم ولا فكر في نصرة مثلهم. فتعين الغرض في قتالهم ومجاهدتهم للأسباب التي ذكرناها. وليس هذا ولا شئ منه موجودا فيمن تقدم ، بل الامر فيه بالعكس مما ذكرناه لان الجمهور والعدد الجم الكثير ، كانوا على موالاتهم وتعظيمهم وتفضيلهم وتصويبهم في اقوالهم وافعالهم. فبعض للشبهة وبعض للانحراف عن أمير المؤمنين عليه السلام والحبة لخروج الامر عنه ، وبعض لطلب الدنيا وحطامها ونيل الرياسات فيها. فمن جمع بين الحالتين وسوى بين الوقتين كمن جمع بين المتضادين. وكيف يقال هذا ويطلب منه (عليه السلام) من الانكار على من تقدم مثل ما وقع منه (عليه السلام) متأخرا في صفين والجمل ، وكل من حارب معه (عليه السلام) في هذه الحروب ، إلا القليل كانوا قائلين بإمامة المتقدمين عليه (عليه السلام) ومنهم من يعتقد تفضيلهم على سائر الامة ، فكيف يستنصر ويتقوى في اظهار الانكار على من تقدم بقوم هذه صفتهم ، وابن الانكار على معاوية وطلحة وفلان وفلان من الانكار على ابي بكر وعمر وعثمان لولا الغفلة والعصبية، ولو انه (عليه السلام) يرجو في حرب الجمل وصفين وسائر حروبه ظفرا ، وخاف من ضرر في الدين عظيم هو اعظم مما ينكره ، لما كان إلا ممسكا ومحجما كسنته فيمن تقدم.
فأما البيعة فإن اريد بها الرضا والتسليم ، فلم يبايع امير المؤمنين عليه السلام القوم بهذا التفسير على وجه من الوجوه. ومن ادعى ذلك كانت عليه الدلالة ، فإنه لا يجدها. وان اريد بالبيعة الصفقة واظهار الرضا ، فذلك مما وقع منه (عليه السلام) ، لكن بعد مطل شديد وتقاعد طويل علمهما الخاص والعام. وانما دعاه إلى الصفقة واظهار التسليم ما ذكرناه من الامور التي بعضها يدعو إلى مثل ذلك. في حضوره مجالسهم :
واما حضور مجالسهم فما كان عليه الصلاة والسلام ممن يتعمدها ويقصدها ، وانما كان يكثر الجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فيقع الاجتماع مع القوم هنا ، وذلك ليس بمجلس لهم مخصوص. وبعد ، فلو تعمد حضور مجالسهم لينهى عن بعض ما يجري فيها من منكر فإن القوم قد كانوا يرجعون إليه في كثير من الامور ، لجاز ولكان للحضور وجه صحيح له بالدين علقه قوية. فأما الدخول في آرائهم ، فلم يكن عليه السلام ممن يدخل فيها إلا مرشدا لهم ومنبها على بعض ما شذ عنهم ، والدخول بهذا الشرط واجب.
أما الصلاة خلفهم فقد علمنا ان الصلاة على ضربين : صلاة مقتد مؤتم بإمامه على الحقيقة ، وصلاة مظهر للاقتداء والائتمام وان كان لا ينويها فإن ادعي على امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام انه صلى ناويا للاقتداء ، فيجب ان يدلوا على ذلك ، فإنا لا نسلمه ولا هو الظاهر الذي لا يمكن النزاع فيه. وان ادعوا صلاة مظهر للاقتداء فذلك مسلم لهم ، لأنه الظاهر. إلا انه غير نافع فيما يقصدونه ، ولا يدل على خلاف ما يذهب إليه في امره (عليه السلام) ، فلم يبق إلا ان يقال فما العلة في اظهار الاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به؟ فالعلة في ذلك غلبة القوم على الامر وتمكنهم من الحل والعقد ، لان الامتناع من اظهار الاقتداء بهم مجاهرة ومنابذة ، وقد قلنا فيما يؤدي ذلك إليه في ما فيه كفاية
فأما أخذه الاعطية فما اخذ عليه السلام إلا حقه ولا سأل على من اخذ ما يستحقه ، اللهم الا ان يقال ان ذلك المال لم يكن وديعة له (عليه السلام) في أيديهم ولا دينا في ذممهم ، فيتعين حقه ويأخذه كيف شاء وأنى شاء. لكن ذلك المال انما يكون حقا له إذا كان الجابي لذلك المال والمستفيد له ممن قد سوغت الشريعة جبايته وغنيمته ، ان كان من غنيمة. والغاصب ليس له ان يغنم ولا ان يتصرف التصرف المخصوص الذي يفيد المال. عن ذلك انا نقول : ان تصرف الغاصب لأمر الامة إذا كان عن قهر وغاية ، وسوغت الحال للامة الامساك عن النكير خوفا وتقية يجري في الشرع مجرى تصرف المحق في باب جواز اخذ الاموال التي تفئ على يده ، ونكاح السبي وما شاكل ذلك. وان كان هو لذلك الفعل موزورا معاقبا ، وهذا بعينه عليه نص عن ائمتنا عليهم السلام لما سئلوا عن النكاح في دول الظالمين والتصرف المخصوص
فأما ما ذكر في السؤال من نكاح السبي فقد قلنا في هذا الباب ما فيه كفاية لو اقتصرنا عليه لكنا نزيد في الامر وضوحا ، بأن نقول ليس المشار بذلك فيه الا إلى الحنفية ام محمد رضي الله عنه ، وقد ذكرنا في كتابنا المعروف بالشافي انه عليه السلام لم يستبحها بالسبي بل نكحها ومهرها ، وقد وردت الرواية من طريق العامة فضلا عن طريق الخاصة بهذا بعينه فان البلاذري روى في كتابه المعروف بتاريخ الاشراف ، عن علي بن المغيرة بن الاثرم وعباس بن هشام الكلبي ، عن هشام عن خراش بن اسمعيل العجلي ، قال اغارت بنو أسد على بني حنيفة فسبوا خولة بنت جعفر وقدموا بها المدينة في أول خلافة ابي بكر ، فباعوها من علي عليه الصلاة والسلام ، وبلغ الخبر قومها فقدموا المدينة على علي عليه السلام فعرفوها واخبروه بموضعها منهم ، فاعتقها ومهرها وتزوجها ، فولدت له محمدا وكناه أبا القاسم. قال وهذا هو الثبت لا الخبر الاول ، يعني بذلك خبرا رواه عن المدايني ، انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن ، فأصاب خولة في بني زبيدة وقد ارتدوا مع عمرو بن معد يكرب ، وصارت في سهمه ، وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : ان ولدت منك غلاما فسمه بإسمي وكنه بكنيتي ، فولدت له (عليه السلام) بعد موت فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فسماه محمدا وكناه أبا القاسم. وهذا الخبر إذا كان صحيحا لم يبق سؤال في باب الحنفية.
فأما انكاحه عليه السلام اياها ، فقد ذكرنا في كتابنا الشافي ، الجواب عن هذا الباب مشروحا ، وبينا انه (عليه السلام) ما أجاب عمر إلى انكاح بنته إلا بعد توعد وتهدد ومراجعة ومنازعة بعد كلام طويل مأثور ، اشفق معه من شؤون الحال ظهور ما لا يزال يخفيه منها ، وان العباس رحمة الله عليه لما رأى ان الامر يفضي إلى الوحشة ووقوع الفرقة سأله (عليه السلام) رد أمرها إليه ففعل ، فزوجها منه. وما يجري على هذا الوجه معلوم معروف انه على غير اختيار ولا إيثار. وبينا في الكتاب الذي ذكرناه انه لا يمتنع ان يبيح الشرع ان يناكح بالإكراه ممن لا يجوز مناكحته مع الاختيار ، لا سيما إذا كان المنكح مظهرا للإسلام والتمسك بسائر الشريعة. وبينا أن العقل لا يمنع من مناكحة الكفار على سائر انواع كفرهم ، وانما المرجع فيما يحل من ذلك أو يحرم إلى الشريعة. وفعل امير المؤمنين عليه السلام اقوى حجة في احكام الشرع ، وبينا الجواب عن الزامهم لنا ، فلو اكره على انكاح اليهود والنصارى لكان يجوز ذلك ، وفرقنا بين الامرين بأن قلنا إن كان السؤال عما في العقل فلا فرق بين الامرين ، وان كان عما في الشرع فالإجماع يحظر ان تنكح اليهود على كل حال. وما اجمعوا على حظر نكاح من ظاهره الاسلام وهو على نوع من القبيح لكفر به ، إذا اضطررنا إلى ذلك واكرهنا عليه. فإذا قالوا فما الفرق بين كفر اليهودي وكفر من ذكرتم؟ قلنا لهم : وأي فرق بين كفر اليهودية في جواز نكاحها عندكم وكفر الوثنية.
فأما الدخول في الشورى فقد بينا في كتابنا المقدم ذكره الكلام فيه مستقصى ، ومن جملته انه عليه السلام لولا الشورى لم يكن ليتمكن من الاحتجاج على القوم بفضائله ومناقبه. والاخبار الدالة على النص بالإمامة عليه ، وبما ذكرناه في الامور التي تدل على ان اسبابه إلى الامامة اقوى من أسبابهم ، وطرقه إلى تناولها اقرب من طرقهم ، ومن كان يصغي لولا الشورى إلى كلامه المستوفى في هذا المعنى. وأي حال لولاها لكانت يقتضي ذكر ما ذكره من المقامات والفضائل ، ولو لم يكن في الشورى من الغرض الا هذا وحده لكان كافيا مغنيا. وبعد ، فان المدخل له في الشورى هو الحامل له على اظهار البيعة للرجلين ، والرضا بإمامتهما وامضاء عقودهما ، فكيف يخالف في الشورى ويخرج منها وهي عقد من عقود من لم يزل (عليه السلام) ممضيا في الظاهر لعقوده حافظا لعهوده ، وأول ما كان يقال له انك انما لا تدخل في الشورى لاعتقادك ان الامامة اليك ، وان اختيار الامة للإمام بعد الرسول باطل ، وفي هذا ما فيه. والامتناع من الدخول يعود إليه ، ويحمل عليه. وقد قال قوم من أصحابنا انه انما دخل فيها تجويز ان ينال الامر منها. ومعلوم ان كل سبب ظن معه ، أو جواز الوصول إلى الامر الذي قد تعين عليه القيام به يلزمه (عليه السلام) التوصل به الهجرة له. وهذه الجملة كافية في الجواب عن جميع ما تضمنه السؤال.
(مسألة) : فإن قيل : إذا كنتم تروون عنه (عليه السلام) وتدعون عليه في احكام الشريعة مذاهب كثيرة لا يعرفها الفقهاء له مذهبا ، وقد كان عليه السلام عندكم يشاهد الامر يجري بخلافها ، فإلا افتى بمذاهبه ونبه عليها وارشد إليها. وليس لكم ان تقولوا انه (عليه السلام) استعمل التقية كما استعملها فيما تقدم ، لأنه (عليه السلام) قد خالفهم في مذاهب استبد بها وتفرد بالقول فيها ، مثل قطع السارق من الاصابع ، وبيع امهات الاولاد ، ومسائل في الحدود ، وغير ذلك مما مذهبه (عليه السلام) فيه إلى الآن معروف. فكيف اتقى في بعض وأمن في آخر؟ وحكم الجميع واحد في انه خلاف في احكام شرعية لا يتعلق بإمامة ولا تصحيح نص ولا ابطال اختيار؟
(الجواب) : قلنا : لم يظهر امير المؤمنين عليه السلام في احكام الشريعة خلافا للقوم إلا بحيث كان له موافق وان قل عدده ، أو بحيث علم ان الخلاف لا يؤول إلى فساد ولا يقتضي إلى مجاهرة ولا مظاهرة. وهذه حال يعلمها الحاضر بالمشاهدة أو يغلب على ظنه فيها ما لا يعلمه الغائب ولا يظنه ، واستعمال القياس فيما يؤدي إلى الوحشة بين الناس ونفار بعضهم من بعض لا يسوغ ، لانا قد نجد كثيرا من الناس يستوحشون في ان يخالفوا في مذهب من المذاهب غاية الاستيحاش ، وان لم يستوحشوا من الخلاف فيما هو اعظم منه وأجل موقعا ، ويغضبهم في هذا الباب الصغير ولا يغضبهم الكبير. وهذا انما يكون لعادات جرت وأسباب استحكمت ، ولاعتقادهم ان بعض الامور وان صغر في ظاهره ، فإنه يؤدي إلى العظائم والكبائر. أو لاعتقادهم ان الخلاف في بعض الاشياء وان كان في ظاهر الامر كالخلاف في غيره ، لا يقع الا مع معاند منافس. وإذا كان الامر على ما ذكرناه لم ينكر أن يكون امير المؤمنين (عليه السلام) انما لم يظهر في جميع مذاهبه التي خالف فيها القوم اظهارا واحدا ، لأنه (عليه السلام) علم أو غلب في ظنه ان اظهار ذلك يؤدي من المحتمل الضرر في الدين إلى ما لا يؤدي إليه اظهار ما اظهره ، وهذا واضح لمن تدبره. وقد دخل في جملة ما ذكرناه الجواب عن قولهم : لم لم يغير الاحكام ويظهر مذاهبه ، وما كان مخبوا في نفسه عند افضاء الامر إليه وحصول الخلافة في يديه ، فإنه لا تقية على من هو أمير المؤمنين وإمام جميع المسلمين ، لانا قد بينا ان الامر ما افضى إليه (عليه السلام) إلا بالاسم دون المعنى ، وقد كان عليه السلام معارضا منازعا مغصصا طول ايام ولايته إلى ان قبضه الله تعالى إلى جنته ، وكيف يأمن في ولايته الخلاف على المتقدمين عليه (عليه السلام) رجل من تابعه وجمهورهم شيعة اعدائه (عليه السلام). ومن يرى انهم مضوا على اعدل الامور وأفضلها ، وأن غاية من يأتي بعدهم ان يتبع آثارهم ويقتفي طرائقهم. وما العجب من ترك امير المؤمنين عليه السلام ما ترك من اظهار بعض مذاهبه التي كان الجمهور يخالفه فيها ، وانما العجب من اظهار شئ من ذلك مع ما كان عليه من شر الفتنة وخوف الفرقة ، وقد كان (عليه السلام) يجهر في كل مقام يقومه بما هو عليه من فقد التمكن وتقاعد الانصار وتخاذل الاعوان ، بما ان ذكرنا قليله طال به الشرح وهو (عليه السلام) القائل : «والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين اهل الانجيل بانجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم ، حتى يظهر كل كتاب من هذه الكتب ويقول يا رب ان عليا قد قضى بقضائك». وهو القائل عليه السلام وقد استأذنه قضاته فقالوا بم نقضي يا امير المؤمنين فقال (عليه السلام) : «اقضوا بما كنتم تقضون حتى يكون الناس جماعة أو اموت كما مات اصحابي» يعني (عليه السلام) من تقدم موته من اصحابه والمخلصين من شيعته الذين قبضهم الله تعالى وهم على احوال التقية والتمسك باطنا بما أوجب الله جل اسمه عليهم التمسك به. وهذا واضح فيما قصدناه. وقد تضمن كلامنا هذا الجواب عن سؤال من يسأل عن السبب في امتناعه عليه السلام من رد فدك إلى يد مستحقها لما افضى التصرف في الامامة إليه (عليه السلام).
(مسألة) : فان قيل : فما الوجه في تحكيمه عليه السلام أبا موسى الاشعري وعمرو بن العاص؟ وما العذر في ان حكم في الدين الرجال. وهذا يدل على شكه في امامته وحاجته إلى علمه بصحة طريقته؟ ثم ما الوجه في تحكيمه فاسقين عنده عدوين له. أو ليس قد تعرض لذلك ان يخلعا امامته ويشككا الناس فيه وقد مكنهما من ذلك بأن حكمهما ، وكانا غير متمكنين منه ولا أقوالهما حجة في مثله؟ ثم ما العذر في تأخره جهاد المرقة الفسقة وتأجيله ذلك مع امكانه واستظهاره وحضور ناصره؟ ثم ما الوجه في محو اسمه من الكتاب بالإمامة وتنظيره لمعاوية في ذكر نفسه بمجرد الاسم المضاف إلى الاب كما فعل ذلك به ، وانتم تعلمون ان بهذه الامور ضلت الخوارج مع شدة تخشنها في الدين وتمسكها بعلائقه ووثايقه؟. (الجواب) : قلنا كل أمر ثبت بدليل قاطع غير محتمل فليس يجوز ان نرجع عنه ونتشكك فيه لأجل امر محتمل ، وقد ثبت امامة أمير المؤمنين عليه السلام وعصمته وطهارته من الخطأ وبراءته من الذنوب والعيوب بادله عقلية وسمعية ، فليس يجوز ان نرجع عن ذلك اجمع ، ولا عن شئ منه ، لما وقع من التحكيم للصواب بظاهره ، وقبل النظر فيه كاحتماله للخطأ ولو كان ظاهره اقرب إلى الخطأ وأدنى إلى مخالفة الصواب ، بل الواجب في ذلك القطع على مطابقة ما ظهر من المحتمل لما ثبت بالدليل ، أو صرف ماله ظاهر عن ظاهره ، والعدول به إلى موافقة مدلول الدلالة التي لا يختلف مدلولها ولا يتطرق عليها التأويل. وهذا فعلنا فيما ورد من آي القرآن التي تخالف بظاهرها الادلة العقلية مما يتعلق به الملحدون أو المجبرة أو المشبهة ، وهذه جملة قد كررنا ذكرها في كتابنا هذا لجلالة موقعها من الحجة ، ولو اقتصرنا في حل هذه الشبهة عليها لكانت مغنية كافية ، كما انها كذلك فيما ذكرناه من الاصول. لكننا نزيد وضوحا في تفصيلها ولا نقتصر عليها كما لم نفعل ذلك فيما صدرنا به هذا الكتاب من الكلام في تنزيه الانبياء عليهم السلام عن المعاصي. فنقول : إن امير المؤمنين عليه السلام ما حكم مختارا ، بل احوج إلى التحكيم وألجئ إليه لان اصحابه (عليه السلام) كانوا من التخاذل والتقاعد والتواكل إلا القليل منهم على ما هو معروف مشهور ، ولما طالت الحرب وكثر القتل وجل الخطب ملوا ذلك وطلبوا مخرجا من مقارعة السيوف ، واتفق من رفع أهل الشام المصاحف والتماسهم الرجوع إليها واظهارهم الرضا بما فيها ما اتفق ، بالحيلة التي نصبها عدو الله عمرو بن العاص ، والمكيدة التى كادبها لما احس بالبوار وعلو كلمة أهل الحق ، وأن معاوية وجنده مأخوذون قد علتهم السيوف ودنت منهم الحتوف ، فعند ذلك وجد هؤلاء الاغنام طريقا إلى الفرار وسبيلا إلى وقوف أمر المناجزة. ولعل فيهم من دخلت عليه الشبهة لبعده عن الحق وغلط فهمه ، وظن ان الذي دعى إليه أهل الشام من التحكيم وكف الحرب على سبيل البحث عن الحق الاستسلام للحجة لا على وجه المكيدة والخديعة ، فطالبوه عليه السلام بكف الحرب والرضا بما بذله القوم فامتنع (عليه السلام) من ذلك امتناع عالم بالمكيدة ظاهر على الحيلة ، وصرح لهم بأن ذلك مكر وخداع ، فأبوا ولجوا فأشفق (عليه السلام) في الامتناع عليهم والخلاف لهم وهم جم عسكره وجمهور اصحابه من فتنة صماء هي اقرب إليه من حرب عدوه ، ولم يأمن ان يعتدى ما بينه وبينهم إلى ان يسلموه إلى عدوه أو يسفكوا دمه ، فأجاب إلى التحكيم على مضض. ورد من كان قد اخذ بخناق معاوية وقارب تناوله وأشرف على التمكن منه ، حتى انهم قالوا للأشتر رحمه الله تعالى وقد امتنع من ان يكف عن القتال وقد احس بالظفر وايقن بالنصر ، أتحب انك ظفرت ها هنا وامير المؤمنين عليه السلام بمكانه قد سلم إلى عدوه وتفرق اصحابه عنه. وقال لهم امير المؤمنين عليه السلام عند رفعهم المصاحف اتقوا الله وامضوا على حقكم ، فإن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن وانا اعرف بهم منكم ، قد صحبتهم اطفالا ورجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال ، انهم والله ما رفعوا المصاحف ليعملوا بها وانما رفعوها خديعة ودهاء ومكيدة. فأجاب (عليه السلام) إلى التحكيم دفعا للشر القوي بالشر الضعيف ، وتلافيا للضرر الاعظم بتحمل الضرر الايسر ، وأراد ان يحكم من جهته عبدالله بن العباس رحمة الله عليه فأبوا عليه ولجوا كما لجوا في أصل التحكيم ، وقالوا لابد من يماني مع مضري. فقال (عليه السلام) فضموا الاشتر وهو يماني إلى عمرو ، فقال الاشعث بن قيس : الاشتر هو الذي طرحنا فيما نحن فيه. واختاروا أبا موسى مقترحين له (عليه السلام) ملزمين له تحكيمه ، فحكمهما بشرط ان يحكما بكتاب الله تعالى ولا يتجاوزاه ، وانهما متى تعدياه فلا حكم لهما. هذا غاية التحرز ونهاية التيقظ ، لانا نعلم انهما لو حكما بما في الكتاب لاصابا الحق. وعلمنا ان امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أولى بالأمر ، وانه لا حظ لمعاوية وذويه في شئ منه. ولما عدلا إلى طلب الدنيا ومكر أحدهما بصاحبه ونبذا الكتاب وحكمه وراء ظهورهما ، خرجا من التحكيم وبطل قولهما وحكمهما ، وهذا بعينه موجود في كلام امير المؤمنين عليه السلام لما ناظر الخوارج واحتجوا عليه في التحكيم. وكل ما ذكرناه في هذا الفصل من ذكر الاعذار في التحكيم والوجوه المحسنة له مأخوذة من كلامه عليه السلام. وقد روي ذلك عنه عليه السلام مفصلا مشروحا.
فأما تحكيمهما مع علمه بفسقهما فلا سؤال فيه ، إذ كنا قد بينا ان الاكراه وقع على اصل الاختيار وفرعه ، وأنه عليه السلام ألجئ إليه جملة ثم إلى تفصيله ، ولو خلى عليه السلام واختياره ما أجاب إلى التحكيم اصلا ، ولا رفع السيوف عن أعناق القوم. لكنه أجاب إليه ملجأ كما اجاب إلى ما اختاروه بعينه كذلك. وقد صرح (عليه السلام) بذلك في كلامه حيث يقول : لقد أمسيت أميرا واصبحت مأمورا ، وكنت أمس ناهيا وأصبحت اليوم منهيا.
وكيف يكون التحكيم منه (عليه السلام) دالا على الشك ، وهو (عليه السلام) ناه عنه وغير راض به ومصرح بما فيه من الخديعة؟ وانما يدل على شك من حمله عليه وقاده إليه ، وانما يقال ان التحكيم يدل على الشك إذا كنا لا نعرف سببه والحامل عليه ، أو كان لا وجه له إلا ما يقتضي الشك. فأما إذا كنا قد عرفنا ما اقتضاه وادخل فيه ، وعلمنا انه (عليه السلام) ما أجاب عليه إلا لدفع الضرر العظيم ، ولان تزول الشبهة عن قلب من ظن به (عليه السلام) أنه لا يرضى بالكتاب ولا يجيب إلى تحكيمه ، فلا وجه لما ذكروه. وقد أجاب (عليه السلام) عن هذه الشبهة بعينها في مناظرتهم لما قالوا له : اشككت؟ فقال عليه السلام : أنا اولى بأن لا أشك في دينى أم النبي صلى الله عليه وآله؟ أو ما قال الله تعالى لرسوله : {قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [القصص: 49] واما قول السائل ، فإنه (عليه السلام) تعرض لخلع امامته ومكن الفاسقين من ان يحكما عليه بالباطل ، فمعاذ الله ان يكون كذلك ، لانا قد بينا انه (عليه السلام) انما حكمهما بشرط لو وفيا به وعملا عليه ، لأقرا امامته واوجبا طاعته ، لكنهما عدلا عنه فبطل حكمهما ، فما مكنهما من خلع امامته ولا تعرض منهما لذلك. ونحن نعلم ان من قلد حاكما أو ولى اميرا ليحكم بالحق ويعمل بالواجب فعدل عما شرط عليه وخالفه ، لا يسوغ القول بأن من ولاه عرضه لباطل ومكنه من العدول عن الواجب ، ولم يلحقه شئ من اللوم بذلك ، بل كان اللوم عائدا على من خالف ما شرط عليه.
فأما تأخيره جهاد الظالمين وتأجيل ما يأتي من استيصالهم ، فقد بينا العذر فيه ، وان اصحابه (عليه السلام) تخاذلوا وتواكلوا واختلفوا ، وان الحرب بلا أنصار وبغير اعوان لا يمكن. والمتعرض لها مغرر بنفسه وأصحابه.
فأما عدوله عن التسمية بأمير المؤمنين واقتصاره على التسمية المجردة ، فضرورة لحال دعت إليها. وقد سبق إلى مثل ذلك سيد الاولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وآله في عام الحديبية ، وقصته مع سهل بن عمرو ، وأنذره عليه السلام بأنه : ستدعى إلى مثل ذلك وتجيب على مضض. فكان كما أنذر وخبر رسول الله صلى الله عليه وآله. واللوم بلا اشكال زايل عما اقتدى فيه بالرسول صلى الله عليه وآله. وهذه جملة تفصيلها يطول ، وفيها لمن انصف من نفسه بلاغ وكفاية.
(مسألة) : فان قيل فإذا كان عليه السلام من أمر التحكيم على ثقة ويقين فلم روي عنه (عليه السلام) انه كان يقول بعد التحكيم في مقام بعد آخر : لقد عثرت عثرة لا تنجبر * سوف اكيس بعدها واستمر واجمع الرأي الشتيت المنتشر أو ليس هذا اذعانا بأن التحكيم جرى على خلاف الصواب؟
(الجواب) : قلنا قد علم كل عاقل قد سمع الاخبار ضرورة ان أمير المؤمنين عليه السلام وأهله وخلصاء شيعته وأصحابه كانوا من أشد الناس اظهارا لوقوع التحكيم من الصواب والسداد موقعه ، وان الذي دعي إليه حسن ، والتدبير اوجبه ، وأنه (عليه السلام) ما اعترف قط بخطأ فيه ولا اغضى عن الاحتجاج على من شك فيه وضعفه ، كيف والخوارج انما ضلت عنه وعصته وخرجت عليه ، لأجل انها ارادته على الاعتراف بالزلل في التحكيم فامتنع كل امتناع وأبي اشد اباء وقد كانوا يقنعون منه ويعاودون طاعته ونصرته بدون هذا الذي اضافوه إليه (عليه السلام) من الاقرار بالخطأ واظهار الندم. وكيف يمتنع من شئ ويعترف بأكثر منه ، ويغصب من جزء ويجيب إلى كل هذا مما لا يظن به احد ممن يعرفه حق معرفته. وهذا الخبر شاذ ضعيف ، فإما ان يكون باطلا موضوعا أو يكون الغرض فيه غير ما ظنه القوم من الاعتراف بالخطأ في التحكيم. فقد روي عنه عليه السلام معنى هذا الخبر وتفسير مراده منه ، ونقل من طرق معروفة موجودة في كتب اهل السير ، انه عليه السلام لما سئل عن مراده بهذا الكلام ، قال كتب الي محمد بن ابي بكر بأن اكتب له كتابا في القضاء يعمل عليه ، فكتبت له ذلك وانفذته إليه ، فاعترضه معاوية فأخذه ، فأسف (عليه السلام) على ظفر عدوه بذلك ، واشفق من أن يعمل بما فيه من الاحكام ، وتوهم ضعفة اصحابه ان ذلك من علمه ومن عنده ، فتقوى الشبهة به عليهم. وهذا وجه صحيح يقتضي التأسف والتندم ، وليس في الخبر المتضمن للشعر ما يقتضي ان تندمه كان على التحكيم دون غيره. فإذا جاءت رواية بتفسير ذلك عنه (عليه السلام) ، كان الاخذ بها اولى.
(مسألة) : فإن قيل فما الوجه فيما فعله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عند حربه للخوارج يوم النهروان من رفعه رأسه إلى السماء ناظرا إليها تارة والى الارض أخرى وقوله (عليه السلام) : والله ما كذبت ولا كذبت. فلما قتلهم وفرغ من الحرب ، قال له ابنه الحسن (عليه السلام) : يا أمير المؤمنين أكان رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم اليك في هؤلاء بشئ؟. قال : لا ولكن أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله بكل حق ، ومن الحق أن أقاتل المارقين والناكثين والقاسطين. أو ليس قد تعلق بهذا النظام في كتابه المعروف بالنكت. وقال هذا توهيم منه (عليه السلام) لأصحابه أن رسول الله قد تقدم إليه في أن الخوارج سيخالفوه ويقتلهم ، إذ يقول والله ما كذبت ولا كذبت.
(الجواب) : إنا لا ندري كيف ذهب على النظام كذب هذه الرواية ، يعني التضمنة لقوله (عليه السلام) انه لم يتقدم الرسول إليه في ذلك بشئ ، إن كان النظام رواها ونقلها ، ام كيف استجاز ان يضيفها إليه (عليه السلام) ان كان تخرصها؟ وكيف ظن ان مثل ذلك يخفى على احد مع ظهور الحال وتواتر الروايات عنه عليه السلام بالإنذار لقتال أهل النهروان وكيفيته ، والاشعار بقتل المخدج ذي الثدية ، وإنما كان عليه السلام ينظر إلى السماء ثم إلى الارض ويقول ما كذبت ولا كذبت استبطاء لوجود المخدج ، لأنه (عليه السلام) عند قتل القوم أمر بطلبه في جملة القتلى ، فلما طال الامر في وجوده واشفق (عليه السلام) من وقوع شبهة من ضعفة اصحابه فيما كان يخبر به وينذر من وجوده فقلق (عليه السلام) لذلك واشتد همه وكرر قوله ما كذبت ولا كذبت ، إلى ان اتاح الله وجوده والظفر به بين القتلى على الهيئة التي كان (عليه السلام) ذكرها ، فلما احضروه اياه كبر (عليه السلام) واستبشر بزوال الشبهة في صحة خبره. وقد روى من طرق مختلفة وجهات كثيرة عنه (عليه السلام) الانذار بقتال الخوارج وقتل المخدج على صفته التي وجد عليها ، وأنه عليه السلام كان يقول لأصحابه أنهم لا يعبرون النهر حتى يصرعوا دونه ، وأنه لا يقتل من أصحابه إلا دون العشرة ، ولا يبقى من الخوارج إلا دون العشرة ، حتى أن رجلا من اصحابه قال له يا أمير المؤمنين ذهب القوم وقطعوا النهر. فقال (عليه السلام) لا والله ما قطعوه ولا يقطعونه حتى يقتلوا دونه عهدا من الله ورسوله. فكيف يستشعر عاقل ان ذلك من غير علم ولا اطلاع من الرسول صلى الله عليه وآله على وقوعه وكونه. وقد روي عن ابن ابي عبيدة اليماني لما سمعه (عليه السلام) يخبر عن النبي صلى الله عليه وآله بقتال الخوارج قبل ذلك بمدة طويلة وقتل المخدج ، شك فيه لضعف بصيرته فقال له : أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك؟ فقال أي ورب الكعبة مرات. وقد روي أمر الخوارج وقتال أمير المؤمنين عليه السلام لهم وانذار الرسول صلى الله عليه وآله بذلك جماعة من الصحابة ، لولا ان في ذكر ذلك خروجا عن غرض الكتاب لذكرناه ، حتى أن عائشة روت ذلك فيما رفعه عامر عن مسروق قال : دخلت على عائشة ، فقالت من قتل الخوارج؟ قلت قتلهم علي بن ابي طالب عليه السلام. فسكتت. فقلت لها يا امة اسألك بحق الله وحق نبيه وحقي ، فإني لك ولد إن كنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيهم شيئا لما اخبرتنيه. قالت سمعت رسول الله يقول هم شر الخلق والخليقة يقتلهم خير الخلق والخليقة وأقربهم عند الله وسيلة. وعن مسروق ايضا عن عائشة أنها قالت من قتل ذا الثدية؟ قلت علي بن ابي طالب. قالت لعن الله عمرو بن العاص ، فإنه كتب الي يخبرني انه قتله بالإسكندرية ، إلا انه لا يمنعني ما في نفسي ان أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله فيه سمعته يقول يقتلهم خير امتي بعدي. وروى فضالة بن ابي فضيلة وهو ممن كان شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بدرا ، قال اشتكى امير المؤمنين عليه السلام بينبع شكاة ثقل منها ، فخرج ابي يعوده ، فخرجت معه ، فلما دخل عليه قال لا تخرج إلى المدينة ، فإن اصابك اجلك شهدك اصحابك وصلوا عليك وإنك هاهنا بين ظهراني اعراب جهينة. فقال عليه السلام اني لا اموت من مرضي هذا لأنه فيما عهده الي رسول الله صلى الله عليه وآله اني لا اموت حتى أؤمر واقتل الناكثين والقاسطين والمارقين ، وحتى تخضب هذه من هذا وأشار (عليه السلام) إلى لحيته ورأسه. وذكر المروي في هذا الباب يطول والامر في اخباره عليه السلام بقصة الخوارج وقتاله (عليه السلام) لهم وانذاره بذلك ظاهرا جدا.
(مسألة) : فإن قيل فما الوجه فيما روي عنه عليه السلام من قوله : إذا حدثتكم عن رسول الله بحديث فهو كما حدثتكم ، فوالله لان أخر من السماء احب الي من أن اكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا سمعتموني احدث فيما بيني وبينكم ، فإنما الحرب خدعة. وأليس هذا مما نفاه النظام ايضا وقال لم يحدثهم عن رسول الله بالمعاريض لما اعتذر من ذلك ، وذكر ان هذا يجري مجرى التدليس في الحديث.
(الجواب) : قلنا ان امير المؤمنين عليه السلام لفرط احتياطه بالدين وتخشنه فيه وعلمه بأن المخبر ربما دعته الضرورة إلى ترك التصريح واستعمال التعريض ، أراد ان يميز للسامعين بين الامرين ويفصل لهم بين ما لا يدخل فيه التعريض من كلامه مما باطنه كظاهره ، وبين ما يجوز ان يعرض فيه للضرورة ، وهذا نهاية الحكمة منه وازالة اللبس والشبهة ، ويجري البيان والايضاح بالضد فيما يوهمه النظام من دخوله في باب التدليس في الحديث ، لان المدلس يقصد إلى الابهام ويعدل عن البيان والايضاح طلبا لتمام غرضه. وهو عليه السلام ميز بين كلامه وفرق بين انواعه حتى لا تدخل الشبهة فيه على احد. واعجب من هذا كله قوله انه لو لم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالمعاريض لما اعتذر من ذلك ، لأنه ما اعتذر كما ظنه ، وانما نفى ان يكون التعريض مما يدخل روايته عن رسول الله. كما انه ربما دخل ما يخبر به عن نفسه قصدا للإيضاح ، ونفي الشبهة. وليس كل من نفى عن نفسه شيئا واخبر عن براءته منه فقد فعله. وقوله عليه السلام لان أخر من السماء يدل على انه ما فعل ذلك ولا يفعله ، وإنما نفاه حتى لا يلتبس على احد خبره عن نفسه ، ومما يجوز فيه مما يرويه ويسنده إلى رسول الله.
(مسألة) : فإن قيل فما الوجه فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام من انه قال كنت إذا حدثني احد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بحديث استحلفته بالله أنه سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله فإن حلف صدقته وإلا فلا. وحدثني ابو بكر وصدقني ، أو ليس هذا الخبر مما طعن به النظام وقال لا يخلو المحدث عنده من ان يكون ثقة أو متهما. فإن كان ثقة فما معنى الاستحلاف؟ وان كان متهما فكيف يتحقق قول المتهم بيمينه؟ وإذا جاز ان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالباطل جاز ان يحلف على ذلك بالباطل؟
(الجواب) : قلنا هذا خبر ضعيف مدفوع مطعون على اسناده ، لان عثمان بن المغيرة رواه عن علي بن ربيعة الوالبي عن اسماء بن الحكم الفزاري. قال سمعت عليا عليه السلام يقول كذا وكذا واسماء بن الحكم هذا مجهول عند اهل الرواية لا يعرفونه ولا روي عنه شئ من الاحاديث غير هذا الخبر الواحد. وقد روي ايضا من طريق سعد بن سعيد بن ابي سعيد المقري عن اخيه عن جده ابي سعيد رواه هشام بن عمار والزبير بن بكار عن سعد بن سعيد بن ابي سعيد عن اخيه عبدالله بن سعيد عن جده عن امير المؤمنين عليه السلام. وقال الزبير عن سعد بن سعيد أنه ما ارى اخبث منه. وقال أبو عبدالرحمن الشيباني : عبدالله بن سعيد بن ابي سعيد المقري متروك الحديث. وقال يحيى بن معين انه ضعيف. ورووه من طريق ابي المغيرة المخزومي عن ابن نافع عن سليمان بن يزيد عن المقري وابو مغيرة المخزومي مجهول لا يعرفه اكثر اهل الحديث. ورووه من طريق عطا بن مسلم عن عمارة عن محرز عن ابي هريرة عن امير المؤمنين عليه السلام قالوا : محرز لم يسمع من امير المؤمنين (عليه السلام) بل لم يره وعمارة وهو عمارة بن حريز وهو ابن هرون العبدي ، قيل أنه متروك الحديث. ومما ينبئ عن ضعف هذا الحديث واختلاله ان من المعروف الظاهر أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يرو عن احد قط حرفا غير النبي صلى الله عليه وآله. واكثر ما يدعى عليه من ذلك هذا الخبر الذي نحن في الكلام عليه. وقوله ما حدثني احد عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلا استحلفته ، يقتضي ظاهره أنه قد سمع اخبارا عنه (عليه السلام) من جماعة من الصحابة. والمعلوم خلاف ذلك. واما تعجب النظام من الاستحلاف ففي غير موضعه ، لانا نعلم ان في عرض اليمين تهيبا لمن عرضت عليه وتذكيرا بالله تعالى وتخويفا من عقابه ، سواء كان من تعرض والاقدام عليها يزيدنا في الثقة بصيرة ، وربما قوى ذلك حال الظنين لبعد الاقدام على اليمين الفاجرة ، ولهذا نجد كثيرا من الجاحدين للحقوق متى عرضت عليهم اليمين امتنعوا منها وأقروا بها بعد الجحود واللجاج. ولهذا استظهر في الشريعة باليمين على المدعى عليه ، وفي القاذف زوجته بالتلفظ باللعان. ولو أن ملحدا أراد الطعن على الشريعة واستعمل من الشبهة ما استعمله النظام ، فقال اي معنى لليمين في الدعاوى ، والمستحلف ان كان ثقة فلا معنى لإحلافه ، وان كان ظنينا متهما فهو بأن يقدم على اليمين اولى. وكذلك في القاذف زوجته لما كان له جواب إلا ما اجبنا به النظام ، وقد ذكرناه. وقد حكي عن الزبير بن بكار في هذا الخبر تأويل قريب وهو انه قال : كان ابو بكر وعمر إذا جاءهما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعرفانه لا يقبلاه حتى يأتي مع الذي ذكره آخر ، فيقوما مقام الشاهدين. قال فأقام امير المؤمنين عليه السلام اليمين مع دعوى المحدث مقام الشاهد مع اليمين في الحقوق ، كما اقاما الرواية في طلب شاهدين عليهما مقام باقي الحقوق. فان قيل أو ليس هذا الحديث إذا سلمتوه واخذتم في تأويله يقتضي ان أمير المؤمنين عليه السلام ما كان يعلم الشئ الذي يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وانه كان يستفيده إلا من المخبر ، ولولا ذلك لما كان لاستحلافه معنى؟ وهذا يوجب انه (عليه السلام) كان غير محيط بعلم الشريعة على ما يذهبون إليه؟.
قلنا : قد بينا الجواب عن هذه الشبهة في كتابنا الملقب بالشافي في الامامة ، وذكرنا انه (عليه السلام) وان كان عالما بصحة ما اخبره به المخبر ، وأنه من الشرع ، فقد يجوز ان يكون المخبر له به ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وآله ، وإن كان من شرعه ، ويكون كاذبا في ادعائه السماع ، فكان يستحلفه لهذه العلة. وقلنا أيضا لا يمتنع ان يكون ذلك انما كان منه (عليه السلام) في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وفي تلك الاحوال لم يكن محيطا بجميع الاحكام ، بل كان يستفيدها حالا بعد حال. فان قيل : كيف خص ابا بكر في هذا الباب بما لم يخص به غيره؟ قلنا : يحتمل ان يكون ابو بكر حدثه بما علم أنه سمعه من الرسول وحضر تلقيه له من جهته صلى الله عليه وآله ، فلم يحتج إلى استحلافه لهذا الوجه.
(مسألة) : فإن قيل فما الوجه فيما ذكره النظام في كتابه المعروف بالنكت من قوله العجب مما حكم به علي بن ابي طالب في حرب اصحاب الجمل ، لأنه (عليه السلام) قتل المقاتلة ولم يغنم ، فقال له قوم من اصحابه إن كان قتلهم حلالا فغنيمتهم حلال ، وإن كان قتلهم حراما فغنيمتهم حرام فكيف قتلت ولم تسب؟ فقال (عليه السلام) فأيكم يأخذ عائشة في سهمه؟ فقال قوم إن عائشة تصان لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ فنحن لا نغنمها ونغنم من ليس سبيله من رسول الله صلى الله عليه وآله سبيلها ، قال فلم يجبهم إلى شئ من ذلك. فقال له عبدالله بن وهب الراسبي : أليس قد جاز ان يقتل كل من حارب مع عائشة ولا تقتل عائشة؟ قال بلى قد جاز ذلك وأحله الله عز وجل. فقال له عبدالله بن وهب : فلم لا جاز ان نغنم غير عايشة ممن حاربنا ويكون غنيمة عايشة غير حلال لنا فيما تدفعنا عن حقنا. فأمسك (عليه السلام) عن جوابه وكان هذا أول شئ حقدته الشراة على علي عليه الصلاة والسلام؟
(الجواب) : قلنا ليس يشنع امير المؤمنين عليه السلام ويعترضه في الاحكام الا من قد اعمى الله قلبه وأضله عن رشده ، لأنه المعصوم الموفق المسدد على ما دلت عليه الادلة الواضحة. ثم لو لم يكن كذلك وكان على ما يعتقده المخالفون ، اليس هو الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وآله بأنه (عليه السلام) اقضي الامة واعرفها بأحكام الشريعة؟ وهو الذي شهد صلى الله عليه وآله له بأن الحق معه يدور كيف ما دار؟ فينبغي لمن جهل وجه شئ فعله (عليه السلام) ان يعود على نفسه باللوم ويقر عليها بالعجز والنقص ، ويعلم ان ذلك موافق للصواب والسداد ، وإن جهل وجهه وضل عن علته. وهذه جملة يغني التمسك بها عن كثير من التفصيل ، واستعمال كثير من التأويل. وأمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل اهل القبلة إلا بعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد صرح (عليه السلام) بذلك في كثير من كلامه الذي قد مضى حكاية بعضه ، ولم يسر فيهم إلا بما عهده إليه من السيرة. وليس بمنكر ان يختلف احكام المحاربين فيكون منهم من يقتل ولا يغنم. ومنهم من يقتل ولا يغنم. لان احكام الكفار في الاصل مختلفة مقاتلو امير المؤمنين عليه السلام عندنا كفار لقتالهم له. وإذا كان في الكفار من يقر على كفره ويؤخذ الجزية منه ، ومنهم من لا يقر على كفره ولا يقعد عن محاربته ، إلى غير ذلك مما اختلفوا فيه من الاحكام جاز ايضا ان يكون فيهم من يغنم ومن لا يغنم ، لان الشرع لا ينكر فيه هذا الضرب من الاختلاف. وقد روي ان مرتدا على عهد ابي بكر يعرف بعلانة ارتد ، فلم يعرض ابو بكر لما له. وقالت امرأته ان يكن علانة ارتد فانا لم نرتد. وروي مثل ذلك في مرتد قتل في ايام عمر بن الخطاب ، فلم يعرض لما له. وروي ان امير المؤمنين عليه السلام قتل مستوردا العجلي ولم يعرض لميراثه. فالقتل ووجوبه ليس بأمارة على تناول المال واستباحته ، على ان الذي رواه النظام من القصة محرف معدول عن الصواب ، والذي تظاهرت به الروايات ونقله أهل السير في هذا الباب من طرق مختلفة ، أن امير المؤمنين عليه السلام لما خطب بالبصرة وأجاب عن مسائل شتى سئل عنها ، واخبر بملاحم وأشياء تكون بالبصرة ، قام إليه عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال يا امير المؤمنين ان الناس يكثرون في أمر الفئ ويقولون من قاتلنا فهو وماله وولده فئ لنا. وقام رجل من بكر بن وايل يقال له عباد بن قيس ، فقال يا امير المؤمنين والله ما قسمت بالسوية ولا عدلت في الرعية ، فقال عليه السلام ولم ويحك؟ قال لأنك قسمت ما في العسكر وتركت الاموال والنساء والذرية. فقال امير المؤمنين (عليه السلام) : يا ايها الناس من كانت به جراحة فليداوها بالسمن. فقال عباد بن قيس جئنا نطلب غنائمنا فجاءنا بالترهات. فقال عليه السلام ان كنت كاذبا فلا اماتك الله حتى يدركك غلام ثقيف. فقال رجل يا امير المؤمنين ومن غلام ثقيف؟ فقال رجل لا يدع لله حرمة الا انتهكها. فقال له الرجل أيموت أو يقتل؟ فقال امير المؤمنين عليه السلام بل يقصمه قاصم الجبارين يخترق سريره لكثرة ما يحدث من بطنه ، يا أخا بكر انت امرؤ ضعيف الرأي ، أما علمت أنا لا نأخذ الصغير بذنب الكبير ، وان الاموال كانت بينهم قبل الفرقة يقسم ما حواه عسكرهم ، وما كان في دورهم فهو ميراث لذريتهم ، فإن عدا علينا احد اخذناه بذنبه ، وان كف عنا لم نحمل عليه ذنب غيره. يا أخا بكر والله لقد حكمت فيكم بحكم رسول الله صلى الله عليه وآله من أهل مكة قسم ما حواه العسكر ، ولم يعرض لما سوى ذلك. وانما اقتفينا اثره حذو النعل بالنعل. يا أخا بكر ، اما علمت ان دار الحرب يحل ما فيها ، ودار الهجرة محرم ما فيها إلا بحق ، مهلا مهلا رحمكم الله فإن انتم انكرتم ذلك علي ، فأيكم يأخذ أمه عايشة بسهمه؟ قالوا يا امير المؤمنين اصبت واخطأنا وعلمت وجهلنا ، أصاب الله بك الرشاد والسداد.
فاما قول النظام ان هذا اول ما حقدته الشراة عليه فباطل ، لان الشراة ما شكوا قط فيه عليه السلام ولا ارتابوا بشئ من افعاله قبل التحكيم الذي منه دخلت الشبهة عليهم ، وكيف يكون ذلك وهم الناصرون له بصفين والمجاهدون بين يديه والسافكون دماءهم تحت رايته. وحرب صفين كانت بعد الجمل بمدة طويلة فكيف يدعى ان الشك منهم في أمره كان ابتداءه في حرب الجمل لولا ضعف البصائر؟
(مسألة) : فإن قيل فما الوجه ذكره النظام من أن ابن جرموز لما أتى أمير المؤمنين عليه السلام برأس الزبير وقد قتله بوادي السباع ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : والله ما كان ابن صفية بجبان ، ولا لئيم ، لكن الحين ومصارع السوء. فقال ابن جرموز الجائزة يا أمير المؤمنين. فقال (عليه السلام) سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار. فخرج ابن جرموز وهو يقول :
أتيت عليا برأس الزبير * وكنت أرجى به الزلفة
فبشر بالنار قبل العيان * فبئس البشارة والتحفة
فقلت له ان قتل الزبير * لولا رضاك من الكلفة
فان ترض ذاك فمنك الرضا * وإلا فدونك لي حلفة
ورب المحلين والمحرمين * ورب الجماعة والالفة
لسيان عندي قتل الزبير * وضرطة عنز بذي الجحفة .
قال النظام ، وقد كان يجب على علي عليه السلام أن يقيده بالزبير وكان يجب على الزبير إذ بان أنه على خطأ أن يلحق يعلي فيجاهد معه .
(الجواب) : أنه لا شبهة في أن الواجب على الزبير أن يعدل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أو ينحاز إليه ويبذل نصرته لا سيما ان كان رجوعه على طريق التوبة والانابة. ومن أظهر ما أظهر من المباينة والمحاربة إذا تاب وتبين خطأه يجب عليه أن يظهر ضد ما كان أظهره لا سيما وأمير المؤمنين عليه السلام في تلك الحال مصاف لعدوه ومحتاج إلى نصرة من هو دون الزبير في الشجاعة والنجدة ، وليس هذا موضع إستقصاء ما يتصل بهذا المعنى وقد ذكرناه في كتابنا الشافي المقدم ذكره.
فأما أمير المؤمنين فإنما عدل أن يقيد ابن جرموز بالزبير لاحد أمرين : إن كان ابن جرموز قتله غدرا وبعد أن آمنه وقتله بعد أن ولى مدبرا ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام أمر أصحابه أن لا يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح فلما قتل ابن جرموز مدبرا كان بذلك عاصيا مخالفا لأمر إمامه ، فالسبب في أنه لم يقيده به أن أولياء الدم الذين هم أولاد الزبير لم يطالبوا بذلك ولا حكموا فيه وكان أكبرهم والمنظور إليه منهم عبدالله محاربا لأمير المؤمنين عليه السلام ، مجاهرا له بالعداوة والمشاقة فقد أبطل بذلك حقه ، لأنه لو أراد أن يطالب به لرجع عن الحرب وبايع وسلم ثم طالب بعد ذلك فانتصف له منه. وإن كان الامر الآخر وهو ان يكون إبن جرموز ما قتل الزبير الا مبارزة من غير غدر ولا أمان تقدم على ما ذهب إليه قوم ، فلا يستحق بذلك قودا ولا مسألة ها هنا في القود. فإن قيل فعلى هذا الوجه ما معنى بشارته بالنار؟ قلنا ، المعنى فيها الخبر عن عاقبة أمره ، لان الثواب والعقاب إنما يحصلان على عواقب الاعمال وخواتيمها ، وابن جرموز هذا خرج مع أهل النهروان على أمير المؤمنين عليه السلام ، فقتل هناك. فكان بذلك الخروج من أهل النار لا بقتل الزبير. فإن قيل : فأي فائدة لإضافة البشارة بالنار إلى قتل الزبير وقتله طاعة وقربة ، وإنما يجب ان تضاف البشارة بالنار إلى ما يستحق به النار قلنا : عن هذا جوابان : أحدهما : أنه (عليه السلام) أراد التعريف والتنبيه ، وإنما يعرف الانسان بالمشهور من أفعاله ، والظاهر من أوصافه ، وابن جرموز كان غفلا خاملا ، وكان فعله بالزبير من أشهر ما يعرف به مثله وهذا وجه في التعريف صحيح. والجواب الثاني : ان قتل الزبير إذا كان بإستحقاق على وجه الصواب من أعظم الطاعات وأكبر القربات ، ومن جرى على يده يظن به الفوز بالجنة ، فأراد (عليه السلام) أن يعلم الناس أن هذه الطاعة العظيمة التي يكثر ثوابها إذا لم تعقب بما يفسده غير نافعة لهذا القاتل ، وأنه سيأتي من فعله في المستقبل ما يستحق به النار ، فلا تظنوا به لما اتفق على يده من هذه الطاعة خيرا. وهذا يجري مجرى أن يكون لاحدنا صاحب خصيص به خفيف في طاعته مشهور بنصيحته ، فيقول هذا المصحوب بعد برهة من الزمان لمن يريد اطرافه وتعجبه : أو ليس صاحبي فلان الذى كانت له من الحقوق كذا وكذا ، وبلغ من الاختصاص بي إلى منزلة كذا قتلته وأبحت حريمه وسلبت ماله؟ وان كان ذلك انما استحقه بما تجدد منه في المستقبل ، وانما عرف بالحسن من أعماله على سبيل التعجب وهذا واضح.
(مسألة) : فإن قيل فما الوجه فيما عابه النظام به عليه السلام من الاحكام التي داعى أنه خالف فيها جميع الامة ، مثل بيع أمهات الاولاد وقطع يد السارق من أصول الاصابع ودفع السارق إلى الشهود ، وجلد الوليد بن عقبة أربعين سوطا في خلافة عثمان وجهره بتسمية الرجال في القنوت وقبوله شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، والله تعالى يقول : {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وأخذه (عليه السلام) نصف دية الرجل من أولياء المرأة وأخذه نصف دية العين من المقتص من الاعور وتخليفه رجلا يصلى العيدين بالضعفاء في المسجد الاعظم ، وأنه (عليه السلام) أحرق رجلا أتى غلاما في دبره ، وأكثره ما أوجب على من فعل هذا الفعل الرجم ، وأنه أوتى بمال من مهور البغايا فقال عليه السلام ارفعوه حتى يجئ عطاء غني وباهلة. فقال النظام لم خص بهذا غنيا وباهلة؟ فان كانوا مؤمنين فمن عداهم من المؤمنين كهم في جواز تناول هذا المال وان كانوا غير مؤمنين فكيف يأخذون العطاء مع المؤمنين؟ قال وذلك المال وان كان من مهور البغايا أو بيع لحم الخنازير بعد أن تملكه الكفار ثم يبيحه الله على المؤمنين فهو حلال طيب للمؤمنين.
(الجواب) : إنا قد بينا قبل هذا الموضع أنه لا يعترض على أمير المؤمنين عليه السلام في أحكام الشريعة ويطمع فيه من عثرة أو زلة إلا معاند لا يعرف قدره ، ومن شهد له النبي (صلى الله عليه وآله) بأنه أقضى الامة وان الحق معه كيف ما دار ، وضرب بيده على صدره وقال : اللهم أهد قلبه وثبت لسانه لما بعثه إلى اليمن حتى قال أمير المؤمنين (عليه السلام) فما شككت في قضاء بين اثنين. وقال النبي فيه : «انا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب» لا يجوز أن يعترض أحكامه عليه السلام ، ولا يظن بها إلا الصحة والسداد. وأعجب من هذا كله الطعن على هذه الاحكام وأشباهها بأنها خلاف الاجماع وأي إجماع ليت شعرى يكون وأمير المؤمنين عليه السلام خارج منه ولا أحد من الصحابة الذين لهم في الاحكام مذاهب وفتاوى وقيام ، إلا وقد تفرد بشئ لم يكن له عليه موافق ، وما عد مذهبه خروجا عن الاجماع ولو لا التطويل لذكرنا شرح هذه الجملة ومعرفتها وظهورها بغنينا عن تكلف ذلك ولو كان للطعن على أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الاحكام مجال وله وجه لكان أعداؤه من بني أمية والمتقربين إليهم من شيعتهم بذلك أخبر وإليه اسبق ، وكانوا يعيبونه عليه ويدخلونه في جملة مثالبهم ومعايبهم التى تمحلوها ، ولما تركوا ذلك حتى يستدركه النظام بعد السنين الطويلة وفى أضرابهم عن ذلك دليل على أنه لا مطعن بذلك ولا معاب. وبعد ، فكل شئ فعله أمير المؤمنين (عليه السلام) من هذه الاحكام وكان له مذهبا ، ففعله له واعتقاده إياه هو الحجة فيه ، وأكبر البرهان على صحته لقيام الادلة على أنه عليه السلام لا يزل ولا يغلط ولا يحتاج إلى بيان وجوه زايدة على ما ذكرناه إلا على سبيل الاستظهار والتقرير على الخصوم وتسهيل طريق الحجة عليهم.
فأما بيع أمهات الاولاد فلم يسر فيهن إلا بنص الكتاب وظاهره ، قال الله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7] ولا شبهة في أن أم الولد يطؤها سيدها بملك اليمين ، لأنها ليست زوجة ولا هو عاد في وطئها إلى ما لا يحل ، وإذا كانت مملوكة مسترقة بطل ما يدعونه من أن ولدها اعتقها ، ويبين ذلك أيضا أنه لا خلاف في أن لسيدها أن يعتقها. ولو كان الولد قد أعتقها لما صح ذلك ، لان عتق المعتق محال. وهذه الجملة توضح عن بطلان ما يروونه من أن ولدها أعتقها ، ثم يقال لهم اليس هذا الخبر لم يقتض أن لها جميع أحكام المعتقات ، لأنه لو اقتضى ذلك لما جاز أن يعتقها السيد ، ولا أن يطأها إلا بعقد ، وانما اقتضى بعض أحكام المعتقات. فلابد من مزيل فيقال لهم : فما انكرتم من أن مخالفكم يمكنه أن يستعمله أيضا على سبيل التخصيص كما استعملتموه ، فنقول انه لو أراد بيعها لم يجز إلا في دين ، وعند ضرورة ، وعند موت الولد. فكأنها يجري مجرى المعتقات فيما لا يجوز بيعها فيه ، وان لم يجز من كل وجه كما أجريتموها مجراهن في وجه دون آخر.
فأما قطع السارق من الاصابع فهو الحق الواضح الجلي ، لان الله تعالى قال (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) واسم اليد يقع على جملة هذا العضو إلى المنكب ، ويقع عليه أيضا إلى المرافق والى الزند والى الاصابع كل ذلك على سبيل الحقيقة. ولهذا يقول أحدهم أدخلت يدي في الماء إلى أصول الاصابع والى الزند والى المرفق والى المنكب ، فيجعل كل ذلك غاية. وقال الله تعالى : {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ } [البقرة: 79] ومعلوم أن الكتابة تكون بالأصابع ، ولو يرى أحدنا قلما فعقرت السكين أصابعه لقيل قطع يده وعقرها ونحو ذلك. وقال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ} [يوسف: 31] ومعلوم أنهن ما قطعن اكفهن إلى الزند ، بل على ما ذكرناه. وإذا كان الامر على ما ذكرناه ولم يجز ان يحمل اليد على كل ما تناولته هذه اللفظة حتى يقطع من الكتف على مذهب الخوارج ، لان هذا باطل عند جميع الفقهاء ، وجب ان نحمله على أدنى ما تناوله ، وهو من أصول الاشاجع ، والقطع من الاصابع أولى بالحكمة وأرفق بالمقطوع ، لأنه إذا قطع من الزند فاته من المنافع أكثر مما يفوته إذا قطع من الاشاجع. وقد روي ان علي بن أصمع سرق عيبة لصفوان ، فأتى به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقطعه من أشاجعه ، فقيل له يا أمير المؤمنين افلا من الرسغ. فقال عليه السلام فعلى أي شئ يتوكأ وبأي شي يستنجي. ومهما شككنا فإنا لا نشك في أن أمير المؤمنين عليه السلام كان أعلم باللغة العربية من النظام وجميع الفقهاء والذين خالفوه في القطع ، وأقرب إلى فهم ما نطق به القرآن. وان قوله (عليه السلام) حجة في العربية وقدوة ، وقد سمع الآية وعرف اللغة التي نزل بها القرآن ، فلم يذهب إلى ما ذهب إليه إلا عن خبرة ويقين.
واما دفع السارق إلى الشهود فلا أدري من أي وجه كان عيبا وهل دفعه إليهم ليقطعوه إلا كدفعه إلى غيرهم ممن يتولى ذلك منه. وفي هذا فضل استظهار عليهم وتهييب لهم من أن يكذبوا فيعظم عليهم تولي ذلك منه ومباشرته بنفوسهم ، وهذا نهاية الحزم والاحتياط في الدين.
وأما جلد الوليد بن عقبة أربعين سوطا فإن المروي انه عليه السلام جلده بنسعة لها رأسان فكان الحد ثمانين كاملة : وهذا مأخوذ من قوله تعالى : {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: 44] .
واما الجهر بتسمية الرجال في القنوت فقد سبقه (عليه السلام) إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وتظاهرت الرواية بأنه (صلى الله عليه وآله) كان يقنت في صلاة الصبح ويلعن قوما من أعدائه بأسمائهم فمن عاب ذلك أو طعن به فقد طعن على أصل الاسلام وقدح في الرسول صلى الله عليه وآله.
واما قبول شهادة الصبيان فالاحتياط للدين يقتضيه ، ولم ينفرد أمير المؤمنين عليه السلام بذلك ، بل قد قال بقوله بعينه أو قريبا منه جماعة من الصحابة والتابعين. وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في شهادة الصبي يشهد بعد كبره ، والعبد بعد عتقه ، والنصراني بعد إسلامه أنها جائزة. وهذا قول جماعة من الفقهاء المتأخرين كالثوري وأبي حنيفة وأصحابه. وروى مالك بن انس عن هشام بن عروة ان عبدالله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. وروي عن هشام بن عروة انه قال سمعت ابي يقول يجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، يؤخذ بأول قولهم. وروي عن مالك بن أنس انه قال : المجمع عليه عندنا يعني أهل المدينة أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ، ولا تجوز على غيرهم إذا كان ذلك قبل ان يتفرقوا ويجيئوا ويعلموا ، فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا ان يكونوا قد اشهدوا عدولا على شهادتهم قبل ان يتفرقوا ، ويوشك أن يكون الوجه في الاخذ بأوائل أقوالهم لان من عادة الصبي وسجيته إذا أخبر بالبديهة ان يذكر الحق الذي عاينه ، ولا يتعمل لتحريفه. وليس جميع الشهادات تراعى فيها العدالة. وجماعة من العلماء قد أجازوا شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم ، وتأولوا لذلك قول الله عز وجل : {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] وقد أجازوا أيضا شهادة النساء وحدهن فيما لا يجوز انت تنظر إليه الرجال ، وقبلوا شهادة القابلة.
وانما اردنا بذكر قبول شهادة النساء ، أن قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] مخصوص غير عام في جميع الشهادات. ألا ترى ان ذلك غير مانع من قبول اليمين مع شهادة الواحد. وبعد فليس قوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} بمقتض غير الامر بالشهادة على هذا الوجه وليس بمانع من قبول شهادة غير العدلين ولا تعلق له بأحكام قبول الشهادات.
فاما أخذ نصف الدية من أولياء المرأة إذ أرادوا قتل الرجل بها فهو الصحيح الواضح الذى لا يجوز خلافه ، لان دية المرأة عشرة آلاف درهم ودية المرأة نصفها فإذا أراد أولياء المرأة قتل الرجل ، فإنما يقتلون نفسا ديتها الضعف من دية مقتولهم ، فلا بد إذا إختاروا ذلك من رد الفضل بين القيمتين ولهذا لو أراد أخذ الدية لم يأخذوا أكثر من خمسة آلاف درهم. وهكذا القول في أخذ نصف الدية من المقتص من الاعور ، لان دية عين الاعور عشرة آلاف درهم ودية احدى عيني الصحيح خمسة الاف درهم. فلا بد من الرجوع بالفضل على ما ذكرناه ، وما أدري من أي وجه تطرق العيب في تخليفه عليه السلام من يصلي العيدين بالضعفاء في المسجد الاعظم ، وذلك من رأفته (عليه السلام) بالضعفاء ورفقه بهم ، وتوصله إلى ان يحظوا بفضل هذه الصلاة من غير تحمل مشقة الخروج إلى المصلى.
فأما ما حكاه من أحراقه اللوطي فالمعروف أنه عليه السلام القى على الفاعل والمفعول به لما رآهما الجدار ، ولو صح الاحراق لم ينكران يكون ذلك الشئ عرفه من الرسول صلى الله عليه وآله. وقد روى فهد بن سليمان عن القاسم بن أميه العدوي عن عمر بن أبي حفص مولى الزبير عن شريك عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة ، أن أبا بكر أتى برجل ينكح فأمر به فضربت عنقه ثم أمر به فأحرق ولعل أمير المؤمنين (عليه السلام) احرقه بالنار بعد القتل بالسيف كما فعل ابو بكر ، وليس ما روي من الاحراق بمانع من ان يكون القتل متقدما له. وقد روي قتل المتلوطين من طرق مختلفة عن الرسول صلى الله عليه وآله وكذلك روي رجمهما. روى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : اقتلوا الفاعل والمفعول به. وروي عبد العزيز عن ابن جريح عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) مثل ذلك. وعن عمر بن ابي عمير عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال فيمن يوجد يعمل بعمل قوم لوط مثل ذلك. وروى ابو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال الذي يعمل عمل قوم لوط ارجموا الاعلى والاسفل ارجموهما جميعا. وسئل ابن عباس ما حد اللوطي؟ ينظر إلى ارفع بناء في القرية فيرمى به منكسا. ثم يتبع بالحجارة. وروي ان عثمان اشرف على الناس يوم الدار ، فقال : ألم تعلموا أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا أربعة : رجل قتل فقتل ، ورجل زنى بعد ان أحصن ، ورجل ارتد بعد إسلام ، ورجل عمل عمل قوم لوط. فلا شبهة على ما ترى في قتل اللوطي ، ولا ريب في وجوب ذلك عليه. وكيف يتهم بحيف في حد يقيمه من يتحرى فيما يخصه هذا التحري المشهور. فيقول عليه السلام لما ضربه اللعين ابن ملجم احسنوا أسره ، فإن عشت فأنا ولي دمي ، وان مت فضربة بضربة. ولا تمثلوا بالرجل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المثلة ولو بالكلب العقور. فمن ينهى عن التمثيل بقاتله مع الغيظ الذى يجده الانسان على ظالمه وميله إلى الاستيفاء والانتقام ، كيف يمثل بمن لا ترة بينه وبينه ولا حسيكة له في قلبه؟ وهذا ما لا يظنه به (عليه السلام) إلا مؤف العقل.
فأما حبسه (عليه السلام) المال المكتسب من مهور البغايا على غنى وباهلة رفله ان كان صحيحا وجه واضح ، وهو ان ذلك المال دني الاصل خسيس السبب ، ومثله ما ينزه عنه ذو الاقدار من جلة المؤمنين ووجوه المسلمين. وإن كان حلالا طلقا فليس كل حلال يتساوى الناس في التصرف فيه. فإن من المكاسب والمهن والحرف ما يحل ويطيب ويتنزه ذوو المرؤات والاقدار عنها. وقد فعل النبي صلى الله عليه وآله نظير ما فعله امير المؤمنين عليه السلام ، فإنه روي عنه انه (صلى الله عليه وآله) نهى عن كسب الحجام ، فلما روجع فيه أمر المراجع له ان يطعمه رقيقه ويعلفه ناضحه ، وإنما قصد (صلى الله عليه وآله) إلى الوجه الذي ذكرناه من التنزيه ، وان كان ذلك الكسب حلالا طلقا. وهاتان القبيلتان معروفتان بالدناءة ولؤم الاصل مطعون عليهما في ديانتهما ايضا ، فخصهما بالكسب اللئيم وعوض من له في ذلك المال سهم من الجلة ، والوجوه من غير ذلك المال. وكل هذا واضح لمن تدبره. في كذب الخبر بأنه خطب بنت أبي جهل. (مسألة :) فإن قيل اليس قد روي ان أمير المؤمنين عليه السلام خطب بنت أبي جهل بن هشام في حياة الرسول صلى الله عليه وآله حتى بلغ ذلك فاطمة عليها السلام وشكته إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فقام على المنبر قائلا ان عليا آذاني بخطب بنت أبي جهل بن هشام ليجمع بينها وبين ابنتي فاطمة ، ولن يستقيم الجمع بين بنت ولي الله وبين بنت عدوه. أما علمتم معشر الناس أن من آذى فاطمة فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ، فما الوجه في ذلك؟ (الجواب) : قلنا هذا خبر باطل موضوع غير معروف ولا ثابت عند أهل النقل ، وانما ذكره الكرابيسي طاعنا به أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله ، ومعارضا بذكره لبعض ما يذكره شيعته من الاخبار في اعدائه ، وهيهات أن يشبه الحق بالباطل ، ولو لم يكن في ضعفه إلا رواية الكرابيسي له واعتماده عليه ، وهو من العداوة لأهل البيت عليهم السلام والمناصبة لهم والازراء على فضائلهم ومآثرهم على ما هو مشهور ، لكفى على أن هذا الخبر قد تضمن ما يشهد ببطلانه ويقتضى على كذبه من حيث ادعى فيه أن النبي ذم هذا الفعل وخطب بإنكاره على المنابر. ومعلوم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) لو كان فعل ذلك على ما حكى ، لما كان فاعلا لمحظور في الشريعة ، لان نكاح الاربع حلال على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وآله. والمباح لا ينكره الرسول (صلى الله عليه وآله) ويصرح بذمه ، وبأنه متأذبه ، وقد رفعه الله عن هذه المنزلة واعلاه عن كل منقصة ومذمة. ولو كان عليه السلام نافرا من الجمع بين بنته وبين غيرها بالطباع التي تنفر من الحسن والقبيح ، لما جاز أن ينكره بلسانه ، ثم ما جاز أن يبالغ في الانكار ويعلن به على المنابر وفوق رؤوس الاشهاد ، ولو بلغ من إيلامه لقلبه كل مبلغ. فما هو اختص به (عليه السلام) من الحلم والكظم ، ووصفه الله بأنه من جميل الاخلاق وكريم الآداب ينافي ذلك ويحيله ويمنع من اضافته إليه وتصديقه عليه. وأكثر ما يفعله مثله (عليه السلام) في هذا الامر إذا ثقل على قلبه ان يعاتب عليه سرا ويتكلم في العدول عنه خفيا على وجه جميل وبقول لطيف. وهذا المأمون الذي لا قياس بينه وبين الرسول (صلى الله عليه وآله) الكرابيسي : أبو علي ، الحسين بن علي ، محدث ، فقيه ، أصولي ، متكلم ، من أهل بغداد ، صحب الشافعي ، له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه ، والجرح والتعديل. وقد انكح أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بنته ونقلها معه إلى مدينة الرسول (صلى الله عليه وآله) لما ورد كتابها عليه تذكر أنه قد تزوج عليها أو تسرى ، يقول مجيبا لها ومنكرا عليها : إنا ما انكحناه لنحظر عليه ما أباحه الله له ، والمأمون أولى بالامتعاض من غيرة بنته ، وحاله أجمل للمنع من هذا الباب والانكار له. فوالله ان الطعن على النبي صلى الله عليه وآله بما تضمنه هذا الخبر الخبيث ، أعظم من الطعن على أمير المؤمنين عليه السلام. وما صنع هذا الخبر إلا ملحد قاصد للطعن عليهما ، أو ناصب معاند لا يبالي ان يشفي غيظه بما يرجع على أصوله بالقدح والهدم ، على أنه لا خلاف بين أهل النقل أن الله تعالى هو الذي اختار أمير المؤمنين عليه السلام لنكاح سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها ، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) رد عنها جلة أصحابه وقد خطبوها وقال «صلى الله عليه وآله» : اني لم أزوج فاطمة عليا (عليه السلام) حتى زوجها الله إياه في سمائه ، ونحن نعلم أن الله سبحانه لا يختار لها من بين الخلائق من غيرها ويؤذيها ويغمها ، فإن ذلك من أدل دليل على كذب الراوي لهذا الخبر. وبعد ، فإن الشئ إنما يحمل على نظائره ويلحق بأمثاله ، وقد علم كل من سمع الاخبار أنه لم يعهد من أمير المؤمنين (عليه السلام) خلاف على الرسول ، ولا كان قط بحيث يكره على اختلاف الاحوال وتقلب الازمان وطول الصحبة ، ولا عاتبه (عليه السلام) على شئ من أفعاله ، مع أن أحدا من اصحابه لم يخل من عتاب على هفوة ونكير لأجل زلة ، فكيف خرق بهذا الفعل عادته وفارق سجيته وسنته لولا تخرص الاعداء وتعديهم. وبعد ، فأين كان أعداؤه (عليه السلام) من بني أمية وشيعتهم عن هذه الفرصة المنهزة ؟ وكيف لم يجعلوها عنوانا لما يتخرصونه من العيوب والقروف؟ وكيف تحملوا الكذب وعدلوا عن الحق وفى علمنا بأن أحدا من الاعداء متقدما لم يذكر ذلك دليل على أنه باطل موضوع؟.
الوجه في مسالمة الحسن لمعاوية.
(مسألة :) فإن قال قائل : ما العذر له في خلع نفسه من الامامة وتسليمها إلى معاوية مع ظهور فجوره وبعده عن أسباب الامامة وتعريه من صفات مستحقها ، ثم في بيعته وأخذ عطائه وصلاته واظهار موالاته والقول بإمامته ، هذا مع وفور انصاره واجتماع أصحابه ومتابعيه من كان يبذل عنه دمه وماله ، حتى سموه مذل المؤمنين وعاتبوه في وجهه عليه السلام؟
(الجواب) : قلنا قد ثبت انه عليه السلام الامام المعصوم المؤيد الموفق بالحجج الظاهرة والادلة القاهرة ، فلابد من التسليم لجميع أفعاله وحملها على الصحة وإن كان فيها ما لا يعرف وجهه على التفصيل ، أو كان له ظاهر ربما نفرت النفوس عنه وقد مضى تلخيص هذه الجملة وتقريرها في مواضع من كتابنا هذا. وبعد ، فإن الذي جرى منه عليه السلام كان السبب فيه ظاهرا والحامل عليه بيا جليا لان المجتمعين له من الاصحاب وان كانوا كثيري العدد وقد كانت قلوب أكثرهم دغلة غير صافية ، وقد كانوا صبوا إلى دنيا معاوية وامراحه من أحب في الاموال من غير مراقبة ولا مساترة ، فأظهروا له (عليه السلام) النصرة وحملوه على المحاربة والاستعداد لها طمعا في أن يورطوه ويسلموه ، وأحس عليه السلام بهذا منهم قبل التولج والتلبس ، فتخلى من الامر وتحرز من المكيدة التي كادت تتم عليه في سعة من الوقت وقد صرح (عليه السلام) بهذه الجملة وبكثير من تفصيلها في مواقف كثيرة بألفاظ مختلفة ، وقال إنما هادنت حقنا للدماء وصيانتها وإشفاقا على نفسي وأهلي والمخلصين من أصحابي ، فكيف لا يخاف أصحابه ويتهمهم على نفسه وأهله ، وهو عليه السلام لما كتب إلى معاوية يعلمه أن الناس قد بايعوه بعد أبيه عليه السلام ويدعوه إلى طاعته ، فأجابه معاوية بالجواب المعروف المتضمن للمغالطة فيه والمواربة وقال له فيه : لو كنت أعلم أنك أقوم بالامر واضبط للناس وأكيد للعدو وأقوى على جميع الاحوال مني لبايعتك ، لاني أراك لكل خير أهلا. وقال في كتابه ان أمري وأمرك شبيه بأمر ابي بكر وأبيك وأمركم بعد وفاة رسول الله دعاه إلى أن خطب خطبة بأصحابه بالكوفة يحثهم على الجهاد ويعرفهم فضله ، وما في الصبر عليه من الاجر ، وأمرهم أن يخرجوا إلى معسكر فما أجابه أحد ، فقال لهم عدي بن حاتم : سبحان الله ألا تجيبون إمامكم؟ أين خطباء مصر؟ فقام قيس بن سعد وفلان وفلان فبذلوا الجهاد واحسنوا القول. ونحن نعلم ان من ضمن بكلامه أولى بأن يضن بفعاله. أو ليس أحدهم قد جلس له في مظلم ساباط وطعنه بمغول كان معه أصاب فخذه ، فشقه حتى وصل إلى العظم وانتزع من يده وحمل عليه السلام إلى المداين وعليها سعيد بن مسعود عم المختار ، وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) ولاه إياها فأدخل منزله ، فأشار المختار على عمه ان يوثقه ويسير به إلى معاوية على أن يطعمه خراج جوخي سنة. فأبي عليه وقال للمختار : قبح الله رأيك أنا عامل أبيه وقد أئتمنني وشرفني ، وهبني نسيت بلاء أبيه أأنسى رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أحفظه في ابن بنته وحبيبه ثم أن سعد بن مسعود أتاه عليه السلام بطبيب وقام عليه حتى برئ وحوله إلى بعض المدائن. فمن ذا الذي يرجو السلامة بالمقام بين أظهر هؤلاء القوم عن النصرة والمعونة؟ وقد أجاب (عليه السلام) حجر بن عدي الكندي لما قال له سودت وجوه المؤمنين ، فقال عليه السلام ما كل أحد يحب ما تحب ولا رأيه كرأيك ، وانما فعلت ما فعلت إبقاء عليكم. وروى عباس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف عن أبي الكنود عبدالرحمن بن عبيدة ، قال لما بايع الحسن عليه السلام معاوية أقبلت الشيعة تتلاقى بإظهار الاسف والحسرة على ترك القتال ، فخرجوا إليه بعد سنتين من يوم بايع معاوية فقال له (عليه السلام) سليمان بن صرد الخزاعي : ما ينقضي تعجبنا من بيعتك لمعاوية ومعك أربعون ألف مقاتل من أهل الكوفة ، كلهم يأخذ العطاء وهم على أبواب منازلهم ، ومعهم مثلهم من أبنائهم وأتباعهم سوى شيعتك من أهل البصرة والحجاز ، ثم لم تأخذ لنفسك ثقة في العهد ولا حظا من العطية فلو كنت إذ فعلت ما فعلت اشهدت على معاوية وجوه أهل المشرق والمغرب ، وكتبت عليه كتابا بأن الامر لك بعده ، كان الامر علينا أيسر. ولكنه أعطاك شيئا بينك وبينه لم يف به ثم لم يلبث ان قال على رؤوس الاشهاد أني كنت شرطت شروطا ووعدت عداة إرادة لإطفاء نار الحرب ومداراة لقطع الفتنة ، فأما إذا جمع الله لنا الكلمة والالفة فإن ذلك تحت قدمي ، والله ما عنى بذلك غيرك ، ولا أراد بذلك إلا ما كان بينه وبينك ، قد نقض. فإذا شئت فأعدت للحرب عدة ، وأذن لي في تقدمك إلى الكوفة ، فأخرج عنها عاملها وأظهر خلعه نبذه ، على سواء أن الله لا يحب الخائنين. وتكلم الباقون بمثل كلام سليمان ، فقال الحسن عليه السلام : أنتم شيعتنا وأهل مودتنا ، ولو كنت بالحزم في أمر الدنيا أعمل ولسلطانها أربض وأنصب ، ما كان معاوية بأشد مني بأسا ولا أشد شكيمة ولا أمضى عزيمة ، ولكني ارى غير ما رأيتم وما أردت بما فعلت إلا حقن الدماء ، فارضوا بقضاء حجر بن عدي الكندي : من صلحاء الصحابة. قاتل في فتوح فارس. كان مع علي في الجمل والنهروان وصفين. قاوم معاوية. قبض عليه وأمر معاوية بقتله في مرج عذراء شرقي دمشق. الله وسلموا لامره والزموا بيوتكم وامسكوا. أو قال : كفوا ايديكم حتى يستريح برأ ويستراح من فاجر. وهذا كلام منه عليه السلام يشفي الصدور ويذهب بكل شبهة. وقد روي انه عليه السلام لما طالبه معاوية بأن يتكلم على الناس ويعلمهم ما عنده في هذا الباب ، قام (عليه السلام) فحمد الله واثنى عليه ثم قال : ان أكيس الكيس التقى ، واحمق الحمق الفجور. أيها الناس انكم لو طلبتم ما بين جابلق وجابلس رجلا جده رسول الله صلى الله عليه وآله ما وجدتموه غيري ، وغير أخي الحسين عليه السلام ، وان الله قد هداكم بأولنا محمد صلى الله عليه وآله ، وان معاوية نازعني حقا هو لي فتركته لصلاح الامة وحقن دمائها ، وقد بايعتموني على ان تسالموا من سالمت وقد رأيت ان أسالمه ورأيت ان ما حقن الدماء خير مما سفكها ، واردت صلاحكم وان يكون ما صنعت حجة على من كان يتمنى هذا الامر ، وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وكلامه عليه السلام في هذا الباب الذي يصرح في جميعه بأنه مغلوب مقهور ملجأ إلى التسليم دافع بالمسالمة الضرر العظيم عن الدين والمسلمين أشهر من الشمس وأجلى من الصبح.
فأما قول السائل انه خلع نفسه من الامامة فمعاذ الله ، لان الامامة بعد حصولها للإمام لا تخرج عنه بقوله.
وعند أكثر مخالفينا أيضا في الامامة أن خلع الامام نفسه لا يؤثر في خروه من الامامة ، وإنما ينخلع من الامامة عندهم وهو حي بالأحداث والكبائر ، ولو كان خلعه نفسه مؤثرا لكان انما يؤثر إذا وقع إختيارا. فأما مع الالجاء والاكراه ، فلا تأثير له لو كان مؤثرا في موضع من المواضع ، ولم يسلم أيضا الامر إلى معاوية بل كف عن المحاربة والمغالبة لفقدان الاعوان واعواز النصار وتلافي الفتنة على ما ذكرناه ، فتغلب عليه معاوية بالقهر والسلطان مع أنه كان متغلبا على أكثره ، ولو أظهر التسليم قولا لما كان فيه شئ إذا كان عن اكراه واضطهاد.
وأما البيعة فإن أريد به الصفقة واظهار الرضا والكف عن المنازعة فقد كان ذلك لكنا قد بينا جهة وقوعه والاسباب المحوجة إليه ، ولا حاجة في ذلك عليه عليه السلام. كما لم يكن في مثله حجة على أبيه عليه السلام لما بايع المتقدمين عليه ، وكف عن نزاعهم وامسك عن خلافهم ، وإن اريد بالبيعة الرضى وطيب النفس ، فالحال شاهدة بخلاف ذلك ، وكلامه المشهور كله يدل على انه (عليه السلام) أحوج وأحرج ، وأن الامر له وهو أحق الناس به. وانما كف عن المنازعة فيه للغلبة والقهر والخوف على الدين والمسلمين.
وأما أخذ العطاء فقد بينا في هذا الكتاب عند الكلام فيما فعله أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك من أخذه من يد الجائر الظالم المتغلب جائز ، وأنه لا لوم فيه على الاخذ ولا حرج.
وأما أخذ الصلات فسايغ بل واجب لان لكل مال في يد الجائر المتغلب على أمر الامة يجب على الامام وعلى جميع المسلمين انتزاعه من يده كيف ما أمكن بالطوع أو الاكراه ، ووضعه في مواضعه. فإذا لم يتمكن من إنتزاع جميع ما في يد معاوية من أموال الله تعالى وأخرج هو شيئا منها إليه على سبيل الصلة ، فواجب عليه أن يتناوله من يده ويأخذ منه حقه ويقسمه على مستحقه لان التصرف في ذلك المال بحق الولاية عليه لم يكن في تلك الحال إلا له ، وليس لاحد أن يقول أن الصلات التى كان يقبلها من معاوية إنما كان ينفقها على نفسه وعياله ، ولا يخرجها إلى غيره وذلك ان هذا مما لا يمكن أحد أن يدعي العلم به والقطع عليه ولا شك أنه عليه السلام كان ينفق منها لان فيها حقه وحق عياله وأهله ، ولا بد من أن يكون قد أخرج منها إلى المستحقين حقوقهم وكيف يظهر ذلك وهو عليه السلام كان قاصدا إلى إخفائه ستره لمكان التقية ، والمحوج إليه إلى قبول تلك الاموال على سبيل الصلة هو المحوج له إلى ستر اخراجها واخراج بعضها إلى مستحقها من المسلمين. وقد كان عليه السلام يتصدق بكثير من أمواله ويواسي الفقراء ويصل المحتاجين. ولعل في جملة ذلك هذه الحقوق.
فأما اظهاره (عليه السلام) موالاته فما أظهر عليه السلام من ذلك شيئا كما لم يبطنه. وكلامه فيه بمشهد معاوية ومغيبه معروف ظاهر يشهد بذم معاوية ومعائبه ، ولو فعل ذلك خوفا واستصلاحا وتلافيا للشر العظيم لكان واجبا ، فقد فعل أبوه عليه السلام مثله مع المتقدمين عليه واعجب من هذا كله دعوى القول بإمامته ومعلوم ضرورة منه (عليه السلام) خلاف ذلك ، وأنه كان يعتقد ويصرح بأن معاوية لا يصلح أن يكون بعض ولاة الامام ولا تباعه فضلا عن الامامة نفسها ، وليس يظن مثل هذه الامور الا عامي حشوي قد قعد به التقليد. وما سبق إلى اعتقاده من تصويب القوم كلهم عن التأمل وسماع الاخبار المأثورة في هذا الباب فهو لا يسمع إلا بما يوافقه. وإذا سمع لم يصدق إلا بما اعجبه والله المستعان.
(مسألة) : فإن قيل : ما العذر في خروج أبو عبد الله الحسين بن على عليهما السلام من مكة بأهله وعياله إلى الكوفة والمستولى عليها أعداؤه ، والمتآمر فيها من قبل يزيد منبسط الامر والنهي ، وقد رأى عليه السلام صنع أهل الكوفة بأبيه وأخيه ، وأنهم غدارون خوانون ، وكيف خالف ظنه ظن جميع أصحابه في الخروج وابن عباس يشير بالعدول عن الخروج ويقطع على العطب فيه ، وابن عمر لما ودعه يقول استودعك الله من قتيل ، إلى غير ما ذكرناه ممن تكلم في هذا الباب. ثم لما علم بقتل مسلم بن عقيل (رضي) وقد انفذه رائدا له ، كيف لم يرجع لما علم الغرور من القوم وتفطن بالحيلة والمكيدة ، ثم كيف استجاز ان يحارب بنفر قليل لجموع عظيمة خلفها ، لها مواد كثيرة. ثم لما عرض عليه ابن زياد الامان وأن يبايع يزيد ، كيف لم يستجب حقنا لدمه ودماء من معه من أهله وشيعته ومواليه. ولم القى بيده إلى التهلكة وبدون هذا الخوف سلم أخوه الحسن عليه السلام الامر إلى معاوية ، فكيف يجمع بين فعليهما بالصحة؟ (الجواب) : قلنا قد علما أن الامام متى غلب في ظنه يصل إلى حقه والقيام بما فوض إليه بضرب من الفعل ، وجب عليه ذلك وان كان فيه ضرب من المشقة يتحمل مثلها تحملها ، وسيدنا أبو عبد الله عليه السلام لم يسر طالبا للكوفة الا بعد توثق من القوم وعهود وعقود ، وبعد ان كاتبوه عليه السلام طائعين غير مكرهين ومبتدئين غير مجيبين. وقد كانت المكاتبة من وجوه أهل الكوفة واشرافها وقرائها ، تقدمت إليه في أيام معاوية وبعد الصلح الواقع بينه وبين الحسن (عليه السلام) فدفعهم وقال في الجواب ما وجب. ثم كاتبوه بعد وفاة الحسن (عليه السلام) ومعاوية باق فوعدهم ومناهم ، وكانت أياما صعبة لا يطمع في مثلها. فلما مضى معاوية وأعادوا المكاتبة بذلوا الطاعة وكرروا الطلب والرغبة ورأى (عليه السلام) من قوتهم على من كان يليهم في الحال من قبل يزيد ، وتشحنهم عليه وضعفه عنهم ، ما قوى في ظنه ان المسير هو الواجب ، تعين عليه ما فعله من الاجتهاد والتسبب ، ولم يكن في حسابه أن القوم يغدر بعضهم ، ويضعف أهل الحق عن نصرته ويتفق بما اتفق من الامور الغريبة. فإن مسلم بن عقيل رحمة الله عليه لما دخل الكوفة أخذ البيعة على أكثر أهلها. ولما وردها عبيد الله بن زياد وقد سمع بخبر مسلم ودخوله الكوفة وحصوله في دار هاني بن عروة المرادى رحمة الله عليه على ما شرح في السير ، وحصل شريك بن الاعور بها جاءه ابن زياد عايدا وقد كان شريك وافق مسلم بن عقيل على قتل ابن زياد عند حضوره لعيادة شريك ، وامكنه ذلك وتيسر له ، فما فعل واعتذر بعد فوت الامر إلى شريك بأن ذلك فتك ، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال أن الايمان قيد الفتك. ولو كان فعل مسلم بن عقيل من قتل ابن زياد ما تمكن منه ، ووافقه شريك عليه لبطل الامر. ودخل الحسين على السلام الكوفة غير مدافع عنها ، وحسر كل أحد قناعه في نصرته ، واجتمع له من كان في قلبه نصرته وظاهره مع أعدائه. وقد كان مسلم بن عقيل أيضا لما حبس ابن زياد هانيا سار إليه في جماعة من أهل الكوفة ، حتى حصره في قصره وأخذ بكظمه ، وأغلق ابن زياد الابواب دونه خوفا وجبنا حتى بث الناس في كل وجه يرغبون الناس ويرهبونهم ويخذلونهم عن ابن عقيل ، فتقاعدوا عنه وتفرق أكثرهم ، حتى أمسى في شر ذمة ، ثم انصرف وكان من أمره ما كان. وإنما أردنا بذكر هذه الجملة أن أسباب الظفر بالأعداء كانت لايحة متوجهة ، وان الاتفاق السئ عكس الامر وقلبه حتى تم فيه مأتم. وقد هم سيدنا أبو عبد الله عليه السلام لما عرف بقتل مسلم بن عقيل ، وأشير عليه بالعود فوثب إليه بنو عقيل وقالوا والله لا ننصرف حتى ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أبونا. فقال عليه السلام : لا خير في العيش بعد هؤلاء.
ثم لحقه الحر بن يزيد ومن معه من الرجال الذين انفذهم ابن زياد ، ومنعه من الانصراف ، وسامه ان يقدمه على ابن زياد نازلا على حكمه ، فامتنع. ولما رأى أن لا سبيل له إلى العود ولا إلى دخول الكوفة ، سلك طريق الشام سائرا نحو يزيد بن معاوية لعلمه عليه السلام بأنه على ما به أرق من ابن زياد وأصحابه ، فسار عليه السلام حتى قدم عليه عمر بن سعد في العسكر العظيم ، وكان من أمره ما قد ذكر وسطر ، فكيف يقال انه القى بيده إلى التهلكة؟ وقد روى أنه صلوات الله وسلامه عليه وآله قال لعمر بن سعد : اختاروا منى إما الرجوع إلى المكان الذي اقبلت منه ، أو ان اضع يدي في يد يزيد ابن عمى ليرى في رأيه ، وإما ان تسيروني إلى ثغر من ثغور المسلمين ، فأكون رجلا من أهله لى ماله وعلي ما عليه. وان عمر كتب إلى عبيد الله بن زياد بما سئل فأبى عليه وكاتبه بالمناجزة وتمثل بالبيت المعروف وهو : الآن علقت مخالبنا به * يرجو النجاة ولات حين مناص فلما رأى (عليه السلام) إقدام القوم عليه وان الدين منبوذ وراء ظهورهم وعلم أنه إن دخل تحت حكم ابن زياد تعجل الذل وآل امره من بعد إلى القتل ، التجأ إلى المحاربة والمدافعة بنفسه وأهله ومن صبر من شيعته ، ووهب دمه ووقاه بنفسه. وكان بين إحدى الحسنيين : إما الظفر فربما ظفر الضعيف القليل ، أو الشهادة والميتة الكريمة.
وأما مخالفة ظنه عليه السلام لظن جميع من أشار عليه من النصحاء كابن عباس وغيره ، فالظنون انما تغلب بحسب الامارات. وقد تقوى عند واحد وتضعف عند آخر ، لعل ابن عباس لم يقف على ما كوتب به من الكوفة ، وما تردد في ذلك من المكاتبات والمراسلات والعهود والمواثيق. وهذه أمور تختلف أحوال الناس فيها ولا يمكن الاشارة إلا إلى جملتها دون تفصيلها.
فأما السبب في أنه (عليه السلام) لم يعد بعد قتل مسلم بن عقيل ، فقد بينا وذكرنا أن الرواية وردت بأنه عليه السلام هم بذلك ، فمنع منه وحيل بينه وبينه.
فأما محاربة الكثير بالنفر القليل فقد بينا أن الضرورة دعت إليها وان الدين والحزم ما اقتضى في تلك الحال الا ما فعله ، ولم يبذل ابن زياد من الامان ما يوثق بمثله. وإنما أراد إذلاله والغض من قدره بالنزول تحت حكمه ، ثم يفضي الامر بعد الذل إلى ما جرى من إتلاف النفس. ولو أراد به (عليه السلام) الخير على وجه لا يلحقه فيه تبعة من الطاغية يزيد ، لكان قد مكنه من التوجه نحوه استظهر عليه بمن ينفذه معه. لكن التراث البدوية والاحقاد الوثنية ظهرت في هذه الاحوال. وليس يمتنع أن يكون عليه السلام من تلك الاحوال مجوزا أن يفئ إليه قوم ممن بايعه وعاهده وقعد عنه ، ويحملهم ما يكون من صبره واستسلامه وقلة ناصره على الرجوع إلى الحق دينا أو حمية ، فقد فعل ذلك نفر منهم حتى قتلوا بين يديه شهداء. ومثل هذا يطمع فيه ويتوقع في أحوال الشدة.
فأما الجمع بين فعله (عليه السلام) وفعل أخيه الحسن فواضح صحيح ، لان أخاه سلم كفا للفتنة وخوفا على نفسه وأهله وشيعته ، واحساسا بالغدر من أصحابه. وهذا لما قوي في ظنه النصرة ممن كاتبه وتوثق له ، ورأى من أسباب قوة أنصار الحق وضعف أنصار الباطل ما وجب عليه الطلب والخروج. فلما انعكس ذلك وظهرت امارات الغدر فيه وسوء الاتفاق رام الرجوع والمكافة والتسليم كما فعل أخوه ، فمنع من ذلك وحيل بينه وبينه ، فالحالان متفقان. إلا أن التسليم والمكافة عند ظهور أسباب الخوف لم يقبلا منه ، ولم يجب إلا إلى الموادعة ، وطلب نفسه (عليه السلام) فمنع منها بجهده حتى مضى كريما إلى جنة الله ورضوانه. وهذا واضح لمن تأمله ، وإذا كنا قد بينا عذر أمير المؤمنين عليه السلام في الكف عن نزاع من استولى على ما هو مردود إليه من أمر الامة ، وأن الحزم والصواب فيما فعله ، فذلك بعينه عذر لكل إمام من أبنائه عليهم السلام في الكف عن طلب حقوقهم من الامامة ، فلا وجه لتكرار ذلك في كل إمام من الائمة (عليهم السلام) والوجه أن نتكلم على ما لم يمض الكلام على مثله.
(مسألة) : إن قيل : كيف تولى على بن موسى الرضا عليه السلام العهد للمأمون ، وتلك جهة لا يستحق الامامة منها ، أو ليس هذا إيهاما فيما يتعلق بالدين؟
(الجواب) : قلنا قد مضى من الكلام في سبب دخول أمير المؤمنين في الشورى ما هو أصل في هذا الباب ، وجملته ان ذا الحق له أن يتوصل إليه من كل جهة ، وبكل سبب ، لا سيما إذا كان يتعلق بذلك الحق تكليف عليه ، فإنه يصير واجبا عليه التوصل والتحمل والتصرف في الامامة مما يستحقه الرضا صلوات الله عليه وآله بالنص من آبائه. فإذا دفع عن ذلك وجعل إليه من وجه آخر أن يتصرف فيه ، وجب عليه أن يجيب إلى ذلك الوجه ليصل منه إلى حقه. وليس في هذا إيهام لان الادلة الدالة على استحقاقه (عليه السلام) للإمامة بنفسه تمنع من دخول الشبهة بذلك ، وان كان فيه بعض الايهام يحسنه دفع الضرورة إليه كما حملته وآبائهم (عليه السلام) على إظهار متابعة الظالمين والقول بإمامتهم ، ولعله (عليه السلام) أجاب إلى ولاية العهد للتقية والخوف ، وأنه لم يؤثر الامتناع إلى من ألزمه ذلك وحمله عليه فيفضي الامر إلى المباينة والمجاهرة والحال لا يقتضيها وهذا بين.
(مسألة) : إن قال قائل فما الوجه في غيبة القائم المهدي صلوات الله عليه واستتاره على الاستمرار والدوام حتى ان ذلك قد صار سببا لنفي ولادته وانكار وجوده؟ وكيف يجوز أن يكون اماما للخلق وهو لم يظهر قط لاحد منهم ، وآباؤه (عليهم السلام) وان كانوا غير آمرين فيما يتعلق بالإمامة ولا ناهين ، فقد كانوا ظاهرين بارزين يفتون في الاحكام ويرشدون عند المعضلات لا يمكن أحد نفي وجودهم وان نفي إمامتهم؟
(الجواب) : قلنا اما الاستتار والغيبة فسببهما اخافة الظالمين له على نفسه ، ومن أخيف على نفسه فقد احوج إلى الاستتار ، ولم كن الغيبة من ابتدائها على ما هي عليه الآن ، فإنه في ابتداء الامر كان ظاهر لأوليائه غائبا عن أعدائه ، ولما اشتد الامر وقوي الخوف وزاد الطلب استتر عن الولي والعدو ، فليس ما ذكره السائل من أنه لم يظهر لاحد من الخلق صحيحا.
فأما كون ذلك سببا لنفي ولادته (عليه السلام) فلم يكن سببا لشئ من ذلك إلا بالشبهة وضعف البصيرة والتقصير عن النظر الصحيح ، وما كان التقصير داعيا إليه والشبهة سببه من الاعتقادات ، وعلى الحق فيه دليل واضح باد لمن أراده ، ظاهر لمن قصده ، ليس يجب المنع في دار التكليف والمحنة منه ، ألا ترى أن تكليف الله تعالى من علم انه يكفر قد صار سببا لاعتقادات كثيرة باطلة ، فالملحدون جعله طريقا إلى نفى الصانع ، والمجبرة جعلته طريقا إلى أن القبيح منا لا يقبح من فعله تعالى ، وآخرون جعلوه طريقا إلى الشك والحيرة الدفع عن القطع على حكمه القديم تعالى ، وكذلك فعل الآلام بالأطفال والبهائم قد شك كثير من الناس ، منهم الثنوية وأصحاب التناسخ والبكرية والمجبرة ، ولم يكن دخول الشبهة بهذه الامور على من قصر في النظر وانقاد إلى الشبهة مع وضوح الحق له لو أراده ، موجبا على الله دفعها ، حتى لا يكلف إلا المؤمنين ولا يؤل إلا البالغين. ولهذا الباب في الاصول نظائر كثيرة ذكرها يطول ، والاشارة إليها كافية. واما الفرق بينه وبين آبائه عليهم السلام فواضح ، لان خوف من يشار إليه بأنه القائم المهدي الذي يظهر بالسيف ويقهر الاعداء ويزيل الدول والممالك ، لا يكون كخوف غيره ممن يجوز له مع الظهور التقية وملازمة منزله ، وليس من تكليفه ولا مما سبق أنه يجري على يده الجهاد واستيصال الظالمين.
(مسألة) : فإن قيل : إذا كان الخوف قد اقتضى ان المصلحة في استتاره وتباعده فقد تغيرت الحال إذا في المصلحة بالامام واختلف ، وصار ما توجبونه من كون المصلحة مستمرة بوجوده وأمره ونهيه مختلفا على ما ترون ، وهذا خلاف مذهبكم.
(الجواب) : قلنا المصلحة التى توجب استمرارها على الدوام بوجوده وأمره ونهيه ، انما هي للمكلفين. وهذه المصلحة ما تغيرت ولا تتغير ، وإنما قلنا ان الخوف من الظالمين اقتضى أن يكون من مصلحته هو (عليه السلام) في نفسه الاستتار والتباعد ، وما يرجع إلى المكلفين به لم يختلف ، ومصلحتنا وإن كانت لا تتم إلا بظهوره وبروزه ، فقد قلنا ان مصلحته الآن في نفسه في خلاف الظهور ، وذلك غير متناقض ، لان من أخاف الامام واحوجه إلى الغيبة والى أن يكون الاستتار من مصلحته قادر على أن يزيل خوفه ، فيظهر ويبرز ويصل كل مكلف إلى مصلحته ، والتمكن مما يسهل سبيل المصلحة تمكن من المصلحة فمن هذا الوجه لم يزل التكليف الذي (به) الامام لطف فيه عن المكلفين بالغيبة منه والاستتار ، على ان هذا يلزم في النبي صلى الله عليه وآله لما استتر في الغار وغاب عن قومه بحيث لا يعرفونه ، لانا نعلم أن المصلحة بظهوره وبيانه كانت ثابتة غير متغيرة. ومع هذه الحال فإن المصلحة له في الاستتار والغيبة عند الخوف ، ولا جواب عن ذلك. وبيان أنه لا تنافي فيه ولا تناقض إلا بمثل ما اعتمدناه بعينه.
(مسألة) : فإن قيل : فإذا كان الامام (عليه السلام) غائبا بحيث لا يصل إليه أحد من الخلق ولا ينتفع به ، فما الفرق بين وجوده وعدمه؟ وإذا جاز ان يكون اخافة الظالمين سببا لغيبته بحيث لا يصل إلى مصلحتنا به حتى إذا زالت الاخافة ظهر ، فلم لا جاز أن يكون اخافتهم له سببا لان يعدمه الله تعالى ، فإذا انقادوا واذعنوا أوجده الله لهم؟
(الجواب) : قلنا : أول ما نقول إنا غير قاطعين على ان الامام (عليه السلام) لا يصل إليه أحد ولا يلقاه بشر ، فهذا أمر غير معلوم ولا سبيل إلى القطع عليه ، ثم الفرق بين وجوده غائبا عن اعدائه للتقية وهو في خلال ذلك منتظر أن يمكنوه فيظهر ويتصرف ، وبين عدمه واح لا خفاء به. وهو الفرق بين أن تكون الحجة فيما فات من مصالح العباد لازمة لله تعالى ، وبين أن تكون لازمة للبشر ، لأنه إذا اخيف فغيب شخصه عنهم كان ما يفهوتهم من مصلحة عقيب فعل سببوه وإلجائه إليه ، فكانت العهدة فيه عليهم والذم لازما لهم وإذا أعدمه الله تعالى ، ومعلوم أن العدم لا يسببه الظالمون بفعلهم ، وانما يفعله الله تعالى اختيارا ، كان ما يفوت بالإعدام من المصالح لازما له تعالى ومنسوبا إليه.
(مسألة) : فإن قيل فالحدود التي تجب على الجناة في حال الغيبة كيف حكمها؟ وهل تسقط عن أهلها؟ وهذا ان قلتموه صرحتم بنسخ شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وان أثبتموه فمن الذي يقيمها والامام (عليه السلام) غائب مستتر؟
(الجواب) : قلنا : أما الحدود المستحقة بالأعمال القبيحة فواجبة في جنوب مرتكبي القبائح ، فإن تعذر على الامام في حال الغيبة إقامتها فالإثم فيما تعذر من ذلك على من سبب الغيبة وأوجبها بفعله ، وليس هذا نسخا للشريعة ، ولان المتقرر بالشرع وجوب إقامة الحد مع التمكن وارتفاع الموانع ، وسقوط فرض إقامته مع الموانع وارتفاع التمكن لا يكون نسخا للشرع المتقرر ، لان الشرط في الوجوب لم يحصل. وإنما يكون ذلك نسخا لو سقط فرض إقامة الحدود عن الامام مع تمكنه ، على أن هذا يلزم مخالفينا في الامامة إذا قيل لهم كيف الحكم في الحدود التي تستحق في الاحوال التي لا يتمكن فيها أهل الحل والعقد من نصب إمام واختياره؟ وهل تبطل الحدود أو تستحق مع تعذر إقامتها؟ وهل يقتضي هذا التعذر نسخ الشريعة فأي شئ اعتصموا به من ذلك فهو جوابنا بعينه.
(مسألة) : فإن قيل فالحق مع غيبة الامام كيف يدرك وهذا يقتضي أن يكون الناس في حيرة مع الغيبة؟ فان قلتم أنه يدرك من جهة الادلة المنصوبة إليه قيل لكم هذا يقتضي الاغتناء عن الامام بهذه الادلة.
(الجواب) : قلنا : أما العلة المحوجة إلى الامام في كل عصر وعلى كل حال ، فهي كونه لطفا فيما أوجب علينا فعله من العقليات من الانصاف والعدل اجتناب الظلم والبغي ، لان ما عدا هذه العلة من الامور المستندة إلى السمع والعبادة به جايز ارتفاعها لجواز خلق المكلفين من العبادات الشرعية كلها ، وما يجوز على حال ارتفاعه لا يجوز أن يكون علته في أمر مستمر لا يجوز زواله. وقد استقصينا هذا المعنى في كتابنا الشافي في الامامة وأوضحناه ، ثم نقول من بعده أن الحق في زماننا هذا على ضربين : عقلي وسمعي : فالعقلي ندركه بالعقل ولا يؤثر فيه وجود الامام ولا فقده. والسمعي انما يدرك بالنقل الذي في مثله الحجة. ولا حق علينا يجب العلم به من الشرعيات إلا وعليه دليل شرعي. وقد ورد النقل به عن النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة من ولده صلوات الله عليهم ، فنحن نصيب الحق بالرجوع إلى هذه الادلة والنظر فيها. والحاجة مع ذلك كله إلى الامام ثابتة لان الناقلين يجوز أن يعرضوا عن النقل إما بشبهة أو اعتماد فينقطع النقل أو يبقى فيمن ليس نقله حجة ولا دليل ، فيحتاج حينئذ المكلفون إلى دليل هو قول الامام وبيانه ، وإنما يثق المكلفون بما نقل إليهم ، وانه جميع الشرع لعلمهم بأن وراء هذا النقل إماما متى اختل استدرك عما شذ منه ، فالحاجة إلى الامام ثابتة مع ادراك الحق في أحوال الغيبة من الادلة الشرعية على ما بيناه.
(مسألة) : فإن قيل : إذا كانت العلة في استتار الامام خوفه من الظالمين واتقائه من المعاندين فهذه العلة زايلة في أوليائه وشيعته ، فيجب أن يكون ظاهرا لهم أو يجب أن يكون التكليف الذي أوجب إمامته لطفا فيه ساقطا عنهم ، لأنه لا يجوز أن يكلفوا بما فيه لطف لهم ثم يحرموه بجناية غيرهم.
(الجواب) : قلنا : قد أجاب أصحابنا عن هذا بأن العلة في استتاره من الاعداء هي الخوف منهم والتقية. وعلة استتاره من الاولياء لا يمتنع أن يكون لئلا يشيعوا خبره ويتحدثوا عنه مما يؤدي إلى خوفه وان كانوا غير قاصدين بذلك. وقد ذكرنا في كتاب الامامة جوابا آخر ، وهو أن الامام (عليه السلام) عند ظهوره عن الغيبة إنما يعلم شخصه ويتميز عينه من جهة المعجز الذي يظهر على يديه لان النص المتقدم من آبائه عليهم السلام لا يميز شخصه من غيره ، كما يميز النص أشخاص آبائه (عليهم السلام) لما وقع على إمامتهم. والمعجز إنما يعلم دلالة وحجة بضرب من الاستدلال ، والشبهة معترضة لذلك وداخلة عليه ، فلا يمتنع على هذا أن يكون كل من لم يظهر له من أوليائه ، فلان المعلوم من حاله أنه متى ظهر له قصر في النظر في معجزه ، ولحق به هذا التقصير عند دخول الشبهة لمن يخاف منه من الاعداء ، وقلنا أيضا أنه غير ممتنع أن يكون الامام عليه السلام يظهر لبعض أوليائه ممن لا يخشى من جهته شيئا من أسباب الخوف ، فإن هذا مما لا يمكن القطع على ارتفاعه وامتناعه ، وإنما يعلم كل واحد من شيعته حال نفسه ، ولا سبيل له إلى العلم بحال غيره. ولو لا أن استقصاء الكلام في مسائل الغيبة يطول ويخرج عن الغرض بهذا الكتاب لاشبعناه ها هنا. وقد أوردنا منه الكثير في كتابنا في الامامة ولعلنا نستقصي الكلام فيه ونأتي على ما لعله لم نورده في كتاب الامامة في موضع نفرده له ، إن أخر الله تعالى في المدة وتفضل بالتأييد والمعونة ، فهو المؤول ذلك والمأمول لكل فضل وخير قربا من ثوابه وبعدا من عقابه ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين
 الاكثر قراءة في مقالات عقائدية
الاكثر قراءة في مقالات عقائدية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)