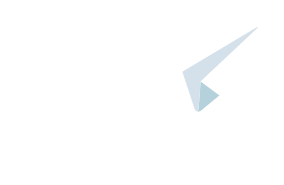تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير الآية (74-79) من سورة الانعام
المؤلف:
اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
15-6-2021
25484
قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (74) وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام : 74 - 79] .
قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} [الأنعام : 74 - 75] .
{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ} أي : واذكر إذ قال {لِأَبِيهِ آزَرَ} فيه أقوال أحدها : إنه اسم أبي إبراهيم ، عن الحسن ، والسدي ، والضحاك . وثانيها : إن اسم أبي إبراهيم تارخ ، قال الزجاج : ليس بين النسابين اختلاف أن اسم أبي إبراهيم تارخ ، والذي في القرآن يدل على أن اسمه آزر . وقيل : آزر عندهم ذم في لغتهم ، كأنه قال : وإذ قال إبراهيم لأبيه يا مخطئ ، فإذا كان كذلك ، فالاختيار الرفع ، وجائز أن يكون وصفا له ، كأنه قال لأبيه المخطئ . وقيل : آزر اسم صنم . عن سعيد بن المسيب ، ومجاهد ، قال الزجاج : فإذا كان كذلك ، فموضعه نصب على إضمار الفعل ، كأنه قال : وإذ قال إبراهيم لأبيه : أتتخذ آزر . وجعل أصناما بدلا من آزر وأشباهه ، فقال بعد أن قال أتتخذ آزر إلها : أتتخذ أصناما آلهة ؟ وهذا الذي قال الزجاج ، يقوي ما قاله أصحابنا : إن آزر كان جد إبراهيم لأمه ، أو كان عمه ، من حيث صح عندهم ، إن آباء النبي إلى آدم كلهم كانوا موحدين ، واجتمعت الطائفة على ذلك .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين ، إلى أرحام المطهرات ، حتى أخرجني في عالمكم هذا ، لم يدنسني بدنس الجاهلية " . ولو كان في آبائه كافر ، لم يصف جميعهم بالطهارة ، مع قوله تعالى {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة : 28] ، ولهم في ذلك أدلة ليس هنا موضع ذكرها .
وقوله {أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً} استفهام المراد به الانكار أي : لا تفعل ذلك {إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ} عن الصواب {مُبِينٍ} : ظاهر . وفي الآية حث للنبي على محاجة قومه الذين دعوه إلى عبادة الأصنام . والاقتداء بأبيه إبراهيم فيه وتسلية له بذلك {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ} أي : مثل ما وصفناه من قصة إبراهيم ، وقوله لأبيه ما قال ، نريه {مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} أي : القدرة التي تقوى بها دلالته على توحيد الله تعالى . وقيل : معناه كما أريناك يا محمد ، أريناه آثار قدرتنا فيما خلقنا من الشمس ، والقمر والنجوم ، وما في الأرض من البحار ، والمياه ، والرياح ، ليستدل بها . وهذا معنى قول ابن عباس ، وقتادة .
وقيل : يعني بالملكوت آيات السماوات والأرض ، عن مجاهد . وقيل : إن ملكوت السماوات والأرض ملكهما بالنبطية ، عن مجاهد أيضا . وقيل : إن ملكوت السماوات والأرض ما نشاهده من الحوادث الدالة على أن الله سبحانه مالك لهما ، والله المالك لهما ، ولكل شيء بنفسه ، لا يملكه سواه ، فأجرى الملكوت على المملوك الذي هو في السماوات والأرض مجازا ، عن أبي علي الجبائي .
وقال أبو جعفر (عليه السلام) : " كشط الله له عن الأرضين حتى رآهن وما تحتهن ، وعن السماوات حتى رآهن وما فيهن من الملائكة ، وحملة العرش " . وروى أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لما رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ، رأى رجلا يزني ، فدعا عليه فمات . ثم رأى آخر ، فدعا عليه فمات ، ثم رأى ثلاثة ، فدعا عليهم فماتوا ، فأوحى الله تعالى : يا إبراهيم إن دعوتك مستجابة ، فلا تدع على عبادي ، فإني لو شئت أن أميتهم بدعائك ما خلقتهم . إني خلقت خلقي على ثلاثة أصناف : صنف يعبدني لا يشرك بي شيئا فأثيبه ، وصنف يعبد غيري ، فليس يفوتني ، وصنف يعبد غيري ، فأخرج من صلبه من يعبدني " {وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} أي : من المتيقنين بأن الله سبحانه هو خالق ذلك ، والمالك له .
- {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (78) إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام : 76 - 79] .
لما تقدم ذكر الآيات التي أراها الله تعالى إبراهيم عليه السلام بين سبحانه كيف استدل بها ، وكيف عرف الحق من جهتها فقال : {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ} أي :
أظلم عليه ، وستر بظلامه كل ضياء {رَأَى كَوْكَبًا} واختلف في الكوكب الذي رآه ، فقيل! : هو الزهرة . وقيل : هو المشتري {قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ} أي : غرب {قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} واختلف في تفسير هذه الآيات على أقوال أحدها : إن إبراهيم عليه السلام إنما قال ذلك ، عند كمال عقله في زمان مهلة النظر ، وخطور الخاطر الموجب عليه النظر بقلبه ، لأنه عليه السلام لما أكمل الله عقله ، وحرك دواعيه على الفكر والتأمل ، رأى الكوكب فأعظمه وأعجبه نوره وحسنه ، وقد كان قومه يعبدون الكواكب ، فقال : هذا ربي ، على سبيل الفكر ، فلما أفل ، علم أن الأفول لا يجوز على الإله ، فاستدل بذلك على أنه محدث مخلوق ، وكذلك كانت حاله في رؤية القمر والشمس ، فإنه لما رأى أفولهما ، قطع على حدوثهما واستحالة إلهيتهما ، وقال في آخر كلامه {يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} إلى آخره . وكان هذا القول منه عقيب معرفته بالله تعالى ، وعلمه بأن صفات المحدثين لا تجوز عليه ، وهذا اختيار أبي القاسم البلخي ، وغيره ، قال : وزمان مهلة النظر هي أكثر من ساعة ، وأقل من شهر ، ولا يعلم ما بينهما إلا الله تعالى .
وثانيها : إنه إنما قال ذلك قبل بلوغه ، ولما قارب كمال العقل ، حركته الخواطر فيما شاهده من هذه الحوادث ، فلما رأى الكوكب ، ونوره ، وإشراقه ، وزهوره ، ظن أنه ربه ، فلما أفل وانتقل من حال إلى حال ، قال : لا أحب الآفلين .
{فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا} عند طلوعه ، ورأى كبره ، وإشراقه ، وانبساط نوره ، وضياءه في الدنيا {قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ} ، وصار مثل الكوكب في الأفول والغيبوبة ، وعلم أنه لا يجوز أن يكون ذلك صفة الإله ، {قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي} إلى رشدي ، ولم يوفقني ، ويلطف بي في إصابة الحق من توحيده ، {لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ} بعبادة هذه الحوادث .
{فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً} أي : طالعة ، وقد ملأت الدنيا نورا ، ورأى عظمها وكبرها ، {قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ} من الكوكب والقمر {فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ} حينئذ لقومه {يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} مع الله الذي خلقني وخلقكم في عبادته من آلهتكم ، فلما أكمل الله عقله ، وضبط بفكره النظر في حدوث الأجسام ، بأن وجدها غير منفكة من المعاني المحدثة ، وأنه لا بد لها من محدث قال حينئذ لقومه {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ} أي نفسي {لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا} أي مخلصا مائلا عن الشرك إلى الإخلاص {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} وهذا اختيار أبي علي الجبائي .
ويسأل عن القول الأول : كيف قال عليه السلام هذا ربي مخبرا ، وهو غير عالم بما يخبر به ، والإخبار بما لا يأمن المخبر أن يكون فيه كاذبا قبيح ؟ والجواب عنه في وجهين أحدهما : إنه لم يقل ذلك مخبرا ، وإنما قاله فارضا ومقدرا على سبيل التأمل ، كما يفرض أحدنا إذا نظر في حدوث الأجسام كونها قديمة ، ليتبين ما يؤدي إليه الفرض من الفساد ، ولا يكون بذلك مخبرا في الحقيقة والأخر : إنه أخبر عن ظنه ، قد يجوز أن يظن المتفكر في حال فكره ونظره ، ما لا أصل له ، ثم يرجع عنه بالأدلة .
(سؤال آخر) : كيف تعجب إبراهيم عليه السلام من رؤية هذه الأشياء تعجب من لم يكن رآها ، وكيف يجوز أن يكون مع كمال عقله ، لم يشاهد السماء والكواكب ؟
والجواب : إنه لا يمتنع أن يكون عليه السلام ما رأى السماء إلا في ذلك الوقت ، لأنه قد روي أن أمه كانت ولدته في مغارة ، خوفا من أن يقتله نمرود ، ومن يكون في المغارة ، لا يرى السماء ، فلما قارب البلوغ ، وبلغ حد التكليف ، خرج من المغارة ، ورأى السماء . وقد يجوز أيضا أن يكون قد رأى السماء قبل ذلك ، إلا أنه لم يفكر في أعلامها ، لأن الفكر لم يكن واجبا عليه ، وحين كمل عقله فكر في ذلك . وثالثها : إن إبراهيم عليه السلام لم يقل {هَذَا رَبِّي} على طريق الشك ، بل كان عالما موقنا أن ربه سبحانه لا يجوز أن يكون بصفة الكواكب ، وإنما قال ذلك على سبيل الانكار على قومه ، والتنبيه لهم على أن من يكون إلها معبودا ، لا يكون بهذه الصفة الدالة على الحدوث ، ويكون قوله {هَذَا رَبِّي} محمولا على أحد الوجهين : إما على أنه كذلك عندكم وفي مذاهبكم . كما يقول أحدنا للمشبه هذا ربه ، جسم يتحرك ويسكن . وإما على أن يكون قال ذلك مستفهما ، وأسقط حرف الاستفهام للاستغناء عنه ، وقد كثر مجيء ذلك في كلام العرب ، قال أوس بن حجر :
لعمرك لا أدري وإن كنت داريا شعيب بن سهم أم شعيب بن منقر
وقال الأخطل :
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا(2)
وقال عمر بن أبي ربيعة :
ثم قالوا تحبها قلت بهرا (3) عدد القطر والحصى والتراب
أي أتحبها ؟ وقال آخر :
رفوني وقالوا : يا خويلد لا ترع فقلت ، وأنكرت الوجوه : هم هم (4)
أي : أهم أهم . وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ} [البلد : 11] معناه أفلا أقتحم فحذف حرف الاستفهام .
ورابعها إنه عليه السلام إنما قال استخداعا للقوم ، يريهم قصور علمهم ، وبطلان عبادتهم لمخلوق جار عليه أعراض الحوادث ، فإنهم كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب ، وبعضهم يعبدون النيران ، وبعضهم يعبدون الأوثان ، فلما رأى الكوكب الذي كانوا يعبدونه ، قال لهم {هَذَا رَبِّي} في زعمكم ، كما قال : {أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ} [القصص : 62] فأضافه إلى نفسه ، حكاية لقولهم ، فكأنه قال لهم {هَذَا رَبِّي} في قولكم . وقيل : انه نوى في قلبه الشرط أي : إن كان ربكم هذا الحجر ، كما تزعمون ، فهذا الكوكب ، وهذا القمر والشمس ، ربي . ولم يكن الحجر ربهم ، ولا الكوكب ربه .
وفي هذه الآيات دلالة على حدوث الأجسام ، وإثبات الصانع ، وإنما استدل إبراهيم بالأفول على حدوثها ، لأن حركتها بالأفول أظهر ، ومن الشبهة أبعد ، وإذا جازت عليها الحركة والسكون ، فلا بد أن تكون مخلوقة محدثة ، وإذا كانت محدثة فلا بد لها من محدث ، والمحدث لا بد أن يكون قادرا ليصح منه الإحداث ، وإذا أحدثها على غاية الإنتظام والإحكام ، فلا بد أن يكون عالما ، وإذا كان قادرا عالما ، وجب أن يكون حيا موجود ! .
وفيها تنبيه لمشركي العرب ، وزجر لهم عن عبادة الأصنام وحث لهم على سلوك طريق أبيهم إبراهيم عليه السلام ، في النظر والتفكر ، لأنهم كانوا يعظمون آباءهم ، فأعلمهم سبحانه أن اتباع الحق من دين إبراهيم الذي يقرون بفضله ، أوجب عليهم .
____________________________
- تفسير مجمع البيان ، ج4 ، ص 89-96 .
- الواسط : بلد بالعراق . الغلس كغرس : ظلمة آخر الليل . والظلام : ذهاب النور ، وأراد به هنا ا لليل . والرباب كسحاب : اسم امرأة . والخيال : الظن .
- قوله بهرا مفعول مطلق لفعل محذوف اي : بهرني بهرا بمعنى غلبني غلبة .
- رفوني أي : سكنوني من الرعب . اعتبر بمشاهدة الوجوه ، وجعلها دليلا على ما في النفوس .
{وإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} . ظاهر الآية يدل صراحة على ان آزر أب حقيقي لإبراهيم الخليل (عليه السلام) وانه كان مشركا يعبد الأصنام ، وان إبراهيم نهاه عن الشرك ودعاه إلى التوحيد . .
هذا هو مدلول الآية الذي يتبادر إلى فهم العالم والجاهل على السواء ، من غير شرح وتفسير ، ومع هذا فقد أطال المفسرون الكلام واختلفوا : هل آزر أب حقيقي لإبراهيم ، أو أب مجازي ؟ وهذا الاختلاف يتفرع عن اختلاف آخر هو : هل جميع آباء محمد (صلَّ الله عليه وآله) وأجداده يجب أن يكونوا موحدين ، ولا يجوز أن يكون فيهم مشرك واحد ، أو يجوز أن يكون فيهم المشرك والموحد ؟ وبعض العلماء ألفوا رسائل خاصة في ذلك .
قال الشيعة : جميع آباء محمد وأجداده موحدون لحديث : ما زلت انتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات ، حتى أخرجني اللَّه إلى عالمكم هذا .
وقالوا : الأب الحقيقي لإبراهيم اسمه تارح ، وان آزر أخو أبيه ، أو جده لأمه ، وأطلق عليه لفظ الأب مجازا (2) . وقال الألوسي في تفسيره : وعلى هذا جم غفير من السنة ، أي انهم يقولون بمقالة الشيعة .
ولكن صاحب تفسير المنار والرازي قالا : ان السنة لا يوافقون الشيعة على رأيهم هذا ، ويجيزون أن يكون في أجداد النبي مشرك أو ملحد . . وظاهر القرآن مع السنة ، بخاصة قوله : {واذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا إِذْ قالَ لأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرُ ولا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً} [مريم - 42] .
وعلى أية حال ، فلا جدوى من هذا النزاع ، وبسط الكلام فيه تكثير له من غير طائل ، لأنه لا يمت إلى عقيدة الإسلام بصلة ، فإن المطلوب من المسلم الإيمان بنبوة محمد (صلَّ الله عليه وآله) وعصمته ، وأنه سيد الأنبياء وخاتمهم ، أما الإيمان بأن جميع آبائه وأجداده موحدون ، وانه آزر عم إبراهيم لا أبوه ، أما هذا فليس من عقيدة الإسلام في شيء .
{وكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ والأَرْضِ} . المراد بكذلك ان اللَّه سبحانه كما كشف لإبراهيم عن ضلال قومه في عبادتهم الأصنام فقد كشف له أيضا عن عجائب السماوات والأرض ليستدل ببديع نظامهما وغريب صنعهما على وجود اللَّه ووحدانيته وعظمته {ولِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} فيؤمن عن حجة ودليل ، وتدل هذه الآية على أمرين :
الأول : ان عقيدة الإسلام تقوم على حرية الرأي والعقل ، لأن اللَّه سبحانه ما أوجب الإيمان به إلا بعد أن أقام الدليل عليه ، ودعاهم إلى النظر فيه .
الثاني : ان الدليل الذي أقامه على وجوده ميسور وسهل على جميع الافهام لا يحتاج إلى جهد ، ولا إلى علم وفلسفة ، فيكفي أن ينظر الإنسان إلى عجائب الكون والنظام الذي يحكمه ليهتدي إلى خالقه وصانعه المبدع .
{فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي} . كان قوم إبراهيم يعبدون الكواكب من دون اللَّه ، فأراد أن يستدرجهم إلى الحق ، ويلفتهم إلى منطق العقل والفطرة برفق ولين ، فانتظر حتى جن عليه الليل ، وستر الأرض بظلامه ، ورأى كوكبا مما يعبدون ، فقال محاكاة لزعمهم : هذا ربي . فاطمأنوا إليه ، ولما أفل الكوكب وغاب تحت الأفق أيقظ عقولهم ، ولفت نظرهم إلى أن الآلهة لا تتقلب وتتغير ، ولا يحجبها شيء .
{فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ} استدراجا لهم واستهواء لقلوبهم : {هذا رَبِّي} لأنه أسطع نورا وأكبر حجما من الأول {فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ} ، يشير إلى أنه غير مطمئن النفس لهذه الكواكب ، وانه لم يهتد بعد إلى الطريق ، وطلب من اللَّه أن ينقذه من هذه الحيرة .
{فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} . لقد مضت التجربة الأولى والثانية والثالثة ، وبقي الشك كما كان ، إذن ، لا بد من البراءة من عبادة الكواكب ، لأنها لا تستأهل العبادة ، ولا تستحق الإكبار ، وبعد أن أعلن البراءة من آلهتهم توجه بقلبه إلى خالق الكون ، وقال : {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ والأَرْضَ حَنِيفاً وما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} . هذه هي النتيجة الحتمية للنظرة الفاحصة ، والتفكير الحنيف في أي شيء من أشياء هذا الكون ، نظرة واحدة لا غير بتجرد وتدبر إلى أية صورة من صور هذا العالم تؤدي حتما إلى اليقين الجازم بأن اللَّه وحده هو فاطر السماوات والأرض .
___________________________
1. تفسير الكاشف ، ج3 ، ص212-214 .
2. لقد تواتر ان عبد المطلب جد النبي (صلَّ الله عليه وآله) حلف إذا رزق عشرة بنين أن يضحي بواحد منهم ، وان السهم خرج على عبد اللَّه أبي محمد (صلَّ الله عليه وآله) ، وهذا يتنافى مع القول : ان جميع أجداد النبي كانوا على دين إبراهيم .
قوله تعالى : {وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ} القراءات السبع في آزر بالفتح فيكون عطف بيان أو بدلا من أبيه وفي بعض القراءات (آزَرَ) بالضم وظاهره أنه منادى مرفوع بالنداء ، والتقدير : يا آزر أتتخذ أصناما آلهة ، وقد عد من القراءات (أأزرا تتخذ) مفتتحا بهمزة الاستفهام ، وبعده (أزرا) بالنصب مصدر أزر يأزر بمعنى قوي والمعنى : وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما للتقوي والاعتضاد .
وقد اختلف المفسرون على القراءة الأولى المشهورة والثانية الشاذة في (آزر) أنه اسم علم لأبيه أو لقب أريد بمعناه المدح أو الذم بمعنى المعتضد أو بمعنى الأعرج أو المعوج أو غير ذلك ومنشأ ذلك ما ورد في عدة روايات أن اسم أبيه (تارح) بالحاء المهملة أو المعجمة ويؤيده ما ضبطه التاريخ من اسم أبيه ، وما وقع في التوراة الموجودة أنه عليه السلام ابن تارخ .
كما اختلفوا أن المراد بالأب هو الوالد أو العم أو الجد الأمي أو الكبير المطاع ومنشأ ذلك أيضا اختلاف الروايات فمنها ما يتضمن أنه كان والده وأن إبراهيم عليه السلام سيشفع له يوم القيامة ولكن لا يشفع بل يمسخه الله ضبعا منتنا فيتبرأ منه إبراهيم ، ومنها ما يدل على أنه لم يكن والده ، وأن والده كان موحدا غير مشرك ، وما يدل على أن آباء النبي صلى الله عليه وآله كانوا جميعا موحدين غير مشركين إلى غير ذلك من الروايات ، وقد اختلفت في سائر ما قص من أمر إبراهيم اختلافا عجيبا حتى اشتمل بعضها على نظائر ما ينسبه إليه العهد العتيق مما تنزهه عنه الخلة الإلهية والنبوة والرسالة .
وقد أطالوا هذا النمط من البحث حتى انجر إلى غايات بعيدة تغيب عندها رسوم البحث التفسيري الذي يستنطق الآيات الكريمة عن مقاصدها عن نظر الباحث ، وعلى من يريد الاطلاع على ذلك أن يراجع مفصلات التفاسير وكتب التفسير بالمأثور .
والذي يهدي إليه التدبر في الآيات المتعرضة لقصصه عليه السلام أنه عليه السلام في أول ما عاشر قومه بدأ بشأن رجل يذكر القرآن أنه كان أباه آزر ، وقد أصر عليه أن يرفض الأصنام ويتبعه في دين التوحيد فيهديه حتى طرده أبوه عن نفسه وأمره أن يهجره قال تعالى : {وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا ، إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً ، يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا ـ إلى أن قال ـ قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا} [مريم : 46] فسلم عليه إبراهيم ووعده أن يستغفر له ، ولعله كان طمعا منه في إيمانه وتطميعا له في السعادة والهدى قال تعالى : {قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا ، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسى أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا} [مريم : 48] والآية الثانية أحسن قرينة على أنه عليه السلام إنما وعده أن يستغفر له في الدنيا لا أن يشفع له يوم القيامة وإن بقي كافرا أو بشرط أن لا يعلم بكفره .
ثم حكى الله سبحانه إنجازه عليه السلام لوعده هذا واستغفاره لأبيه في قوله : {رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [الشعراء : 89] وقوله : {إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ} يدل على أنه عليه السلام إنما دعا بهذا الدعاء لأبيه بعد موته أو بعد مفارقته إياه وهجره له لمكان قوله :
{كانَ} وذيل كلامه المحكي في الآيات يدل على أنه كان صورة دعاء أتى بها للخروج عن عهدة ما وعده وتعهد له فإنه عليه السلام يقول : اغفر لهذا الضال يوم القيامة ثم يصف يوم القيامة بأنه لا ينفع فيه شيء إلا القلب السليم .
وقد كشف الله سبحانه عن هذه الحقيقة بقوله ـ وهو في صورة الاعتذار ـ : {ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ ، وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ} [التوبة : 114] والآية بسياقها تشهد على أن هذا الدعاء إنما صدر منه عليه السلام في الدنيا وكذلك التبري منه لا أنه سيدعو له ثم يتبرأ منه يوم القيامة فإن السياق سياق التكليف التحريمي العام وقد استثنى منه دعاء إبراهيم ، وبين أنه كان في الحقيقة وفاء منه عليه السلام بما وعده ، ولا معنى لاستثناء ما سيقع مثلا يوم القيامة عن حكم تكليفي مشروع في الدنيا ثم ذكر التبري يوم القيامة .
وبالجملة هو سبحانه يبين دعاء إبراهيم عليه السلام لأبيه ثم تبريه منه ، وكل ذلك في أوائل عهد إبراهيم ولما يهاجر إلى الأرض المقدسة بدليل سؤاله الحق واللحوق بالصالحين وأولادا صالحين كما يستفاد من قوله في الآيات السابقة : {رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ} الآية وقوله تعالى ـ ويتضمن التبري عن أبيه وقومه واستثناء الاستغفار أيضا ـ : {قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ} [الممتحنة : 4] .
ثم يذكر الله تعالى عزمه عليه السلام على المهاجرة إلى الأرض المقدسة وسؤاله أولادا صالحين بقوله : {فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ ، وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى رَبِّي سَيَهْدِينِ ، رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ} [الصافات : 100] .
ثم يذكر تعالى ذهابه إلى الأرض المقدسة ورزقه صالح الأولاد بقوله : {وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ ، وَنَجَّيْناهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ ، وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ} [الأنبياء : 72] وقوله : {فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنا نَبِيًّا} [مريم : 49] .
ثم يذكر تعالى آخر دعائه بمكة وقد وقع في آخر عهده عليه السلام بعد ما هاجر إلى الأرض المقدسة وولد له الأولاد وأسكن إسماعيل مكة وعمرت البلدة وبنيت الكعبة ، وهو آخر ما حكي من كلامه في القرآن الكريم : {وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ ـ إلى أن قال ـ رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ ـ إلى أن قال ـ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ ـ إلى أن قال ـ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ} [إبراهيم : 41] .
والآية بما لها من السياق وبما احتف بها من القرائن أحسن شاهد على أن والده الذي دعا له فيها غير الذي يذكره سبحانه بقوله : {لِأَبِيهِ آزَرَ} فإن الآيات كما ترى تنص على أن إبراهيم عليه السلام استغفر له وفاء بوعده ثم تبرأ منه لما تبين له أنه عدو لله ، ولا معنى لإعادته عليه السلام الدعاء لمن تبرأ منه ولاذ إلى ربه من أن يمسه فأبوه آزر غير والده الصلبي الذي دعا له ولأمه معا في آخر دعائه .
ومن لطيف الدلالة في هذا الدعاء أعني دعاءه الأخير ما في قوله : {وَلِوالِدَيَ} حيث عبر بالوالد والوالد لا يطلق إلا على الأب الصلبي وهو الذي يلد ويولد الإنسان مع ما في دعائه الآخر : {وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ} والآيات الآخر المشتملة على ذكر أبيه آزر فإنها تعبر عنه بالأب والأب ربما تطلق على الجد والعم وغيرهما ، وقد اشتمل القرآن الكريم على هذا الإطلاق بعينه في قوله تعالى : {أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنِيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة : 133] فإبراهيم جد يعقوب وإسماعيل عمه وقد أطلق على كل منهما الأب ، وقوله تعالى فيما يحكي من كلام يوسف عليه السلام : {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف : 38] فإسحاق جد يوسف وإبراهيم عليه السلام جد أبيه وقد أطلق على كل منهما الأب .
فقد تحصل أن آزر الذي تذكره الآية ليس أبا لإبراهيم حقيقة وإنما كان معنونا ببعض الأوصاف والعناوين التي تصحح إطلاق الأب عليه ، وأن يخاطبه إبراهيم عليه السلام بيا أبت ، واللغة تسوغ إطلاق الأب على الجد والعم وزوج أم الإنسان بعد أبيه وكل من يتولى أمور الشخص وكل كبير مطاع ، وليس هذا التوسع من خصائص اللغة العربية بل يشاركها فيه وفي أمثاله سائر اللغات كالتوسع في إطلاق الأم والعم والأخ والأخت والرأس والعين والفم واليد والعضد والإصبع وغير ذلك مما يهدي إليه ذوق التلطف والتفنن في التفهيم والتفهم .
فقد تبين أولا أن لا موجب للاشتغال بما تقدمت الإشارة إليه من الأبحاث الروائية والتاريخية والأدبية في أبيه ولفظة آزر وأنه هل هو اسم علم أو لقب مدح أو ذم أو اسم صنم فلا حاجة إلى شيء من ذلك في الحصول على مراد الآية .
على أن غالب ما أوردوه في هذا الباب تحكم لا دليل عليه مع ما فيه من إفساد ظاهر الآية وإخلال أمر السياق باعتبار التراكيب العجيبة التي ذكروها للجملة {آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً} من تقديم وتأخير وحذف وتقدير .
وثانيا : أن والده الحقيقي غير آزر لكن القرآن لم يصرح باسمه ، وإنما وقع في الروايات ويؤيده ما يوجد في التوراة أن اسمه (تارخ) .
ومن عجيب الوهم ما ذكره بعض الباحثين أن القرآن الكريم كثيرا ما يهمل فيما يذكره من تاريخ الأنبياء والأمم ويقصه من قصص الماضين أمورا مهمة هي من جوهريات القصص كذكر تاريخ الوقوع ومحله والأوضاع الطبيعية والاجتماعية والسياسية وغيرها المؤثرة في تكون الحوادث الدخيلة في تركب الوقائع ومنها ما في مورد البحث فإن من العوامل المقومة لمعرفة حقيقة هذه القصة معرفة اسم أبي إبراهيم ونسبه وتاريخ زمن نشوئه ونهضته ودعوته ومهاجرته .
وليس ذلك إلا لأن القرآن سلك في قصصه المسلك الجيد الذي يهدي إليه فن القصص الحقيقي وهو أن يختار القاص في قصته كل طريق ممكن موصل إلى غايته ومقصده إيصالا حسنا ، ويمثل المطلوب تمثيلا تاما بالغا من غير أن يبالغ في تمييز صحيح ما يقصه من سقيمه ، ويحصي جميع ما هو من جوهريات القصة كتأريخ الوقوع ومكانه وسائر نعوته اللازمة فمن الجائز أن يأخذ القرآن الكريم في سبيل النيل إلى مقصده وهو الهداية إلى السعادة الإنسانية قصصا دائرة بين الناس أو بين أهل الكتاب في عصر الدعوة وإن لم يوثق بصحتها أو لم يتبين فيما بأيديهم من القصة جميع جهاتها الجوهرية حتى لو كانت قصة تخييلية كما قيل بذلك في قصة موسى وفتاه وفي قصة الملإ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وغير ذلك فالفن القصصي لا يمنع شيئا من ذلك بعد ما ميز القاص أن القصة أبلغ وسيلة وأسهل طريقة إلى النيل بمقصده .
وهذا خطأ فإن ما ذكره من أمر الفن القصصي حق غير أن ذلك غير منطبق على مورد القرآن الكريم فليس القرآن كتاب تاريخ ولا صحيفة من صحف القصص التخييلية وإنما هو كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وقد نص على أنه كلام الله سبحانه ، وأنه لا يقول إلا الحق ، وأن ليس بعد الحق إلا الضلال ، وأنه لا يستعين للحق بباطل ، ولا يستمد للهدى بضلال ، وأنه كتاب يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم ، وأن ما فيه حجة لمن أخذ به وعلى من تركه في آيات جمة لا حاجة إلى إيرادها فكيف يسع لباحث يبحث عن مقاصد القرآن أن يجوز اشتماله على رأي باطل أو قصة كاذبة باطلة أو خرافة أو تخييل .
لست أريد أن مقتضى الإيمان بالله ورسوله وبما جاء به رسوله أن ينفى عن القرآن أن يشتمل على باطل أو كذب أو خرافة وإن كان ذلك ، ولا أن الواجب على كل إنسان سليم العقل صحيح الفكر مستقيم الأمر أن تخضع نفسه للقرآن بتصديقه ونفي كل خطإ وزلة عنه في وسائل من المعارف توسل بها إلى مقاصده ، وفي نفس تلك المقاصد وإن كان كذلك .
وإنما أقول : إنه كتاب يدعي لنفسه أنه كلام إلهي موضوع لهداية الناس إلى حقيقة سعادتهم يهدي بالحق ويهدي إلى الحق ومن الواجب على من يفسر كتابا هذا شأنه ويستنطقه في مقاصده ومطالبه أن يفترضه صادقا في حديثه مقتصرا على ما هو الحق الصريح في خبره وكل ما يسوقه من بيان أو يقيمه من برهان على مقاصده وأغراضه هاديا إلى الصراط الذي لا يتخلله باطل موصلا إلى غاية لا يشوبها شيء من غير جنس الحق ولا يداخلها أي وهن وفتور .
وكيف يكون مقصد من المقاصد حقا على الإطلاق وقد تسرب باطل ما إلى طريقه الذي يدعو إليه المقصد ولا يدعو ـ على ما يراه ـ إلا إلى حق ؟ وكيف يكون قضية من القضايا قولا فصلا ما هو بالهزل وقد تسرب إلى البيان المنتج لها شيء من المسامحة والمساهلة ؟
وكيف يمكن أن يكون حديث أو نبأ كلاما لله الذي يعلم غيب السماوات والأرض وقد دب فيه جهل أو خبط أو خطاء ؟ وهل ينتج النور ظلمة أو الجهل معرفة ؟ .
فهذا هو المسلك الوحيد الذي لا يحل تعديه في استنطاق القرآن الكريم في مضامين آياته وهو يرى أنه كلام حق لا يشوبه باطل في غرضه وطريق غرضه .
وأما البحث عن أنه هل هو صادق فيما يدعيه لنفسه : أنه كلام الله ، وأنه محض الحق في طريقه وغايته ؟ وأنه ما ذا يقضي به الكتب المقدسة الأخرى كالعهدين وأوستا وغيرها في قضايا قضى بها القرآن ؟ وأنه ما ذا تهدي إليه الأبحاث العلمية الأخر التاريخية أو الطبيعية أو الرياضية أو الفلسفية أو الاجتماعية أو غيرها ؟ فإنما هذه وأمثالها أبحاث خارجة عن وظيفة التفسير ليس من الجائز أن تخلط به أو يقام بها مقامه .
نعم قوله تعالى : {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} [النساء : 82] ينطق بأن هناك شبهات عارضة وأوهاما متسابقة إلى الأذهان تسول لها أن في القرآن اختلافا كان يتراءى من آية أنها تخالف آية ، أو أن يستشكل في آية أنها بمضمونها تخالف الحق والحقيقة وإذ كان القرآن ينص على أنه يهدي إلى الحق فيختلف الآيتان بالآخرة ، هذه تدل على أن كل ما تنبئ عنه آية فهو حق وهذه بمضمونها تنبئ نبأ غير حق لكن الآية أعني قوله : {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ} إلخ ، تصرح القول بأن القرآن تكفي بعض آياته لدفع المشكلة عن بعضها الآخر ويكشف جزء منه عما اشتبه على بعض الأفهام من حال جزء آخر فعلى الباحث عن مراده ومقصده أن يستعين بالبعض على البعض ويستشهد بالبعض على البعض ويستنطق البعض في البعض والقرآن الكريم كتاب دعوة وهداية لا يتخطى عن صراطه ولو خطوة وليس كتاب تاريخ ولا قصة وليست مهمته مهمة الدراسة التاريخية ولا مسلك الفن القصصي ، وليس فيه هوى ذكر الأنساب ولا مقدرات الزمان والمكان ، ولا مشخصات أخر لا غنى للدرس التاريخي أو القصة التخييلية عن إحصائها وتمثيلها .
فأي فائدة دينية في أن ينسب إبراهيم أنه إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن أرفكشاذ بن سام بن نوح ؟ أو أن يقال : إنه ولد في أور الكلدانيين حدود سنة ألفين تقريبا قبل الميلاد في عهد فلان الملك الذي ولد في كذا وملك كذا مدة ومات سنة كذا .
وسنجمع في ذيل البحث عن آيات القصة جملا من قصة إبراهيم عليه السلام منثورة في القرآن ثم نتبعها بما في التوراة وغيرها من تاريخ حياته وشخصيته فلينظر الباحث المتدبر بعين النصفة ثم ليقض فيما اختاره القرآن منها وحققه ما هو قاض .
والقرآن الكريم مع ذلك لم يهمل الواجب في حق العلوم النافعة ، ولم يحرم البحث عن العالم وأجزائه السماوية والأرضية ، ولا منع من استطلاع أخبار الأمم الماضية وسنن المجتمعات والقرون الخالية ، والاستعانة بها على واجب المعرفة ولازم العلم والآيات تمدح العلم أبلغ المدح ، وتندب إلى التفكر والتفقه والتذكر كثرة لا حاجة معها إلى إيرادها هاهنا .
قوله تعالى : {أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} قال الراغب في المفردات : ، الصنم جثة متخذة من فضة أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونها متقربين به إلى الله تعالى وجمعه أصنام قال الله تعالى : {أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً} ، {لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ} ، انتهى ، وما ذكره من اتخاذه من فضة أو نحاس أو خشب إنما هو من باب المثال لا ينحصر فيه اتخاذها بل كان يتخذ من كل ما يمكن أن يمثل به تمثال من أقسام الفلزات والحجارة وغيرها ، وقد روي أن بني حنيفة من اليمامة كانوا قد اتخذوا صنما من أقط ، وربما كانوا يتخذونه من الطين وربما كان صورة مصورة .
وكيف كان فقد كانت الأصنام ربما يمثل بها موضوع اعتقادي غير محسوس كإله السماء والأرض وإله العدل ، وربما يمثل بها موضوع محسوس كصنم الشمس وصنم القمر ، وقد كانت من النوعين جميعا أصنام لقوم إبراهيم عليه السلام على ما تؤيده الآثار المكشوفة منهم في خرائب بابل وقد كانوا يعبدونها تقربا بها إلى أربابها ، وبأربابها إلى الله سبحانه ، وهذا أنموذج بارز من سفه أحلام البشر أن يخضع أعلى حد الخضوع ـ وهو خضوع العبد للرب ـ لمثال مثل به موضوعا يستعظم أمره ويعظمه ، وحقيقته منتهى درجة خضوع المصنوع المربوب لصانعه من صانع لمصنوع نفسه كان الواحد منهم يأخذ خشبة فينحت بيده منه صنما ثم ينصبه فيعبده ويتذلل له ويخضع ولذلك جيء بلفظة الأصنام في قوله المحكي : {أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً} نكرة ليدل على هوان أمرها وحقارته من جهة أنها مصنوعة لهم مخلوقة بأيديهم كما يشير إليه قوله عليه السلام لقومه فيما حكى الله : {أَتَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ} [الصافات : 95] ومن جهة أنها فاقدة لأظهر صفات الربوبية وهو العلم والقدرة كما في قوله لأبيه : {إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً} [مريم : 42] .
فقوله : {أَتَتَّخِذُ أَصْناماً} إلخ ، معناه : أتتخذ أصناما لا خطر في أمرها آلهة والإله هو الذي في أمره خطر عظيم إني أراك وقومك في ضلال مبين ، وكيف لا يظهر هذا الضلال وهو عبادة وتذلل عبودي من صانع فيه آثار العلم والقدرة لمصنوعه الذي يفقد العلم والقدرة .
والذي تشتمل عليه الآية أعني قوله : {أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً}إلخ ، من الحجاج وإن كان بمنزلة التلخيص لعدة احتجاجات واجه بها إبراهيم عليه السلام أباه وقومه على ما حكي تفصيلها في عدة مواضع من القرآن الكريم إلا أنه أول ما حاج به أباه وقومه فإن الذي حكاه الله سبحانه من محاجته هو حجاجه أباه وحجاجه قومه في أمر الأصنام وحجاجهم في ربوبية الكوكب والقمر والشمس وحجاجه الملك .
أما حجاجه في ربوبية الكوكب والقمر والشمس فالآيات دالة على كونه بعد الحجاج في أمر الأصنام ، والاعتبار والتدبر يعطي أن يكون حجاجه الملك بعد ما ظهر أمره وشاع مخالفته لدين الوثنية والصابئة وكسر الأصنام ، وأن يكون مبدأ أمره مخالفته أباه في دينه وهو معه وعنده قبل أن يواجه الناس ويخالفهم في نحلتهم فقد كان أول ما حاج به في التوحيد هو ما حاج به أباه وقومه في أمر الأصنام .
قوله تعالى : {وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ} إلخ ، ظاهر السياق أن تكون الإشارة بقوله : {كَذلِكَ} إلى ما تضمنته الآية السابقة : {وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ} إلخ ، أنه عليه السلام أري الحق في ذلك ، فالمعنى : على هذا المثال من الإراءة نري إبراهيم ملك السماوات والأرض .
وبمعونة هذه الإشارة ودلالة قوله في الآية التالية : {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ} الدالة على ارتباط ما بعده بما قبله يظهر أن قوله : {نُرِي} لحكاية الحال الماضية كقوله تعالى : {وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ} [القصص : 5] .
فالمعنى : أنا أرينا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض فبعثه ذلك أن حاج أباه وقومه في أمر الأصنام وكشف له ضلالهم ، وكنا نمده بهذه العناية والموهبة وهي إراءة الملكوت وكان على هذه الحال حتى جن عليه الليل ورأى كوكبا .
وبذلك يظهر أن ما يتراءى من بعضهم : أن قوله : {وَكَذلِكَ نُرِي} إلخ ، كالمعترضة لا يرتبط بما قبله ولا بما بعده ، وكذا قول بعضهم : إن إراءة الملكوت أول ما ظهر من أمرها في إبراهيم عليه السلام أنه لما جن عليه الليل رأى كوكبا إلخ ، فاسد لا ينبغي أن يصار إليه .
وأما ملكوت السماوات والأرض فالملكوت هو الملك مصدر كالطاغوت والجبروت وإن كان آكد من حيث المعنى بالنسبة إلى الملك كالطاغوت والجبروت بالنسبة إلى الطغيان والجبر أو الجبران .
والمعنى الذي يستعمله فيه القرآن هو المعنى اللغوي بعينه من غير تفاوت كسائر الألفاظ المستعملة في كلامه تعالى غير أن المصداق غير المصداق وذلك أن الملك والملكوت وهو نوع من السلطنة إنما هو فيما عندنا معنى افتراضي اعتباري بعثنا إلى اعتباره الحاجة الاجتماعية إلى نظم الأعمال والأفراد نظما يؤدي إلى الأمن والعدل والقوة الاجتماعيات وهو في نفسه يقبل النقل والهبة والغصب والتغلب كما لا نزال نشاهد ذلك في المجتمعات الإنسانية .
وهذا المعنى على أنه وضعي اعتباري وإن أمكن تصويره في مورده تعالى من جهة أن الحكم الحق في المجتمع البشري لله سبحانه كما قال تعالى : {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام : 57] وقال : {لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ} [القصص : 70] لكن تحليل معنى هذا الملك الوضعي يكشف عن ثبوت ذلك في الحقائق ثبوتا غير قابل للزوال والانتقال كما أن الواحد منا يملك نفسه بمعنى أنه هو الحاكم المسلط المتصرف في سمعه وبصره وسائر قواه وأفعاله بحيث إن سمعه إنما يسمع وبصره إنما يبصر بتبع إرادته وحكمه لا بتبع إرادة غيره من الأناسي وحكمه وهذا معنى حقيقي لا نشك في تحققه فينا مثلا تحققا لا يقبل الزوال والانتقال كما عرفت فالإنسان يملك قوى نفسه وأفعال نفسه وهي جميعا تبعات وجوده قائمة به غير مستقلة عنه ولا مستغنية عنه فالعين إنما تبصر بإذن من الإنسان الذي يبصر بها وكذا السمع يسمع بإذن منه ، ولو لا الإنسان لم يكن بصر ولا إبصار ولا سمع ولا استماع كما أن الفرد من المجتمع إنما يتصرف فيما يتصرف فيه بإذن من الملك أو ولي الأمر ، ولو لم تكن هذه القوة المدبرة التي تتوحد عندها أزمة المجتمع لم يكن اجتماع ، ولو منع عن تصرف من التصرفات الفردية لم يكن له أن يتصرف ولا نفذ منه ذلك ، ولا شك أن هذا المعنى بعينه موجود لله سبحانه الذي إليه تكوين الأعيان وتدبير النظام فلا غنى لمخلوق عن الخالق عز اسمه لا في نفسه ولا في توابع نفسه من قوى وأفعال ، ولا استقلال له لا منفردا ولا في حال اجتماعه مع سائر أجزاء الكون وارتباط قوى العالم وامتزاج بعضها ببعض امتزاجا يكون هذا النظام العام المشاهد .
قال تعالى : {قُلِ اللهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ} [آل عمران : 26] وقال تعالى : {لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ} [المائدة : 120] وقال تعالى : {تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ ـ إلى أن قال ـ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً} [الملك : 3] والآيات ـ كما ترى ـ تعلل الملك بالخلق فكون وجود الأشياء منه وانتساب الأشياء بوجودها وواقعيتها إليه تعالى هو الملاك في تحقق ملكه وهو بمعنى ملكه الذي لا يشاركه فيه غيره ولا يزول عنه إلى غيره ولا يقبل نقلا ولا تفويضا يغني عنه تعالى وينصب غيره مقامه .
وهذا هو الذي يفسر به معنى الملكوت في قوله : {إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ، فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} [يس : 83] فالآية الثانية تبين أن ملكوت كل شيء هو كلمة كن الذي يقوله الحق سبحانه له ، وقوله فعله ، وهو إيجاده له .
فقد تبين أن الملكوت هو وجود الأشياء من جهة انتسابها إلى الله سبحانه وقيامها به ، وهذا أمر لا يقبل الشركة ويختص به سبحانه وحده ، فالربوبية التي هي الملك والتدبير لا تقبل تفويضا ولا تمليكا انتقاليا .
ولذلك كان النظر في ملكوت الأشياء يهدي الإنسان إلى التوحيد هداية قطعية كما قال تعالى : {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} [الأعراف : 185] والآية ـ كما ترى ـ تحاذي أول سورة الملك المنقول آنفا .
فقد بان أن المراد بإراءة إبراهيم ملكوت السماوات والأرض على ما يعطيه التدبر في سائر الآيات المربوطة بها هو توجيهه تعالى نفسه الشريفة إلى مشاهدة الأشياء من جهة استناد وجودها إليه ، وإذ كان استنادا لا يقبل الشركة لم يلبث دون أن حكم عليها أن ليس لشيء منها أن يرب غيره ويتولى تدبير النظام وأداء الأمور فالأصنام تماثيل عملها الإنسان وسماها أسماء لم ينزل الله عليها من سلطان ، وما هذا شأنه لا يرب الإنسان ولا يملكه وقد عملته يد الإنسان ، والأجرام العلوية كالكوكب والقمر والشمس تتحول عليها الحال فتغيب عن الإنسان بعد حضورها ، وما هذا شأنه لا يكون له الملك وتولي التدبير تكوينا كما سيجيء بيانه .
قوله تعالى : {وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} اللام للتعليل ، والجملة معطوفة على أخرى محذوفة والتقدير : ليكون كذا وكذا وليكون من الموقنين .
واليقين هو العلم الذي لا يشوبه شك بوجه من الوجوه ، ولعل المراد به أن يكون على يقين بآيات الله على حد ما في قوله : {وَجَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَكانُوا بِآياتِنا يُوقِنُونَ} [السجدة : 24] وينتج ذلك اليقين بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا .
وفي معنى ذلك ما أنزله في خصوص النبي صلى الله عليه وآله قال : {سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا} [الإسراء : 1] وقال : {ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى ، لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى} [النجم : 18] وأما اليقين بذاته المتعالية فالقرآن يجله تعالى أن يتعلق به شك أو يحيط به علم وإنما يسلمه تسليما .
وقد ذكر في كلامه تعالى من خواص العلم اليقيني بآياته تعالى انكشاف ما وراء ستر الحس من حقائق الكون على ما يشاء الله تعالى كما في قوله : {كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ} [التكاثر : 6] وقوله : {كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ، وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ ، كِتابٌ مَرْقُومٌ ، يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ} [المطففين : 21] .
قوله تعالى : {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي} إلى آخر الآية قال الراغب في المفردات ، : أصل الجن [بفتح الجيم] ستر الشيء عن الحاسة يقال : جنه الليل وأجنه وجن عليه : فجنه ستره ، وأجنه جعل له ما يجنه كقولك : قبرته وأقبرته وسقيته وأسقيته ، وجن عليه كذا ستر عليه قال عز وجل : {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً} ، انتهى . فجن الليل إسداله الظلام لا مجرد ما يحصل بغروب الشمس .
وقوله : {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ} تفريع على ما تقدم من نفيه ألوهية الأصنام بما يرتبطان بقوله : {وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ} ومحصل المعنى على ذلك أنا كنا نريه الملكوت من الأشياء فأبطل ألوهية الأصنام إذ ذاك ، ودامت عليه الحال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال كذا وكذا .
وقوله : {رَأى كَوْكَباً} كأن تنكير الكوكب إنما هو لنكتة راجعة إلى مرحلة الإخبار والتحدث فلا غرض في الكلام يتعلق بتعيين هذا الكوكب وأنه أي كوكب كان من السيارات أو الثوابت لأن الذي أخذه في الحجاج يجري في أي كوكب من الكواكب يطلع ويغرب لا أن إبراهيم عليه السلام أشار إلى كوكب ما من الكواكب من غير أن يمتاز بأي مميز مفروض : أما أولا فلأن اللفظ لا يساعده فلا يقال لمن أشار إلى كوكب بين كواكب لا تحصى كثرة فقال : هذا ربي : إنه رأى كوكبا قال هذا ربي ، وأما ثانيا فلأن ظاهر الآيات أنه كان هناك قوم يعبدون الكوكب الذي أشار إليه وقال فيه ما قال ، والصابئون ما كانوا يعبدون أي كوكب ولا يحترمون إلا السيارات .
والذي يؤيده الاعتبار أنه كان كوكب الزهرة ، وذلك لأن الصابئين ما كانوا يحترمون وينسبون حوادث العالم الأرضي إلا إلى سبعة من الأجرام العلوية التي كانوا يسمونها بالسيارات السبع : القمر ، وعطارد ، والزهرة ، والشمس ، والمريخ ، والمشتري ، وزحل وإنما كان أهل الهند هم الذين يحترمون النجوم الثوابت وينسبون الحوادث إليها ، ونظيرهم في ذلك بعض أرباب الطلسمات ووثنية العرب وغيرهم .
فالظاهر أن الكوكب كان أحد السبعة والقمر والشمس مذكوران بعد ، وعطارد مما لا يرى إلا شاذا لضيق مداره فقد كان أحد الأربعة : الزهرة ، والمريخ والمشتري ، وزحل ، والزهرة من بينها هي الكوكبة الوحيدة التي يمنعها ضيق مدارها أن تبتعد من الشمس أكثر من سبع وأربعين درجة ، ولذلك كانت كالتابعة الملازمة للشمس فأحيانا تتقدمها فتطلع قبيل طلوعها وتسمى عند العامة حينئذ نجمة الصباح ثم تغيب بعد طلوعها ، وأحيانا تتبعها فتظهر بعد غروب الشمس في أفق المغرب ثم لا تلبث إلا قليلا في أول الليل دون أن تغيب ، وإذا كانت على هذا الوضع والليلة من ليالي النصف الأخير من الشهر القمري كليلة ثماني عشرة وتسع عشرة والعشرين فإنها تجامع بغروبها طلوع القمر فترى أن الشمس تغرب فتظهر الزهرة في الأفق الغربي ثم تغرب بعد ساعة أو ساعتين مضتا من غروب الشمس ثم يطلع القمر عند ذلك أو بعد ذلك بيسير .
وهذه الخصوصية من بينها إنما هي للزهرة بحسب نظام سيرها وفي غيرها كالمشتري والمريخ وزحل أمر اتفاقي ربما يقع في أوضاع خاصة لا يسبق إلى الذهن فيشبه من هنا أن الكوكب كان هو الزهرة .
على أن الزهرة أجمل الكواكب الدرية وأبهجها وأضوؤها أول ما يجلب نظر الناظر إلى السماء بعد جن الليل وعكوف الظلام على الآفاق يجلب إليها .
وهذا أحسن ما يمكن أن تنطبق عليه الآية بحسب ما يتسابق إلى الذهن من قوله : {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ} ـ إلى أن قال ـ {فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً} (إلخ) حيث وصل ظاهرا بين أفول الكوكب وبزوغ القمر .
ويتأيد هذا الذي ذكرناه بما ورد في بعض الروايات عن أئمة أهل البيت عليه السلام أن الكوكب كان هو الزهرة .
وعلى هذا فقد كان عليه السلام رأى الزهرة والقوم يتنسكون بواجب عبادتها من خضوع وصلاة وقربان ، وكانت الزهرة وقتئذ تتلو الشمس في غروبها ، والليلة من ليالي النصف الأخير من الشهر القمري جن عليه الليل فرأى الزهرة في الأفق الغربي حتى أفلت فرأى القمر بازغا بعده .
وقوله تعالى : {قالَ هذا رَبِّي} المراد بالرب هو مالك الأشياء المربوبين ، المدبر لأمرهم لا الذي فطر السماوات والأرض وأوجد كل شيء بعد ما لم يكن موجودا فإنه الله سبحانه الذي ليس بجسم ولا جسماني ولا يحويه مكان ولا يقع عليه إشارة ، والذي يظهر مما حكي من كلام إبراهيم مع قومه في أمر الأصنام ظهورا لا شك فيه أنه كان على بينة من ربه وله من العلم بالله وآياته ما لا يخفى عليه معه أن الله سبحانه أنزه ساحة من التجسم والتمثل والمحدودية ، قال تعالى حكاية عنه في محاورة له مع أبيه : {يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا} إلى آخر الآيات : [مريم : 43] .
على أن الوثنيين والصابئين لا يثبتون لله سبحانه شريكا في الإيجاد يكافئ بوجوده وجوده تعالى بل إنما يثبتون الشريك بمعنى بعض من هو مخلوق لله مصنوع له ولا أقل مفتقر الوجود إليه فوض إليه بعد تدبير الخليقة كإله الحسن وإله العدل وإله الخصب أو تدبير بعض الخليقة كإله الإنسان أو إله القبيلة أو إله يخص بعض الملوك والأشراف وقد دلت على ذلك آثارهم المستخرجة وأخبارهم المروية ، والموجودون منهم اليوم على هذه الطريقة فقوله عليه السلام بالإشارة إلى الكوكب : {هذا رَبِّي} أراد به إثبات أنه رب يدبر الأمر لا إله فاطر مبدع .
وعليه يدل ما حكي عنه في آخر الآيات المبحوث عنها : {قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ، إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} فإن ظاهره أنه ينصرف عن فرض الشريك إلى إثبات أن لا شريك له لا أنه يثبت وجوده تعالى .
فالذي يعطيه ظاهر الآيات أنه عليه السلام سلم أن لجميع الأشياء إلها فاطرا واحدا لا شريك له في الفطر والإيجاد وهو الله تعالى ، وأن للإنسان ربا يدبر أمره لا محالة ، وإنما يبحث عن أن هذا الرب المدبر للأمر أهو الله سبحانه وإليه يرجع التدبير كما إليه يرجع الإيجاد أم أنه بعض خلقه أخذه شريكا لنفسه وفوض إليه أمر التدبير .
وفي إثر ذلك ما كان منه عليه السلام من افتراض الكوكب الذي كانوا يعبدونه ثم القمر ثم الشمس والنظر في أمر كل منها هل يصلح لأن يتولى أمر التدبير وإدارة شئون الناس ؟ .
وهذا الافتراض والنظر وإن كان بحسب طبعه قبل العلم اليقيني بالنتيجة فإن النتيجة فرع يتأخر طبعا عن الحجة النظرية لكنه لا يضر به عليه السلام فإن الآيات كما استفدناه فيما تقدم تقص أول أمر إبراهيم والإنسان في أول زمن يأخذ بالتمييز ويصلح لتعلق التكليف الإلهي بالنظر في أمر التوحيد وسائر المعارف الأصلية كاللوح الخالي عن النقش والكتابة غير مشغول بنقش مخالف فإذا أخذ في الطلب وشرع يثبت شيئا وينفي شيئا لغاية الحصول على الاعتقاد الحق والإيمان الصحيح فهو بعد في سبيل الحق لا بأس عليه في زمن يمر عليه بين الانتزاع من قصور التمييز وبين الاعتصام بالمعرفة الكاملة والعلم التام بالحق .
ومن ضروريات حياة الإنسان أن يمر عليه لحظة هي أول لحظة ينتقل فيها من قصور الجهل بواجب الاعتقاد إلى بلوغ العلم بحيث يتعلق به التكليف العقلي بالانتهاض إلى الطلب والنظر ، وهذه سنة عامة في الحياة الإنسانية المتدرجة من النقص إلى الكمال لا يختلف فيها إنسان وإنسان ، وإن أمكن أن يظهر من بعض الأفراد بعض ما يخالف ذلك من أمارات الفهم والعلم قبل المتعارف من سن التمييز والبلوغ كما يحكيه القرآن عن المسيح ويحيى عليه السلام فإنما ذلك من خوارق العادة الجارية وما كل إنسان على هذا النعت ولا كل نبي فعل به ذلك .
وبالجملة ليس الإنسان من أول ما ينفخ فيه الروح الإنساني واجدا لشرائط التكليف بالاعتقاد الحق أو العمل الصالح ، وإنما يستعد لذلك على سبيل التدريج حتى يستتم الشرائط فيكلف بالطلب والنظر فزمن حياته منقسم لا محالة إلى قسمين هما قبل التمييز والبلوغ وبعد التمييز والبلوغ وهو الزمان الذي يصلح لأن يشغله الاعتقاد كما أن ما يقابله يقابله فيه ، وبين الزمانين الصالح لإشغاله بالاعتقاد وغير الصالح له لا محالة زمان متخلل يتوجه إليه فيه التكليف بالطلب والنظر ، وهو الفصل الذي يبحث فيه عن واجب الاعتقاد بما تهدي إليه فطرته من طريق الاستدلال فيفرض نفسه أو العالم مثلا بلا صانع مرة ومع الصانع أخرى ، ويفرض الصانع وحده مرة ومع الشريك أخرى وهكذا ثم ينظر ما ذا تؤيده الآثار المشهودة في العالم من كل فرض فرضه أو لا تؤيده فيأخذ بذاك ويترك هذا .
فهو ما لم يتم له الاستدلال غير قاطع بشيء ولا بان على شيء وإنما هو مفترض ومقدر لما افترضه وقدره .
وعلى هذا فقول إبراهيم عليه السلام في الكوكب : {هذا رَبِّي} وكذا قوله الآتي في القمر والشمس ليس من القطع والبناء اللذين يعدان من الشرك ، وإنما هو افتراض أمر للنظر إلى الآثار التي تثبته وتؤيده ، ومن الدليل على ذلك ما في الآيات من الظهور في أنه عليه السلام كان على حالة الترقب والانتظار ، فهذا وجه .
ولكن الذي يتأيد بما حكاه الله عنه في سورة مريم في محاجته أباه : {يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا ، يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا ، يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا ، قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ، قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا} [مريم : 47] أنه عليه السلام كان على علم بحقيقة الأمر وأن الذي يتولى تدبير أمره ويحفي عليه ويبالغ في إكرامه هو الله سبحانه دون غيره .
وعلى هذا فقوله : {هذا رَبِّي} جار مجرى التسليم والمجاراة بعد نفسه كأحدهم ومجاراتهم وتسليم ما سلموه ثم بيان ما يظهر به فساد رأيهم وبطلان قولهم ، وهذا الطريق من الاحتجاج أجلب لإنصاف الخصم ، وأمنع لثوران عصبيته وحميته ، وأصلح لإسماع الحجة .
قوله تعالى : {فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} الأفول الغروب وفيه إبطال ربوبية الكوكب بعروض صفة الأفول له فإن الكوكب الغارب ينقطع بغروبه ممن طلع عليه ولا يستقيم تدبير كوني مع الانقطاع .
على أن الربوبية والمربوبية بارتباط حقيقي بين الرب والمربوب وهو يؤدي إلى حب المربوب لربه لانجذابه التكويني إليه وتبعيته له ، ولا معنى لحب ما يفنى ويتغير عن جماله الذي كان الحب لأجله ، وما يشاهد من أن الإنسان يحب كثيرا الجمال المعجل والزينة الداثرة فإنما هو لاستغراقه فيه من غير أن يلتفت إلى فنائه وزواله فمن الواجب أن يكون الرب ثابت الوجود غير متغير الأحوال كهذه الزخارف المزوقة التي تحيا وتموت وتثبت وتزول وتطلع وتغرب وتظهر وتخفى وتشب وتشيب وتنضر وتشين ، وهذا وجه برهاني وإن كان ربما يتخيل أنه بيان خطابي أو شعري فافهم ذلك .
وعلى أي حال فهو عليه السلام أبطل ربوبية الكوكب بعروض الأفول له إما بالتكنية عن البطلان بأنه لا يحبه لأفوله لأن المربوبية والعبودية متقومة بالحب فليس يسع من لا يحب شيئا أن يعبده وقد ورد في المروي عن الصادق عليه السلام : (هل الدين إلا الحب ؟) وقد بينا ذلك فيما تقدم .
وإما لكون الحجة متقومة بعدم الحب وإنما ذكر الأفول ليوجه به عدم حبه له المنافي للربوبية لأن الربوبية والألوهية تلازمان المحبوبية فما لا يتعلق به الحب الغريزي الفطري لفقدانه الجمال الباقي الثابت لا يستحق الربوبية ، وهذا الوجه هو الظاهر يتكئ عليه سياق الاحتجاج في الآية .
ففي الكلام أولا إشارة إلى التلازم بين الحب والعبودية أو المعبودية .
وثانيا أنه أخذ في إبطال ربوبية الكوكب وصفا مشتركا بينه وبين القمر والشمس ثم ساق الاحتجاج وكرر ما احتج به في الكوكب في القمر والشمس أيضا ، وذلك إما لكونه عليه السلام لم يكن مسبوق الذهن من أمر القمر والشمس وأنهما يطلعان ويغربان كالكوكب كما تقدمت الإشارة إليه وإما لكون القوم المخاطبين في كل من المراحل الثلاث غير الآخرين .
وثالثا أنه اختار للنفي وصف أولي العقل حيث قال : {لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} وكأنه للإشارة إلى أن غير أولي الشعور والعقل لا يستحق الربوبية من رأس كما يؤمي إليه في قوله المحكي : {يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً} [مريم : 42] وقوله الآخر : {إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ ، قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ ، قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ، أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ، قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ} [الشعراء : 74] فسألهم أولا عن معبودهم كأنه لا يعلم من أمرها شيئا فأجابوه بما يشعر بأنها أجساد وهياكل غير عاقلة ولا شاعرة فسألهم ثانيا عن علمها وقدرتها وهو يعبر بلفظ أولي العقل للدلالة على أن المعبود يجب أن يكون على هذه الصفة صفة العقل .
قوله تعالى : {فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي} إلى آخر الآية ، البزوغ هو الطلوع تقدم الكلام في دلالة قوله : {فَلَمَّا رَأَى} إلخ ، على اتصال القضية بما قبلها ، وقوله : {هذا رَبِّي} على سبيل الافتراض أو المجاراة والمماشاة والتسليم نظير ما تقدم في الآية السابقة .
وأما قوله بعد أفول القمر : {لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ} فهو موضوع وضع الكناية فهو عليه السلام أبطل ربوبية الكوكب بما يعم كل غارب ولما غرب القمر ظهر عندئذ رأيه في أمر ربوبيته بما كان قد قاله قبل ذلك في الكوكب : {لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} فقوله : {لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي} إلخ ، إشارة إلى أن الوضع الذي ذكره في القمر بقوله : {هذا رَبِّي} كان ضلالا لو دام وأصر عليه كان أحد أولئك الضالين القائلين بربوبيته والوجه في كونه ضلالا ما قاله في الكوكب حيث عبر بوصف لا يختص به بل يصدق في مورده وكل مورد يشابهه .
وفي الكلام إشارة أولا إلى أنه كان هناك قوم قائلون بربوبية القمر كالكوكب كما أن قوله في الآية التالية بعد ذكر أمر الشمس : {يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} لا يخلو عن الدلالة على مثله .
وثانيا : أنه عليه السلام كان وقتئذ في مسير الطلب راجيا للهداية الإلهية مترقبا لما يفيض ربه عليه من النظر الصحيح والرأي اليقيني سواء كان ذلك بحسب الحقيقة كما لو حملنا الكلام على الافتراض لتحصيل الاعتقاد ، أو بحسب الظاهر كما لو حملناه على الوضع والتسليم لبيان الفساد ، وقد تقدم الوجهان آنفا .
وثالثا : أنه عليه السلام كان على يقين بأن له ربا إليه تدبير هدايته وسائر أموره ، وإنما كان يبحث واقعا أو ظاهرا ليعرفه : أهو الذي فطر السماوات والأرض بعينه أو بعض من خلقه ، وإذ بان له أن الكوكب والقمر لا يصلحان الربوبية لأفولها توقع أن يهديه ربه إلى نفسه ويخلصه من ضلال الضالين .
قوله تعالى : {فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ} الكلام في دلالة اللفظ على الاتصال بما قبله لمكان قوله : {فَلَمَّا} وكون قوله : {هذا رَبِّي} مسوقا للافتراض أو التسليم كما تقدم في الآية السابقة .
وقد كان تكرر قوله : {هذا رَبِّي} في القمر لما رآه بازغا بعد ما رأى الكوكب ، ولذلك ضم قوله : {هذا أَكْبَرُ} إلى قوله {هذا رَبِّي} في الشمس في المرة الثالثة ليكون بمنزلة الاعتذار للعود إلى فرض الربوبية لها مع تبين خطإ افتراضه مرة بعد مرة .
وقد تقدمت الإشارة إلى أن إشارته إلى الشمس بلفظة (هذا) تشعر بأنه عليه السلام ما كان يعرف من الشمس ما يعرفه أحدنا أنه جرم سماوي يطلع ويغرب بحسب ظاهر الحس في كل يوم وليلة ، وإليها تستند النهار والليل والفصول الأربعة السنوية إلى غير ذلك من نعوتها .
فإن الإتيان في الإشارة بلفظ المذكر هو الذي يستريح إليه من لا يميز المشار إليه في نوعه كما تقول فيمن لاح لك شبحه وأنت لا تدري أرجل أم امرأة : من هذا ؟ ونظيره ما يقال في شبح لا يدرى أمن أولي العقل هو أو لا : ما هذا ؟ فلعله إنما كان ذلك من إبراهيم عليه السلام أول ما خرج من مختفى أخفي فيه إلى أبيه وقومه ، ولم يكن عهد مشاهد الدنيا الخارجة والمجتمع البشري فرأى جرما هو كوكب وجرما هو القمر وجرما هو الشمس ، وكلما شاهد واحدا منها ـ ولم يكن يشاهد إلا جرما مضيئا لامعا ـ قال : هذا ربي ، على سبيل عدم المعرفة بحاله معرفة تامة كما سمعت .
ويؤيده بعض التأييد قوله : {فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} فإن فيه إشعارا بأنه عليه السلام مكث بانيا على كون الكوكب ربا حتى شاهد غروبه فحكم بأن الفرض باطل وأنه ليس برب ، ولو كان عالما بأنه سيغرب أبطل ربوبيته مقارنا لفرض ربوبيته كما فعل ذلك في أمر الأصنام على ما يدل عليه قوله لأبيه : {أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} وقوله أيضا : {يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً} .
وإن أمكن أن يقال : إنه أراد بتأخير قوله . {لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} إلى أن يأفل أن يحاجهم بما وقع عليه الحس كما أراد بما فعل بالأصنام حيث جعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم أن يريهم عجز الأصنام وكونها أجسادا ميتة لا تدفع عن أنفسها الضر والشر .
وللمفسرين في تذكير الإشارة في قوله : {هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ} مسالك من التوجيه مختلفة :
فمنهم من قال : تذكير الإشارة إنما هو بتأويل المشار إليه أو الجرم النير السماوي أي هذا المشار إليه أو هذا الجرم النير ربي وهو أكبر .
وفيه أنه لا ريب في صحة الاستعمال بهذا التأويل لكن الشأن في النكتة التي تصحح هذا التأويل ، ولا يجوز ذلك من غير نكتة مسوغة ، ولو جاز ذلك في اللغة من غير اعتماد على نكتة لجاز تذكير كل مؤنث قياسي وسماعي في إرجاع الضمير والإشارة إليه بتأويل الشخص ونحوه وفي ذلك نسخ اللغة قطعا .
ومنهم من قال : إنه من قبيل إتباع المبتدإ للخبر في تذكيره فإن الرب وأكبر مذكران فأتبع اسم الإشارة للخبر المذكر كما عكس في قوله تعالى : {ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا} الآية فأتبع المذكر للمؤنث .
وفيه أنهم كانوا يرون من الآلهة إناثا كما يثبتون ذكورا ويسمون الأنثى من الآلهة إلهة وربة وبنت الله وزوجة الرب فكان من الواجب أن يطلق على الشمس ربة لمكان التأنيث ، وأن يقال : هذه ربتي أو آلهتي ، فالكلام في تذكير الخبر في قوله : {هذا رَبِّي} كالكلام في تذكير المبتدإ ، ولا معنى حينئذ لحديث الإتباع .
وكذا قوله : {هذا أَكْبَرُ} الخبر فيه من صيغ التفضيل وحكم صيغة التفضيل إذا وقعت خبرا أن يجاء بأفعل ويستوي فيه المذكر والمؤنث يقال زيد أفضل من عمر وليلى أجمل من سلمى ، وما هذا شأنه لا نسلم أنه من صيغ المذكر الذي يجري فيه الإتباع .
ومنهم من قال : إن تذكير الإشارة إنما هو لتعظيم الشمس حيث نسب إليها الربوبية صونا للإله عن وصمة التأنث .
وفيه : أنهم كانوا يعدون الأنوثية من النواقص التي يجب أن ينزه عنها الإله وقد كان لأهل بابل أنفسهم آلهة أنثى كالإلهة {نينو} إلهة الأمهات الخالفة ، والإلهة {نين كاراشا} ابنة الإله {آنو} والإلهة {مالكات} زوجة الإله {شاماش} والإلهة {زاربانيت} إلهة الرضاع ، والإلهة {آنوناكي} . وكانت طائفة من مشركي العرب تعبد الملائكة وتعدهم بنات الله ، وقد رووا في تفسير قوله تعالى : {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِناثاً} [النساء : 117] أنهم كانوا يسمون آلهتهم إناثا ، وكانوا يقولون : أنثى بني فلان يعنون به الصنم الذي يعبدونه .
ومنهم من قال : إن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعدون الشمس من الذكور وقد أثبتوا لها زوجة يسمونها {أنونيت} فاحتفظ في الكلام على ظاهر عقيدتهم .
وفيه : أن اعتقادهم بكون الشمس ذكرا لا يصحح تبديل تأنيث لفظها تذكيرا . على أن قوله عليه السلام للملك : {فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ} [البقرة : 258] وهو يريد الشمس ينافي ذلك .
ومنهم من قال : إن إبراهيم عليه السلام كان يتكلم باللغة السريانية وهي لغة قومه ، ولا يفرق فيها في الضمائر وأسماء الإشارة بالتذكير والتأنيث بل الجميع على صفة التذكير ، وقد احتفظ القرآن الكريم في حكاية قوله على ما أتى به من التذكير .
وفيه : منع جواز ذلك فإنه أمر راجع إلى أحكام الألفاظ المختلفة باختلاف اللغات بل إنما يجوز ذلك فيما يرجع إلى المعنى الذي لا يؤثر في الخصوصية اللفظية ، على أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام احتجاجات كثيرة وأدعية وافرة في القرآن وفيها موارد كثيرة اعتبر فيها التأنيث فما بال هذا المورد اختص من بينها بإلغاء جهة التأنيث ؟ حتى أن قوله فيما يحاج به ملك بابل : {إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قالَ إِبْراهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ} [البقرة : 258] ويتضمن ذكر الشمس وتأنيث الضمير العائد إليها .
ومن عجيب ما أورد على هذا الوجه ما ذكره بعض المفسرين وأصر عليه : أن إبراهيم عليه السلام وكذا إسماعيل وهاجر كانوا يتكلمون باللغة العربية القديمة ، وأنها كانت لغة قومه ، قال ما ملخصه : إنه ثبت عند علماء الآثار القديمة ، أن عرب الجزيرة قد استعمروا منذ فجر التاريخ بلاد الكلدان ومصر وغلبت لغتهم فيهما ، وصرح بعضهم بأن الملك حموربي الذي كان معاصرا لإبراهيم عليه السلام عربي وحموربي هذا ملك البر والسلام ووصف في العهد العتيق بأنه كاهن الله العلي ، وذكر فيه أنه بارك إبراهيم ، وأن إبراهيم أعطاه العشرة من كل شيء ، قال : ومن المعروف في كتب الحديث والتاريخ العربي أن إبراهيم أسكن إسماعيل ابنه عليه السلام مع أمه هاجر المصرية في الواد الذي بنيت فيه مكة بعد ذلك ، وأن الله سخر لهما جماعة من جرهم سكنوا معهما هنالك ، وأن إبراهيم عليه السلام كان يزورهما ، وأنه هو وولده إسماعيل بنيا بيت الله الحرام ونشرا دين الإسلام في البلاد العربية ، وفي الحديث : أن إبراهيم عليه السلام جاء مكة ليزور ابنه ـ وقد خرج إلى الصيد ـ فكلم زوجته وكانت جرهمية فلم يرتض أمرها ـ ثم جاءها بعد مدة ليزوره فلم يجده فكلم زوجته الأخرى ـ فدعته إلى النزول وغسل رأسه ـ فارتضى أمرها ودعا لها ، وكل ذلك يدل على أنه كان يتكلم بالعربية ، هذا ملخص ما ذكره .
وفيه : أن مجاورة عرب الجزيرة مصر وكلدان واختلاطهم بهم أو استعمارهم واستيلاؤهم عليهم لا يوجب تبدل لغاتهم إلى العربية ، وقد كانت لغة مصر قبطية ولغة كلدان والآشوريين سريانية ، نعم ربما أوجب ذلك دخول أسماء وألفاظ من لغة بعضهم في لغة بعض كما يوجد في القرآن الكريم أمثال القسطاس والإستبرق وغيرهما وهي من الدخيل .
وأما ما ذكره من أمر حموربي ومعاصرته لإبراهيم عليه السلام فلا يطابق ما هو الصحيح من تاريخه ويؤيده الآثار المكشوفة من خرائب بابل والنصب المستخرجة التي كتبت فيها شريعته التي وضعها وأجراها في مملكته وهي أقدم القوانين المدونة في العالم على ما بلغنا ، وقد ذكر بعضهم أن أيام ملكه كانت بين (1728) ق م و (1686) ق م ، وذكر آخرون : أنه تملك بابل سنة [2287 ـ 2232] ق م (2) وكان إبراهيم عليه السلام يعيش في حدود سنة (2000) ق م ، وحموربي هذا وثني ، وقد استمد فيما وجد من كلامه المنقوش في ذيل شريعته المنقوشة على النصب بعده من الآلهة لبقاء شريعته وعمل الناس بها وتدمير من أراد نسخها أو مخالفتها (3) وأما ما ذكره من حديث إسكانه ابنه وأم ولده بتهامة وبناء بيت الله الحرام ونشر دين الله وتفاهمه مع العرب فشيء من ذلك لا يدل على كونه عليه السلام متكلما باللغة العربية وهو ظاهر .
ولنرجع إلى ما كنا فيه فنقول : قوله : {فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً} إلخ ـ كما سمعت ـ يدل على اتصال ما بعد {فَلَمَّا} بما قبله وهو قوله : {فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ} فهو يدل على أن القمر قد كان غرب حينما رأى عليه السلام الشمس بازغة ، وهذا إنما يكون في الخريف أو الشتاء في العرض الشمالي الذي كانت فيه بلاد كلدان حين يطول الليالي وخاصة إذا كان القمر في شيء من البروج الجنوبية كالقوس والجدي فعند ذلك يجيز الوضع السماوي أن يغرب القمر في النصف الأخير من الشهر القمري قبل طلوع الشمس ، وقد تقدم سابقا في قوله تعالى : {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي} أن ظاهر الكلام المؤيد بالاعتبار يدل على أن الليلة كانت من ليالي النصف الأخير من الشهر القمري ، وكان الكوكب هي الزهرة ، شاهدها أولا في المغرب حال الانحطاط ثم شاهد غروبها وطلوع القمر من ناحية المشرق .
فيتحصل من الآيات أن إبراهيم عليه السلام حاج قومه في أمر الأصنام يوم حاجهم واشتغل بهم يومه ذلك حتى جن عليه الليل فلما جن عليه الليل رأى الزهرة وقوم يعبدونها فجاراهم في ربوبيتها وأخذ ينتظر ما يحل بها من حال حتى أفلت بعد سويعات فحاجهم به وتبرأ من ربوبيتها ، ثم رأى القمر بازغا وهناك قوم يعبدونه فجاراهم في ربوبيته بقوله : {هذا رَبِّي} وأخذ يراقب ما يحدث به حتى أفل ، وكانت الليلة من الليالي الطوال في النصف الثاني من الشهر القمري ولعل القمر كان يسير في قوس قصير من أقواس المدارات الجنوبية فلما أفل تبرأ من ربوبيته ، وأخذ يستهدي ربه ويستعيذ به من الضلال حتى طلعت الشمس فرآها بازغة وأكبر بالنسبة إلى ما تقدمها من الكوكب والقمر فعاد كذلك إلى مجاراتهم في ربوبيتها مع ما لاح له من بطلان ربوبية الكوكب والقمر وهما مثلها في كونها جرما سماويا نيرا لكنه اتخذ كونها أكبر منها عذرا يعتذر به فيما يفترضه أو يسلمه من ربوبيتها فقال : {هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ} وأخذ ينتظر مستقبل الأمر حتى أفلت فتبرأ من ربوبيتها وشرك قومه فقال : {يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} ثم أثبت الربوبية لله سبحانه كما كان يثبت الألوهية بمعنى إيجاد السماوات والأرض وفطرها له تعالى فقال : {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ ـ وهو العبودية قبال الربوبية ـ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ـ غير منحرف من حاق الوسط إلى يمين أو يسار ـ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ـ بإشراك شيء من خلقه ومفطوراته له تعالى في العبادة والإسلام ـ} .
وقد تقدم أن قوله تعالى في ضمن الآيات محفوفا بها : {وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} يدل على أنه عليه السلام إنما كان يأخذ ما يلقيه من الحجة على أبيه وقومه مما كان يشاهده من ملكوت السماوات والأرض ، وقد أفاض الله سبحانه اليقين الذي ذكره غاية لإراءته الملكوت على قلبه بهذه المشاهدة والرؤية .
وهذا أوضح شاهد على أن الذي ذكره عليه السلام من الحجة كانت حجة برهانية ترتضع من ثدي اليقين ، وقد أورد في ذلك قوله : {لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} وتقدمت الإشارة إلى تقريره .
فتبين من جميع ما تقدم :
أولا : أن قوله عليه السلام : {لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} حجة برهانية يقينية بني الكلام فيه على عدم حبه للآفلين ، ومنافاة الأفول للربوبية ، ويظهر من كلام بعضهم أنه يأخذه حجة عامية غير برهانية إذ يقول : والصواب أن الكلام كان تعريضا خفيا لا برهانا نظريا جليا يعرض فيه بجهل قومه في عبادة الكواكب أنهم يعبدون ما يتحجب عنهم ، ولا يدري شيئا من أمر عبادتهم ، وهذا هو السبب في جعله الأفول منافيا للربوبية دون البزوغ والظهور بل بنى عليه القول بها فإن من صفات الرب أن يكون ظاهرا وإن لم يكن ظهوره كظهور غيره من خلقه ، هذا .
وقد خفي عليه أولا : أن وضع قوله : {وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} بين الآيات المتضمنة لحججه ع أدل دليل على كون حججه مأخوذة من مشهوداته الملكوتية التي هي ملاك يقينه بالله وآياته وكيف يتصور مع ذلك كونها حجة عامية غير برهانية .
وخفي عليه ثانيا أن الحجة بنيت على الحب وعدمه لا على الأفول مضافا إلى أن البناء على الأفول أيضا لا يخرجها عن كونها برهانية فهو عليه السلام إنما ذكر سبب براءته من ربوبيتها أنه وجدها آفلة غاربة وهو لا يحب الآفلين فلا يعبدها ، ومن المعلوم أن عبادة الإنسان لربه إنما هي لأنه رب أي لأنه يدبر أمر الإنسان فيفيض عليه الحياة والرزق والصحة والخصب والأمن والقدرة والعلم إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في بقائه فهو متعلق الوجود بربه من كل جهة ، ومن فطريات الإنسان أن يحب ما يسعده مما يحتاج إليه وأن يحب من يسعده بذلك لا يرتاب فيه ذو ريب البتة فإنما يعبد الرب لأن الإنسان يحبه لجلبه المنافع إليه أو لدفعه المضار عنه أو لهما جميعا .
ومن فطريات الإنسان أيضا أنه لا تتعلق نفسه بما لا بقاء له إلا أن يحول حرص أو شبق أو نحوهما نظره إلى جهة اللذة ويصرفه عن التأمل والإمعان في جهة فنائه وزواله ، وقد استعمل القرآن الكريم هذه الطريقة كثيرا في ذم الدنيا ، وردع الناس عن التعلق المفرط بزينتها والانهماك في شهواتها كقوله : {إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ} [يونس : 24] وقوله : {ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ} [النحل : 96] وقوله : {وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى} [الشورى : 36] .
فهو عليه السلام يفيد بقوله : {لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} أن الذي من شأنه أن يفقده الإنسان ويغيب عنه ولا يبقى ولا يثبت له لا يستحق أن يحبه الإنسان وتتعلق به نفسه ، والرب الذي يعبده الإنسان يجب أن يحبه فيجب أن لا يكون من شأنه أن يأفل عنه ويفقد فهذه الأجرام الآفلة لا تستحق اسم الربوبية ، وهذه ـ كما ترى ـ حجة يعرفها العامة والخاصة .
وقد خلط ثالثا بين البزوغ والظهور فحكم أنه غير مناف للربوبية بل القول مبني عليه فإن من صفات الرب أن يكون ظاهرا إلى آخر ما قال فإن الذي ذكر في الآية ـ ولم يبن الحجة عليه ـ هو البزوغ وهو الطلوع والظهور بعد خفاء المنافي للربوبية فيبقى السؤال : لم بنى الكلام على الأفول دون البزوغ ؟ على حاله .
وثانيا : أن أخذ الأفول في الحجة دون البزوغ إنما هو لأن البزوغ لا يستوجب عدم الحب الذي بنى الحجة عليه بخلاف الأفول ، وبذلك يظهر ما في قول الكشاف في وجه العدول ، قال : {فإن قلت : لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ وكلاهما انتقال من حال إلى حال ؟ قلت : الاحتجاج بالأفول أظهر لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب} انتهى . فإن الاحتجاج كما عرفت إنما هو بعدم تعلق الحب لا بالأفول حتى يوجه العدول إليه من البزوغ بما ذكره .
وثالثا : أن الاحتجاج إنما أريد به نفي ربوبية الأجرام الثلاثة بمعنى تدبيرها للعالم الأرضي أو العالم الإنساني لا الربوبية بمعنى المقام الذي ينتهي إليه الإيجاد والتدبير جميعا فإن الوثنية وعبدة الكواكب لا ينكرون أن آلهتهم ليست أربابا بهذا المعنى ، وأنه الله الواحد لا شريك له .
ومن هنا يظهر ما في قول بعضهم : إن الأفول إنما أخذ مبدأ للبرهان لأنه يستلزم الإمكان ، وكل ممكن محتاج يجب أن يقف سلسلة حاجته عند موجود واجب الوجود ، وكذا ما في قول آخرين : إن الأفول إنما ينفي الربوبية عن المتصف به لأنه حركة ، ولا بد لكل حركة من محرك ، وينتهي لا محالة إلى محرك غير متحرك وثابت غير متغير بذاته وهو الله عز اسمه .
وذلك أنهما وإن كانا حجتين برهانيتين غير أنهما تنفيان عن الممكنات وعن المتحركات الربوبية بمعنى العلية الأولى التي ينتهي إليها جميع العلل ، وسببية الإيجاد والتدبير التي يقف عندها جميع الأسباب ، وعبدة الكواكب من الصابئين وغيرهم وإن ذهبوا إلى أن كل جرم سماوي قديم زماني غير قابل للكون والفساد متحرك بحركة دائمة غير أنهم لا ينكرون أن جميعها معلولة لإمكانها غير مستغنية لا في وجودها ولا في آثار وجودها عن الواجب عز اسمه .
فالحجتان إنما هما قائمتان على منكري وجود الصانع من الطبيعيين لا الصابئين وعبدة أرباب الأنواع وغيرهم من الوثنيين ، وإبراهيم عليه السلام إنما كان يحاج هؤلاء دون أولئك .
على أنك عرفت أن الحجة لم تركب من جهة الأفول بل من جهة عدم تعلق الحب بشيء من شأنه الأفول والغروب .
وأما من دفع ما ذكروه من تقرير الحجة من جهة الإمكان أو الحركة بأن تفسير الأفول بذلك تفسير للشيء بما يباينه فإن العرب لا يعرفون الأفول بمعنى الإمكان أو الحدوث وكذلك تفسير الأفول بالتغير والحركة غلط كسابقه .
فقد خفي عليه أن هؤلاء لا يقولون : إن الأفول في الآية بمعنى الإمكان أو بمعنى الحركة ، وإنما يقولون : إن الأفول إنما احتج به لاستلزامه الإمكان أو الحركة والتغير ، وأما الأفول بمعنى الغيبة بعد الحضور والخفاء بعد الظهور مع قطع النظر عن استلزامه الإمكان أو التغير غير اللائقين بساحة الواجب جل ثناؤه فليس ينافي الربوبية كما اعترف به هذا المورد نفسه .
وذلك أن الواجب تعالى أيضا غائب عن مشاعرنا من غير أن يتحول عليه الحال ويطرأ عليه التغير بالغيبة بعد الحضور والخفاء بعد الظهور ، ولا ينفع القول بأن الغيبة والخفاء فيه تعالى من جهتنا لا من جهته ولاشتغالنا بما يصرفنا عنه لا لمحدودية وجوده وقصور استيلائه فإن غيبة هذه الأجرام السماوية وخاصة الشمس بالحركة اليومية أيضا من قبلنا حيث أنا أجزاء من الأرض التي تتحرك بحركتها اليومية فتحولنا بها من مسامتة هذه الأجرام ومواجهتها إلى خلاف ذلك فنغرب عنها في الحقيقة بعد طلوعنا عليها وإن كان الخطأ الحسي يخيل لنا غيره .
وقد أراد الرازي أن يجمع بين الوجوه جميعا فقال في تفسيره ما نصه : الأفول عبارة عن غيبوبة الشيء بعد ظهوره وإذا عرفت هذا فلسائل أن يسأل فيقول : الأفول إنما يدل على الحدوث من حيث إنه حركة ، وعلى هذا التقدير فيكون الطلوع أيضا دليلا على الحدوث فلم ترك إبراهيم عليه السلام الاستدلال على حدوثها بالطوع وعول في إثبات هذا المطلوب على الأفول ؟ .
والجواب : لا شك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث إلا أن الدليل الذي يحتج به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلهم إلى الله لا بد وأن يكون ظاهرا جليا بحيث يشترك في فهمه الذكي والغبي والعاقل ، ودلالة الحركة على الحدوث وإن كانت يقينية إلا أنها دقيقة لا يعرفها إلا الأفاضل من الخلق ، أما دلالة الأفول فإنها دلالة ظاهرة يعرفها كل أحد فإن الكوكب يزول سلطانه وقت الأفول فكانت دلالة الأفول على هذا المقصود أتم .
وأيضا قال بعض المحققين : الهوي في خطرة الإمكان أفول وأحسن الكلام ما تحصل فيه حصة الخواص وحصة الأوساط وحصة العوام : فالخواص يفهمون من الأفول الإمكان وكل ممكن محتاج لا يكون مقطوع الحاجة فلا بد من الانتهاء إلى من يكون منزها عن الإمكان حتى تنقطع الحاجات بسبب وجوده كما قال : {وَأَنَّ إِلى رَبِّكَ الْمُنْتَهى} .
وأما الأوساط فإنهم يفهمون من الأفول مطلق الحركة فكل متحرك محدث ، وكل محدث فهو محتاج إلى القديم القادر فلا يكون الآفل إلها بل الإله هو الذي يحتاج إليه ذلك الآفل .
وأما العوام فإنهم يفهمون من الأفول الغروب ، وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من الأفول والغروب فإنه يزول نوره ، وينتقص ضوؤه ، ويذهب سلطانه ، ويكون كالمعزول ، ومن يكون كذلك لا يصلح للإلهية ، فهذه الكلمة الواحدة أعني قوله {لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} كلمة مشتملة على نصيب المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين .
وفيه دقيقة أخرى ، وهو أنه عليه السلام إنما كان يناظرهم وهم كانوا منجمين ، ومذهب أصحاب النجوم أن الكوكب إذا كان في الربع الشرقي ويكون صاعدا إلى وسط السماء كان قويا عظيم التأثير ، أما إذا كان غربيا وقريبا من الأفول فإنه يكون ضعيف التأثير قليل القوة فنبه بهذه الدقيقة على أن الإله هو الذي لا تتغير قدرته إلى العجز وكماله إلى النقصان ، ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الربع الغربي يكون ضعيف القوة ناقص التأثير عاجز عن التدبير ، وذلك يدل على القدح في إلهيته فظهر على قول المنجمين أن للأفول مزيد خاصية في كونه موجباً للقدح في إلهيته ، انتهى موضع الحاجة من كلامه على طوله .
وأنت بالتأمل في ما تقدم تقف على أن ما تفنن به من تقسيم البرهان إلى حصص مختلفة باختلاف النفوس ، وتقريره بوجوه شتى لا لفظ الآية يدل عليه ، ولا شبهة الصابئين وأصحاب النجوم تندفع به فإنهم لا يرون الجرم السماوي إلها واجب الوجود غير متناهي القدرة ذا قوة مطلقة ، وإنما يرونه ممكنا معلولا ذا حركة دائمة يدبر بحركته ما دونه من العالم الأرضي ، وشيء مما ذكره من الوجوه لا يدفع هذه النظرية ، وكأنه تنبه لهذا الإشكال بعد كلامه المنقول آنفا فبسط في الكلام وأطنب في الخروج من العويصة بما لا يجدي شيئا .
على أن الحجة الثانية على ما قرره حجة غير تامة فإن الحركة إنما تدل على حدوث المتحرك من حيث وصفه وهو التحرك لا من حيث ذاته ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله ، والمصير إلى ما قدمناه في تقرير الحجة من جهة الحركة .
ورابعا : أن إبراهيم عليه السلام إنما ساق هذه الحجج بحسب ما كان الله سبحانه يريه ملكوت السماوات والأرض ، وبحسب ما يسمح له جريان محاجته أباه وقومه آخذا بالمحسوس المعاين إما لأنه لم يكن رأى تفصيل الحوادث السماوية والأرضية اليومية كما تقدمت الإشارة إليه أو لأنه أراد أن يحاجهم بما تحت حسهم فأورد قوله {هذا رَبِّي} لما شاهد شيئا من الأجرام الثلاثة لامعا بازغا ، وأورد قوله {لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} أو ما في معناه لما شاهد أفولها .
وبذلك يظهر الجواب عما يمكن أن يقال : إن قوله : {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً} يدل على أنه عليه السلام كان في النهار المتصل بذلك الليل شاهد قومه فما باله لم يذكر الشمس لينفي ربوبيتها .
فإن من المحتمل أن يكون قد خرج إلى قومه للمحاجة والوقت لا يسع أزيد مما حاج به أباه وقومه في أمر الأصنام فكان يحاجهم طول النهار أو مدة ما أدركه من النهار عند قومه حتى إذا تمم الحجاج لم يلبث دون أن جن عليه الليل ، وهناك محتملات أخر كغيم في الهواء أو حضور قومه للصلوات والقرابين في أول الطلوع فحسب وقد كان يريد أن يواجههم فيما يلقيه إليهم .
وخامسا : أن الآيات كما قيل تدل على أن الهداية من الله سبحانه وأما الإضلال فلم ينسب إليه تعالى في هذه الآيات بل دل قوله : {لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ} بعض الدلالة على أن من شأن الإنسان بحسب ما يقتضيه نقص نفسه أن يتصف بالضلال لو لم يهده ربه ، وهو الذي يستفاد من قوله تعالى : {وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً} [النور : 21] وقوله : {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ} [القصص : 56] إلى غير ذلك من الآيات .
نعم هناك آيات تنسب إليه تعالى الإضلال لكن أمثال قوله : {وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ} [البقرة : 26] تبين أن الضلال المنسوب إليه تعالى هو الإضلال الواقع بحسب المجازاة دون الإضلال الابتدائي ، وقد تقدم البحث في تفسير الآية في الجزء الأول من هذا الكتاب .
وسادسا : أنه عليه السلام أخذ في حجته لإبطال ربوبية الأجرام الثلاثة أنه لا يحب الآفل لأفوله وهو أن يفقده الإنسان بعد أن يجده فهو الوصف الذي لا يتعلق به الحب المسوغ للعبادة ، وإذ كان ذلك وصفا مطردا في جميع الجسمانيات التي تسير إلى الزوال والفوت والهلاك والبيد كانت الحجة قاطعة على كل شرك ووثنية حتى على ما يظهر من بعض الوثنيين من القول بألوهية أرباب الأنواع والموجودات النورية التي يذعنون بوجودها وأنها فوق المادة والطبيعة متعالية عن الجسمية والحركة فإنهم يصرحون بأنها على ما لها من صفاء الجوهر وشرف الوجود مستهلكة تجاه النور القيومي ، مستذلة تحت القهر الأحدي ، وإذ كان هذه صفة ما يدعونه فلو توجه تلقاءها حب لم يتعلق إلا بمن يدبر أمرها ويصلح شأنها لا بها .
قوله تعالى : {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ} إلى آخر الآية .
ذكر الراغب في المفردات : ، أن أصل الفطر الشق طولا يقال : فطر فلان كذا فطرا وأفطر هو فطورا وانفطر انفطارا قال : {هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ} أي اختلال ووهي فيه ، وذلك قد يكون على سبيل الفساد ، وقد يكون على سبيل الصلاح قال : السماء منفطر به كان وعده مفعولا .
وفطرت الشاة حلبتها بإصبعين ، وفطرت العجين إذا عجنته فخبزته من وقته ، ومنه الفطرة ، وفطر الله الخلق وهو إيجاده الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال فقوله : {فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها} إشارة منه تعالى إلى ما فطر أي أبدع وركز في الناس من معرفته تعالى ، وفطرة الله هي ما ركز فيه من قوته على معرفة الإيمان وهو المشار إليه بقوله : {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ} ، انتهى . وذكر أيضا : أن الحنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة والجنف ميل عن الاستقامة إلى الضلال قال : وسمت العرب كل من حج أو اختتن حنيفا تنبيها على أنه على دين إبراهيم عليه السلام والأحنف من في رجله ميل ، قيل : سمي بذلك على التفاؤل وقيل : بل أستعير للميل المجرد ، انتهى .
لما تبرأ عليه السلام من شركهم وشركائهم بقوله : {يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ} إلخ ، وقد سلك إليه تدريجا بإظهار عدم تعلق قلبه بالشريك حيث قال : {لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} ثم الإيماء إلى كون عبادة الشريك ضلالا حيث قال : {لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ} ثم التبري الصريح من ذلك بقوله : {يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} رجع إلى توحيده التام في الربوبية ، وهو إثبات الربوبية والمعبودية للذي فطر السماوات والأرض ، ونفي الشرك عن نفسه فقال : {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً} .
فتوجيه الوجه كناية عن الإقبال إلى الله سبحانه بالعبادة فإن لازم العبودية والمربوبية أن يتعلق العبد المربوب بربه في قوته وإرادته ، ويدعوه ويرجع إليه في جميع أعماله ، ولا يكون دعاء ولا رجوع إلا بتوجيه الوجه والإقبال إليه فكنى بتوجيه الوجه عن العبادة التي هي دعاء ورجوع .
وذكر ربه وهو الله سبحانه الذي وجه وجهه إليه ، بنعته الذي يخصه بلا نزاع فيه وهو فطر السماوات والأرض ، وجاء بالموصول والصلة ليدل على العهد فلا يشتبه الأمر على أحد منهم فقال : {لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ} أي إني أقبلت بعبادتي على من ينتهي إليه إيجاد كل شيء وإبداعه ، وهو الذي يثبته ويثبتونه فوق الجميع .
ثم نفى غيره مما يدعونه شريكا بقوله : {حَنِيفاً} أي مائلا إليه عن غيره نافيا للشريك عنه ، وأكده بقوله : {وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} فأفاد مجموع قوله : {إِنِّي وَجَّهْتُ} إلخ ، إثبات المعبودية لله تعالى ونفي الشريك عنه قريبا مما تفيده الكلمة الطيبة : {لا إِلهَ إِلَّا اللهُ} .
واللام في قوله : {لِلَّذِي} للغاية وتفيد معنى إلى ، وكثيرا ما تستعمل في الغاية اللام كما تستعمل {إلى} قال : {أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ} [البقرة : 11] {وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ} [لقمان : 22] .
وفي تخصيص فطر السماوات والأرض من بين صفاته تعالى الخاصة وكذا من بين الألفاظ الدالة على الخلقة كالباري والخالق والبديع إشارة إلى ما يؤثره إبراهيم عليه السلام من دين الفطرة وقد كرر توصيف هذا الدين في القرآن الكريم بأنه دين إبراهيم الحنيف ودين الفطرة أي الدين الذي بنيت معارفه وشرائعه على خلقة الإنسان ونوع وجوده الذي لا يقبل التبدل والتغير فإن الدين هو الطريقة المسلوكة التي يقصد بها الوصول إلى السعادة الحقيقية والسعادة الحقيقية هي الغاية المطلوبة التي يطلبها الشيء حسب تركب وجوده وتجهزه بوسائل الكمال طلبا خارجيا واقعيا ، وحاشا أن يسعد الإنسان أو أي شيء آخر من الخليقة بأمر ولم يتهيأ بحسب خلقته له أو هيئ لخلافه كأن يسعد بترك التغذي أو النكاح أو ترك المعاشرة والاجتماع وقد جهز بخلافها ، أو يسعد بالطيران كالطير أو بالحياة في قعر البحار كالسمك ولم يجهز بما يوافقه .
فالدين الحق هو الذي يوافق بنواميسه الفطرة وحاشا ساحة الربوبية أن يهدي الإنسان أو أي مخلوق آخر مكلف بالدين ـ إن كان ـ إلى غاية سعيدة مسعدة ولا يوافق الخلقة أو لم يجهز بما يسلك به إليها فإنما الدين عند الله الإسلام وهو الخضوع لله بحسب ما يهدي إليه ويدل عليه صنعه وإيجاده .
قوله تعالى : {وَحاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدانِ} . قسم تعالى حججه ع إلى قسمين : أحدهما ما بدأ به هو فحاج الناس ، وثانيهما ما بدأ به الناس فكلموه به بعد ما تبرأ من آلهتهم ، وهذا الذي تعرض له في الآية وما بعده هو القسم الثاني .
لم يذكر تعالى ما أوردوه عليه من الحجة لكنه لوح إليه بقوله حكاية عن إبراهيم عليه السلام : {وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ} فهو الاحتجاج لوجوب عبادة آلهتهم من جهة الخوف وقد تقدم وسيجيء أن الذي بعثهم إلى اتخاذ الآلهة وعبادتها أحد أمرين : الخوف من سخطها وقهرها بما لها من السلطة على حوادث العالم الأرضي ، أو رجاء البركة والسعادة منها ، وأشد الأمرين تأثيرا في نفوسهم هو الأمر الأول أعني الخوف وذلك أن الناس بحسب الطباع يرون ما بأيديهم من النعمة والسعادة المادية ملك أنفسهم إما مرهون جهدهم في سلوك سبيل المعاش في اقتناء الأموال واكتساب المقام والجاه أو مما ملكهم إياه الجد الرفيع أو البخت السعيد كمن ورث مالا من مورثه أو صادف كنزا فتملكه أو ساد قومه برئاسة أبيه .
فطريق الرجاء قليل التأثير في وجوب العبودية حتى أن المسلمين مع ما بأيديهم من التعليم الكامل الإلهي يتأثرون من الوعد والبشارة أقل مما يتأثرون من الوعيد والإنذار ، ولذلك بعينه نرى أن القرآن يذكر الإنذار من وظائف الأنبياء أكثر من ذكر التبشير ، وكلا الأمرين من وظائفهم والطرق التي يستعملونها في الدعوة الدينية .
وبالجملة اختار قوم إبراهيم عليه السلام في محاجتهم إياه عند ما كلموه في أمر الآلهة سبيل الخوف فأرهبوه من قهر الآلهة وسخطها ووعظوه بسلوك سبيلهم ولزوم طريقهم في التقرب بالآلهة ورفض القول بربوبية الله سبحانه ، وإثباته في المقام الذي أثبتوه فيه وهو أنه الذي ينتهي إليه الكل فحسب .
ولما وجد عليه السلام كلامهم ينحل إلى جزئين : الردع عن القول بربوبية الله سبحانه والتحريض على القول بربوبية آلهتهم احتج عليهم من الجهتين جميعا لكن لا غنى للجهة الأولى عن الثانية كما سيجيئ .
وما أورده في الاحتجاج على حجاجهم في الله سبحانه هو قوله : {أَتُحاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدانِ} أي إني واقع في أمر مفروغ عنه ومهتد بهداية ربي حيث آتاني العلم بما أراني من ملكوت السماوات والأرض وألهمني بذلك حجة أنفي بها ربوبية غيره من الأصنام والكواكب ، وإني لا أستغني عن رب يدبر أمري فأنتج لي أنه هو الرب وحده لا شريك له ، وإذ هداني إليه فأنا في غنى عن الإصغاء إلى حجتكم والبحث عن الربوبية ثانيا فإن البحث إنما ينفع الطالب ولا طلب بعد الوصول إلى الغاية .
هذا ما يعطيه ظاهر الآية بالتبادر إلى الذهن لكن هناك معنى أدق من ذلك يظهر بالتدبر وهو أن قوله : {وَقَدْ هَدانِ} استدلال بنفس الهداية لا استغناء بالهداية عن الاستدلال وتقريره أن الله هداني بما علمني من الحجة على نفي ربوبية ، غيره وإثبات ربوبيته ونفس هدايته دليل على أنه رب ولا رب غيره فإن الهداية إلى الرب من جملة التدبير فهي شأن من هو رب ، ولو لم يكن الله سبحانه هو ربي لم يكن ليهديني ولأقام بها إلى الذي هو الرب لكن الله هو هداني فهو ربي .
ولم يكن لهم أن يقولوا : إن الذي علمك ما علمت وألهمك الحجة هو بعض آلهتنا لأن الشيء لا يهدي إلى ما يضره ويميت ذكره ويفسد أمره فاهتداؤه عليه السلام إلى نفي ربوبيتها لا يصح أن ينسب إليها ، هذا .
ولكن كان لهم أن يقولوا أو أنهم قالوا : إن ذلك من فعل بعض آلهتنا فعل بك ذلك قهرا وسخطا أبعدك عن القول بربوبيتها ولقنك هذه الحجج لما وجد من فساد رأيك وعلة نفسك نظير ما شافهت به عاد هودا عليه السلام لما دعاهم إلى توحيد الله سبحانه واحتج عليهم بأن الله هو الذي يجب أن يرجى ويخاف ، وأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر فردوا عليه بأن بعض آلهتنا اعتراك بسوء قال تعالى في قصتهم حكاية عن هود عليه السلام : {وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ، قالُوا يا هُودُ ـ إلى أن قال ـ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ، مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ} [هود : 55] .
فقوله عليه السلام : {وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ} إلخ ، ينفي هذه الشبهة وكما أنه ينفي هذه الشبهة فإنه حجة تامة تنفي ربوبية شركائهم .
ومحصله : أنكم تدعونني إلى القول بربوبية شركائكم ورفض القول بربوبية ربي بما تخافونني من أن تمسني شركاؤكم بسوء ، وترهبونني بإلقاء الشبهة فيما اهتديت به ، وإني لا أخاف ما تشركون به لأنها جميعا مخلوقات مدبرة لا تملك نفعا ولا ضرا وإذ لم أخفها سقطت حجتكم وأرتفعت شبهتكم .
ولو كنت خفتها لم يكن الخوف الحاصل في نفسي من صنع شركائكم لأنها لا تقدر على شيء بل كان من صنع ربي وكان هو الذي شاء أن أخاف شركاءكم فخفتها فكان هذا الخوف دليلا آخر على ربوبيته وآية أخرى من آيات توحيده يوجب إخلاص العبادة له لا دليلا على ربوبية شركائكم وحجة توجب عبادتها .
والدليل على أن ذلك من ربي أنه وسع كل شيء علما فهو يعلم كل ما يحدث ويجري من خير وشر في مملكته التي أوجدها لغايات صحيحة متقنة ، وكيف يمكن أن يعلم في ملكه بشيء ينفع أو يضر فيسكت ولا يستقبله بأحد أمرين : إما المنع أو الإذن . ؟
فلو حصل في نفسي شيء من الخوف لكان بمشية من الله وإذن على ما يليق بساحة قدسه ، وكان ذلك من التدبير الدال على ربوبيته ونفي ربوبية غيره أفلا تتذكرون وترجعون إلى ما تدركونه بعقولكم وتهدي إليه فطرتكم .
فهذا وجه في تقرير الحجة المودعة في قوله : {وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ} وعلى ذلك فقوله : {وَلا أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ} كالمتمم للحجة في قوله : {أَتُحاجُّونِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدانِ} وهو مع ذلك حجة تامة في نفسه لإبطال ربوبية شركائهم بعدم الخوف منها ، وقوله : {إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً} كالكلام في الحجة على تقدير التسليم أي تحتجون على وجوب عبادتها بالخوف ولا خوف في نفسي ، ولو فرض خوف لكان دليلا على ربوبية ربي لا على ربوبية شركائكم فإنه عن مشية من ربي ، وقوله : {وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً} بيان وتعليل لكون الخوف المفروض مستندا إلى مشية ربه فإن فاطر السماوات والأرض لا يجهل ما يقع في ملكه فلا يقع إلا بإذن منه فهو الذي يدبر أمره ويقوم بربوبيته ، وقوله : {أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ} استفهام توبيخي وإشارة إلى أن الحجة فطرية ، هذا .
____________________________
1. تفسير الميزان ، ج7 ، ص 137-166 .
2. سيأتي ذكر الاختلاف في تعيين عهد ملكه في ذيل ما ننقله من التوراة من قصص إبراهيم عليه السلام .
3. راجع في ذلك كتاب شريعة حموربي ، تأليف صاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن الكيالي وسائر ما ألف في هذا الشأن .
قال تعالى : {وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} [الأنعام : 74] .
لما كانت هذه السورة تحارب الشرك وعبادة الأصنام ويدور فيها الكلام أكثر ما يدور على المشركين وعبدة الأصنام ، وتستخدم مختلف الأساليب لإيقاظهم ، فهي تستخدم هنا حكاية إبراهيم بطل التوحيد ، وتشير إلى منطقه القوي في تحطيم الأصنام ضمن بضع آيات .
من الجدير بالانتباه أنّ القرآن في كثير من بحوثه عن التوحيد ومحاربة عبادة الأصنام يستند إلى هذه الحقيقة ، لأنّ إبراهيم عليه السلام كان يحظى باحترام الأقوام كافة ، وعلى الأخص مشركي العرب .
يقول : إنّ إبراهيم وبخ أباه (عمّه) قائلا : أتختار هذه الأصنام الحقيرة التي لا حياة فيها آلهة للعبادة : {وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً إِنِّي أَراكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} وأي ضلال أشد وأضح من أن يجعل الإنسان ما يخلقه بيده إلها يعبده ، ويتخذ من كائن جامد لا روح فيه ولا إحساس ملجأ يفزع إليه ويبحث عن حل مشاكله عنده .
هل كان آزر أبا إبراهيم ؟
تطلق كلمة «الأب» في العربية على الوالد غالبا ، ولكنّها قد تطلق أيضا على الجد من جهة الأمّ وعلى العم ، وكذلك على المربي والمعلم والذين يساهمون بشكل ما في تربية الإنسان ، ولكنّها إذا جاءت مطلقة فإنها تعني الوالد ما لم تكن هناك قرينة تدلّ على غير ذلك .
فهل الرجل الذي تشير إليه الآية (آزر) هو والد إبراهيم؟ أيجوز أن يكون عابد الأصنام وصانعها والد نبي من أولي العزم؟ ألا يكون للوراثة من هذا الوالد تأثير شيء في أبنائه ؟
بعض مفسّري أهل السنّة يجيب بالإيجاب على السؤال الأوّل ، ويعتبر آزر والد إبراهيم الحقيقي ، أمّا المفسّرون الشيعة فيجمعون على أن آزر ليس والد إبراهيم ، بل قال بعضهم : إنّه كان جدّه لأمّه ، وقال أكثرهم : إنّه كان عمه ، وهم في ذلك يستندون إلى القرائن التّالية :
1 ـ لم يرد في كتب التّأريخ أنّ أبا إبراهيم هو آزر ، بل يقول التّأريخ إنّ اسم أبيه هو «تارخ» وهذا ما ورد أيضا في العهدين القديم والجديد ، والذين يعتبرون آزر والد إبراهيم يستندون إلى تعليلات لا يمكن قبولها من ذلك أنّهم يقولون : إنّ اسم والد إبراهيم هو تارخ ولقبه آزر ، وهذا القول لا تسنده الوثائق التّأريخية .
أو يقولون : إنّ «آزر» اسم صنم كان أبو إبراهيم يعبده ، وهذا القول لا يأتلف مع هذه الآية التي تقول أن أباه كان آزر ، إلّا إذا قدرنا جملة أو كلمة ، وهذا أيضا خلاف الظاهر .
2 ـ يقول القرآن : {ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى} . . . ثمّ لكيلا يتخذ أحد من استغفار إبراهيم لآزر حجّة يقول :
{وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} [التوبة : 113 - 114] وذلك لأنّ إبراهيم كان قد وعد آزر أن يستغفر له : {سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي} [مريم : 47] بأمل رجوعه عن عبادة الأصنام ، ولكنّه عند ما رآه مصمما على عبادة الأصنام ومعاندا ، ترك الاستغفار له .
يتّضح من هذه الآية بجلاء أن إبراهيم بعد أن يئس من آزر ، لم يعد يطلب له المغفرة ولم يكن يليق به أن يفعل .
كل القرائن تدل على أنّ هذه الحوادث وقعت عند ما كان إبراهيم شابا ، يعيش في بابل ويحارب عبدة الأصنام .
ولكن آيات أخرى في القرآن تشير إلى أن إبراهيم في أواخر عمره ، وبعد الانتهاء من بناء الكعبة ، طلب المغفرة لأبيه (في هذه الآيات ـ كما سيأتي ـ لم تستعمل كلمة «أب» بل استعملت كلمة «والد» الصريحة في المعنى) حيث يقول : {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ . . . رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ} [إبراهيم : 39 و 41] .
إذا جمعنا هذه الآية مع آية سورة التوبة التي تنهي المسلمين عن الاستغفار للمشركين وتنفي ذلك عن إبراهيم ، إلّا لفترة محدودة ولهدف مقدس ، تبيّن لنا بجلاء أنّ المقصود من «أب» في الآية المذكورة ليس «الوالد» ، بل هو العم أو الجد من جانب الأمّ أو ما إلى ذلك ، وبعبارة أخرى : إنّ «والد» تعطي معنى الأبوة المباشرة ، بينما «أب» لا تفيد ذلك .
وقد وردت في القرآن كلمة «أب» بمعنى العم ، كما في الآية (133) من سورة البقرة : {قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً} والضمير في «قالوا» يعود على أبناء يعقوب ، وكان إسماعيل عم يعقوب ، لا أباه .
3 ـ وهناك روايات إسلامية مختلفة تؤكّد هذا الأمر ، فقد جاء في حديث معروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : «لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا لم يدنسني بدنس الجاهلية» (2) .
ولا شك أن أقبح أدناس الجاهلية هو الشرك وعبادة الأوثان ، أما القائلون أنّ أقبحها هو الزنا فلا يقوم على قولهم دليل . خاصّة وانّ القرآن يقول : {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة : 28] .
الطبري ، وهو من علماء أهل السنة ، ينقل في تفسيره «جامع البيان» عن المفسّر المعروف «مجاهد» أنّه قال : لم يكن آزر والد إبراهيم (3) .
الآلوسي في «روح المعاني» يؤكّد عند تفسير هذه الآية أنّ الشيعة ليسوا وحدهم الذين يعتقدون أن آزر لم يكن والد إبراهيم ، بل إن كثيرا من علماء المذاهب الأخرى يرون أن آزر اسم عم إبراهيم (4) .
والسيوطي العالم السني المعروف ، نقل في كتابه «مسالك الحنفاء» عن أسرار التنزيل للفخر الرازي أن والدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجداده لم يكونوا مشركين أبدا . مستدلا على ذلك بالحديث الذي نقلنا آنفا ، ثمّ يستند السيوطي نفسه إلى مجموعتين من الرّوايات .
الأولى : تقول إنّ آباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأجداده حتى آدم كان كل واحد منهم أفضل أهل زمانه (وينقل أمثال هذه الرّوايات عن «صحيح البخاري» و «دلائل النبوة» للبيهقي وغيرهما من المصادر) .
والثّانية : هي التي تقول : إنّه في كل عصر وزمان كان هناك أناس من الموحدين الذين يعبدون الله ، ثمّ يجمع بين هاتين المجموعتين من الرّوايات ويستنتج أنّ أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بما فيهم والد إبراهيم ، كانوا حتما من الموحدين (5) .
يتبيّن من هذا أنّ التّفسير المذكور لهذه الآية مبني على وجود قرائن واضحة من القرآن نفسه ومن مختلف الرّوايات الإسلامية ، وليس تفسيرا مبنيا على الرأي الشخصي فقط ، كما يقول بعض مفسّري أهل السنة ، مثل صاحب «المنار» .
{وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام : 75-79] .
أدلة التوحيد في السموات :
على أثر الكره الذي كان يحمله إبراهيم للأوثان وطلبه من آزر أن يترك عبادة الأصنام ، تشير هذه الآيات إلى نضال إبراهيم المنطقي مع مختلف عبدة الأصنام ، وتبيّن كيفية توصله إلى أصل التوحيد عن طريق الاستدلال العقلي الواضح .
تبيّن أولا أنّ الله كما عرّف إبراهيم على أضرار عبادة الأصنام عرّفه على مالكية الله وسلطته المطلقة على السموات والأرض : {وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ} (6) .
«الملكوت» من «ملك» بمعنى المالكية والحكم و «الواو» و «التاء» أضيفتا للتوكيد والمبالغة ، فالمقصود من الكلمة هنا حكومة الله المطلقة على عالم الوجود برمته .
ولعل هذه الآية إجمال للتفصيل الوارد في الآيات التّالية بشأن الكواكب والقمر والشمس وإدراك أنّها من المخلوقات لدى مشاهدة أفولها .
أي أنّ القرآن بدأ بذكر مجمل تلك الحالات ، ثمّ أخذ يفصلها ، وبهذا يتّضح المقصود من إراءة ملكوت السموات والأرض لإبراهيم عليه السلام .
كما أنّه في الختام يقول إنّ الهدف من ذلك هو أن يصبح إبراهيم من أهل اليقين : {وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} .
لا شك أنّ إبراهيم كان موقنا يقينا استدلاليا وفطريا بوحدانية الله ، ولكنّه بدراسة أسرار الخلق بلغ يقينه حد الكمال ، كما أنّه كان مؤمنا بالمعاد ويوم القيامة ، ولكنّه بمشاهدة الطيور المذبوحة التي عادت إليها الحياة بلغ إيمانه مرحلة «عين اليقين» .
الآيات التّالية تشرح هذا المعنى ، وتبيّن استدلال إبراهيم من أفول الكواكب والشمس على عدم الوهيتها ، فعند ما غطى ستار الليل المظلم العالم كلّه ، ظهر أمام بصره كوكب لامع ، فنادى إبراهيم : هذا ربّي! ولكنّه إذ رآه يغرب ، قال : لا أحبّ الذين يغربون : {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} .
ومرّة أخرى رفع عينيه إلى السماء فلاح له قرص القمر الفضي ذو الإشعاع واللمعان الجذاب على أديم السماء ، فصاح ثانية : هذا ربّي : ولكنّ مصير القمر لم يكن بأفضل من مصير الكواكب قبله ، فقد أخفى وجهه خلف طيات الأفق .
هنا قال إبراهيم : إذا لم يرشدني ربّي إلى الطريق الموصل إليه فسأكون في عداد التائهين {فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بازِغاً قالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ} .
عند ذاك كان الليل قد انقضى ، وراح يجمع أطراف أستاره المظلمة هاربا من كبد السماء ، بينما راحت الشمس تطل من المشرق وتلقي بأشعتها الجميلة كنسيج ذهبي تنشره على الجبل والوادي والصحراء ، وما أن وقعت عين إبراهيم الباحث عن الحقيقة على قرص الشمس الساطع صاح : هذا ربّي فإنّه أكبر وأقوى ضوءا ، ولكنّه إذ رآها كذلك تغرب وتختفي في جوف الليل البهيم أعلن إبراهيم قراره النهائي قائلا : يا قوم ! لقد سئمت كل هذه المعبودات المصطنعة التي تجعلونها شريكة لله : {فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قالَ يا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ} .
الآن بعد أن عرفت أنّ وراء هذه المخلوقات المتغيرة المحدودة الخاضعة لقوانين الطبيعة إلها قادرا وحاكما على نظام الكائنات ، فإني أتجه إلى الذي خلق السموات والأرض ، وفي إيماني هذا لن أشرك به أحدا ، فاني موحد ولست مشركا : {إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} .
* * *
للمفسّرين كلام كثير في تفسير هذه الآية والآيات التّالية بشأن ما دفع بإبراهيم الموحد العابد لله الواحد ، أن يشير إلى كوكب في السماء ويقول : هذا ربّي ؟ ومن بين آراء المفسّرين الكثيرة نقف عند تفسيرين قد اختار كلا منهما عدد من كبار المفسّرين ، كما أنّهما مدعومان بشواهد من المصادر الحديثية :
الأوّل : يقول إنّ إبراهيم كان يريد شخصيا أن يفكر في معرفة الله وأن يعثر على المعبود الذي كان يجده بفطرته النقية في أعماق ذاته ، إنّه كان يعرف الله بنور فطرته ودليل العقل الإجمالي إذ إنّ كل تعبيراته تدل على أنّه لم يكن يشك أبدا في وجوده ، ولكنّه كان يبحث عن مصداقه الحقيقي ، بل لقد كان يعلم بمصداقه الحقيقي أيضا ، ولكنّه كان يريد أن يصل عن طريق الاستدلال العقلي الأوضح إلى مرحلة «حق اليقين» .
وقد وقعت له هذه الحوادث قبل نبوته ، ويحتمل أن تكون في أوّل بلوغه أو قبيل ذلك .
نقرأ في بعض التواريخ والرّوايات أنّ هذه كانت المرّة الأولى التي يرنو فيها إبراهيم بنظره إلى السماء وإلى كواكبها الساطعة ، لأن أمّه كانت منذ طفولته قد أخفته في عار خوفا عليه من بطش نمرود الجبار وجلاوزته .
غير أنّ هذا الاحتمال يبدو بعيدا ، إذ يصعب أن نتصور إنسانا يعيش سنوات طويلة في بطن غار ولا يخلو خارجه ، ولو مرّة ، في ليلة ظلماء ، فلعل الذي قوى هذا الاحتمال في نظر بعض المفسّرين هو تعبير {رَأى كَوْكَباً} الذي يوحي بأنه لم يكن قد رأى كوكبا حتى ذلك الحين ، ولكن هذا التعبير لا يحمل في الواقع مثل هذا المفهوم ، بل المقصود هو أنّه ، وإن كان قد رأى الكواكب والشمس والقمر مرات حتى ذلك الوقت ، فقد ألقى الأوّل مرّة نظرة فاحصة مستطلعة إلى هذه الظواهر . وكان يفكر في مغزى بزوغها وأفولها ونفي الألوهية عنها ، في الحقيقة كان إبراهيم قد رآها مرارا ، ولكن لا بتلك النظرة .
لذلك فإنه عند ما يقول : {هذا رَبِّي} لا يقولها قاطعا جازما ، بل يقولها من باب الفرض والاحتمال حتى يفكر في الأمر ، وهذا يشبه تماما حالنا ونحن نحاول أن نعثر على سبب حادثة ما ، فنقلب مختلف الاحتمالات والافتراضات على وجوهها واحدة واحدة ، ونستقصي لوازم كل فرضية حتى نعثر على العلة الحقيقية ، وهذا لا يكون كفرا ، بل ولا حتى دليلا على عدم الإيمان ، بل هو طريق لتحقيق أكثر ولمعرفة أفضل ، للوصول إلى مراحل أعلى من الإيمان ، كما فعل إبراهيم في مسألة «المعاد» إذ قام بمزيد من الدراسة يوصل إلى مرحلة الشهود والاطمئنان .
جاء في تفسير العياشي عن محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام أنّه قال : «إنّما كان إبراهيم طالبا لربّه ، ولم يبلغ كفرا ، وانّه من فكر من الناس في مثل ذلك فإنه بمنزلته» (7) .
وهنالك روايتان أخريان يذكرهما تفسير نور الثقلين بهذا الشأن .
أمّا التّفسير الثّاني فيقول : إن إبراهيم كان يقول هذا الكلام أثناء مخاطبته عبدة النجوم والشمس ، ويحتمل أن يكون ذلك بعد مخاصماته الشديدة في بابل مع عبدة الأوثان وخروجه منها إلى الشام ، حيث التقى بهؤلاء الأقوام ، وإبراهيم الذي كان قد خبر عناد الأقوام الجاهلة في بابل وخطأ تفكيرهم ، أراد أن يحلب إليه انتباه عبدة الكواكب والشمس والقمر ، فأظهر في البداية أنّه معهم وقال لهم : إنكم تقولون : إنّ كوكب الزاهرة هذا هو ربّي ، حسنا ، فلنر ما يحصل لهذا الإعتقاد في النهاية ، ولم يمض وقت طويل حتى اختفى وجه الكواكب النير خلف ستار الأفق المظلم ، عندئذ اتّخذ إبراهيم من هذا الأفول سلاحا يواجههم به فقال : أنا لا يمكنني أن أتقبل معبودا كهذا .
وعليه ، فإنّ عبارة {هذا رَبِّي} تعني : هذا ما تعتقدون أنّه ربّي ، أو أنّه قالها بلهجة الاستفهام : «هذا ربّي؟» .
ويؤيد هذا التّفسير أيضا رواية في «نور الثقلين» وتفاسير أخرى عن كتاب «عيون أخبار الرضا عليه السلام» .
كيفية استدلال إبراهيم على التوحيد :
هنا يبرز هذا السؤال : كيف استطاع إبراهيم أن يستدل من غروب الشمس والقمر والكواكب على عدم ربوبيتها ؟
يمكن أن يكون هذا الاستدلال من طرق ثلاثة :
1 ـ إنّ الله المربي ، كما يستفاد من كلمة «رب» لا بدّ أن يكون دائما قريبا من مخلوقاته وأن لا ينفصل عنهم لحظة واحدة ، وعليه لا يجوز لكائن يغرب ويختفي ساعات طويلة ، بنوره وبركته وتنقطع صلته كليا عن الكائنات الأخرى ، أن يكون ربّا وإلها .
2 ـ إنّ كائنا يغرب ويبزغ ويخضع للقوانين الطبيعية ، لا يمكن أن يحكم على هذه القوانين ويملكها ؟ إنّه هو نفسه مخلوق ضعيف يخضع لأوامرها وغير قادر على أدنى انحراف عنها . . .
3 ـ إنّ الكائن المتحرك لا يمكن إلّا يكون كائنا حادثا ، فقد أثبتت الفلسفة أنّ الحركة دليل على الحدوث ، لأنّ الحركة ذاتها نوع من الوجود الحادث ، وأن ما يكون في معرض الحوادث ، أي يكون ذا حركة ، لا يمكن أن يكون كائنا أزليا وأبديا (تأمل بدقّة) .
___________________________
- تفسير الأمثل ، ج4 ، ص 121-129 .
- يورد هذا الحديث كثيرون من مفسّري الشيعة والسنة ، كالمرحوم الطبرسي في «مجمع البيان» والنيسابوري في تفسير «غرائب القرآن» والفخر الرازي في «التّفسير الكبير» والآلوسي في تفسير «روح المعاني» .
- «جامع البيان» ، ج 7 ، ص 158 .
- تفسير «روح المعاني» ، ج 7 ، ص 169 .
- «مسالك الحنفاء» ، ص 17 كما جاء في هامش «بحار الأنوار» ، 15 ، 18 أو بعدها ، الطبعة الجديدة .
- وعلى هذا ، هناك محذوف مقدار في الآية يدل عليه ما في الآيات السابقة ، فيكون مضمون الآية : كما أرينا إبراهيم قبح ما كان عليه قومه من عبادة الأصنام كذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض (تأمل بدقة) .
- تفسير نور الثقلين : ج 1 ، ص 738 .
 الاكثر قراءة في سورة الأنعام
الاكثر قراءة في سورة الأنعام
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)