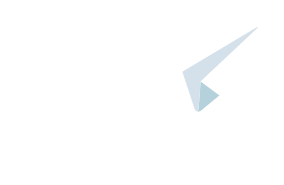تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير الآية (50-55) من سورة الانعام
المؤلف:
اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
9-6-2021
6467
قال تعالى : {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ (50) وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (51) وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ (53) وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (54) وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام : 50 - 55] .
قال تعالى : {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ} [الأنعام : 50].
أمر النبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) أن يقول بعد اقتراحهم الآيات منه : إني لا أدعي الربوبية ، وإنما أدعي النبوة فقال : {قل} يا محمد {لَا أَقُولُ لَكُمْ} أيها الناس {عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ} يريد : خزائن رحمة الله ، عن ابن عباس . وقيل : خزائن الله مقدوراته ، عن الجبائي . وقيل : أرزاق الخلق حتى يؤمنوا طمعا في المال {وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} الذي يختص الله بعلمه ، وإنما أعلم قدر ما يعلمني الله تعالى من أمر البعث ، والنشور ، والجنة ، والنار ، وغير ذلك . وقيل : عاقبة ما تصيرون إليه ، عن ابن عباس {وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} لأني انسان تعرفون نسبي ، يريد ، لا أقدر على ما يقدر عليه الملك ، وقد استدل بهذا على أن الملائكة أفضل من الأنبياء ، وهذا بعيد لأن الفضل الذي هو كثرة الثواب ، لا معنى له ههنا ، وإنما المراد لا أقول لكم : إني ملك فأشاهد من أمر الله وغيبه عن العباد ما تشاهده الملائكة .
{إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ} يريد : ما أخبركم إلا بما أنزله الله إلي ، عن ابن عباس . وقال الزجاج : أي ما أنبأتكم به من غيب فيما مضى ، وفيما سيكون ، فهو بوحي من الله ، عز وجل .
ثم أمره سبحانه فقال {قل} يا محمد لهم {هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ} أي : هل يستوي العارف بالله سبحانه ، العالم بدينه ، والجاهل به وبدينه ، فجعل الأعمى مثلا للجاهل ، والبصير مثلا للعارف بالله وبنبيه ، وهذا قول الحسن ، واختاره الجبائي .
وفي تفسير أهل البيت : هل يستوي من يعلم ومن لا يعلم . وقيل : معناه هل يستوي من صدق على نفسه ، واعترف بحاله التي هو عليها من الحاجة والعبودية لخالقه ، ومن ذهب عن البيان ، وعمي عن الحق ، عن البلخي {أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ} فتنصفوا من أنفسكم ، وتعملوا بالواجب عليكم من الإقرار بالتوحيد ، ونفي التشبيه .
وهذا استفهام يراد به الإخبار : يعني إنهما لا يستويان .
- {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأنعام : 51] .
ثم أمر سبحانه بعد تقديم البينات بالإنذار ، فقال : {وَأَنْذِرْ} أي : عظ وخوف {به} أي : بالقرآن ، عن ابن عباس . وقيل : بالله ، عن الضحاك {الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ} يريد المؤمنين يخافون يوم القيامة ، وما فيها من شدة الأهوال ، عن ابن عباس ، والحسن . وقيل : معناه يعلمون ، عن الضحاك . وقيل : يخافون أن يحشروا علما بأنه سيكون ، عن الفراء قال : ولذلك فسره المفسرون بيعلمون . قال الزجاج : المراد بهم كل معترف بالبعث ، من مسلم وكتابي ، وإنما خصر الذين يخافون الحشر ، دون غيرهم ، وهو ينذر جميع الخلق ، لأن الذين يخافون الحشر ، الحجة عليهم أوجب ، لاعترافهم بالمعاد . قال الصادق (عليه السلام) : " أنذر بالقرآن من يرجون الوصول إلى ربهم ، ترغبهم فيما عنده ، فإن القرآن شافع مشفع لهم " . {لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ} أي : غير الله {وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} عن الضحاك . وقال الزجاج : إن اليهود والنصارى ، ذكرت أنها أبناء الله وأحباؤه ، فأعلم الله ، عز اسمه ، أن أهل الكفر ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع ، وهذا الذي قاله ظاهر في أهل الكفر ، والمفسرون على أن الآية في المؤمنين ، ويكون معنى قوله {لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} : على أن شفاعة الأنبياء وغيرهم للمؤمنين ، إنما تكون بإذن الله لقوله سبحانه : {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة : 255] فذلك راجع إلى الله تعالى {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} كي يخافوا في الدنيا ، وينتهوا عما نهيتم عنه ، عن ابن عباس .
- {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ (52) وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام : 52 - 53] .
ثم نهى سبحانه رسوله عليه واله السلام ، عن إجابة المشركين ، فيما اقترحوه عليه من طرد المؤمنين ، فقال : {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} يريد يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة ، يعني صلاة الصبح والعصر ، عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، وقيل : إن المراد بالدعاء ههنا الذكر ، أي : يذكرون ربهم طرفي النهار ، عن إبراهيم . وروي عنه أيضا أن هذا في الصلوات الخمس {يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} يعني : يطلبون ثواب الله ، ويعملون ابتغاء مرضاة الله ، لا يعدلون بالله شيئا ، عن عطا ، قال الزجاج : شهد الله لهم بصدق النيات ، وأنهم مخلصون في ذلك له . أي : يقصدون الطريق الذي أمرهم بقصده ، فكأنه ذهب في معنى الوجه إلى الجهة والطريق .
{مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ} يريد : ما عليك من حساب المشركين شيء ، ولا عليهم من حسابك شيء ، إنما الله الذي يثيب أولياءه ، ويعذب أعداءه ، عن ابن عباس ، في رواية عطا ، وأكثر المفسرين ، يردون الضمير إلى الذين يدعون ربهم ، وهو الأشبه . وذكروا فيه وجهين أحدهما : ما عليك من عملهم ، ومن حساب عملهم من شيء ، عن الحسن ، وابن عباس . وهذا كقوله تعالى في قصة نوح : {إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ} [الشعراء : 113] وهذا لأن المشركين ازدروهم لفقرهم وحاجتهم إلى الأعمال الدينية ، وهم برفع المشركين عليهم في المجلس ، فقيل له : ما عليك من حسابهم من شيء ، أي : لا يلزمك عار بعملهم . {فَتَطْرُدَهُمْ} ثم قال : وما من حسابك عليهم من شيء تأكيدا لمطابقة الكلام ، وإن كان مستغنى عنه بالأول . الوجه الثاني : ما عليك من حساب رزقهم من شيء ، فتملهم وتطردهم ، أي : ليس رزقهم عليك ، ولا رزقك عليهم ، وإنما يرزقك وإياهم الله الرازق ، فدعهم يدنوا منك ، ولا تطردهم {فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} لهم بطردهم ، عن ابن زيد . وقيل : فتكون من الضارين لنفسك بالمعصية ، عن ابن عباس .
قال ابن الأنباري عظم الأمر في هذا على النبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) ، وخوف الدخول في جملة الظالمين ، لأنه كان قد هم بتقديم الرؤساء وأولي الأموال على الضعفاء مقدرا أنه يستجر بإسلامهم اسلام قومهم ، ومن لف لفهم ، كان (صلَّ الله عليه وآله وسلم) لم يقصد في ذلك إلا قصد الخير ، ولم ينو به ازدراء بالفقراء ، فأعلمه الله أن ذلك غير جائز .
ثم أخبر الله سبحانه أنه يمتحن الفقراء بالأغنياء ، والأغنياء بالفقراء فقال : {وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} أي : كما ابتلينا قبلك الغني بالفقير ، والشريف بالوضيع ، ابتلينا هؤلاء الرؤساء من قريش بالموالي ، فإذا نظر الشريف إلى الوضيع قد آمن قبله ، حمي آنفا أن يسلم ، ويقول : سبقني هذا بالإسلام ، فلا يسلم ، وإنما قال سبحانه {فَتَنَّا} وهو لا يحتاج إلى الاختبار ، لأنه عاملهم معاملة المختبر {لِيَقُولُوا} هذه لام العاقبة ، المعنى : فعلنا هذا ليصبروا ويشكروا ، فال أمرهم إلى هذه العاقبة {أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا} والاستفهام معناه الانكار ، كأنهم أنكروا أن يكونوا سبقوهم بفضيلة ، أو خصوا بمنة . وقال أبو علي الجبائي : المعنى في فتنا : شددنا التكليف على أشراف العرب ، بأن أمرناهم بالإيمان وبتقديمهم هؤلاء الضعفاء على نفوسهم ، لتقدمهم إياهم في الإيمان ، وهذا أمر كان شاقا عليهم ، فلذلك سماه الله فتنة .
وقوله : {لِيَقُولُوا} أي : فعلنا هذا بهم ليقول بعضهم لبعض على وجه الاستفهام لا على وجه الانكار ، أهؤلاء من الله عليهم بالإيمان إذا رأوا النبي يقدم هؤلاء عليهم ، وليرضوا بذلك من فعل رسول الله ، ولم يجعل هذه الفتنة والشدة في التكليف ، ليقولوا ذلك على وجه الانكار ، لأن إنكارهم لذلك كفر بالله ، ومعصية ، والله سبحانه ، لا يريد ذلك ، ولا يرضاه ، ولأنه لو أراد ذلك وفعلوه ، كانوا مطيعين له ، لا عاصين ، وقد ثبت خلافه . وقوله : {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} هذا استفهام تقرير أي : إنه كذلك ، كقول جرير :
ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح (2)
وهذا دليل واضح على أن فقراء المؤمنين وضعفاءهم ، أولى بالتقريب والتقديم والتعظيم من أغنيائهم ، ولقد قال أمير المؤمنين علي (عليه السلام) : (من أتى غنيا فتواضع لغنائه ذهب ثلثا دينه) .
- {وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام : 54] .
ثم أمر سبحانه نبيه بتعظيم المؤمنين ، فقال : {وَإِذَا جَاءَكَ} يا محمد {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ} أي : يصدقون {بِآيَاتِنَا} أي : بحججنا وبراهيننا {فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} ذكر فيه وجوه ، أحدها : إنه أمر نبيه (صلَّ الله عليه وآله وسلم) أن يسلم عليهم من الله تعالى ، فهو تحية من الله على لسان نبيه (صلَّ الله عليه وآله وسلم) ، عن الحسن . وثانيها : إن الله تعالى أمر نبيه (صلَّ الله عليه وآله وسلم) أن يسلم عليهم تكرمة لهم ، عن الجبائي . وثالثها : إن معناه اقبل عذرهم واعترافهم ، وبشرهم بالسلامة مما اعتذروا منه ، عن ابن عباس .
{كَتَبَ رَبُّكُمْ} أي : أوجب ربكم {عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} إيجابا مؤكدا ، عن الزجاج قال : إنما خوطب الخلق بما يعقلون ، وهم يعقلون أن الشيء المؤخر إنما يحفظ بالكتاب . وقيل : معناه كتبه في اللوح المحفوظ ، وقد سبق بيان هذا في أول السورة {أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ} . قال الزجاج : يحتمل الجهالة ههنا وجهين أحدهما : إنه عمله وهو جاهل بمقدار المكروه فيه أي : لم يعرف أن فيه مكروها والآخر : إنه علم أن عاقبته مكروهة ، ولكنه آثر العاجل ، فجعل جاهلا بأنه آثر النفع القليل على الراحة الكثيرة ، والعافية الدائمة ، وهذا أقوى . ومثله قوله سبحانه {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} [النساء : 17] الآية وقد ذكرنا ما فيه هناك {ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ} أي : رجع عن ذنبه ، ولم يصر على ما فعل ، وأصلح عمله {فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
- {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام : 55]
ثم عطف سبحانه على الآيات التي احتج بها على مشركي مكة ، وغيرهم فقال : {وَكَذَلِكَ} أي : كما قدمناه من الدلالات على التوحيد ، والنبوة ، والقضاء . {نُفَصِّلُ الْآيَاتِ} : وهي الحجج والدلالات أي : نميزها ، ونبينها ، ونشرحها ، على صحة قولكم ، وبطلان ما يقوله هؤلاء الكفار .
{وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} بالرفع أي : ليظهر طريق من عاند بعد البيان إذا ذهب عن فهم ذلك ، بالإعراض عنه ، لمن أراد التفهم لذلك من المؤمنين ، ليجانبوها ، ويسلكوا غيرها .
وبالنصب : ليعرف السامع أو السائل أو لتعرف أنت يا محمد سبيلهم .
وسبيلهم : يريد به ما هم عليه من الكفر ، والعناد ، والإقدام على المعاصي ، والجرائم المؤدية إلى النار . وقيل : إن المراد بسبيلهم : ما عاجلهم الله به من الإذلال ، واللعن ، والبراءة منهم ، والأمر بالقتل ، والسبي ، ونحو ذلك . والواو في {وَلِتَسْتَبِينَ} للعطف على مضمر محذوف والتقدير : لتفهموا ، ولتستبين سبيل المجرمين والمؤمنين . وجاز الحذف لأن فيما أبقى دليلا على ما ألقى .
____________________________
1 . تفسير مجمع البيان ، ج4 ، ص 59-67 .
2 . المطايا كسجايا جمع مطية : الدابة السريعة . وأندى أفعل تفضيل من الندا : المطر والمراد السخاء . والراح جمع الراحة بمعنى الكف .
{قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ ولا أَعْلَمُ الْغَيْبَ ولا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ} . طلب المشركون من النبي (صلَّ الله عليه وآله) أن يخبرهم بالغيب ويفجر الينابيع ، ويأتي بالملائكة ، ويرقى إلى السماء ، ويسقطها عليهم ، وما إلى ذلك مما لا يمت إلى موضوع الرسالة بصلة ، فأنزل اللَّه سبحانه هذه الآية ، وأمره النبي أن يقول لهم : انه ليس بإله ، ولا ملك ، وإنما هو بشر يوحى إليه وكفى .
وبتعبير ثان ان للإله صفات تخصه ، ومنها انه قادر على كل شيء ، عالم بكل شيء ، وأيضا للملك صفات تخصه ، ومنها انه يرقى إلى السماء ، ولا يأكل الطعام ، ولا يمشي في الأسواق ، أما الرسول فهو بشر كسائر الناس ، وإنما يمتاز عنهم بنزول الوحي عليه من ربه ، مبشرا من استجاب له بحسن الثواب ، ومنذرا من أعرض بسوء العقاب ، وليس من موضوع الرسالة واختصاصها أن يتنبأ بالغيب ، ويأتي بالخوارق ، فالخلط بين صفات اللَّه وصفات ملائكته ورسله جهل وعمى .
{قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمى والْبَصِيرُ} . أي فرق بعيد بين الجاهل الضال الذي لا يفرق بين صفات اللَّه وصفات الرسول ، وبين من يعرف ان الرسول بشر يجري عليه ما يجري على غيره من الناس إلا انه يوحى إليه {أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ} في ان الرسول ليس إلها ولا ملكا ، وانه بشير ونذير ، فتنتصفوا من أنفسكم ، وتؤمنوا بلا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه ؟ .
{وأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ} . الضمير في يعود إلى القرآن الذي تقدمت إليه الإشارة في قوله تعالى : {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ} .
واختلف المفسرون في المراد من قوله : {الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ} : هل هم المؤمنون ، أو الكافرون بالنظر إلى أن بعضهم كان يتأثر من تخويف النبي وإنذاره ، كما جاء في تفسير الرازي .
وفي رأينا ان النبي (صلَّ الله عليه وآله) بعد أن أنذر الناس بما تقوم به الحجة عليهم أمره اللَّه سبحانه في هذه الآية أن يستمر ويتابع إنذار المؤمنين بالقرآن ليزدادوا إيمانا وعلما بالدين وأحكامه ، وأيضا أن ينذر به غير المؤمنين ممن ترجى هدايته بمتابعة الانذار وتكراره .
{لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ ولا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} . أي حين تنذرهم يا محمد يستمعون إليك ، وينتفعون بإنذارك لهم ، ويدركون انه لا ولي ينصرهم من دون اللَّه ، ولا شفيع يشفع عنده إلا بإذنه .
{ولا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ والْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ} . الغداة والعشي كناية عن مداومة ذكرهم للَّه وعبادتهم له ، كما تقول : الحمد للَّه بكرة وأصيلا ، ووجه اللَّه كناية عن اللَّه ، لأنه تعالى ليس كمثله شيء ، وضمير حسابهم وعليهم وتطردهم يعود إلى المؤمنين الذين يدعون ربهم ، ومعنى ما عليك من حسابهم ان حسابهم وحساب غيرهم لا يدخل في موضوع النبوة ، ولا هو من شؤونها ، وانما حسابهم على اللَّه وحده ، تماما كحسابك أنت يا محمد ، لا فرق بينك وبينهم من هذه الحيثية .
ان المسلم يؤمن إيمانا قاطعا بأن محمدا (صلَّ الله عليه وآله) أشرف الخلق على الإطلاق ، وفي الوقت نفسه يؤمن بأن عظمة محمد لا تخول له أن يحاسب أحدا ، أو يعاقبه أو يثيبه ، ان الحساب والجزاء للَّه ومن اللَّه وحده لا شريك له ، وبهذه الفضيلة امتاز الإسلام عن جميع الأديان ، بنفي السبيل للإنسان على انسان كائنا من كان وبها نعتز نحن المسلمين ونفاخر الاشتراكيين والشيوعيين والقوميين والديمقراطيين ، وجميع أهل الأديان والمذاهب .
وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية ان المترفين من قريش مروا برسول اللَّه (صلَّ الله عليه وآله) ، وعنده عمار بن ياسر وخباب وبلال وغيرهم من ضعفاء المسلمين ، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء ؟ لاء نكون تبعا ، فنحّهم عنك ، حتى نخلوا بك ، ثم إذا انصرفنا فأعدهم إلى مجلسك ان شئت . . وقيل ان النبي (صلَّ الله عليه وآله) أراد أن يجيبهم إلى ما طلبوا فنزلت الآية .
وظاهر اللفظ لا يأبى ذلك ، بخاصة قوله : {فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} لهم حيث انهم أولى بمجلسك والاستفادة منك ، وبتعبير ثان ان النبي أراد أن يقرب الأغنياء ليستفيدوا منه ، فقال له الجليل : الفقراء أولى بالاستفادة ، فإن تركت هذا الأولى ظلمت الفقراء المؤمنين من حيث الاستفادة .
وتسأل : الا يتنافى ترك الأولى والأرجح مع العصمة ؟ .
الجواب : ان ترك الأولى جائز ، وليس محرما ، حتى يتنافى مع العصمة . .
هذا ، إلى أن النبي لم يحاول طرد الفقراء استنكافا من فقرهم ، بل حرصا وطمعا في اسلام الرؤوس ، فنبه سبحانه النبي إلى أن الإسلام غني عن هؤلاء المتكبرين الطغاة ، وان لهم يوما يستسلمون فيه أذلاء صاغرين ، كما حدث بالفعل .
{وكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا} . معنى الفتنة هنا الاختبار ، واختبار اللَّه لعبده أن يظهره للملأ على حقيقته عن طريق أفعاله وأعماله ، كما بينا ذلك مفصلا عند تفسير الآية 94 من سورة المائدة ، فقرة : معنى الاختبار من اللَّه . واللام في ليقولوا للعاقبة ، أي اختبرنا الأغنياء بالفقراء ، ليشكروا اللَّه على نعمته عليهم ، فآل أمرهم إلى التكبر والاستعلاء ، قال الإمام علي (عليه السلام) : « لا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد جهلا بمواقع الفتنة والاختبار في مواضع الغنى والاقتدار ، وقد قال سبحانه : {أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وبَنِينَ نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ} [المؤمنون - 56] . فان اللَّه سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم . ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون (عليه السلام) على فرعون ، وعليهما مدارع الصوف ، وبأيديهما العصي ، فشرطا إن أسلم بقاء ملكه ودوام عزه ، فقال : ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء الملك ، وهما بما ترون من حال الفقر والذل ؟ . فهلا القي عليهما اسارة من ذهب ؟ . - إلى قوله - : ولكن اللَّه سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم ، وضعفة فيما ترى الأعين من حالهم .
السلام عليكم ورحمة اللَّه :
{وإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} .
قال رسول اللَّه (صلَّ الله عليه وآله) : أدبني ربي فأحسن تأديبي . وأي أدب كأدب خالق السماوات والأرض ؟ . وأية نفس ينمو ويثمر فيها الأدب الإلهي كنفس محمد ؟ .
لقد أدب سبحانه هذه النفس الطيبة الزاكية ، ليؤهلها لرسالته ، رسالة الرحمة للعالمين التي بها وبصاحبها تمت مكارم الأخلاق . . أدّب اللَّه محمدا في العديد من آياته ، ومنها هذه الآية ، وهي تعلَّم رسول اللَّه وخير خلق اللَّه كيف يسلك ويعامل الضعفاء والمساكين . . فكان يلقاهم بالبشاشة والترحاب ، ويقول : سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ، ويحبس نفسه معهم ، ما داموا في مجلسه ، حتى يكونوا هم الذين ينصرفون .
وإذا كان النبي مقصود اللَّه بهذا التأديب فنحن مقصودون بالتأسي والاقتداء به ، فلا نكرم أحدا لمال أو جاه أو جنس ولون ، وإنما نكرم ونحترم للدين والخلق الكريم ، قال بعض المفسرين الجدد : كانت الحياة البشرية قبل محمد (صلَّ الله عليه وآله) في الحضيض ، فرفعها محمد إلى القمة ، وتراجعت الآن عن القمة السامقة ، وانحدرت في نيويورك وواشنطن وشيكاغو ، حيث العصبيات النتنة ، عصبيات الجنس واللون .
أجل ، لا جنس ولا لون ، ولا جاه ولا ثراء ، لا فضل في الإسلام إلا بالتقوى ، وفي هذا المبدأ الإسلامي الإلهي يكمن السر لتواضع المراجع الكبار من علماء المسلمين . . يصل إليهم الصغير والكبير على السواء ، دون بواب وحجاب ، ويخاطبهم على سجيته بما شاء ، ودون تكلف وتحفظ . . أما البابا ومن إليه من رؤساء الأديان فلا يحلم بمجالسته ومخاطبته إلا وزير وكبير ، على أن يحدّد له من قبل وقت المقابلة وأمدها .
وعودا إلى قوله تعالى : {وإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} . السلام عليكم ورحمة اللَّه ، هذه هي تحية الإسلام ، دعاء بالنجاة لمن تحييه من كل سوء ، والعيش بأمان واطمئنان ، وبرحمة اللَّه ورضوانه ، إذ لا نجاة ولا أمان مع غضبه جل وعلا ، أما إذا عطفت بركات اللَّه على رحمته فقد دعوت لصاحبك بالرزق الواسع ، والعطاء الجزيل . . وأين مرحبا وصباح الخير ونهارك سعيد من هذه التحية الإلهية الإسلامية ؟ ! .
وسبق قوله تعالى : {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} في الآية 12 من هذه السورة ، وقلنا في تفسيرها : ان رحمته تعالى لا تنفك عن ذاته القدسية ، تماما كقدرته وعلمه .
{أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
المراد بالجهالة هنا السفاهة ، أما التوبة فقد عقدنا لها فصلا خاصا بعنوان التوبة والفطرة عند تفسير الآية 18 من سورة النساء {فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} هذا هو الرب الذي نعبده ، يغفر لمن أناب ، ويرحم العباد ، وكل من رحم الناس وعمل لصالحهم فقد عبد اللَّه في عمله ، وان جحده بلسانه ، وكل من اعتدى على حق من حقوقهم فقد كفر باللَّه - عمليا - وإن هلل وكبّر .
{وكَذلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ ولِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} . ذكر سبحانه في كتابه صفات الصالحين ، وأيضا ذكر صفات المجرمين ، ليظهر كل فئة بسماتها . .
هذا ، إلى أن معرفة إحدى الفئتين تستدعي معرفة الأخرى ، تماما كالهداية والضلالة .
_____________________________
1. تفسير الكاشف ، ج3 ، ص 193 – 197 .
قوله تعالى : {قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} لعل المراد بخزائن الله ما ذكره بقوله تعالى : {قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ} [الإسراء : 100] وخزائن الرحمة هذه هي ما يكشف عن أثره ، قوله تعالى : {ما يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها} ، الآية : [فاطر : 2] وهي فائضة الوجود التي تفيض من عنده تعالى على الأشياء من وجودها ، وآثار وجودها وقد بين قوله تعالى : {إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس : 82] أن مصدر هذا الأثر الفائض هو قوله ، وهو كلمة {كُنْ} الصادرة عن مقام العظمة والكبرياء ، وهذا هو الذي يخبر عنه بلفظ آخر في قوله : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر : 21] .
فالمراد بخزائن الله هو المقام الذي يعطي بالصدور عنه ما أريد من شيء من غير أن ينفد بإعطاء وجود أو يعجزه بذل وسماحة ، وهذا مما يختص بالله سبحانه ، وأما غيره كائنا ما كان ومن كان فهو محدود وما عنده مقدر إذا بذل منه شيئا نقص بمقدار ما بذل ، وما هذا شأنه لم يقدر على إغناء أي فقير ، وإرضاء أي طالب ، وإجابة أي سؤال .
وأما قوله : {وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} فإنما أريد بالعلم الاستقلال به من غير تعليم بوحي وذلك أنه تعالى يثبت الوحي في ذيل الآية بقوله : {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ} ، وقد بين في مواضع من كلامه أن بعض ما يوحيه لرسله من الغيب ، كقوله تعالى : {عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ} ، : [الجن : 26] وكقوله بعد سرد قصة يوسف : {ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ} [يوسف : 102] وقوله في قصة مريم : {ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران : 44] وقوله بعد قصة نوح : {تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا} [هود : 49] .
فالمراد بنفي علم الغيب نفي أن يكون مجهزا في وجوده بحسب الطبع بما لا يخفى عليه معه ما لا سبيل للإنسان بحسب العادة إلى العلم به من خفيات الأمور كائنة ما كانت .
وأما قوله : {وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} فهو كناية عن نفي آثار الملكية من أنهم منزهون عن حوائج الحياة المادية من أكل وشرب ونكاح وما يلحق بذلك ، وقد عبر عنه في مواضع أخرى بقوله : {قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ} [الكهف : 110] وإنما عبر عن ذلك هاهنا بنفي الملكية دون إثبات البشرية ليحاذي به ما كانوا يقترحونه عليه (صلَّ الله عليه وآله) بمثل قولهم : {ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ} [الفرقان : 7] .
ومن هنا يظهر أن الآية بما في سياقها من النفي بعد النفي ـ كأنها ـ ناظرة إلى الجواب عما كانوا يقترحونه على النبي (صلَّ الله عليه وآله) من سؤال الآيات المعجزة والاعتراض بما كان يأتي به من أعمال كأعمال المتعارف من الناس كما حكاه عنهم في قوله : {وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً * أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها} [الفرقان : 8] وقوله : {وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً * أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً * أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً * أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ ـ إلى أن قال ـ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً} [الإسراء : 93] وقوله : {فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ} [الإسراء : 51] ، وكقوله : {يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها} [الأعراف : 187] ، فمعنى قوله : {قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ} إلخ ، قل : لم أدع فيما أدعوكم إليه وأبلغكموه أمرا وراء ما أنا عليه من متعارف حال الإنسان حتى تبكتوني بإلزامي بما تقترحونه مني فلم أدع أني أملك خزائن الألوهية حتى تقترحوا أن أفجر أنهارا أو أخلق جنة أو بيتا من زخرف ، ولا ادعيت أني أعلم الغيب حتى أجيبكم عن كل ما هو مستور تحت أستار الغيوب كقيام الساعة ولا ادعيت أني ملك حتى تعيبوني وتبطلوا قولي بأكل الطعام والمشي في الأسواق للكسب .
قوله تعالى : {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ} بيان لما يدعيه حقيقة بعد رد ما اتهموه به من الدعوى من جهة دعواه الرسالة من الله إليهم أي ليس معنى قولي : إني رسول الله إليكم أن عندي خزائن الله ولا أني أعلم الغيب ولا أني ملك بل إن الله يوحي إلي بما يوحي .
ولم يثبته في صورة الدعوى بل قال : {إِنْ أَتَّبِعُ} إلخ ، ليدل على كونه مأمورا بتبليغ ما يوحى إليه ليس له إلا اتباع ذلك فكأنه لما قال : لا أقول لكم كذا ولا كذا ولا كذا قيل له : فإذا كان كذلك وكنت بشرا مثلنا وعاجزا كأحدنا لم تكن لك مزية علينا فما ذا تريد منا ؟ فقال : إن أتبع إلا ما يوحى إلي أن أبشركم وأنذركم فأدعوكم إلى دين التوحيد .
والدليل على هذا المعنى قوله بعد ذلك : {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ} فإن مدلوله بحسب ما يعطيه السياق : أني وإن ساويتكم في البشرية والعجز لكن ذلك لا يمنعني عن دعوتكم إلى اتباعي فإن ربي جعلني على بصيرة بما أوحى إلي دونكم فأنا وأنتم كالبصير والأعمى ولا يستويان في الحكم وإن كانا متساويين في الإنسانية فإن التفكر في أمرهما يهدي الإنسان إلى القضاء بأن البصير يجب أن يتبعه الأعمى ، والعالم يجب أن يتبعه الجاهل .
قوله تعالى : {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ} إلى آخر الآية الضمير في {بِهِ} راجع إلى القرآن وقد دل عليه قوله في الآية السابقة : {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ} وقوله : {لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ} حال والعامل فيه يخافون أو يحشرون .
والمراد بالخوف معناه المعروف دون العلم وما في معناه إذ لا دليل عليه بحسب ظاهر المعنى المتبادر من السياق ، والأمر بإنذار خصوص الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم لا ينافي عموم الإنذار لهم ولغيرهم كما يدل عليه قوله في الآيات السابقة : {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} [آية : 19] بل لما كان خوف الحشر إلى الله معينا لنفوسهم على القبول ومقربا للدعوة إلى أفهامهم أفاد تخصيص الأمر بالإنذار بهم ووصفهم هذا الوصف تأكيدا لدعوتهم وتحريضا له أن لا يسامح في أمرهم ولا يضعهم موضع غيرهم بل يخصهم بمزيد عناية بدعوتهم لأن موقفهم أقرب من الحق وإيمانهم أرجى فالآية بضميمة سائر آيات الأمر بالإنذار العام تفيد من المعنى : أن أنذر الناس عامة ولا سيما الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم .
وقوله : {لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ} نفي مطلق لولاية غير الله وشفاعته فيقيده الآيات الأخر المقيدة كقوله : {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة : 255] وقوله : {وَلا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى} [الأنبياء : 28] وقوله : {وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف - 86] .
وإنما لم يستثن في الآية لأن الكلام يواجه به الوثنيون الذين كانوا يقولون بولاية الأوثان وشفاعتها ، ولم يكونوا يقولون بذلك بالإذن والجعل فإن الولاية والشفاعة عن إذن يحتاج القول به إلى العلم به ، والعلم إلى الوحي والنبوة ، وهم لم يكونوا قائلين بالنبوة ، وأما الذي أثبتوه من الولاية والشفاعة فكأنه أمر متهيئ لأوليائهم وشركائهم بالضرورة من طبعها لا بإذن من الله كأن أقوياء الوجود من الخليقة لها نوع من التصرف في ضعفائه بالطبع وإن لم يأذن به الله سبحانه ، وإن شئت قلت : لازمه أن يكون إيجادها إذنا اضطراريا في التصرف في ما دونها .
وبالجملة قيل : {لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ} ولم يقل : إلا بإذنه لأن المشركين إنما قالوا إن الأوثان أولياء وشفعاء من غير تقييد فنفي ما ذكروه من الولي والشفيع من دون الله محاذاة بالنفي لإثباتهم ، وأما الاستثناء فهو وإن كان صحيحا كما وقع في مواضع من كلامه تعالى لكن لا يتعلق به غرض هاهنا .
وقد تبين مما تقدم أن الآية على إطلاق ظاهرها تأمر بإنذار كل من لا يخلو من استشعار خوف من الحشر في قلبه إذا ذكر بآيات الله سواء كان ممن يؤمن بالحشر كالمؤمنين من أهل الكتاب أو ممن لا يؤمن به كالوثنيين وغيرهم لكنه يحتمله فيغشى الخوف نفسه بالاحتمال أو المظنة فإن الخوف من شيء يتحقق بمجرد احتمال وجوده وإن لم يوقن بتحققه .
وقد اختلفت أنظار المفسرين في الآية فمن قائل : إن الآية نزلت في المؤمنين القائلين بالحشر ، وأنهم هم الذين عنوا في الآية التالية بقوله : {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِ} . ومن قائل : إنها نزلت في طائفة من المشركين الوثنيين يجوزون الحشر بعد الموت وإن لم يثبت وجود القائل بهذا القول بين مشركي مكة أو العرب يوم نزول السورة مع كون خطابات السورة متوجهة إلى المشركين من قريش أو العرب بحسب السياق . ، ومن قائل : إن المراد بهم كل معترف بالحشر من مسلم أو كتابي ، وإنما خص هؤلاء المعترفون بالأمر بالإنذار مع أن وجوب الإنذار عام لجميع الخلق لأن الحجة أوجب عليهم لاعترافهم بالمعاد .
لكن الآية لم تأخذ في وصفهم إلا الخوف من الحشر ، ولا يتوقف الخوف من الشيء على العلم بتحققه ولا الاعتراف بوجوده بل الشك ـ وهو الاحتمال المتساوي طرفاه ـ والمظنة وهي الإدراك الراجح على ما له من المراتب يجامع الخوف كالعلم وهو ظاهر .
فالآية إنما تحرض النبي (صلَّ الله عليه وآله) على إنذار كل من شاهد في سيماه علائم الخوف من أي طائفة كان لأن بناء الدعوة الدينية على أساس الحشر وإقامة المحاسبة على السيئة والحسنة والمجازاة عليهما ، وأدنى ما يرجى من تأثير الدعوة الدينية في واحد أن يجوزه فيخافه ، وكلما ازداد احتمال وقوعه ازداد الخوف وقوي التأثير حتى يتلبس باليقين وينتفي احتمال الخلاف بالكلية ، فهناك التأثير التام .
قوله تعالى : {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} إلى آخر الآية ظاهر السياق على ما يؤيده ما في الآية التالية : {وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} إلخ ، أن المشركين من قومه (صلَّ الله عليه وآله) اقترحوا عليه أن يطرد عن نفسه الضعفاء المؤمنين به فنهاه الله تعالى في هذه الآية عن ذلك .
وذلك منهم نظير ما اقترحه المستكبرون من سائر الأمم من رسلهم أن يطردوا عن أنفسهم الضعفاء والفقراء من المؤمنين استكبارا وتعززا ، وقد حكى الله تعالى ذلك عن قوم نوح فيما حكاه من محاجته عليه السلام حجاجا يشبه ما في هذه الآيات من الحجاج قال تعالى : {فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ * قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ ـ إلى أن قال ـ وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ ـ إلى أن قال ـ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً اللهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ} [هود ـ 31] .
والتطبيق بين هذه الآيات والآيات التي نحن فيها يقضي أن يكون المراد بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ويريدون وجهه هم المؤمنين ، وإنما ذكر دعاءهم بالغداة والعشي وهو صلاتهم أو مطلق دعائهم ربهم للدلالة على ارتباطهم بربهم بما لا يداخله غيره تعالى وليوضح ما سيذكره من قوله : {أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} .
وقوله : {يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} أي وجه الله ، قال الراغب في مفرداته : ، أصل الوجه الجارحة قال : {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} ، {وَتَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ} ، ولما كان الوجه أول ما يستقبلك وأشرف ما في ظاهر البدن استعمل في مستقبل كل شيء وفي أشرفه ومبدئه فقيل : وجه كذا ووجه النهار ، وربما عبر عن الذات بالوجه في قول الله : {وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ} ، قيل : ذاته وقيل أراد بالوجه هاهنا التوجه إلى الله بالأعمال الصالحة .
وقال : {فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} ، {كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} ، {يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ} ، {إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ} ، قيل : إن الوجه في كل هذا ذاته ويعني بذلك كل شيء هالك إلا هو وكذا في أخواته ، وروي أنه قيل ذلك لأبي عبد الله بن الرضا فقال : سبحان الله لقد قالوا قولا عظيما إنما عنى الوجه الذي يؤتى منه ومعناه : كل شيء من أعمال العباد هالك وباطل إلا ما أريد به الله ، وعلى هذا الآيات الأخر ، وعلى هذا قوله : {يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} ، {يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ} ، انتهى .
أقول : أما الانتقال الاستعمالي من الوجه بمعنى الجارحة إلى مطلق ما يستقبل به الشيء غيره توسعا فلا ريب فيه على ما هو المعهود من تطور الألفاظ في معانيها لكن النظر الدقيق لا يسوغ إرادة الذات من الوجه فإن الشيء أيا ما كان إنما يستقبل غيره بشيء من ظواهر نفسه من صفاته وأسمائه ، وهي التي تتعلق بها المعرفة فإنا إنما نعرف ما نعرف بوصف من أوصافه أو اسم من أسمائه ثم نستدل بذلك على ذاته من غير أن نماس ذاته مساسا على الاستقامة .
فإنا إنما ننال معرفة الأشياء أولا بأدوات الحس التي لا تنال إلا الصفات من أشكال وتخاطيط وكيفيات وغير ذلك من دون أن ننال ذاتا جوهرية ثم نستدل بذلك على أن لها ذوات جوهرية هي القيمة لأعراضها وأوصافها التابعة لما أنها تحتاج إلى ما يقيم أودها ويحفظها ففي الحقيقة قولنا : ذات زيد مثلا معناه الشيء الذي نسبته إلى أوصاف زيد وخواصه كنسبتنا إلى أوصافنا وخواصنا فإدراك الذوات إدراكا فكريا يكون دائما بضرب من القياس والنسبة .
وإذا لم يمكن إدراك الذوات الماهوية بإدراك تام فكري إلا من طريق أوصافها وآثارها بضرب من القياس والنسبة فالأمر في الله سبحانه ولا حد لذاته ولا نهاية لوجوده أوضح وأبين ، ولا يقع العلم على شيء إلا مع تحديد ما له فلا مطمع في الإحاطة العلمية به تعالى قال : {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ} [طه : 111] وقال : {وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً} [طه : 110] .
لكن وجه الشيء لما كان ما يستقبل به غيره كانت الجهة بمعنى الناحية أعني ما ينتهي إليه الإشارة وجها فإنها بالنسبة إلى الشيء الذي يحد الإشارة كالوجه بالنسبة إلى الإنسان يستقبل غيره به ، وبهذه العناية تصير الأعمال الصالحة وجها لله تعالى كما أن الأعمال الطالحة وجه للشيطان وهذا بعض ما يمكن أن ينطبق عليه أمثال قوله : {يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ} وقوله : {إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ} وغير ذلك ، وكذا الصفات التي يستقبل بها الله سبحانه خلقه كالرحمة والخلق والرزق والهداية ونحوها من الصفات الفعلية بل الصفات الذاتية التي نعرفه تعالى بها نوعا من المعرفة كالحياة والعلم والقدرة كل ذلك وجهه تعالى يستقبل خلقه بها ويتوجه إليه من جهتها كما يشعر به بعض الأشعار أو الدلالة قوله تعالى : {وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ} [الرحمن : 27] فإن ظاهر الآية أن قوله : {ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ} نعت للوجه دون الرب فافهم ذلك .
وإذا صح أن ناحيته تعالى جهته ووجهه صح بالجملة أن كل ما ينسب إليه تعالى نوعا من نسبة القرب كأسمائه وصفاته وكدينه ، وكالأعمال الصالحة وكذا كل من يحل في ساحة قربه كالأنبياء والملائكة والشهداء وكل مغفور له من المؤمنين وجه له تعالى .
وبذلك يتبين أولا : معنى قوله سبحانه : {وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ} [النحل : 96] وقوله : {وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ} [الأنبياء : 19] وقوله : {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ} [الأعراف : 206] ، وقوله فيمن يقتل في سبيل الله : {بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران : 169] وقوله : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ} [الحجر : 21] فالآيات تدل بانضمام الآية الأولى إليهن أن هذه الأمور كلها باقية ببقائه تعالى لا سبيل للهلاك والبوار إليها ، ثم قال تعالى : {كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [القصص : 88] فدل الحصر الذي في الآية على أن ذلك كله وجه لله سبحانه وبعبارة أخرى كلها واقعة في جهته تعالى مستقرة مطمئنة في جانبه وناحيته .
وثانيا : أن ما تتعلق به إرادة العبد من ربه هو وجهه كما في قوله : {يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْواناً} [المائدة : 2] وقوله : {ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ} [الإسراء : 28] وقوله : {وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} [المائدة : 35] فكل ذلك وجهه تعالى لأن صفات فعله تعالى كالرحمة والمرضاة والفضل ونحو ذلك من وجهه ، وكذلك سبيله تعالى من وجهه على ما تقدم ، وقال تعالى : {إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللهِ} [البقرة : 272] .
وقوله : {ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ} الحساب هو استعمال العدد بالجمع والطرح ونحو ذلك ، ولما كان تمحيص الأعمال وتقديرها لتوفية الأجر أو أخذ النتيجة ونحوهما لا يخلو بحسب العادة من استعمال العدد بجمع أو طرح سمي ذلك حسابا للأعمال .
وإذ كان حساب الأعمال لتوفية الجزاء ، والجزاء إنما هو من الله سبحانه فالحساب على الله تعالى أي في عهدته وكفايته كما قال : {إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى رَبِّي} [الشعراء : 113] ، وقال : {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ} [الغاشية : 26] وعكس في قوله : {إِنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً} [النساء : 86] للدلالة على سلطانه تعالى وهيمنته على كل شيء .
وعلى هذا فالمراد من نفي كون حسابهم عليه أو حسابه عليهم نفي أن يكون هو الذي يحاسب أعمالهم ليجازيهم حتى إذا لم يرتض أمرهم وكره مجاورتهم طردهم عن نفسه أو يكونوا هم الذين يحاسبون أعماله حتى إذا خاف مناقشتهم أو سوء مجازاتهم أو كرههم استكبارا واستعلاء عليهم طردهم ، وعلى هذا فكل من الجملتين : {ما عَلَيْكَ} إلخ ، (وما عليهم) إلخ ، مقصودة في الكلام مستقلة .
وربما أمكن أن يستفاد من قوله : {ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} نفي أن يحمل عليه حسابهم أي أعمالهم المحاسبة حتى يستثقله وذلك بإيهام أن للعمل ثقلا على عامله أو من يحمل عليه فالمعنى ليس شيء من ثقل أعمالهم عليك ، وعلى هذا فاستتباعه بقوله : {وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ} ـ ولا حاجة إليه لتمام الكلام بدونه ـ إنما هو لتتميم أطراف الاحتمال وتأكيد مطابقة الكلام ، ومن الممكن أيضا أن يقال : إن مجموع الجملتين أعني قوله : {ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ} كناية عن نفي الارتباط بين النبي (صلَّ الله عليه وآله) وبينهم من حيث الحساب .
وربما قيل : إن المراد بالحساب حساب الرزق دون حساب الأعمال والمراد : ليس عليك حساب رزقهم ، وإنما الله يرزقهم وعليه حساب رزقهم ، وقوله : {وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ} إلخ ، جيء به تأكيدا لمطابقة الكلام على ما تقدم في الوجه السابق ، والوجهان وإن أمكن توجيههما بوجه لكن الوجه هو الأول .
وقوله : {فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} الدخول في جماعة الظالمين متفرع على طردهم أي طرد الذين يدعون ربهم فنظم الكلام بحسب طبعه يقتضي أن يفرع قوله : {فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} ، على قوله في أول الآية : {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ} إلخ ، إلا أن الكلام لما طال بتخلل جمل بين المتفرع والمتفرع عليه أعيد لفظ الطرد ثانيا في صورة الفرع ليتفرع عليه قوله : {فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} بنحو الاتصال ويرتفع اللبس .
فلا يرد عليه أن الكلام مشتمل على تفريع الشيء على نفسه فإن ملخصه : ولا تطرد الذين يدعون ربهم فتطردهم ، وذلك أن إعادة الطرد ثانيا لإيصال الفرع أعني قوله : {فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} ، إلى أصله كما عرفت .
قوله تعالى : {وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا} إلى آخر الآية ، الفتنة هي الامتحان ، والسياق يدل على أن الاستفهام في قوله : {أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا} للتهكم والاستهزاء ، ومعلوم أنهم لا يسخرون إلا ممن يستحقرون أمره ويستهينون موقعه من المجتمع ، ولم يكن ذلك إلا لفقرهم ومسكنتهم وانحطاط قدرهم عند الأقوياء والكبرياء منهم .
فالله سبحانه يخبر نبيه أن هذا التفاوت والاختلاف إنما هو محنة إلهية يمتحن بها الناس ليميز به الكافرين من الشاكرين ، فيقول أهل الكفران والاستكبار في الفقراء المؤمنين : {أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا} فإن السنن الاجتماعية عند الناس توصف بما عند المستن بها من الشرافة والخسة ، وكذا العمل يوزن بما لعامله من الوزن الاجتماعي فالطريقة المسلوكة عند الفقراء والأذلاء والعبيد يستذلها الأغنياء والأعزة ، والعمل الذي أتى به مسكين أو الكلام الذي تكلم به عبد أو أسير مستذلا لا يعتني به أولو الطول والقوة .
فانتحال الفقراء والأجراء والعبيد بالدين ، واعتناء النبي بهم وتقريبه إياهم من نفسه كالدليل عند الطغاة المستكبرين من أهل الاجتماع على هوان أمر الدين وأنه دون أن يلتفت إليه من يعتني بأمره من الشرفاء والأعزة .
وقوله تعالى : {أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} جواب عن استهزائهم المبني على الاستبعاد ، بقولهم : {أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا} ومحصله أن هؤلاء شاكرون لله دونهم ولذلك قدم هؤلاء لمنه وأخرهم فكنى سبحانه عن ذلك بأن الله أعلم بالشاكرين لنعمته أي إنهم شاكرون ، ومن المسلم أن المنعم إنما يمن وينعم على من يشكر نعمته وقد سمى الله تعالى توحيده ونفي الشريك عنه شكرا في قوله حكاية عن قول يوسف عليه السلام : {ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ} [يوسف : 38] .
فالآية تبين أنهم بجهالتهم يبنون الكرامة والعزة على التقدم في زخارف الدنيا من مال وبنين وجاه ، ولا قدر لها عند الله ولا كرامة ، وإنما الأمر يدور مدار صفة الشكر والنعمة بالحقيقة هي الولاية الإلهية .
قوله تعالى : {وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ} إلى آخر الآية ، قد تقدم معنى السلام ، والمراد بكتابته الرحمة على نفسه إيجابها على نفسه أي استحالة انفكاك فعله عن كونه معنونا بعنوان الرحمة ، والإصلاح هو التلبس بالصلاح فهو لازم وإن كان بحسب الحقيقة متعديا وأصله إصلاح النفس أو إصلاح العمل .
والآية ظاهرة الاتصال بالآية التي قبلها يأمر الله سبحانه فيها نبيه (صلَّ الله عليه وآله) ـ بعد ما نهاه عن طرد المؤمنين عن نفسه ـ أن يتلطف بهم ويسلم عليهم ويبشر من تاب منهم عن سيئة توبة نصوحا بمغفرة الله ورحمته فتطيب بذلك نفوسهم ويسكن طيش قلوبهم .
ويتبين بذلك أولا : أن الآية ـ وهي من آيات التوبة ـ إنما تتعرض للتوبة عن المعاصي والسيئات دون الكفر والشرك بدليل قوله : {مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ} أي المؤمنين بآيات الله .
وثانيا : أن المراد بالجهالة ما يقابل الجحود والعناد اللذين هما من التعمد المقابل للجهالة فإن من يدعو ربه بالغداة والعشي يريد وجهه وهو مؤمن بآيات الله لا يعصيه تعالى استكبارا واستعلاء عليه بل لجهالة غشيته باتباع هوى في شهوة أو غضب .
وثالثا : أن تقييد قوله : {تابَ} بقوله : {وَأَصْلَحَ} للدلالة على تحقق التوبة بحقيقتها فإن الرجوع حقيقة إلى الله سبحانه واللواذ بجنابه لا يجامع لطهارة موقفه التقذر بقذارة الذنب الذي تطهر منه التائب الراجع ، وليست التوبة قول : (أتوب إلى الله) قولا لا يتعدى من اللسان إلى الجنان ، وقد قال تعالى : {وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ} [البقرة : 284] .
ورابعا : أن صفاته الفعلية كالغفور والرحيم يصح تقييدها بالزمان حقيقة فإن الله سبحانه وإن كتب على نفسه الرحمة لكنها لا تظهر ولا تؤثر أثرها إلا إذا عمل بعض عباده سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح .
وقد تقدم في الكلام على قوله تعالى : {إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ} إلى آخر الآيتين [النساء : 17] في الجزء الرابع من الكتاب ما له تعلق بالمقام .
قوله تعالى : {وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} تفصيل الآيات بقرينة المقام شرح المعارف الإلهية وتخليصها من الإبهام والاندماج ، وقوله : {وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} اللام فيه للغاية ، وهو معطوف على مقدر طوي عن ذكره تعظيما وتفخيما لأمره وهو شائع في كلامه تعالى ، كقوله : {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا} [آل عمران : 140] وقوله : {وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ} [انعام : 75] .
فالمعنى : وكذلك نشرح ونميز المعارف الإلهية بعضها من بعض ونزيل ما يطرأ عليها من الإبهام لأغراض هامة منها أن تستبين سبيل المجرمين فيتجنبها الذين يؤمنون بآياتنا ، وعلى هذا فالمراد بسبيل المجرمين السبيل التي يسلكها المجرمون قبال الآيات الناطقة بتوحيد الله سبحانه والمعارف الحقة التي تتعلق به وهي سبيل الجحود والعناد والإعراض عن الآيات وكفران النعمة .
وربما قيل إن المراد بسبيل المجرمين السبيل التي تسلك في المجرمين ، وهي سنة الله فيهم من لعنهم في الدنيا وإنزال العذاب إليه بالآخرة ، وسوء الحساب وأليم العقاب في الآخرة ، والمعنى الأول أوفق بسياق الآيات المسرودة في السورة .
_________________________
1. تفسير الميزان ، ج7 ، ص 80-90 .
قال تعالى : {قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ} [الانعام : 50] .
معرفة الغيب :
هذه الآية استمرار للردّ على اعتراضات الكفار والمشركين المختلفة ، والرد يشمل ثلاثة أقسام من تلك الاعتراضات في جمل قصيرة :
الأوّل : هو أنّهم كانوا يريدون من رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) القيام بمعجزات عجيبة وغريبة ، وكان كل واحد يتقدم باقتراح حسب رغبته ، بل إنّهم لم يكونوا يقنعون بمشاهدة معجزات طلبها آخرون ، فمرّة كانوا يطلبون بيوتا من ذهب ، ومرّة يريدون هبوط الملائكة ، ومرّة يريدون أن تتحول أرض مكّة القاحلة المحرقة إلى بستان مليء بالمياه والفواكه وغير ذلك ممّا كانوا يطلبونه من النّبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) ، ممّا سيأتي شرحه في تفسير الآية (90) من سورة الإسراء .
ولعلهم بطلباتهم الغريبة تلك كانوا يتوقعون أن يروا للنبي مقام الألوهية وامتلاك الأرض والسماء ، فللردّ على هؤلاء يأتي الأمر من الله : {قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ} .
«الخزائن» جمع الخزينة ، بمعنى المكان الذي تخزن فيه الأشياء التي يراد حفظها وإخفاؤها عن الآخرين ، واستنادا إلى الآية : {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ} [الحجر : 21]. يتّضح أنّ «خزائن الله» تشمل مصدر ومنبع جميع الأشياء ، وهي في الحقيقة تستقي من ذات الله اللامتناهية منبع جميع الكمالات والقدرات .
ثمّ تردّ الآية على الّذين كانوا يريدون من رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) أن يكشف لهم عن جميع أسرار المستقبل ، بل ويطلعهم على ما ينتظرهم من حوادث لكي يدفعوا الضرر ويستجلبوا النفع ، فتقول : {وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} .
سبق أن قلنا إنّه لا يكون أحد مطلعا على كل شيء إلّا إذا كان حاضرا وشاهدا في كل مكان وزمان ، وهو الله وحده ، أمّا الذي يكون وجوده محددا بمكان وزمان معينين فلا يمكن بالطبع أن يطلع على كل شيء ، ولكن ما من شيء يحول دون أن يمنح الله جزءا من عمله هذا إلى الأنبياء والقادة الإلهيين لإكمال مسيرة القيادة ، حسبما يراه من مصلحة ، وهذا بالطبع لا يكون علما بالغيب بالذات ، بل هو «علم بالغيب بالعرض» أي أنّه تعلم من عالم الغيب .
هنالك آيات عديدة في القرآن تدل على أنّ الله لا يظهر علمه هذا للأنبياء والقادة الإلهيين وحدهم ، بل قد يظهره لغيرهم أيضا ، ففي الآيتين (26 و 27) من سورة الجن نقرا : {عالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ} .
لا شك أنّ مقام القيادة ، وخاصة القيادة العالمية العامة ، يتطلب الاطلاع على كثير من المسائل الخافية على عامّة الناس ، فإذا لم يطلع الله مبعوثيه وأولياءه على علمه ، فإنّ مراكزهم القيادية لن تكون كاملة (تأمل بدقّة) .
وإذا تجاوزنا ذلك ، فإنّنا نلاحظ أنّ بعض الكائنات الحيّة لا بدّ لها أن تعلم الغيب للمحافظة على حياتها ، فيهبها الله ما تحتاجه من علم ، فنحن ـ مثلا ـ قد سمعنا عن بعض الحشرات التي تتنبأ في الصيف بما سيكون عليه الجو في الشتاء ، أي أنّ الله قد وهبها هذا العلم بالغيب ، لأنّ حياتها ستتعرض لخطر الفناء دون هذه المعرفة ، وسوف نفصل هذه الموضوع أكثر إن شاء الله عند تفسير الآية (188) من سورة الأعراف .
في الجملة الثّالثة ردّ على الذين كانوا يتصورون النّبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) ملكا ، أو أن يصاحبه ملك ، وان لا يتصف بما يتصف به البشر من تناول الطعام والسير في الطرقات ، وغير ذلك ، فقال : {وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ} .
يتّضح من هذه الآية بجلاء أن كل ما عند رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) من علم ، وكل ما فعله كان بوحي من السماء ، وإنّه لم يكن يفعل شيئا باجتهاده ولا بالعمل بالقياس ولا بأي شيء آخر كما يرى بعض ـ وإنّما كان يتبع الوحي في كل أمر من أمور الدين .
وفي الختام يؤمر رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) أنّ يقول لهم : هل يمكن للذين يغمضون أعينهم ويغلقون عقولهم فلا يفكرون أن ينظر إليهم على قدم المساواة مع الذين يرون الحقائق جيدا ويتفهمونها؟ {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ} .
إنّ ذكر هذه الجملة في أعقاب الجملات الثلاث السابقة قد يكون لأنّ رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) سبق أن قال : {لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ} و {وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ} و {لا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} بل {إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَ} ، ولكن هذا كلّه لا يعني إنّني مثلكم ، أيّها المشركون ، بل أنا إنسان بصير بالواقع بينما المشرك أشبه بالأعمى ، فهل يستويان ؟
ثمّة احتمال آخر لربط هذه الجمل ، وهو أن الأدلة والبراهين على التوحيد وعلى صدق رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) واضحة جلية ، ولكنّها تتطلب عينا بصيرة لكي تراها ، فإذا كنتم لا تقبلونها فليس لأنها أدلة غامضة معقدة ، بل لكونكم تفتقرون إلى العين البصيرة ، فهل يستوي الأعمى والبصير؟
* * *
{وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأنعام : 51] .
في ختام الآية السابقة ذكر سبحانه عدم استواء الأعمى بالبصير ، وفي هذه الآية يأمر نبيّه أن ينذر الذين يخشون يوم القيامة {وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلى رَبِّهِمْ} أي أن هؤلاء لهم هذا القدر من البصيرة بحيث يحتملون وجود حساب وجزاء ، وفي ضوء هذا الاحتمال والخوف من المسؤولية تتولّد فيهم القابلية على التلقّي والقبول .
سبق أن قلنا : إنّ وجود القائد المؤهل والبرنامج التربوي الشامل لا يكفيان وحدهما لهداية الناس ، بل ينبغي أن يكون لدى هؤلاء الناس الاستعداد لتقبل الدعوة ، تماما مثل أشعة الشمس التي لا تكفي وحدها لتشخيص معالم الطريق ، بل لا بدّ من وجود العين الباصرة أيضا ، ومثل البذرة السليمة التي لا يمكن أن تنمو بغير وجود الأرض الصالحة للزراعة .
يتّضح من هذا أنّ الضمير في «به» يعود على القرآن ، وهذا يتبيّن من القرائن ، على الرغم من أنّ القرآن لم يذكر في الآيات السابقة صراحة .
كما أنّ المقصود من «يخافون» أي يحتملون وجود الضرر ، إذ يخطر ببال كل عاقل يستمع إلى دعوة الأنبياء الإلهيين ، بأنّ من المحتمل أن تكون دعوة هؤلاء صادقة ، وأنّ الإعراض عنها يوجب الخسران والضرر ، ويستنتج من ذلك أنّ من الخير له أن يدرس الدعوة ويطلع على الأدلة .
وهذا واحد من شروط الهداية ، وهو ما يطلق عليه علماء العقائد اسم «لزوم دفع الضرر المحتمل» ويعتبرونه دليل وجوب دراسة دعوى من يدعي النّبوة ، ولزوم المطالعة لمعرفة الله .
ثمّ يقول : إنّ أمثال هؤلاء من ذوي القلوب الواعية يخافون ذلك اليوم الذي ليس فيه غير الله ملجأ ولا شفيع : {لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلا شَفِيعٌ} .
نعم ، أنذر أمثال هؤلاء الناس وادعهم إلى الله ، إذ أنّ الأمل في هدايتهم موجود : {لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} .
بديهي أنّ نفي «الشفاعة» و «الولاية» في هذه الآية عن غير الله لا يتناقض مع شفاعة أولياء الله وولايتهم ، إذ إنّنا سبق أن أشرنا إلى أنّ المقصود هو نفي الشفاعة والولاية بالذات ، أي أنّ هذين الأمرين مختصان ذاتا بالله ، فإذا كان لأحد غيره مقام الشفاعة والولاية فبإذن منه وبأمره ، كما يصرح القرآن بذلك : {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة : 255] .
للمزيد من التوضيح بشأن الشفاعة عموما ، انظر المجلد الأوّل : ص 198 . والمجلد الثّاني من هذا التّفسير .
{وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ * وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام : 52-53] .
مكافحة التّفكير الطّبقي :
في هذه الآية إشارة إلى واحد من احتجاجات المشركين ، وهو أنّهم كانوا يريدون من النّبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) أن يقرّ ببعض الامتيازات لطبقة الأغنياء ويفضلهم على طبقة الفقراء ، إذ كانوا يرون في جلوسهم مع الفقراء من أصحاب رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) منقصة لهم أي منقصة! مع أنّ الإسلام كان قد جاء للقضاء على مثل هذه الامتيازات الزائفة الجوفاء ، كانوا يصرون على هذا الطلب في طرد أولئك عنه ، غير أنّ القرآن ردّ هذا الطلب مستندا إلى أدلة حية ، فيقول : {وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} (2) .
وممّا يلفت النظر أنّ القرآن لم يشر إلى هؤلاء الأشخاص إشارة خاصّة ، بل اكتفى بصفتهم البارزة وهي أنّهم يذكرون الله صباح مساء ، أي دائما ، وانّ ذكرهم الله هذا ليس فيه رياء ، بل هو لذات الله وحده ، فهم يريدونه وحده ويبحثون عنه ، وليس ثمّة امتياز اسمى من هذا .
يتبيّن من آيات قرآنية مختلفة أنّ هذا لم يكن أوّل طلب من نوعه يتقدم به هؤلاء المشركون الأغنياء المتكبرون إلى رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) ، بل لقد تكرر اعتراضهم على النّبي بشأن اجتماع الفقراء حوله ، ومطالبتهم إياه بطردهم .
في الحقيقة كان هؤلاء يستندون في طلبهم ذاك إلى سنة قديمة خاطئة تقيم المرء على أساس ثروته ، وكانوا يعتقدون أنّ المعايير الطبقية القائمة على أساس الثروة يجب أن تبقى محفوظة ، ويرفضون كل دعوة تستهدف إلغاء هذه القيم والمعايير .
في سيرة النّبي نوح عليه السلام نرى أنّ أشراف زمانه كانوا يقولون له : {وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ} [هود : 27] واعتبروا ذلك دليلا على بطلان رسالته .
إنّ واحدا من دلائل عظمة الإسلام والقرآن ، وعظمة مدرسة الأنبياء عموما ، هو أنّها وقفت ثابتة لا تتزحزح في وجه أمثال هذه الطلبات ، وراحت تحطم هذه الامتيازات الموهومة في كل المجتمعات التي تعتبر التمايز الطبقي مسألة ثابتة ، لتعلن أنّ الفقر ليس نقصا في أشخاص مثل سلمان وأبي ذر والخباب وبلال ، كما أنّ الثروة ليست امتيازا اجتماعيا ، أو معنويا لهؤلاء الأثرياء الفارغين المتحجرين المتكبرين .
ثمّ تقول الآية : إنّه ليس ثمّة ما يدعو إلى إبعاد هؤلاء المؤمنين عنك ، لأنّ حسابهم ليس عليك ، ولا حسابك عليهم : {ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ} ، ولكنّك مع ذلك إذا فعلت تكون ظالما : {فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} .
يختلف المفسّرون في توضيح المقصود من «الحساب» هنا .
منهم من يقول : إنّ المقصود هو حساب رزقهم ، أي أنّهم وإن كانوا فقراء فإنّهم لا يثقلون عليك بشيء ، لأنّ حساب رزقهم على الله ، كما أنّك أنت أيضا لا تحملهم ثقل معيشتك ، إذ ليس من حساب رزقك عليهم من شيء .
غير أنّ هذا الاحتمال يبدو بعيدا ، لأن الظاهر أن القصد من الحساب هو حساب الأعمال ، كما يقول كثير من المفسّرين ، أمّا لماذا يقول الله أن حساب أعمالهم ليس عليك ، مع أنّهم لم يبدر منهم أي عمل سيء يستوجب هذا القول؟ فالجواب : إنّ المشركين كانوا يتهمون أصحاب رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) الفقراء بالابتعاد عن الله بسبب فقرهم ، زاعمين أنّهم لو كانت أعمالهم مقبولة عند الله لزمه الترفيه والتوسعة عليهم في معيشتهم ، بل كانوا يتهمونهم بأنّهم لم يؤمنوا إلّا لضمان معيشتهم والوصول إلى لقمة العيش .
فيرد القرآن على ذلك مبينا أنّنا حتى لو فرضنا أنّهم كذلك ، فان حسابهم على الله ، ما دام هؤلاء قد آمنوا وأصبحوا في صفوف المسلمين ، فلا يجوز طردهم بأي ثمن ، وبهذا يقف في وجه احتجاج أشراف قريش .
وشاهد هذا التّفسير ما جاء في حكاية النّبي نوح عليه السلام التي تشبه حكاية أشراف قريش ، فأولئك كانوا يقولون لنوح : {أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} فيرد عليهم نوح قائلا : {وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ، وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ} [الشعراء : 111-114] .
من هنا يجب على الأنبياء أن يتقبلوا كل امرئ يظهر الإيمان بدون أي تمييز ومن أية طبقة كان فكيف بالمؤمنين الأطهار الذين لا يريدون إلّا وجه الله ، وكل ذنبهم هو أنّهم فقراء صفر اليدين من الثروة ، ولم يتلوثوا بالحياة الدنيئة لطبقة الأشراف !
امتياز كبير للإسلام :
إنّنا نعلم أنّ دائرة صلاحيات رجال الدين المسيحيين المعاصرين قد اتسعت اتساعا مضحكا بحيث إنّهم أعطوا أنفسهم حق غفران الذنوب ، فبإمكانهم طرد الأشخاص وتكفيرهم أو قبولهم لأتفه الأمور .
إلّا أنّ القرآن ، في هذه الآية وفي آيات أخرى ينفي صراحة أن يكون لأحد الحقّ ، بل ولا لرسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) نفسه في أن يطرد أحدا أظهر إيمانه ولم يفعل ما يوجب إخراجه من الإسلام ، وأن غفران الذنوب والحساب بيد الله وحده ، ولا يحق لأحد التدخل في هذا أبدا .
والكلام هنا على «الطرد الديني» لا «الطرد الحقوقي» فلو كانت إحدى المدارس وقفا على طبقة خاصّة من الطلاب ، وقبل أحدهم فيها لتوفر شروط القبول فيه ، ثمّ فقد بعض تلك الشروط ، فان طرده وإخراجه من تلك المدرسة لا مانع فيه ، كذلك لو أنّ مدير مدرسة أعطيت له صلاحيات معينة لغرض إدارة شؤونها ، فله كل الحقّ في الاستفادة من تلك الصلاحيات لحفظ النظام ورعاية مصالح المدرسة (فما ورد في حديث صاحب تفسير المنار عند تفسيره الآية ممّا يخالف هذا المعنى ناشئ من الاشتباه بين الطرد الديني والطرد الحقوقي) .
الآية الثّانية يحذر فيها القرآن أصحاب المال والثروة من أن هذه الأمور اختبار لهم ، فإذا لم يجتازوا الامتحان فعليهم أن يتحملوا العواقب المؤلمة ، فالله يمتحن بعضهم ببعض : {وَكَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} .
«الفتنة» تعني هنا الامتحان (3) وأي امتحان أصعب ممّا يمر به الأغنياء الذين كانوا قد اعتادوا لسنوات طويلة على الترفع على الطبقات الدنيا ، فلا يشاركونهم أفراحهم وأتراحهم ، بل حتى أنّهم يبعدون قبور موتاهم عن قبورهم ، أمّا الآن فيطلب منهم أن يتخلوا عن كل ذلك وأن يحطموا كل تلك العادات والسنن ، ويكسروا القيود والسلاسل ليلتحقوا بدين طلائعه من الفقراء ومن يسمون بالطبقة الدنيا .
ثمّ تضيف الآية أنّ الأمر يصل بهؤلاء إلى أنّهم ينظرون إلى المؤمنين الصادقين نظرة احتقار {لِيَقُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا} (4) ؟!
ثمّ تجيب الآية على المعترضين مؤكدة أنّ هؤلاء الأشخاص أناس شكروا نعمة التشخيص الصحيح بالعمل ، كما أنّهم شكروا نعمة دعوة رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) بقبولها ، فأي نعمة أكبر ، وأي شكر أرفع ، ولذلك رسخ الله الإيمان في قلوبهم : {أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} .
{وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} [الأنعام : 54-55] .
يرى بعض المفسّرين أنّ الآية نزلت بشأن الذين نهت الآيات السابقة عن طردهم وإبعادهم ، ويرى بعض آخر أنّها نزلت في فريق من المذنبين قدموا على رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) وقالوا : إنّهم قد أذنبوا كثيرا ، فسكت النّبي (صلَّ الله عليه وآله وسلم) حتى نزلت الآية .
ومهما يكن سبب نزول الآية ، فالذي لا شك فيه أنّ معناها واسع وشامل ، لأنّها تبدأ أوّلا بالطلب من رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) أن لا يطرد المذنبين مهما عظمت ذنوبهم ، بل عليه أن يستقبلهم ويتقبلهم : {وَإِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ} .
يحتمل أن يكون هذا السّلام من الله بوساطة رسوله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) ، أو أنّه من الرّسول (صلَّ الله عليه وآله وسلم) مباشرة ، وهو ـ على كلا الاحتمالين دليل على القبول والترحيب والتفاهم والمحبّة .
ثمّ تقول الآية {كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ} .
«كتب» تأتي في كثير من الأحيان كناية عن الإلزام والتعهد ، إذ إنّ من نتائج الكتابة توكيد الأمر وثبوته .
وفي الجزء الأخير من الآية ـ وهو توضيح وتفسير لرحمة الله ـ يتحدث بلهجة عاطفية : {أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .
وقد سبق القول (5) أنّ «الجهالة» في مثل هذه المواضع تعني طغيان الشهوة وسيطرتها ، والإنسان بسبب هذه الأهواء المستفحلة ، لا بسبب عدائه لله وللحق ـ يفقد المقدرة العقيلة والسيطرة على الشهوات ، مثل هذا الشخص ـ وإن كان عالما بالذنب والحرمة ـ يسمى جاهلا ، لأنّ علمه مستتر وراء حجب الأهواء والشهوات ، وهذا الشخص مسئول عن ذنوبه ، ولكنّه يسعى لإصلاح نفسه وجبران أخطائه لأنّ أفعاله لم تكن عن روح عداء وخصام .
تأمر الآية رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) أن لا يطرد أي شخص مؤمن مهما تكن طبقته وظروفه وعنصره ، بل عليه أن ينظر إلى الجميع بعين المساواة ، وأن يحتضنهم ويعمل على إصلاحهم حتى وإن كانوا ملوثين بالذنوب .
الآية التّالية ومن أجل توكيد هذا الموضوع تشير إلى أنّ الله سبحانه يوضح آياته وأوامره توضيحا بيّنا لكي يتبيّن طريق الباحثين عنه والمطيعين له ، كما يتبيّن طريق الآثمين المعاندين من أعداء الله : {وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ} (6) .
من الواضح في هذه الآية أنّ «المجرم» ليس كل مذنب ، لأنّ رسول الله (صلَّ الله عليه وآله وسلم) مكلّف في هذه الآية أن يتقبل المذنبين الذين يقبلون عليه ، مهما يكن جرمهم الذي ارتكبوه عن جهل ، وعليه فان المجرمين هنا هم أولئك المذنبون المعاندون الذين لا يستسلمون للحق .
أي بعد هذه الدعوة العامّة إلى الله ، التي تشمل حتى المجرمين النادمين يتّضح بشكل كامل طريق المعاندين الذين لا يرجعون عن عنادهم .
_________________________
1. تفسير الأمثل ، ج4 ، ص 81-92 .
2. معنى «الوجه» في اللغة معروف ، ولكن الكلمة قد تعني «الذات» كما في هذه الآية ، وهناك شرح أوفى لذلك في المجلد الثاني من هذا التفسير .
3. لمزيد من الشرح انظر المجلد الثّاني في تفسير الآيتين 191 و 193 من سورة البقرة .
4. أشرنا في تفسير الآية 164 من سورة آل عمران إلى أنّ «المنة» تعني في الأصل النعمة يهبها الله .
5. المجلد الثّالث من هذا التّفسير .
6. جملة «ولتستبين» معطوفة في الواقع على جملة محذوفة تدرك بالقرينة ، فيكون المعنى لتستبين سبيل المؤمنين المطيعين ولتستبين سبيل المجرمين .
 الاكثر قراءة في سورة الأنعام
الاكثر قراءة في سورة الأنعام
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)