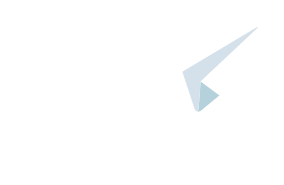تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير الاية (20-24) من سورة الحديد
المؤلف:
اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
22-9-2017
2812
قال تعالى : {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} [الحديد: 20 - 24].
زهد سبحانه المؤمنين في الدنيا والركون إلى لذاتها فقال {اعلموا أنما الحياة الدنيا} يعني أن الحياة في هذه الدار الدنيا {لعب ولهو} أي بمنزلة اللهو واللعب إذ لا بقاء لذلك ولا دوام ويزول عن وشيك كما يزول اللهو واللعب قال مجاهد كل لعب لهو وقيل اللعب ما رغب في الدنيا واللهو ما ألهى عن الآخرة.
{وزينة} تتزينون بها في الدنيا وقيل أراد بذلك أنها تتحلى في أعين أهلها ثم تتلاشى {وتفاخر بينكم} أي يفاخر الرجل بها قرينة وجاره عن ابن عباس {وتكاثر في الأموال والأولاد} قال يجمع ما لا يحل له تكاثرا به ويتطاول على أولياء الله بماله وولده وخدمه والمعنى أنه يفني عمره في هذه الأشياء ثم بين سبحانه لهذه الحياة شبها فقال {كمثل غيث} أي مطر {أعجب الكفار نباته} أي أعجب الزراع ما ينبت من ذاك الغيث قال الزجاج ويجوز أن يكون المراد الكفار بالله لأن الكافر أشد إعجابا بالدنيا من غيره {ثم يهيج} أي يبيس {فتريه مصفرا} وهو إذا قارب اليبس {ثم يكون حطاما} يتحطم ويتكسر بعد يبسه وشرح هذا المثل قد تقدم في سورة يونس {وفي الآخرة عذاب شديد} لأعداء الله عن مقاتل {ومغفرة من الله ورضوان} لأوليائه وأهل طاعته {وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور} لمن اغتر بها ولم يعمل لآخرته قال سعيد بن جبير متاع الغرور لمن لم يشتغل بطلب الآخرة ومن اشتغل بطلبها فهي له متاع بلاغ إلى ما هو خير منه وقيل معناه والعمل للحياة الدنيا متاع الغرور وأنه كهذه الأشياء التي مثل بها في الزوال والفناء .
ثم رغب سبحانه في المسابقة لطلب الجنة فقال {سابقوا} أي بادروا العوارض القاطعة عن الأعمال الصالحة وسارعوا إلى ما يوجب الفوز في الآخرة {إلى مغفرة من ربكم} قال الكلبي إلى التوبة وقيل إلى الصف الأول وقيل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) {وجنة عرضها كعرض السماء والأرض} أي وسابقوا إلى استحقاق ثواب جنة هذه صفتها وذكر في ذكر العرض دون الطول وجوه {أحدها} أن عظم العرض يدل على عظم الطول {والآخر} أن الطول قد يكون بلا عرض ولا يكون عرض بلا طول {وثالثها} أن المراد به أن العرض مثل السماوات والأرض وطولها لا يعلمه إلا الله تعالى قال الحسن أن الله يفني الجنة ثم يعيدها على ما وصفه فلذلك صح وصفها بأن عرضها كعرض السماء والأرض وقال غيره إن الله قال عرضها كعرض السماء والأرض والجنة المخلوقة في السماء السابعة فلا تنافي.
{أعدت للذين آمنوا} أي ادخرت وهيئت للمؤمنين {بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء} معناه أنه يجزي الدائم الباقي على القليل الفاني ولو اقتصر في الجزاء على قدر ما يستحق بالأعمال كان عدلا منه لكنه تفضل بالزيادة وقيل معناه أن أحدا لا ينال خيرا في الدنيا
والآخرة إلا بفضل الله فإنه سبحانه لو ولم يدعنا إلى الطاعة ولم يبين لنا الطريق ولم يوفقنا للعمل الصالح لما اهتدينا إليه وذلك كله من فضل الله وأيضا فإنه سبحانه تفضل بالأسباب التي يفعل بها الطاعة من التمكين والألطاف وكمال العقل وعرض المكلف للثواب فالتكليف أيضا تفضل وهو السبب الموصل إلى الثواب وقال أبو القاسم البلخي والبغداديون من أهل العدل إن الله سبحانه وتعالى لو اقتصر لعباده في طاعاتهم على مجرد إحساناته السالفة إليهم لكان عدلا فلهذا جعل سبحانه الثواب والجنة فضلا وفي هذه الآية أعظم رجاء لأهل الإيمان لأنه ذكر أن الجنة معدة للمؤمنين ولم يذكر مع الإيمان شيئا آخر.
{والله ذو الفضل العظيم} أي ذو الإفضال العميم والإحسان الجسيم إلى عباده ثم قال {ما أصاب من مصيبة في الأرض} مثل قحط المطر وقلة النبات ونقص الثمرات {ولا في أنفسكم} من الأمراض والثكل بالأولاد {إلا في كتاب} يعني إلا وهو مثبت مذكور في اللوح المحفوظ {من قبل أن نبرأها} قبل أن أي من يخلق الأنفس ليستدل ملائكته به على أنه عالم لذاته يعلم الأشياء بحقائقها {إن ذلك على الله يسير} أي إثبات ذلك على كثرته هين على الله يسير سهل غير عسير.
ثم بين سبحانه لم فعل لذلك فقال {لكيلا تأسوا على ما فاتكم} أي فعلنا ذلك لئلا تحزنوا على ما يفوتكم من نعم الدنيا {ولا تفرحوا بما آتاكم} أي بما أعطاكم الله منها والذي يوجب نفي الأسى والفرح من هذا أن الإنسان إذا علم أن ما فأت منها ضمن الله تعالى عليه العوض(2) في الآخرة فلا ينبغي أن يحزن لذلك وإذا علم أن ما ناله منها كلف الشكر عليه والحقوق الواجبة فيه فلا ينبغي أن يفرح به وأيضا فإذا علم أن شيئا منها لا يبقى فلا ينبغي أن يهتم له بل يجب أن يهتم لأمر الآخرة التي تدوم ولا تبيد.
وفي هذه الآية إشارة إلى أربعة أشياء {الأول} حسن الخلق لأن من استوى عنده وجود الدنيا وعدمها لا يحسد ولا يعادي ولا يشاح فإن هذه من أسباب سوء الخلق وهي من نتائج حب الدنيا {وثانيها} استحقار الدنيا وأهلها إذا لم يفرح بوجودها ولم يحزن لعدمها {وثالثها} تعظيم الآخرة لما ينال فيها من الثواب الدائم الخالص من الشوائب {ورابعها} الافتخار بالله دون أسباب الدنيا ويروى أن علي بن الحسين (عليهما السلام) جاءه رجل فقال له ما الزهد فقال الزهد عشرة أجزاء فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضاء وإن الزهد كله في آية من كتاب الله {لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم} وقيل لبزرجمهر ما لك أيها الحكيم لا تأسف على ما فأت ولا تفرح بما هو آت فقال إن الفائت لا يتلافى بالعبرة والآتي لا يستدام بالخبرة وعن عبد الله بن مسعود قال لئن(3) جمرة الحسرة أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقت أحب إلي من أن أقول لشيء كان ليته لم يكن أو لشيء لم يكن ليته كان.
{والله لا يحب كل مختال فخور} أي متكبر بما أوتي فخور على الناس بالدنيا {الذين يبخلون} بمنع الواجبات {ويأمرون الناس بالبخل} وفي الحديث أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) سأل عن سيد بني عوف فقالوا جد بن قيس على أنه يزن بالبخل فقال (صلى الله عليه وآله وسلّم) وأي داء أدوى من البخل سيدكم البراء بن معرور ومعنى يزن يتهم ويقرف {ومن يتول} أي يعرض عما دعاه الله إليه {فإن الله هو الغني} عنه وعن طاعته وصدقته {الحميد} في جميع أفعاله .
______________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج9 ، ص396-400.
2- في المخطوطة بدل عله العوض في الاخرة : العوض في غيره.
3- في نسخة لان الحس جمرة .. وفي اخرى : لان الحسن جمرات حرقت . وفي اخرى ايضا : لان الحسن جمرة احرقت.
قال تعالى : {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ ولَهْو وزِينَةٌ وتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وتَكاثُرٌ فِي الأَمْوالِ والأَوْلادِ} .
تقدم مثله في العديد من الآيات ، منها الآية 32 من سورة الانعام . . والدنيا المذمومة في كتاب اللَّه وعلى لسان أنبيائه هي التي تطلب للشهوات والملذات ، وللزهو واللهو، وللكبرياء والخيلاء ، أما الدنيا التي تقضى بها حوائج المحتاجين ، وتدفع بها ظلامة المظلومين ، وينتفع بها عباد اللَّه وعياله فهي من الآخرة لا من الدنيا المذمومة ، ومن تتبع آي الذكر الحكيم يجد أن ثواب اللَّه وقف على من آمن وعمل صالحا في هذه الحياة ، وأدى الحقوق والواجبات ، وانه لا وسيلة إلى السعادة الأخرى إلا العمل النافع في الحياة الدنيا .
{كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً} .
هذا الوصف يصلح للدنيا لأنها لا تدوم على حال . . انها تخضر وتصفر ، وتقسو وتلين ، وتعطي وتمنع . . ولو أعطت الإنسان كل ما أحب وأراد فإنها عما قليل تسلبه كل شيء حتى نفسه وأهله . . وأيضا يصلح هذا الوصف للإنسان في الحياة الدنيا . . انه يشب ويقوى عظمه ويشتد لحمه ، وينضر لونه . . ثم يدب فيه الوهن فيذوب منه اللحم ، ويدق العظم ، ويصفر اللون ، وينتقل في كل يوم من سئ إلى أسوأ حتى يتحطم ويضمحل . . وإذا كان هذا شأن الدنيا ، وشأن الإنسان فيها فأولى له ثم أولى ان يعمل لحياة دائمة لا يفنى نعيمها ولا يهرم مقيمها .
{وفِي الآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ ومَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ ورِضْوانٌ} . بعد أن ذكر سبحانه ان الدنيا لا يدوم لها رخاء ولا عناء ذكر ان الآخرة ثابتة على وتيرة واحدة . نعيمها
دائم ، وجحيمها دائم ، لأن سبب النعيم رضوان اللَّه ، وسبب الجحيم غضبه تعالى ، وكل منهما قائم بقيام سببه {ومَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ} . نقل الرازي عن الصحابي الجليل سعيد بن جبير انه قال عند تفسير هذه الآية :
{الدنيا متاع الغرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة ، أما إذا دعتك إلى طلب رضوان اللَّه وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة} . وهذا الصحابي من تلامذة الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) المقربين .
{سابِقُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وجَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ والأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ ورُسُلِهِ} . المراد بالمغفرة هنا سببها كالتوبة والعمل الصالح .
وقال بعض المفسرين : إذا كان عرضها كذلك فما ظنك بطولها ؟ . وقال آخر :
ان المراصد الحديثة كشفت ان أبعاد الكون لا حدود لها ، وعليه فالمراد العرض حقيقة لا مجازا ! . . وبالرغم من هذا الكشف فنحن لا نفهم من العرض هنا إلا التعبير عن عظمة الجنة وسعتها لا تقدير مساحتها حقيقة . وتقدم مثله في الآية 33 من سورة آل عمران ج 2 ص 156 {ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ واللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} على الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ، وليس من شك ان الطاعة سبب للمزيد من فضله ، بل هي السبب لفضله ورضوانه في يوم الفصل .
{ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ ولا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} . ضمير نبرأها يعود إلى أنفسكم ، والمعنى الظاهر من هذه الآية ان المصائب بكاملها هي من اللَّه سواء أكانت من نوع الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات ، أم كانت اجتماعية كالحروب والفقر والعدوان . .
وهذا غير مراد قطعا بحكم الوحي والعقل ، وفيما يلي التوضيح :
المصائب وصاحب الظلال :
قال صاحب الظلال عند تفسير هذه الآية : {اللفظ على إطلاقه اللغوي لا يختص بخير أو بشر فكل مصيبة تقع في الأرض كلها وفي النفس البشرية أو المخاطبين هي في ذلك الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس} .
وتسأل : صاحب الظلال : إذا كنت تعتمد حقا على ظاهر اللفظ وإطلاقه اللغوي فلما ذا لم تعتمد على ظاهر اللفظ وإطلاقه ، وأنت تفسر هذه الآية : {وما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} - 30 الشورى ؟ وهل نسيت انك قلت في تفسيرها ما نصه بالحرف الواحد : {فكل مصيبة تصيب الإنسان لها سبب مما كسبت يداه - المجلد السابع الجزء الخامس والعشرون من القرآن الكريم ص 38 وهل تعتمد على الظاهر من كل آية وإطلاقها اللغوي الحقيقي حتى ولوكان بين الآيتين تناقض بحسب الظاهر والإطلاق اللغوي ؟ وأيضا هل تعتمد على هذا الظاهر إذا اصطدم مع حكم العقل والواقع ودل على ان للَّه يدا ووجها وسمعا وبصرا ؟ .
وهل الصهيونية والاستعمار اللذين هما مصدر المصائب والأدواء في هذا العصر ، هل هما من اللَّه لا من الصهاينة والمستعمرين ؟ .
ان التناقض بين الآيات حقيقة وواقعا وتصادم إحداها مع حكم العقل - مستحيل على القرآن وفي القرآن . . كيف وهومن لدن حكيم عليم ؟ فإذا تصادم ظاهر آية مع آية أخرى أو مع حكم العقل علمنا ان هذا الظاهر على إطلاقه غير مراد للَّه تعالى ، وانه انما أطلق اللفظ اتكالا على ما عرف من عادته في التعبير كتعبيره عن اليهود والنصارى بأهل الكتاب ، أو على ما هو معروف بحكم العقل كالتعبير عن قدرته تعالى باليد أو على آية أخرى من كلامه كآية الشورى التي تقول :
{وما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} والآية 117 من سورة آل عمران :
ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ ولكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} والآية 41 من سورة الروم : {ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ والْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ} . فإن هذه الآية وما في معناها قرينة قاطعة على ان الإطلاق اللغوي في آية سورة الحديد غير مراد ، وان اللَّه سبحانه قد أطلق في سورة الحديد اتكالا على ما قاله في سورة الشورى وسورة آل عمران وسورة الروم ، وعليه فالمراد بمصيبة الأرض في سورة الحديد الكوارث الطبيعية كالزلازل وبمصيبة النفس بعض الأمراض التي لا تجدي معها وقاية ولا حذر ، ونحو ذلك ، أما آيات الشورى وآل عمران والروم فالمراد بها المصائب التي هي من صنع الإنسان لا من صنع الرحمن كالظلم والحرب والجوع .
{لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ} . قال الإمام علي (عليه السلام) :
الزهد كله بين كلمتين من القرآن ، ثم تلا هذه الآية وقال : {ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه} . وما من أحد إلا ويحزن ويفرح حتى الأنبياء ، والقصد من النهي أن لا يدخله الفرح في باطل ، ولا يخرجه الحزن عن الحق ، فقد ثبت عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) انه قال عند موت ولده إبراهيم : {تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون} .
{واللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ} . ولا شيء أدل على الجهل من الكبرياء والمباهاة . وفي نهج البلاغة : ما لابن آدم والفخر ؟ أوله نطفة ، وآخره جيفة ، لا يرزق نفسه ، ولا يدفع حتفه ! {الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ويَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ} . البخيل جبان ولئيم ، أما من بخل وأمر الناس بالبخل فهومن المعنيين بقوله تعالى :
{مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِكَ زَنِيمٍ} - 13 القلم . العتل الجاف والزنيم الدعي . قال الرازيّ هذه صفة اليهود . {ملاحظة توفي الرازي سنة 606 ه} .
وتقدم مثله في الآية 37 (النساء) ج 2 ص 323 {ومَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهً هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} .
لا يضر البخيل إلا نفسه ، واللَّه سبحانه لا تضره معصية من عصى ، ولا تنفعه طاعة من أطاع . وتقدم مثله في الآية 38 من سورة محمد .
__________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج7 ، ص251-254.
قوله تعالى: {اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد} إلخ، اللعب عمل منظوم لغرض خيالي كلعب الأطفال، واللهو ما يشغل الإنسان عما يهمه، والزينة بناء نوع وربما يراد به ما يتزين به وهي ضم شيء مرغوب فيه إلى شيء آخر ليرغب فيه بما اكتسب به من الجمال، والتفاخر المباهاة بالأنساب والأحساب، والتكاثر في الأموال والأولاد.
والحياة الدنيا عرض زائل وسراب باطل لا يخلو من هذه الخصال الخمس المذكورة: اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر وهي التي يتعلق بها هوى النفس الإنسانية ببعضها أو بجميعها وهي أمور وهمية وأعراض زائلة لا تبقى للإنسان وليست ولا واحدة منها تجلب للإنسان كمالا نفسيا ولا خيرا حقيقيا.
وعن شيخنا البهائي رحمه الله أن الخصال الخمس المذكورة في الآية مترتبة بحسب سني عمر الإنسان ومراحل حياته فيتولع أولا باللعب وهو طفل أو مراهق ثم إذا بلغ واشتد عظمه تعلق باللهو والملاهي ثم إذا بلغ أشده اشتغل بالزينة من الملابس الفاخرة والمراكب البهية والمنازل العالية وتوله للحسن والجمال ثم إذا اكتهل أخذ بالمفاخرة بالأحساب والأنساب ثم إذا شاب سعى في تكثير المال والولد.
وقوله: {كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما} مثل لزينة الحياة الدنيا التي يتعلق بها الإنسان غرورا ثم لا يلبث دون أن يسلبها.
والغيث المطر والكفار جمع كافر بمعنى الحارث، ويهيج من الهيجان وهو الحركة، والحطام الهشيم المتكسر من يابس النبات.
والمعنى: أن مثل الحياة الدنيا في بهجتها المعجبة ثم الزوال كمثل مطر أعجب الحراث نباته الحاصل بسببه ثم يتحرك إلى غاية ما يمكنه من النمو فتراه مصفر اللون ثم يكون هشيما متكسرا - متلاشيا تذروه الرياح -.
وقوله: {وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان} سبق المغفرة على الرضوان لتطهير المحل ليحل به الرضوان، وتوصيف المغفرة بكونه من الله دون العذاب لا يخلو من إيماء إلى أن المطلوب بالقصد الأول هو المغفرة وأما العذاب فليس بمطلوب في نفسه وإنما يتسبب إليه الإنسان بخروجه عن زي العبودية كما قيل.
وقوله: {وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور} أي متاع التمتع منه هو الغرور به، وهذا للمتعلق المغرور بها.
والكلام أعني قوله: {وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان} إشارة إلى وجهي الحياة الآخرة ليأخذ السامع حذره فيختار المغفرة والرضوان على العذاب، ثم في قوله: {وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور} تنبيه وإيقاظ لئلا تغره الحياة الدنيا بخاصة غروره.
قوله تعالى: {سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض} إلخ المسابقة هي المغالبة في السبق للوصول إلى غرض بأن يريد كل من المسابقين جعل حركته أسرع من حركة صاحبه ففي معنى المسابقة ما يزيد على معنى المسارعة فإن المسارعة الجد في تسريع الحركة والمسابقة الجد في تسريعها بحيث تزيد في السرعة على حركة صاحبه.
وعلى هذا فقوله: {سابقوا إلى مغفرة} إلخ، يتضمن من التكليف ما هو أزيد مما يتضمنه قوله: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ } [آل عمران: 133].
ويظهر به عدم استقامة ما قيل: إن آية آل عمران في السابقين المقربين والآية التي نحن فيها في عامة المؤمنين حيث لم يذكر فيها إلا الإيمان بالله ورسله بخلاف آية آل عمران فإنها مذيلة بجملة الأعمال الصالحة، ولذا أيضا وصف الجنة الموعودة هناك بقوله: {عرضها السماوات والأرض} بخلاف ما هاهنا حيث قيل: {عرضها كعرض السماء والأرض} فدل على أن جنة أولئك أوسع من جنة هؤلاء.
وجه عدم الاستقامة ما عرفت أن المكلف به في الآية المبحوث عنها معنى فوق ما كلف به في آية آل عمران.
على أن اللام في {السماء} للجنس فتنطبق على {السماوات} في تلك الآية.
وتقديم المغفرة على الجنة في الآية لأن الحياة في الجنة حياة طاهرة في عالم الطهارة فيتوقف التلبس بها على زوال قذارات الذنوب وأوساخها.
والمراد بالعرض السعة دون العرض المقابل للطول وهو معنى شائع، والكلام كأنه مسوق للدلالة على انتهائها في السعة.
وقيل: المراد بالعرض ما يقابل الطول والاقتصار على ذكر العرض أبلغ من ذكر الطول معه فإن العرض أقصر الامتدادين وإذا كان كعرض السماء والأرض كان طولها أكثر من طولهما.
ولا يخلو الوجه من تحكم إذ لا دليل على مساواة طول السماء والأرض لعرضهما ثم على زيادة طول الجنة على عرضها حتى يلزم زيادة طول الجنة على طولهما والطول قد يساوي العرض كما في المربع والدائرة وسطح الكرة وغيرها وقد يزيد عليه.
وقوله: {أعدت للذين آمنوا بالله ورسله} قد عرفت في ذيل قوله: {آمنوا بالله ورسله} وقوله: {والذين آمنوا بالله ورسله} أن المراد بالإيمان بالله ورسله هو مرتبة عالية من الإيمان تلازم ترتب آثاره عليه من الأعمال الصالحة واجتناب الفسوق والإثم.
وبذلك يظهر أن قول بعضهم: إن في الآية بشارة لعامة المؤمنين حيث قال: {أعدت للذين آمنوا بالله ورسله} ولم يقيد الإيمان بشيء من العمل الصالح ونحوه غير سديد فإن خطاب الآية وإن كان بظاهر لفظه يعم الكافر والمؤمن الصالح والطالح لكن وجه الكلام إلى المؤمنين يدعوهم إلى الإيمان الذي يصاحب العمل الصالح، ولوكان المراد بالإيمان بالله ورسله مجرد الإيمان ولولم يصاحبه عمل صالح وكانت الجنة معدة لهم والآية تدعو إلى السباق إلى المغفرة والجنة كان خطاب {سابقوا} متوجها إلى الكفار فإن المؤمنين قد سبقوا وسياق الآيات يأباه.
وقوله: {ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء} وقد شاء أن يؤتيه الذين آمنوا بالله ورسله، وقد تقدم بيان أن ما يؤتيه الله من الأجر لعباده المؤمنين فضل منه تعالى من غير أن يستحقوه عليه.
وقوله: {والله ذو الفضل العظيم} إشارة إلى عظمة فضله، وأن ما يثيبهم به من المغفرة والجنة من عظيم فضله.
قوله تعالى: {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها} إلخ، المصيبة الواقعة التي تصيب الشيء مأخوذة من إصابة السهم الغرض وهي بحسب المفهوم أعم من الخير والشر لكن غلب استعمالها في الشر فالمصيبة هي النائبة، والمصيبة التي تصيب في الأرض كالجدب وعاهة الثمار والزلزلة المخربة ونحوها، والتي تصيب في الأنفس كالمرض والجرح والكسر والقتل والموت، والبرء والبروء الخلق من العدم، وضمير {نبرأها} للمصيبة، وقيل: للأنفس، وقيل: للأرض، وقيل: للجميع من الأرض والأنفس والمصيبة، ويؤيد الأول أن المقام مقام بيان ما في الدنيا من المصائب الموجبة لنقص الأموال والأنفس التي تدعوهم إلى الإمساك عن الإنفاق والتخلف عن الجهاد.
والمراد بالكتاب اللوح المكتوب فيه ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة كما تدل عليه الآيات والروايات وإنما اقتصر على ذكر ما يصيب في الأرض وفي أنفسهم من المصائب لكون الكلام فيها.
قيل: إنما قيد المصيبة بما في الأرض وفي الأنفس لأن مطلق المصائب غير مكتوبة في اللوح لأن اللوح متناه والحوادث غير متناهية ولا يكون المتناهي ظرفا لغير المتناهي.
والكلام مبني على أن المراد باللوح لوح فلزي أو نحوه منصوب في ناحية من نواحي الجو مكتوب فيه الحوادث بلغة من لغاتنا بخط يشبه خطوطنا، وقد مر كلام في معنى اللوح والقلم وسيجيء له تتمة.
وقيل: المراد بالكتاب علمه تعالى وهو خلاف الظاهر إلا أن يراد به أن الكتاب المكتوب فيه الحوادث من مراتب علمه الفعلي.
وختم الآية بقوله: {إن ذلك على الله يسير} للدلالة على أن تقدير الحوادث قبل وقوعها والقضاء عليها بقضاء لا يتغير لا صعوبة فيه عليه تعالى.
قوله تعالى: {لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم} إلخ، تعليل راجع إلى الآية السابقة وهو تعليل للإخبار عن كتابة الحوادث قبل وقوعها لا لنفس الكتابة، والأسى الحزن، والمراد بما فات وما آتى النعمة الفائتة والنعمة المؤتاة.
والمعنى: أخبرناكم بكتابة الحوادث قبل حدوثها وتحققها لئلا تحزنوا بما فاتكم من النعم ولا تفرحوا بما أعطاكم الله منها لأن الإنسان إذا أيقن أن الذي أصابه مقدر كائن لا محالة لم يكن ليخطئه وأن ما أوتيه من النعم وديعة عنده إلى أجل مسمى لم يعظم حزنه إذا فاته ولا فرحه إذا أوتيه.
قيل: إن اختلاف الإسناد في قوليه: {ما فاتكم} و{ما آتاكم} حيث أسند الفوت إلى نفس الأشياء والإيتاء إلى الله سبحانه لأن الفوات والعدم ذاتي للأشياء فلو خليت ونفسها لم تبق بخلاف حصولها وبقائها فإنه لا بد من استنادهما إلى الله تعالى.
وقوله: {والله لا يحب كل مختال فخور} المختال من أخذته الخيلاء وهي التكبر عن تخيل فضيلة تراءت له من نفسه - على ما ذكره الراغب - والفخور الكثير الفخر والمباهاة والاختيال والفخر ناشئان عن توهم الإنسان أنه يملك ما أوتيه من النعم باستحقاق من نفسه، وهو مخالف لما هو الحق من استناد ذلك إلى تقدير من الله لا لاستقلال من نفس الإنسان فهما من الرذائل والله لا يحبها.
قوله تعالى: {الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل} وصف لكل مختال فخور يفيد تعليل عدم حبه تعالى.
والوجه في بخلهم الاحتفاظ للمال الذي يعتمد عليه اختيالهم وفخرهم والوجه في أمرهم الناس بالبخل أنهم يحبونه لأنفسهم فيحبونه لغيرهم، ولأن شيوع السخاء والجود بين الناس وإقبالهم على الإنفاق في سبيل الله يوجب أن يعرفوا بالبخل المذموم.
وقوله: {ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد} أي ومن يعرض عن الإنفاق ولم يتعظ بعظة الله ولا اطمأن قلبه بما بينه من صفات الدنيا ونعت الجنة وتقدير الأمور فإن الله هو الغني فلا حاجة له إلى إنفاقهم، والمحمود في أفعاله.
والآيات الثلاث أعني قوله: {وما أصاب من مصيبة - إلى قوله - الغني الحميد} كما ترى حث على الإنفاق وردع عن البخل والإمساك بتزهيدهم عن الأسى بما فاتهم والفرح بما آتاهم لأن الأمور مقدرة مقضية مكتوبة في كتاب معينة قبل أن يبرأها الله سبحانه.
_____________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج19 ، ص144-148.
بما أنّ المجموعة الاُولى كانت في أعلى مستويات الإيمان، ففي المقابل أيضاً ذكرت الآية أيضاً الكفر بأسوأ صوره في الجماعة الثانية المقارن للتكذيب بآيات الله.
ولأنّ حبّ الدنيا مصدر كلّ رذيلة، ورأس كلّ خطيئة، فالآية اللاحقة ترسم بوضوح وضع الحياة الدنيا والمراحل المختلفة والمحفّزات والظروف والأجواء التي تحكم كلّ مرحلة من هذه المراحل، حيث يقول سبحانه: {اعلموا إنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد}.
وبهذه الصورة فإنّ «الغفلة» و«اللهو» و«الزينة» و«التفاخر» و«التكاثر» تشكّل المراحل الخمس لعمر الإنسان.
ففي البداية مرحلة الطفولة، والحياة في هذه المرحلة عادةً مقترنة بحالة من الغفلة والجهل واللعب.
ثمّ مرحلة المراهقة حيث يأخذ اللهو مكان اللعب، وفي هذه المرحلة يكون الإنسان لاهثاً وراء الوسائل والاُمور التي تلهيه وتبعده عن الأعمال الجدّية.
والمرحلة الثالثة هي مرحلة الشباب والحيوية والعشق وحبّ الزينة.
وإذا ما تجاوز الإنسان هذه المرحلة فإنّه يصل إلى المرحلة الرابعة حيث تتولّد في نفسه دوافع العلو والتفاخر.
وأخيراً يصل إلى المرحلة الخامسة حيث يفكّر فيها بزيادة المال والأولاد وما إلى ذلك.
والمراحل الاُولى تشخّص حسب العمر تقريباً، إلاّ أنّ المراحل اللاحقة تختلف عند الأشخاص تماماً، والبعض من هذه المراحل تستمر مع الإنسان إلى نهاية عمره، كمرحلة جمع المال، وبالرغم من أنّ البعض يعتقد أنّ كلّ مرحلة من هذه المراحل الخمس تأخذ سنين من عمر الإنسان مجموعها أربعون سنة، حيث تتثبّت شخصية الإنسان عند وصوله إلى هذا العمر.
كما أنّ بعض الأشخاص يمكن أن تتوقّف شخصيتهم في المرحلة الاُولى والثانية حتّى مرحلة الهرم، ولذا فإنّ سمات هذه المرحلة تبقى هي الشاخصة في سلوكهم وتكوين شخصياتهم، حيث اللعب والشجار واللهو هو الطابع العامّ لهم، وتفكيرهم منهمك للغاية في تهيئة البيت الأنيق والملابس الفاخرة وغير ذلك من متع الحياة الدنيا حتّى الموت .. إنّهم أطفال في سنّ الكهولة، وشيوخ في روحية الأطفال.
ويذكر سبحانه مثالا لبداية ونهاية الحياة ويجسّد الدنيا أمام أعين الناس بهذه الصورة حيث يقول سبحانه: {كمثل غيث أعجب الكفّار نباته ثمّ يهيج فتراه مصفّراً ثمّ يكون حطاماً}(1).
«كفّار» هنا ليس بمعنى الأشخاص غير المؤمنين، ولكن بمعنى «الزرّاع» لأنّ أصل الكفر هو التغطية، وبما أنّ الزارع عندما ينثر البذور يغطّيها بالتراب، فقد قيل له كافر، ويقال أنّ «الكر» جاء بمعنى القبر أحياناً، لأنّه يغطّي جسم الميّت كما ورد في (سورة الفتح الآية / 29).
وفي الحديث عن النمو السريع للنبات يقول تعالى: {يعجب الزرّاع) إذ وردت هنا كلمة «الزرّاع» بدلا من الكفّار.
ويحتمل بعض المفسّرين أيضاً أنّ المقصود من «الكفّار» هنا هو نفس الكفر بالله تعالى وذكروا عدّة توجيهات لهذا، والظاهر أنّ هذا التّفسير لا يتناسب وسياق الآية، إذ أنّ المؤمن والكافر شريكان في هذا التعجّب.
(حطام) من مادّة (حطم) بمعنى التكسير والتفتيت، ويطلق على الأجزاء المتناثرة للتبن (حطام) وهي التي تأخذها الرياح باتّجاهات مختلفة.
إنّ المراحل التي يمرّ بها الإنسان مدّة سبعين سنة أوأكثر تظهر في النبات بعدّة أشهر، ويستطيع الإنسان أن يسكن بجوار المزرعة ويراقب بداية ونهاية العمر في وقت قصير.
ثمّ يتطرّق القرآن الكريم إلى حصيلة العمر ونتيجته النهائية حيث يقول سبحانه: {وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان}.
وأخيراً تنهي الآية حديثها بهذه الجملة: {وما الحياة الدنيا إلاّ متاع الغرور}.
«غرور» في الأصل من مادّة (غَرّ) على وزن «حرّ» بمعنى الأثر الظاهر للشيء، ويقال (غُرّة) للأثر الظاهر في جبهة الحصان، ثمّ اُطلقت الكلمة على حالة الغفلة، حيث أنّ ظاهر الإنسان واع، ولكنّه غافل في الحقيقة، وتستعمل أيضاً بمعنى الخدعة والحيلة.
«المتاع» بمعنى كلّ نوع ووسيلة يستفاد منها، وبناءً على هذا فإنّ جملة (الدنيا متاع الغرور) كما جاءت في قوله تعالى: {وما الحياة الدنيا إلاّ متاع الغرور)تعني أنّها وسيلة وأداة للحيلة والخدعة للفرد وللآخرين.
وطبيعي أنّ هذا المعنى وارد في الأشخاص الذين يعتبرون الدنيا هدفهم النهائي، وتكون منتهى غاياتهم، ولكن إذا كانت الهبات المادية في هذا العالم وسيلة للوصول بالإنسان للسعادة الأبدية، فذلك لا يعدّ من الدنيا، بل ستكون جسراً وقنطرة ومزرعة للآخرة التي ستتحقّق فيها تلك الأهداف الكبيرة حقّاً.
من البديهي أنّ النظر إلى الدنيا باعتبار أنّها «مقرّ» أو «جسر» سوف يعطي للإنسان توجّهين مختلفين، الأوّل: يكون سبباً للنزاع والفساد والتجاوز والظلم، والطغيان والغفلة، والثاني: وسيلة للوعي والتضحية والاُخوة والإيثار.
وقوله تعالى : {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (21) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (23) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ } [الحديد: 21 - 24]
المسابقة المعنوية الكبرى!!
بعد ما بيّنت الآيات السابقة قيمة هذه الدنيا المتواضعة الفانية، وكيف أنّ الناس فيها منهمكون في اللذات والتكاثر والتفاخر وجمع الأموال .. تأتي الآيات مورد البحث لتدعو الناس إلى العمل للحصول على موقع في الدار الآخرة، ذلك الموقع المتّسم بالثبات والبقاء والخلود، وتدعوهم إلى السباق في هذا المجال وبذل الجهد فيه، حيث يقول سبحانه: {سابقوا إلى مغفرة من ربّكم، جنّة عرضها عرض السماء والأرض اُعدّت للذين آمنوا بالله ورسله}.
وفي الحقيقة أنّ مغفرة الله هي مفتاح الجنّة، تلك الجنّة التي عرضها السماوات والأرض وقد اُعدّت من الآن لضيافة المؤمنين، حتّى لا يقول أحد إنّ الجنّة نسيئة ودَين ولا أمل في النسيئة، فعلى فرض أنّها نسيئة فانّها أقوى من كلّ نقد، لأنّها ضمن وعد الله القادر على كلّ شيء وأصدق من كلّ وعد، فكيف الحال وهي موجودة الآن وبصورة نقد؟!
وقد ورد نفس هذا المعنى في سورة آل عمران (الآية رقم 133) مع إختلاف بسيط، حيث إنّ في الآية مورد البحث جاءت كلمة (سابقوا) من مادّة (المسابقة) وهنالك وردت كلمة (سارعوا) من مادّة (المسارعة)، وكلاهما قريب من الآخر بالنظر إلى مفهوم باب «المفاعلة» حيث تتجسّد غلبة شخصين أحدهما على الآخر.
والإختلاف الآخر هو أنّها هنالك قد جاءت بوصف: {عرضها السماوات والأرض} وهنا جاءت: {عرضها كعرض السماء والأرض) وإذا دقّقنا قليلا يتّضح أنّ هذين التعبيرين يوضّحان حقيقة واحدة أيضاً.
ويقول سبحانه هناك: {اُعدّت للمتّقين} وهنا يقول: {اُعدّت للذين آمنوا}.
ولأنّ المتّقين ثمرة شجرة الإيمان الحقيقي، فإنّ هذين التعبيرين في الواقع كلّ منها لازم وملزوم للآخر.
وبهذه الصورة فإنّ الإثنين يتحدّثان عن حقيقة واحدة ببيانين مختلفين، ولهذا فما ذكره البعض من أنّ الآية (سورة آل عمران تشير إلى «جنّة المقرّبين»، وآية مورد البحث تشير إلى «جنّة المؤمنين»، صحيح حسب الظاهر.
وعلى كل حال فالتعبير بـ (عرض) هنا ليس في مقابل (الطول) كما قال بعض المفسّرين حيث كانوا يبحثون عن طول تلك الجنّة التي عرضها مثل السماء والأرض، ولهذا السبب فإنّهم واجهوا صعوبة في توجيه ذلك، حيث إنّ العرض في مثل هذه الإستعمالات بمعنى «السعة».
والتعبير بـ «المغفرة» قبل البشارة بالجنّة ـ الذي ورد في الآيتين ـ هو إشارة لطيفة إلى أنّه ليس من اللائق الدخول إلى الجنّة والقرب من الله قبل المغفرة والتطهير.
وممّا ينبغي ملاحظته أنّ المسارعة لمغفرة الله لابدّ أن تكون عن طريق أسبابها كالتوبة والتعويض عن الطاعات الفائتة، وأساساً فانّ طاعة الله عزّوجلّ يعني تجنّب المعاصي، ولكنّنا نجد في بعض الأحاديث تأكيد على القيام بالواجبات وبعض المستحبّات كالتقدّم للصفّ الأوّل في الجماعة، أو الصفّ الأوّل في الجهاد، أو تكبيرة الإحرام مع إمام الجماعة، أو الصلاة في أوّل وقتها، فهذه من قبيل بيان المصداق ولا يقلّل شيئاً من المفهوم الواسع للآية.
ويضيف تعالى في نهاية الآية: {ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم}.
ومن المؤكّد أنّ جنّة بذلك الإتّساع وبهذه النعم، ليس من السهل للإنسان أن يصل إليها بأعماله المحدودة، لذا فإنّ الفضل واللطف والرحمة الإلهية ـ فقط ـ هي التي تستطيع أن تمنحه ذلك الجزاء العظيم في مقابل اليسير من أعماله، إذ أنّ الجزاء الإلهي لا يكون دائماً بمقياس العمل، بل إنّه بمقياس الكرم الإلهي.
وعلى كلّ حال فإنّ هذا التعبير يرينا بوضوح أنّ الثواب والجزاء لا يتناسب مع طبيعة العمل، حيث أنّه نوع من التفضل والرحمة.
ولمزيد من التأكيد على عدم التعلّق بالدنيا، وعدم الفرح والغرور عند إقبالها، أو الحزن عند إدبارها، يضيف سبحانه: {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلاّ في كتاب من قبل أن نبرأها إنّ ذلك على الله يسير}(3).
نعم، إنّ المصائب التي تحدث في الطبيعة كالزلازل والسيول والفيضانات والآفات المختلفة، وكذلك المصائب التي تقع على البشر كالموت وأنواع الحوادث المؤلمة التي تشمل الإنسان، فإنّها مقدّرة من قبل ومسجّلة في لوح محفوظ.
والجدير بالإنتباه أنّ المصائب المشار إليها في الآية هي المصائب التي لا يمكن التخلّص منها، وليست ناتجة عن أعمال الإنسان. (بتعبير آخر الحصر هنا حصر إضافي).
والشاهد في هذا الكلام قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ } [الشورى: 30] .
وبملاحظة أنّ الآيات يفسّر بعضها البعض الآخر يتبيّن لنا عندما نضع هاتين الآيتين جنباً إلى جنب أنّ المصائب التي يبتلى بها الإنسان على نوعين:
الأوّل: المصائب التي تكون مجازاة وكفّارة للذنوب، كالظلم والجور والخيانة والإنحراف وأمثالها، فإنّها تكون مصدراً للكثير من مصائب الإنسان.
الثاني: من المصائب هوما لا تكون للإنسان يد فيه، وتكون مقدّرة وحتمية وغير قابلة للإجتناب حيث يبتلي فيها الفرد والمجتمع، لذا فإنّ الكثير من الأنبياء والأولياء والصالحين يبتلون بمثل هذه المصائب.
إنّ هذه المصائب لها فلسفة دقيقة حيث أشرنا إليها في أبحاث معرفة الله والعدل الإلهي ومسألة الآفات والبلايا.
ونقرأ في هذا الصدد القصّة التالية: عندما أدخل الإمام علي بن الحسين (عليه السلام)مغلولا مكبّلا في مجلس يزيد بن معاوية، فالتفت يزيد إلى الإمام; وقرأ آية سورة الشورى: {ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم} وكان يريد أن يظهر أنّ مصائبكم كانت نتيجة أعمالكم، وبهذا أراد الطعن بالإمام (عليه السلام) بهذا الكلام، إلاّ أنّ الإمام ردّ عليه فوراً وقال: كلاّ، ما نزلت هذه فينا، إنّما نزلت فينا: {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلاّ في كتاب من قبل أن نبرأها}(4).
ولنا بحث مفصّل في هذا المجال في تفسير الآية رقم30 من سورة الشورى(5).
أتباع أهل البيت أيضاً عرفوا نفس المعنى، في هذه الآية، إذ نقل أنّ الحجّاج عندما جيء له بسعيد بن جبير وصمّم على قتله، بكى رجل من الحاضرين. قال سعيد: وما يبكيك؟ فأجاب: للمصاب الذي حلّ بك، قال: لا تبكِ فقد كان في علم الله أن يكون ذلك، ألم تسمع قوله تعالى: {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلاّ في كتاب من قبل أن نبرأها}(6).
ومن الطبيعي أنّ كلّ الحوادث التي تحدث في هذا العالم مسجّلة في لوح محفوظ وفي علم الله عزّوجلّ اللاّ محدود، وإذا أشرنا هنا إلى المصائب التي تقع في الأرض وفي الأنفس فقط، فلأنّ موضوع الحديث بهذا الإتّجاه، كما سنرى في الآية اللاحقة التي يستنتج منها الموضوع نفسه.
وبالضمن فإنّ جملة: {إنّ ذلك على الله يسير} تشير إلى تسجيل وحفظ كلّ هذه الحوادث في لوح محفوظ مع كثرتها البالغة، وذلك سهل يسير على الله تعالى.
والمقصود من «اللوح المحفوظ» هو: العلم اللا متناهي لله سبحانه، أو صحيفة عالم الخلقة ونظام العلّة والمعلول، والتي هي مصداق العلم الفعلي لله سبحانه «فتدبّر».
ولنلاحظ الآن ما هي فلسفة تقدير المصائب في اللوح المحفوظ، ومن ثمّ بيان هذه الحقيقة في القرآن الكريم؟
الآية اللاحقة تزيح هذا الحجاب عن هذا السرّ المهمّ حيث يقول تعالى: {لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم}.
هاتان الجملتان القصيرتان تحلاّن ـ في الحقيقة ـ إحدى المسائل المعقّدة لفلسفة الخلقة، لأنّ الإنسان يواجه دائماً مشاكل وصعوبات وحوادث مؤسفة في عالم الوجود، ويسأل دائماً نفسه هذا السؤال وهو: رغم أنّ الله رحمن رحيم وكريم ..، فلماذا هذه الحوادث المؤلمة؟!
ويجيب سبحانه أنّ هدف ذلك هو: ألا تأسركم مغريات هذه الدنيا وتنشدّوا إليها وتغفلوا عن أمر الآخرة .. كما ورد في الآية أعلاه.
والمطلوب أن تتعاملوا مع هذا المعبر والجسر الذي إسمه الدنيا بشكل لا تستولي على لباب قلوبكم، وتفقدوا معها شخصيّتكم وكيانكم وتحسبون أنّها خالدة وباقية، حيث إنّ هذا الإنشداد هو أكبر عدو لسعادتكم الحقيقية، حيث يجعلكم في غفلة عن ذكر الله ويمنعكم من مسيرة التكامل.
هذه المصائب هي إنذار للغافلين وسوط على الأرواح التي تعيش الغفلة والسبات، ودلالة على قصر عمر الدنيا وعدم خلودها وبقائها.
والحقيقة أنّ المظاهر البرّاقة لدار الغرور تبهر الإنسان وتلهيه بسرعة عن ذكر الحقّ سبحانه، وقد يستيقظ فجأةً ويرى أنّ الوقت قد فات وقد تخلّف عن الركب.
هذه الحوادث كانت ولا تزال في الحياة، وستبقى بالرغم من التقدّم العلمي العظيم، ولن يستطيع العلم أن يمنع حدوثها ونتائجها المؤلمة، كالزلازل والطوفان والسيول والأمطار وما إلى ذلك .. وهي درس من قسوة الحياة وصرخة مدوّية فيها ..
وهذا لا يعني أن يعرض الإنسان عن الهبات الإلهية في هذا العالم أو يمتنع من الإستفادة منها، ولكن المهمّ ألاّ يصبح أسيراً فيها، وألاّ يجعلها هي الهدف والنقطة المركزية في حياته.
والجدير بالملاحظة هنا أنّ القرآن الكريم إستعمل لفظ (فاتكم) للدلالة على ما فقده الإنسان من أشياء، أمّا ما يخصّ الهبات والنعم التي حصل عليها فإنّه ينسبها لله، (بما آتاكم)، وحيث أنّ الفوت والفناء يكمن في ذات الأشياء، وهذا الوجود هومن الفيض الإلهي.
نعم، إنّ هذه المصائب تكسر حدّة الغرور والتفاخر وحيث يقول سبحانه في نهاية الآية: {إنّ الله لا يحبّ كلّ مختال فخور}.
«مختال» من مادّة (خيال) بمعنى متكبّر، لأنّ التكبّر من التخيّل، أي من تخيّل الإنسان الفضل لنفسه، وتصوّره أنّه أعلى من الآخرين. و(فخور) صيغة مبالغة من مادّة (فخر) بمعنى الشخص الذي يفتخر كثيراً على الآخرين.
والشخص الوحيد الذي يبتلى بهذه الحالات هو المغرور الذي أسكرته النعم، وهذه المصائب والآفات بإمكانها أن توقظه عن هذا السكر والغفلة وتهديه إلى سير التكامل.
ومن ملاحظة ما تقدّم أعلاه فإنّ المؤمنين عندما يرزقون النعم من قبل الله سبحانه فإنّهم يعتبرون أنفسهم مؤتمنين عليها، ولا يأسفون على فقدانها وفواتها، ولا يغفلون ويسكرون بوجودها. إذ يعتبرون أنفسهم كالأشخاص المسؤولين عن بيت المال إذ يستلمون في يوم أموالا كثيرة ويدفعونها في اليوم الثاني، وعندئذ لا يفرحون بإستلامها، ولا يحزنون على إعطائها.
وكم هو تعبير رائع ما قاله أمير المؤمنين (عليه السلام) حول هذه الآية: «الزهد كلّه بين كلمتين في القرآن الكريم قال تعالى: {لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم}، ومن لم يأس على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطر فيه»(7).
والنقطة الاُخرى الجديرة بالملاحظة هي أنّ هذا الأصل ـ وجود المصائب ـ في حياة الإنسان أمر قدّر عليه طبقاً لسنّة حكيمة، حيث أنّ الدنيا في حالة غير مستقرّة، وهذا الأصل يعطي للإنسان الشجاعة لتحمّل المصائب ويمنحه الصلاة والسكينة أمام الحوادث ويكون مانعاً له من الجزع والضجر ..
ونؤكّد مرّة اُخرى أنّ هذا يتعلّق ـ فقط ـ بالمصائب المقدّرة والغير قابلة للردّ، وإلاّ فإنّ المصائب والمصاعب التي تكون بسبب ذنوب الإنسان وتسامحه في الطاعات والإلتزامات الإلهيّة، فإنّها خارجة عن هذا البحث، ولمواجهتها لابدّ من وضع برنامج صحيح في حياة الإنسان.
وننهي هذا البحث بما ذكر في التاريخ حيث نقل عن بعض المفسّرين ما يلي:
قال «قتيبة بن سعيد»(8): دخلت على إحدى قبائل العرب فرأيت صحراء مملوءة بجمال ميّتة لا تعدّ، وكانت بقربي امرأة عجوز فسألتها: لمن هذه الجمال؟ قالت: لذلك الرجل الجالس فوق التل الذي تراه يغزل، فذهبت إليه وقلت: هل هذا كلّه لك؟ قال: كانت باسمي، قلت: ما الذي جرى وأصبحن بهذا الحال؟ فأجابني ـ دون الإشارة إلى علّة موتهنّ ـ إنّ المعطي قد أخذ. قلت: هل ضجرت لما أصابك؟ وهل قلت شيئاً بعد مصابك؟ قال: بلى. وأنشد هذين البيتين:
لا والذي أنا عبد من خلائقه والمرء في الدهر نصب الرزء والمحن
ما سرّني أنّ إبلي في مباركها وما جرى من قضاء الله لم يكن
أنا راض برضى الله تعالى فقط وكلّما يقدّر فأنا أقبله(9).
وفي آخر آية مورد البحث نلاحظ توضيحاً وتفسيراً لما جاء في الآيات السابقة، والذي يوضّح حقيقة الإنسان المختال الفخور حيث يقول عنه تعالى: {الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل}(10).
نعم، إنّ الإنشداد العميق لزخارف الدنيا ينتج التكبّر والغرور، ولازم التكبّر والغرور هو البخل ودعوة الآخرين للبخل. أمّا البخل فلأنّ التكبّر والغرور كثيراً ما يكون بسبب ثراء الإنسان الذي يدفعه إلى أن يحرص عليه، وبالتالي يبخل في إنفاقه، ومن هنا فإنّ لازمة الغرور والتكبّر هو البخل.
أمّا دعوة الآخرين إلى البخل، فلأنّ سخاء الآخرين سيفضح غيرهم من البخلاء، هذا أوّلا، والثاني أنّ البخيل يحبّ البخل، لذا فإنّه يدعو للشيء الذي يرغب فيه.
ولكي لا يتصوّر أنّ تأكيد الله سبحانه على الإنفاق وترك البخل، أو كما عبّرت عنه الآيات السابقة بـ {القرض لله) مصدره إحتياج ذاته المقدّسة، فإنّه يقول في نهاية الآية: {ومن يتولّ فإنّ الله هو الغني الحميد}.
بل نحن كلّنا محتاجون إليه وهو الغني عنّا جميعاً، لأنّ جميع خزائن الوجود عنده وتحت قبضته، ولأنّه جامع لصفات الكمال فإنّه يستحقّ كلّ شكر وثناء.
وبالرغم من أنّ الآية أعلاه تتحدّث عن البخل المالي. إلاّ أنّه لا ينحصر عليه، لأنّ مفهوم البخل واسع يستوعب في دائرته البخل في العلم وأداء الحقوق وما إلى ذلك أيضاً.
__________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج13 ، ص588-599.
2 ـ «يهيج» من مادّة هيجان جاءت هنا بمعنيين الأوّل: جفاف النبات، والآخر: التحرّك والحيوية، وقد يرجع هذان المعنيان إلى أصل واحد، لأنّ النبات عند جفافه يكون مهيّأ للإندثار والإنتشار بحركة الرياح.
3 ـ بالنسبة لعود الضمير في (نبرأها) فقد ذكروا إحتمالات متعدّدة حيث اعتبر البعض أنّ مرجعها للأرض والأنفس، والبعض الآخر إعتبرها للمصيبة، وبعض جميعها، إلاّ أنّه بالنظر إلى ذيل الآية فإنّ المعنى الأوّل هو الأنسب لأنّه يريد أن يقول: حتّى قبل خلق السماء والأرض وخلقكم فإنّ هذه المصائب مقدّرة.
4 ـ تفسير علي بن إبراهيم مطابق لنقل نور الثقلين، ج5، ص247.
5 ـ كان لدينا بحث آخر في نهاية الآية (78)، (79) من سورة النساء والتي تتناسب مع الآيات مورد البحث.
6 ـ روح البيان ج9، ص375.
7 ـ نهج البلاغة، كلمات قصار 439.
8 ـ قتيبة بن سعيد أحد المحدّثين الذي يروي عن مالك بن أنس (منتهى الأرب).
9 ـ تفسير روح الجنان، ج11، ص53 وجاء نظير هذا المعنى في تفسير روح البيان، ج9، ص376.
10 ـ «الذين» بدل من (كلّ مختال فخور) وتفسير الكشّاف ذيل الآية مورد البحث) وبالضمن يجدر الإنتباه إلى أنّ البدل والمبدّل منه ليس بالضرورة أن يتطابقا في المعرفة والنكرة.
 الاكثر قراءة في سورة الحديد
الاكثر قراءة في سورة الحديد
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)