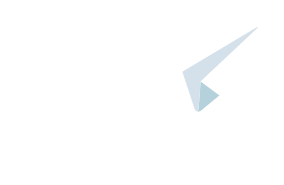تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير الاية (260) من سورة البقرة
المؤلف:
اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
10-5-2017
11753
قال تعالى : {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [البقرة : 260] .
ذكر تعالى ما أراه إبراهيم عيانا من إحياء الموتى فقال {وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى} اختلف في سبب سؤال إبراهيم هذا على وجوه (أحدها) ما قاله الحسن والضحاك وقتادة وهو المروي عن أبي عبد الله أنه رأى جيفة تمزقها السباع فيأكل منها سباع البر وسباع الهواء ودواب البحر فسأل الله إبراهيم فقال يا رب قد علمت أنك تجمعها من بطون السباع والطير ودواب البحر فأرني كيف تحييها لأعاين ذلك (وثانيها) ما روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي أن الملك بشر إبراهيم (عليه السلام) بأن الله قد اتخذه خليلا وأنه يجيب دعوته ويحيي الموتى بدعائه فسأل الله تعالى أن يفعل ذلك ليطمئن قلبه بأنه قد أجاب دعوته واتخذه خليلا (وثالثها) أن سبب السؤال منازعة نمرود إياه في الإحياء إذ قال أنا أحيي وأميت وأطلق محبوسا وقتل إنسانا فقال إبراهيم ليس هذا بإحياء وقال يا رب أرني كيف تحيي الموتى ليعلم نمرود ذلك وروي أن نمرود توعده بالقتل إن لم يحيي الله الميت بحيث يشاهده فلذلك قال {ليطمئن قلبي} أي بأن لا يقتلني الجبار عن محمد بن إسحاق بن يسار ( ورابعها ) أنه أحب أن يعلم ذلك علم عيان بعد أن كان عالما به من جهة الاستدلال والبرهان لتزول الخواطر ووساوس الشيطان وهذا أقوى الوجوه .
{قال أ ولم تؤمن} هذه الألف استفهام ويراد به التقرير كقول الشاعر :
أ لستم خير من ركب المطايا *** وأندى العالمين بطون راح (2)
أي : قد آمنت لا محالة فلم تسأل ذا وهذه الألف إذا دخلت على الإثبات فالمراد النفي كقوله {أ أنت قلت للناس} أي لم تقل {قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} أي بلى أنا مؤمن ولكن سألت ذاك لأزداد يقينا إلى يقيني عن الحسن وقتادة ومجاهد وابن جبير وقيل لأعاين ذلك ويسكن قلبي إلى علم العيان بعد علم الاستدلال وقيل ليطمئن قلبي بأنك قد أجبت مسألتي واتخذتني خليلا كما وعدتني .
{قال فخذ أربعة من الطير} مختلفة الأجناس وإنما خص الطير من بين سائر الحيوانات لخاصية الطيران وقيل إنها الطاووس والديك والحمام والغراب أمر أن يقطعها ويخلط ريشها بدمها هذا قول مجاهد وابن جريج وعطاء وابن زيد وهو المروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) {فصرهن إليك} أي قطعهن عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وقيل معناه اضممهن إليك عن عطاء وابن زيد وقد تقدم بيانه في وجه القراءة .
{ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا} وروي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن معناه فرقهن على كل جبل وكانت عشرة أجبل ثم خذ بمناقيرهن وادعهن باسمي الأكبر وحلفهن بالجبروت والعظمة يأتينك سعيا ففعل إبراهيم ذلك وفرقهن على عشرة أجبل ثم دعاهن فقال أجبن بإذن الله فكانت تجتمع ويأتلف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه وطارت إلى إبراهيم وقيل أن الجبال كانت سبعة عن ابن جريج والسدي وقيل كانت أربعة عن ابن عباس والحسن وقتادة وقيل أراد كل جبل على العموم بحسب الإمكان كأنه قال فرقهن على كل جبل يمكنك التفرقة عليه عن مجاهد والضحاك .
ويسأل فيقال كيف قال ثم ادعهن ودعاء الجماد قبيح وجوابه أنه أراد بذلك الإشارة إليها والإيماء لتقبل عليه إذا أحياها الله وقيل معنى الدعاء هاهنا الإخبار عن تكوينها أحياء كقوله سبحانه {كونوا قردة خاسئين} وقوله {ائتيا طوعا أوكرها} عن الطبري .
وقول من قال أنه جعل على كل جبل طيرا ثم دعاها بعيد من الصواب والفائدة لأنه إنما طلب بالعلم به كونه قادرا على إحياء الموتى عيانا وليس في إتيان طائر حي إليه بالإيماء ما يدل على ذلك وفي الكلام حذف فكأنه قال فقطعهن ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءا فإن الله يحييهن فإذا أحياهن فادعهن فيكون الإيماء إليها بعد أن صارت أحياء ففعل إبراهيم ذلك فنظر إلى الريش يسعى بعضها إلى بعض وكذلك العظام واللحم ثم أتينه مشيا على أرجلهن فتلقى كل طائر رأسه وذلك قوله {يأتينك سعيا} .
وذكر عن النضر بن شميل قال سألت الخليل بن أحمد عن قوله تعالى {يأتينك سعيا} هي يقال للطائر إذا طار سعى فقال لا قلت فما معناه قال معناه يأتينك وأنت تسعى سعيا {واعلم أن الله عزيز} أي قوي لا يعجز عن شيء {حكيم} في أفعاله وأقواله وقيل عزيز يذل الأشياء له ولا يمتنع عليه شيء حكيم أفعاله كلها حكمة وصواب ومما يسأل في هذه الآية أن يقال كيف أجيب إبراهيم إلى آيات الآخرة دون موسى في قوله {أرني أنظر إليك} وجوابه من وجهين ( أحدهما ) أنه سأل آية لا يصح معها بقاء التكليف من وقوع الضرورة التي لا يعترضها الشكوك بوجه وإبراهيم إنما سأل في شيء خاص يصح معه التكليف ( والآخر ) أن الأحوال قد تختلف فيكون الأصلح في بعض الأحوال الإجابة وفي بعضها المنع فيما لم يتقدم فيه إذن .
__________________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج2 ، ص177-179 .
2- المطايا كسجايا مطية : الدابة السرية . أندى أفعل تفضيل من الندى : المطر والمراد السخاء . والراح جمع الراحة : الكف . والقائل جرير احد أعمدة الثالوث الاموي (الفرزدق والاخطل وجرير) .
معنى الآية واضح ، ولكن المفسرين يريدون أن يوجدوا سببا للكلام على كل حال ، ولذلك تساءلوا عن السبب الذي دعا إبراهيم ( عليه السلام ) إلى هذا السؤال ، مع العلم بأنه مؤمن بالبعث ايمانا لا يشوبه شك ، ثم اختلفوا في جوابه على اثني عشر قولا ، ذكرها الرازي ، ولا وجه لبحثهم من الأساس ، لأن الايمان بالغيب لا يتنافى مع طلب المشاهدة بالعيان ، فان كل من آمن باللَّه وملائكته ، وبما جاء في كتبه من أخبار الغيب ، كل المؤمنين من أكبر كبير إلى أصغر صغير يتمنون أن يشاهدوا بالعيان ما آمنوا به عن طريق الغيب والوحي الا علي بن أبي طالب الذي قال : (لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا) .
وكيف كان ، فان خليل الرحمن ( صلى الله عليه واله ) آمن بالبعث ايمانا غيبيا عن طريق الوحي كغيره من الأنبياء والصديقين ، ثم أحب أن يشاهد الحادثة بعينه بعد أن شاهدها بقلبه وعقله ، وبذلك تتم لديه جميع طرق المعرفة قلبا وعقلا وتجربة .
وقد أجاب اللَّه سؤله ، وأمره أن يأخذ أربعة من الطير ، ويضمها إليه ، ثم يقطَّعها أجزاء ، ويفرقها أشلاء ، ويجعل على كل جبل منهن جزءا ، ثم يدعوهن إليه ، فيأتينه سعيا بإذن اللَّه . وامتثل إبراهيم أمر ربه ، فعادت الأشلاء إلى مكانها ، ورجعت الحياة إليها ، وسعت إليه بقدرة اللَّه .
والذي ننتهي إليه من هذه الآية ان طلب الكشف عن سر الخلق أو البعث ينشأ تارة عن الشك والتردد ، وهذا يتنافى مع الايمان بقدرة اللَّه والثقة بوحيه وأنبيائه ، وتارة ينشأ عن حب الاطلاع والمعرفة الحسية ، مع الايمان بقدرة الخالق ، والثقة بأنبيائه ، حتى ولولم ير كيف يحيي اللَّه الموتى ، كما هو الشأن في ايمان إبراهيم ، وهذا الطلب لا يضر بالايمان في شيء ، ولكنه صعب المنال ، بل ومحال ان يتحقق لراغب إلا إذا كان نبيا كإبراهيم الذي لا يزعزع إيمانه بقدرة اللَّه شيء ، حتى ولولم يستجب اللَّه لسؤله ، وعلى هذا فمن اشترط التجربة والمشاهدة لإيمانه بالبعث فهو كافر من الأساس ، ولوكان مؤمنا بقدرة اللَّه حقا لكان في غنى عن هذا الشرط ، لأن قدرته تعالى لا يعجزها شيء في السماوات ولا في الأرض .
____________________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج1 ، ص409-410 .
قوله تعالى : {وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى} ، قد مر أنه معطوف على مقدر والتقدير : واذكر إذ قال "إلخ" وهو العامل في الظرف ، وقد احتمل بعضهم أن يكون عامل الظرف هو قوله : {قال أ ولم تؤمن} ، وترتيب الكلام : أ ولم تؤمن إذ قال إبراهيم رب أرني "إلخ" وليس بشيء .
وفي قوله : {أرني كيف تحيي الموتى} ، دلالة : أولا على أنه (عليه السلام) إنما سأل الرؤية دون البيان الاستدلالي ، فإن الأنبياء وخاصة مثل النبي الجليل إبراهيم الخليل أرفع قدرا من أن يعتقد البعث ولا حجة له عليه ، والاعتقاد النظري من غير حجة عليه إما اعتقاد تقليدي أوناش عن اختلال فكري وشيء منهما لا ينطبق على إبراهيم (عليه السلام) ، على أنه (عليه السلام) إنما سأل ما سأل بلفظ كيف ، وإنما يستفهم بكيف عن خصوصية وجود الشيء لا عن أصل وجوده فإنك إذا قلت : أ رأيت زيدا كان معناه السؤال عن تحقق أصل الرؤية ، وإذا قلت : كيف رأيت زيدا كان أصل الرؤية مفروغا عنه وإنما السؤال عن خصوصيات الرؤية ، فظهر أنه (عليه السلام) إنما سأل البيان بالإراءة والإشهاد لا بالاحتجاج والاستدلال .
وثانيا : على أن إبراهيم (عليه السلام) إنما سأل أن يشاهد كيفية الإحياء لا أصل الإحياء كما أنه ظاهر قوله : {كيف تحيي الموتى} ، وهذا السؤال متصور على وجهين : الوجه الأول : أن يكون سؤالا عن كيفية قبول الأجزاء المادية الحياة ، وتجمعها بعد التفرق والتبدد ، وتصورها بصورة الحي ، ويرجع محصله إلى تعلق القدرة بالإحياء بعد الموت والفناء .
الوجه الثاني : أن يكون عن كيفية إفاضة الله الحياة على الأموات وفعله بأجزائها الذي به تلبس الحياة ، ويرجع محصله إلى السؤال عن السبب وكيفية تأثيره ، وهذا بوجه هو الذي يسميه الله سبحانه بملكوت الأشياء في قوله عز من قائل : { إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (82) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ} [يس : 82 ، 83] .
وإنما سأل إبراهيم (عليه السلام) عن الكيفية بالمعنى الثاني دون المعنى الأول : أما أولا : فلأنه قال : كيف تحيي الموتى ، بضم التاء من الإحياء فسأل عن كيفية الإحياء الذي هو فعل ناعت لله تعالى وهو سبب حياة الحي بأمره ، ولم يقل : كيف تحيي الموتى ، بفتح التاء من الحياة حتى يكون سؤالا عن كيفية تجمع الأجزاء وعودها إلى صورتها الأولى وقبولها الحياة ، ولوكان السؤال عن الكيفية بالمعنى الثاني لكان من الواجب أن يرد على الصورة الثانية ، وأما ثانيا : فلأنه لوكان سؤاله عن كيفية قبول الأجزاء للحياة لم يكن لإجراء الأمر بيد إبراهيم وجه ، ولكفى في ذلك أن يريد الله إحياء شيء من الحيوان بعد موته ، وأما ثالثا : فلأنه كان اللازم على ذلك أن يختم الكلام بمثل أن يقال : وأعلم أن الله على كل شيء قدير لا بقوله : واعلم أن الله عزيز حكيم ، على ما هو المعهود من دأب القرآن الكريم فإن المناسب للسؤال المذكور هو صفة القدرة دون صفتي العزة والحكمة فإن العزة والحكمة - وهما وجدان الذات كل ما تفقده وتستحقه الأشياء وإحكامه في أمره - إنما ترتبطان بإفاضة الحياة لا استفاضة المادة لها فافهم ذلك .
ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره بعض المفسرين : أن إبراهيم (عليه السلام) إنما سأل بقوله : رب أرني حصول العلم بكيفية حصول الإحياء دون مشاهدة كيفية الإحياء ، وأن الذي أجيب به في الآية لا يدل على أزيد من ذلك ، قال : ما محصله : أنه ليس في الكلام ما يدل على أن الله سبحانه أمره بالإحياء ، ولا أن إبراهيم (عليه السلام) فعل ما أمره به ، فما كل أمر يقصد به الامتثال ، فإن من الخبر ما يأتي بصورة الإنشاء كما إذا سألك سائل كيف يصنع الحبر مثلا؟ فتقول : خذ كذا وكذا وأفعل به كذا وكذا يكن حبرا تريد أن هذه كيفيته ، ولا تريد به أن تأمره أن يصنع الحبر بالفعل .
قال : وفي القرآن شيء كثير مما ورد فيه الخبر في صورة الأمر ، والكلام هاهنا مثل لإحياء الموتى ، ومعناه خذ أربعة من الطير فضمها إليك وآنسها بك حتى تأنس وتصير بحيث تجيب دعوتك إذا دعوتها فإن الطيور من أشد الحيوان استعدادا لذلك ثم اجعل كل واحد منها على جبل ثم ادعها فإنها تسرع إليك من غير أن يمنعها تفرق أمكنتها وبعدها ، كذلك أمر ربك إذا أراد إحياء الموتى يدعوهم بكلمة التكوين : كونوا أحياء ، فيكونون أحياء كما كان شأنه في بدء الخلقة ، ذلك إذ قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أوكرها قالتا : أتينا طائعين .
قال : والدليل على ذلك من الآية قوله تعالى : {فصرهن} ، فإن معناه أملهن أي أوجد ميلها إليك وأنسها بك ، ويشهد به تعديته بإلى فإن صار إذا تعدى بإلى كان بمعنى الإمالة ، وما ذكره المفسرون من كونه بمعنى التقطيع أي قطعهن أجزاء بعد الذبح لا يساعد عليه تعديته بإلى ، وأما ما قيل : إن قوله : {إليك} متعلق بقوله : {فخذ} دون قوله : {فصرهن} والمعنى : خذ إليك أربعة من الطير فقطعهن فخلاف ظاهر الكلام .
وثانيا : أن الظاهر : أن ضمائر فصرهن ومنهن وادعهن ويأتينك جميعا راجعة إلى الطير ، ويلزم على قولهم : إن المراد تقطيعها وتفريق أجزائها ، ووضع كل جزء منها على جبل ثم دعوتهن أن يفرق بين الضمائر فيعود الأولان إلى الطيور ، والثالث والرابع إلى الأجزاء وهو خلاف الظاهر .
وأضاف إلى ذلك بعض من وافقه في معنى الآية وجوها أخرى نتبعها بها .
وثالثا : أن إراءة كيفية الخلقة إن كان بمعنى مشاهدة كيفية تجمع أجزائها وتغير صورها إلى الصورة الأولى الحية فهي مما لا تحصل على ما ذكروه من تقطيعه الأجزاء ومزجه إياها ووضعه على جبل بعيد ، جزءا منها فكيف يتصور على هذا مشاهدة ما يعرض ذرات الأجزاء من الحركات المختلفة والتغيرات المتنوعة ، وإن كان المراد إراءة كيفية الإحياء بمعنى الإحاطة على كنه كلمة التكوين التي هي الإرادة الإلهية المتعلقة بوجود الشيء وحقيقة نطقها بالأشياء فظاهر القرآن وهوما عليه المسلمون أن هذا غير ممكن للبشر ، فصفات الله منزهة عن الكيفية .
ورابعا : أن قوله : {ثم اجعل} ، يدل على التراخي الذي هو المناسب لمعنى التأنيس وكذلك قوله : فصرهن بخلاف ما ذكروه من معنى الذبح والتقطيع .
وخامسا : أنه لوكان كما يقولون لكان الأنسب هو ختم الآية باسم القدير دون الاسمين : العزيز الحكيم فإن العزيز هو الغالب الذي لا ينال ، هذا ما ذكروه .
وأنت بالتأمل في ما قدمناه من البيان تعرف سقوط ما ذكروه ، فإن اشتمال الآية على السؤال بلفظ {أرني} وقوله : {كيف تحيي} وإجراء الأمر بيد إبراهيم على ما مر بيانها كل ذلك ينافي هذا المعنى ، على أن الجزء في قوله تعالى : {ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا} ظاهره جزء الطير لا واحد من الطيور .
وأما الوجوه التي ذكروها فالجواب عن الأول : أن معنى صرهن قطعهن ، وتعديته بإلى لمكان تضمينه معنى الإمالة كما في قوله تعالى : {الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } [البقرة : 187] ، حيث ضمن معنى الإفضاء .
وعن الثاني : أن جميع الضمائر الأربع راجعة إلى الطيور ، والوجه في رجوع ضمير ادعهن ويأتينك إليها مع أنها غير موجودة بأجزائها وصورها بل هي موجودة بأجزائها فقط هو الوجه في رجوع الضمير إلى السماء مع عدم وجودها إلا بمادتها في قوله تعالى : {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} [فصلت : 11] ، وقوله تعالى : { إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ} [يس : 82] ، وحقيقة الأمر : أن الخطاب اللفظي فرع وجود المخاطب قبل الخطاب ، وأما الخطاب التكويني فالأمر فيه بالعكس ، والمخاطب فيه فرع الخطاب ، فإن الخطاب فيه هو الإيجاد ومن المعلوم أن الوجود فرع الإيجاد ، كما يشير إليه قوله تعالى : {أن نقول له كن فيكون} الآية فقوله فيكون إشارة إلى وجود الشيء المتفرع على قوله كن وهو خطاب الأمر .
وعن الثالث : أنا نختار الشق الثاني وأن السؤال إنما هوعن كيفية فعل الله سبحانه وإحيائه لا عن كيفية قبول المادة وحياتها ، وقوله : إن البشر لا يمكنه أن ينال كنه الإرادة الإلهية التي هي من صفاته كما يدل ظاهر القرآن وعليه المسلمون .
قلنا : إن الإرادة من صفات الفعل المنتزعة منه كالخلق والإحياء ونحوهما ، والذي لا سبيل إليه هو الذات المتعالية كما قال تعالى : {وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا } [طه : 110] .
فالإرادة منتزعة من الفعل ، وهو الإيجاد المتحد مع وجود الشيء ، وهو كلمة كن في قوله تعالى : {أن نقول له كن فيكون} ، وقد ذكر الله في تالي الآية أن هذه الكلمة - كلمة كن - هي ملكوت كل شيء إذ قال : {فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء} الآية ، وقد ذكر الله تعالى أنه أرى إبراهيم ملكوت خلقه إذ قال : "وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين : " الأنعام - 75 ، ومن الملكوت إحياء الطيور المذكورة في الآية .
ومنشأ هذه الشبهة ونظائرها من هؤلاء الباحثين أنهم يظنون أن دعوة إبراهيم (عليه السلام) للطيور في إحيائها ، وقول عيسى (عليه السلام) لميت عند إحيائه : قم بإذن الله وجريان الريح بأمر سليمان وغيرها مما يشتمل عليه الكتاب والسنة إنما هو لأثر وضعه الله تعالى في ألفاظهم المؤلفة من حروف الهجاء ، أوفي إدراكهم التخيلي الذي تدل عليه ألفاظهم نظير النسبة التي بين ألفاظنا العادية ومعانيها وقد خفي عليهم أن ذلك إنما هوعن اتصال باطني بقوة إلهية غير مغلوبة وقدرة غير متناهية هي المؤثرة الفاعلة بالحقيقة .
وعن الرابع : أن التراخي المدلول عليه بقوله : {ثم} كما يناسب معنى التربية والتأنيس كما ذكروه يناسب معنى التقطيع وتفريق الأجزاء ووضعها على الجبال كما هو ظاهر .
وعن الخامس : أن الإشكال مقلوب عليهم فإن الذي ذكروه هو أن الله إنما بين كيفية الإحياء لإبراهيم بالبيان العلمي النظري دون الشهودي ، فيرد عليهم أن المناسب حينئذ ختم الآية بصفة القدرة دون العزة والحكمة ، وقد عرفت مما قدمنا أن الأنسب على ما بيناه من معنى الآية هو الختم بالاسمين : العزيز الحكيم كما في الآية .
ويظهر مما ذكرنا أيضا فساد ما ذكره بعض آخر من المفسرين : أن المراد بالسؤال في الآية إنما هو السؤال عن إشهاد كيفية الإحياء بمعنى كيفية قبول الأجزاء صورة الحياة .
قال : ما محصله : أن السؤال لم يكن في أمر ديني - والعياذ بالله - ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء ليحيط علما بها ، وكيفية الإحياء لا يشترط في الإيمان الإحاطة بصورتها فإبراهيم (عليه السلام) طلب علم لا يتوقف الإيمان على علمه ، ويدل على ذلك ورود السؤال بصيغة كيف ، وموضوعها السؤال عن الحال ، ونظير هذا أن يقول القائل كيف يحكم زيد في الناس ، فهولا يشك أنه يحكم فيهم ، ولكنه سأل عن كيفية حكمه المعلوم ثبوته ، ولوكان سائلا عن ثبوت ذلك لقال : أ يحكم زيد في الناس ، وإنما جاء التقرير أعني قوله ، أ ولم تؤمن ، بعده لأن تلك الصيغة وإن كانت تستعمل ظاهرا في السؤال عن الكيفية كما علمت إلا أنها قد تستعمل أيضا في الاستعجاز كما إذا ادعى مدع : أنه يحمل ثقلا من الأثقال وأنت تعلم بعجزه عن حمله فتقول له : أرني كيف تحمل هذا تريد أنك عاجز عن حمله ، والله سبحانه لما علم براءة إبراهيم (عليه السلام) عن الحوم حول هذا الحمى أراد أن ينطقه في الجواب بما يدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظي في العبارة الأولى لكون إيمانه مخلصا بعبارة تنص عليه بحيث يفهمها كل من سمعها فهما لا يتخالجه فيه شك ، ومعنى الطمأنينة حينئذ سكون القلب عن الجولان في كيفيات الإحياء المحتملة بظهور التصوير المشاهد ، وعدم حصول هذه الطمأنينة قبل لا ينافي حصول الإيمان بالقدرة على الإحياء على أكمل الوجودة ، ورؤية الكيفية لم يزد في إيمانه المطلوب منه شيئا ، وإنما أفادت أمرا لا يجب الإيمان به .
ثم قال بعد كلام له طويل : إن الآية تدل على فضل إبراهيم (عليه السلام) حيث أراه الله سبحانه ما سأله في الحال على أيسر ما يكون من الوجوه ، وأرى عزيرا ما أراه بعد ما أماته مائة عام .
وأنت بالتدبر في الآية والتأمل فيما قدمناه من البيان تعرف سقوط ما ذكره فإن السؤال إنما وقع عن كيفية إحيائه تعالى لا عن كيفية قبول الأجزاء الحياة ثانيا فقد قيل : {كيف تحيي} ، بضم التاء لا بفتحها ، على أن إجراء الأمر على يد إبراهيم (عليه السلام) يدل على ذلك ولوكان السؤال عن كيفية القبول لكفى في ذلك إراءة شيء من الموتى يحييه الله كما في قصة المار على القرية الخاوية في الآية السابقة حيث قال تعالى : {وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما} ، ولم تكن حاجة إلى إجراء الإحياء على يد إبراهيم (عليه السلام) ، وهذا ه والذي أشرنا إليه آنفا : أنهم يقيسون نفوس الأنبياء في تلقيهم المعارف الإلهية ومصدريتهم للأمور الخارقة بنفوسهم العادية فينتج ذلك مثلا : أن لا فرق بين تكون الحياة بيد إبراهيم وتكونه في الخارج بالنسبة إلى حال إبراهيم ، وهذا أمر لا يخطر على بال الباحث عن الحقائق الخبير بها ، لكن هؤلاء لإهمالهم أمر الحقائق وقعوا فيما وقعوا فيه من الفساد ، وكلما أمعنوا في البحث زادوا بعدا عن الحق .
أ لا ترى أنه فسر الطمأنينة بارتفاع الخطورات في الصور المحتملة في التكون والأشكال المتصورة مع أن هذا التردد الفكري من اللغو الذي لا سبيل له إلى ساحة مثل إبراهيم (عليه السلام) ، مع أن الجواب المنقول في الآية لم يأت في ذلك بشيء فإن إبراهيم (عليه السلام) قال : كيف تحيي الموتى؟ فأطلق الموتى وهو يريد موتى الإنسان أو الأعم منه ومن غيره والله سبحانه ما أراه إلا تكون الحياة في أربعة من الطير .
ثم ذكر فضل إبراهيم (عليه السلام) على عزير يريد به صاحب القصة في الآية السابقة بما ذكر فأخذ القصة في الآيتين من نوع واحد وهو السؤال عن الكيفية التي فسرها بما فسرها والجواب عنها ، فاختلط عليه معنى الآيتين جميعا ، مع أن الآيتين جميعا - على ما فيهما من غرر البيان ودقائق المعاني - أجنبيتان عن الكيفية بالمعنى الذي ذكره كل ذلك واضح بالرجوع إلى ما مر فيهما .
على أن المناسب لبيان الكيفية ختم الآية بصفة القدرة لا بصفتي العزة والحكمة كما في قوله تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [فصلت : 39] ، فالآية كما ترى في مقام بيان الكيفية وقد ختمت بصفة القدرة المطلقة ، ونظيره قوله تعالى : {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [الأحقاف : 33] ، ففيه أيضا بيان الكيفية بإراءة الأمثال ثم ختم الكلام بصفة القدرة .
قوله تعالى : قال : {أ ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي} ، بلى كلمة يرد به النفي ولذلك ينقلب به النفي إثباتا كقوله تعالى : {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف : 172] ، ولو قالوا نعم لكان كفرا ، والطمأنينة والاطمينان سكون النفس بعد انزعاجها واضطرابها ، وهو مأخوذ من قولهم : اطمأنت الأرض وأرض مطمئنة إذا كانت فيه انخفاض يستقر فيها الماء إذا سال إليها والحجر إذا هبط إليها .
وقد قال تعالى : {أ ولم تؤمن} ، ولم يقل : أ لم تؤمن للإشعار بأن للسؤال والطلب محلا لكنه لا ينبغي أن يقارن عدم الإيمان بالإحياء : ولو قيل : أ لم تؤمن دل على أن المتكلم تلقى السؤال منبعثا عن عدم الإيمان ، فكان عتابا وردعا عن مثل هذا السؤال ، وذلك أن الواو للجميع ، فكان الاستفهام معه استفهاما عن أن هذا السؤال هل يقارنه عدم الإيمان ، لا استفهاما عن وجه السؤال حتى ينتج عتابا وردعا .
والإيمان مطلق في كلامه تعالى ، وفيه دلالة على أن الإيمان بالله سبحانه لا يتحقق مع الشك في أمر الإحياء والبعث ، ولا ينافي ذلك اختصاص المورد بالإحياء لأن المورد لا يوجب تخصيص عموم اللفظ ولا تقييد إطلاقه .
وكذا قوله تعالى حكاية عنه (عليه السلام) : {ليطمئن قلبي} ، مطلق يدل على كون مطلوبه (عليه السلام) من هذا السؤال حصول الاطمينان المطلق وقطع منابت كل خطور قلبي وأعراقه ، فإن الوهم في إدراكاتها الجزئية وأحكامها لما كانت معتكفة على باب الحس وكان جل أحكامها وتصديقاتها في المدركات التي تتلقاها من طريق الحواس فهي تنقبض عن مطاوعة ما صدقه العقل ، وإن كانت النفس مؤمنة موقنة به ، كما في الأحكام الكلية العقلية الحقة من الأمور الخارجة عن المادة الغائبة عن الحس فإنها تستنكف عن قبولها وإن سلمت مقدماتها المنتجة لها ، فتخطر بالبال أحكاما مناقضة لها ، ثم تثير الأحوال النفسانية المناسبة لاستنكافها فتقوى وتتأيد بذلك في تأثيرها المخالف ، وإن كانت النفس من جهة عقلها موقنة بالحكم مؤمنة بالأمر فلا تضرها إلا أذى ، كما أن من بات في دار مظلمة فيها جسد ميت فإنه يعلم : أن الميت جماد من غير شعور وإرادة فلا يضر شيئا ، لكن الوهم تستنكف عن هذه النتيجة وتستدعي من المتخيلة أن تصور للنفس صورا هائلة موحشة من أمر الميت ثم تهيج صفة الخوف فتتسلط على النفس ، وربما بلغ إلى حيث يزول العقل أو تفارق النفس .
فقد ظهر : أن وجود الخطورات المنافية للعقائد اليقينية لا ينافي الإيمان والتصديق دائما ، غير أنها تؤذي النفس ، وتسلب السكون والقرار منها ، ولا يزول وجود هذه الخواطر إلا بالحس أو المشاهدة ، ولذلك قيل : إن للمعاينة أثرا لا يوجد مع العلم ، وقد أخبر الله تعالى موسى في الميقات بضلال قومه بعبادة العجل فلم يوجب ذلك ظهور غضبه حتى إذا جاءهم وشاهدهم وعاين أمرهم غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه .
وقد ظهر من هنا ومما مر سابقا أن إبراهيم (عليه السلام) ما كان يسأل المشاهدة بالحس الذي يتعلق بقبول أجزاء الموتى الحياة بعد فقدها ، بل إنما كان يسأل مشاهدة فعل الله سبحانه وأمره في إحياء الموتى ، وليس ذلك بمحسوس وإن كان لا ينفك عن الأمر المحسوس الذي هو قبول الأجزاء المادية للحياة بالاجتماع والتصور بصورة الحي ، فهو(عليه السلام) إنما كان يسأل حق اليقين .
قوله تعالى : {قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا} .
صرهن بضم الصاد على إحدى القراءتين من صار يصور إذا قطع أو أمال ، أو بكسر الصاد على القراءة الأخرى من صار يصير بأحد المعنيين ، وقرائن الكلام يدل على إرادة معنى القطع ، وتعديته بإلى تدل على تضمين معنى الإمالة .
فالمعنى : أقطعهن مميلا إليك أو أملهن إليك قاطعا إياهن على الخلاف في التضمين من حيث التقدير .
وكيف كان فقوله تعالى : {خذ أربعة من الطير} "إلخ" ، جواب عن ما سأله إبراهيم (عليه السلام) بقوله : {رب أرني كيف تحيي الموتى} ، ومن المعلوم وجوب مطابقة الجواب للسؤال ، فبلاغة الكلام وحكمة المتكلم يمنعان عن اشتمال الكلام على ما هو لغو زائد لا يترتب على وجوده فائدة عائدة إلى الغرض المقصود من الكلام وخاصة القرآن الذي هو خير كلام ألقاه خير متكلم إلى خير سامع واع ، وليست القصة على تلك البساطة التي تتراءى منها في بادي النظر ، ولوكان كذلك لتم الجواب بإحياء ميت ما كيف كان ، ولكان الزائد على ذلك لغوا مستغنى عنه وليس كذلك ، ولقد أخذ فيها قيود وخصوصيات زائدة على أصل المعنى ، فاعتبر في ما أريد إحياؤه أن يكون طيرا ، وأن يكون حيا ، وأن يكون ذا عدد أربعة ، وأن يقتل ويخلط ويمزج أجزاؤها ، وأن يفرق الأجزاء المختلطة أبعاضا ثم يوضع كل بعض في مكان بعيد من الآخر كقلة هذا الجبل وذاك الحبل ، وأن يكون الإحياء بيد إبراهيم (عليه السلام) نفس السائل بدعوته إياهن ، وأن يجتمع الجميع عنده .
فهذه كما ترى خصوصيات زائدة في القصة ، هي لا محالة دخيلة في المعنى المقصود إفادته ، وقد ذكروا لها وجوها من النكات لا تزيد الباحث إلا عجبا يعلم صحة ما ذكرناه بالرجوع إلى مفصلات التفاسير .
وكيف كان فهذه الخصوصيات لا بد أن تكون مرتبطة بالسؤال ، والذي يوجد في السؤال – وهو قوله : {رب أرني كيف تحيي الموتى} - أمران .
أحدهما : ما اشتمل عليه قوله : {تحيي} وهو أن المسئول مشاهدة الإحياء من حيث إنه وصف لله سبحانه لا من حيث إنه وصف لأجزاء المادة الحاملة للحياة .
وثانيهما : ما اشتمل عليه لفظ الموتى من معنى الجمع فإنه خصوصية زائدة .
أما الأول : فيرتبط به في الجواب إجراء هذا الأمر بيد إبراهيم نفسه حيث يقول : فخذ ، فصرهن ، ثم اجعل ، بصيغة الأمر ويقول ثم ادعهن يأتينك ، فإنه تعالى جعل إتيانهن سعيا وهو الحياة مرتبطا متفرعا على الدعوة ، فهذه الدعوة هي السبب الذي يفيض عنه حياة ما أريد إحياؤه ، ولا إحياء إلا بأمر الله ، فدعوة إبراهيم إياهن بأمر الله ، قد كانت متصلة نحو اتصال بأمر الله الذي منه تترشح حياة الأحياء ، وعند ذلك شاهده إبراهيم ورأى كيفية فيضان الأمر بالحياة ، ولو كانت دعوة إبراهيم إياهن غير متصلة بأمر الله الذي هو أن يقول لشيء أراده : كن فيكون ، كمثل أقوالنا غير المتصلة إلا بالتخيل كان هو أيضا كمثلنا إذ قلنا لشيء كن فلا يكون ، فلا تأثير جزافي في الوجود .
وأما الثاني : فقوله كيف تحيي الموتى تدل على أن لكثرة الأموات وتعددها دخلا في السؤال ، وليس إلا أن الأجساد بموتها وتبدد أجزائها وتغير صورها وتحول أحوالها تفقد حالة التميز والارتباط الذي بينها فتضل في ظلمة الفناء والبوار ، وتصير كالأحاديث المنسية لا خبر عنها في خارج ولا ذهن فكيف تحيط بها القوة المحيية ولا محاط في الواقع .
وهذا هو الذي أورده فرعون على موسى (عليه السلام) وأجاب عنه موسى بالعلم كما حكاه الله تعالى بقوله : {قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} [طه : 52] .
وبالجملة فأجابه الله تعالى بأن أمره بأن يأخذ أربعة من الطير ولعل اختيار الطير لكون هذا العمل فيها أسهل وأقل زمانا فيشاهد حياتها ويرى اختلاف أشخاصها وصورها ، ويعرفها معرفة تامة أولا ، ثم يقتلها ويخلط أجزاءها خلطا دقيقا ثم يجعل ذلك أبعاضا ، وكل بعض منها على جبل لتفقد التميز والتشخص ، وتزول المعرفة ، ثم يدعوهن يأتينه سعيا ، فإنه يشاهد حينئذ أن التميز والتصور بصورة الحياة كل ذلك تابع للدعوة التي تتعلق بأنفسها ، أي إن أجسادها تابعة لأنفسها لا بالعكس فإن البدن فرع تابع للروح لا بالعكس ، بل نسبة البدن إلى الروح بوجه نسبة الظل إلى الشاخص ، فإذا وجد الشاخص تبع وجوده وجود الظل وإلى أي حال تحول الشاخص أو أجزاؤه تبعه فيه الظل حتى إذا انعدم تبعه في الانعدام ، والله سبحانه إذا أوجد حيا من الأحياء ، أو أعاد الحياة إلى أجزاء مسبوقة بالحياة فإنما يتعلق إيجاده بالروح الواجدة للحياة أولا ثم يتبعه أجزاء المادة بروابط محفوظة عند الله سبحانه لا نحيط بها علما فيتعين الجسد بتعين الروح من غير فصل ولا مانع وبذلك يشعر قوله تعالى : {ثم ادعهن يأتينك سعيا} أي مسرعات مستعجلات .
وهذا هو الذي يستفاد من قوله تعالى : { وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (10) قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ} [السجدة : 10 ، 11] ، وقد مر بعض الكلام في الآية في البحث عن تجرد النفس ، وسيأتي تفصيل الكلام في محله إن شاء الله .
فقوله تعالى : فخذ أربعة من الطير إنما أمر بذلك ليعرفها فلا يشك فيها عند إعادة الحياة إليها ولا ينكرها ، وأما هي عليه من الاختلاف والتميز أولا وزوالهما ثانيا ، وقوله : {فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا} أي اذبحهن وبدد أجزاءهن واخلطها ثم فرقها على الجبال الموجودة هناك لتتباعد الأجزاء وهي غير متميزة ، وهذا من الشواهد على أن القصة إنما وقعت بعد مهاجرة إبراهيم من أرض بابل إلى سورية فإن أرض بابل لا جبل بها ، وقوله {ثم ادعهن} ، أي ادع الطيور يا طاووس ويا فلان ويا فلان ، ويمكن أن يستفاد ذلك مضافا إلى دلالة ضمير "هن" الراجعة إلى الطيور من قوله : {ادعهن} ، فإن الدعوة لو كانت لأجزاء الطيور دون أنفسها كان الأنسب أن يقال : ثم نادهن فإنها كانت على جبال بعيدة عن موقفه (عليه السلام) واللفظ المستعمل في البعيد خاصة هو النداء دون الدعاء ، وقوله : {يأتينك سعيا} ، أي يتجسدن واتصفن بالإتيان والإسراع إليك .
قوله تعالى : {واعلم أن الله عزيز حكيم} ، أي عزيز لا يفقد شيئا بزواله عنه ، حكيم لا يفعل شيئا إلا من طريقه اللائق به ، فيوجد الأجساد بإحضار الأرواح وإيجادها دون العكس .
وفي قوله تعالى : {واعلم أن} "إلخ" ، دون أن يقال إن الله "إلخ" ، دلالة على أن الخطور القلبي الذي كان إبراهيم يسأل ربه المشاهدة ليطمئن قلبه من ناحيته كان راجعا إلى حقيقة معنى الاسمين : العزيز الحكيم ، فأفاده الله سبحانه بهذا الجواب العلم بحقيقتهما .
___________________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج2 ، ص312-321 .
تجلّي للمعاد في هذه الدنيا :
يذكر القرآن الكريم حول مسألة المعاد بعد قصة عزير قصةً اُخرى عن إبراهيم (عليه السلام) ليكتمل البحث ، ويذكر معظم المفسّرين والمؤرخين في تفسير هذه الآية الحكاية التالية :
مرّ إبراهيم (عليه السلام) يوماً على ساحل البحر فرأى جيفة مرميّة على الساحل نصفها في الماء ونصفها على الأرض تأكل منها الطيور والحيوانات البرّ والبحر من الجانبين وتتنازع أحياناً فيما بينها على الجيفة ، عند رؤية إبراهيم (عليه السلام) هذا المشهد خطرت في ذهنه مسألة يودّ الجميع لو عرفوا جوابها بالتفصيل ، وهي كيفيّة عودة الأموات إلى الحياة مرّة اُخرى ، ففكّر وتأمّل في نفسه أنّه لو حصل مثل هذا الحادث لبدن الإنسان وأصبح طعاماً لحيوانات كثيرة ، وكان بالتالي جزءً من بدن تلك الحيوانات ، فكيف يحصل البعث ويعود ذلك الجسد الإنساني نفسه إلى الحياة ؟
فخاطب إبراهيم (عليه السلام) ربّه وقال : {ربّ أرني كيف تحيي الموتى} .
فأجابه الله تعالى : أوَلم تؤمن بالمعاد ؟ فقال (عليه السلام) : بلى ولكن ليطمئّن قلبي .
فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور ويذبحها ويخلط لحمها ، ثمّ يقسّمها عدّة أقسام ويضع على كلّ جبل قسماً منها ، ثمّ يدعو الطيور إليه ، وعندئذ سوف يرى مشهد يوم البعث ، فأمتثل إبراهيم للأمر واستولت عليه الدهشة لرؤيته أجزاء الطيور تتجمّع وتأتيه من مختلف النقاط وقد عادت إليها الحياة (2) .
وثمّة تفسير آخر للآية نقله الفخر الرازي (3) عن أحد المفسّرين يدعى (أبو مسلم) يخالف آراء بقيّة المفسّرين ولكنّنا نذكره هنا لئنّ مفسّراً معاصراً وهو صاحب المنار قد اختار هذا الرأي (4) .
يقول هذا المفسّر : ليس في هذه الآية ما يدلّ على أنّ إبراهيم (عليه السلام) ذبح الطيور وبعد ذلك عادت إلى الحياة من جديد بأمر الله تعالى ، بل أنّ الآية في صدد بيان مثال لتوضيح مسألة المعاد ، يعني أنّك يا إبراهيم خذ أربعة من الطير فضمّها إليك حتّى تستأنس بك بحيث تجيب دعوتك إذا دعوتها ، فإنّ الطيور من أشدّ الحيوانات إستعداداً لذلك ، ثمّ إجعل كلّ واحدة منهنّ على جبل ثمّ ادعها ، فإنّها تسرع إليك ، وهذه المسألة اليسيرة بالنسبة لك تماثل في سهولتها ويسرها مسألة إحياء الأموات وجمع إجزائها المتناثرة بالنسبة إلى الله تعالى .
فعلى هذا يكون أمر الله تعالى لإبراهيم (عليه السلام) في الطيور الأربعة لا يعني أن يقدم إبراهيم على هذا العمل حتماً ، بل أنّه مجرّد بيان مثال وتشبيه كأن يقول شخصٌ لآخر لبيان سهولة الأمر عليه : إشرب هذا القدح من الماء حتّى انهي هذا العمل ويريد بذلك بيان سهولته ، لا أنّ الآخر يجب عليه أن يشرب الماء .
وأستدلّ أنصار النظريّة الثانية بكلمة (فصرهنّ إليك) وقالوا إنّ هذه الجملة إذا كانت متعدّية بحرف (إلى) فتكون بمعنى الأنس والميل ، فعلى هذا يكون مفهوم الجملة أنّه (خذ هذه الطيور وآنسهى بك) مضافاً إلى أنّ الضمائر في (صرهنّ) و(منهنّ) و(ادعهنّ) كلّها تعود إلى الطيور ، وهذا لا يكون سليماً إلاّ إذا أخذنا بالتفسير الثاني ، لأنّه على التفسير الأوّل تعود بعض هذه الضمائر على نفس الطيور وتعود البعض الآخر على أجزائها ، وهذا غير مستساغ في الاستعمال .
الجواب على هذه الاستدلالات سيأتي ضمن تفسيرنا للآية الشريفة ولكن ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنّ الآية تبيّن بوضوح هذه الحقيقة ، وهي أنّ إبراهيم(عليه السلام)طلب من الله تعالى المشاهدة الحسيّة للمعاد والبعث لكي يطمئّن قلبه ، ولاشكّ أنّ ضرب المثل والتشبيه لا يجسّد مشهداً ولا يكون مدعاة لتطمين الخاطر ، وفي الحقيقة أنّ إبراهيم كان مؤمناً عقلاً ومنطقاً بالمعاد ، ولكنّه كان يريد أن يدرك ذلك عن طريق الحس أيضاً .
والآن نبدأ بتفسير الآية ليتّضح لنا أيّ التفسيرين أقرب وأنسب : {وإذ قال إبراهيم ربِّ أرني كيف تحيي الموتى} .
سبق أن قلنا إنّ هذه الآية تكملة للآية السابقة في موضوع البعث ، يفيد تعبير {أرني كيف . . .} أنّه طلب الرؤية والشهود عياناً لكيفيّة حصول البعث لا البعث نفسه .
{قال أوَلم تؤمن قال بلى ولكن لِيطمئنَّ قلبي} .
كان من الممكن أن يتصور بعضهم أنّ طلب إبراهيم (عليه السلام) هذا إنّما يدلّ على تزلزل إيمان إبراهيم (عليه السلام) ، ولإزالة هذا التوهّم أوحى إليه السؤال : «أوَلم تؤمن ؟» لكي يأتي جوابه موضحاً الأمر ، ومزيلاً كلّ التباس قد يقع فيه البعض في تلك الحادثة ، لذلك أجاب إبراهيم (عليه السلام) (بلى ولكن ليطمئن قلبي) .
يفهم من هذه الآية أيضاً على أنّ الإستدلالات العملية والمنطقية قد تؤدّي إلى اليقين ولكنها لا تؤدّي إلى اطمئنان القلب ، إنّها ترضي العقل لا القلب ولا العواطف . إنّ ما يستطيع أن يرضي الطرفين هو الشهود العيني والمشاهد الحسيّة . هذا موضوع مهمّ سوف نزيده إيضاحاً في موضعه .
التعبر بالاطمئنان القلبي يدلّ على أن الفكر قبل وصوله إلى مرحلة الشهود يكون دائماً في حالة حركة وتقلَّب ولكن اذا وصل مرحلة الشهود يسكن ويهدأ .
{قال فخذ أربعةً من الطير فصرهنّ إليك ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً} .
«صرهنّ» من «الصَوْر» أي التقطيع ، أو الميل ، أو النداء ، ومعنى التقطيع أنسب . أي خذ أربعة من الطير واذبحهنّ وقطّعهنّ واخلطهنّ .
لقد كان المقصود أن يشاهد إبراهيم (عليه السلام) نموذجاً من البعث وعودة الأموات إلى الحياة بعد أن تلاشت أجسادها . وهذا لا يأتلف مع أملهنّ ولا مع صح بهنّ وعلى الأخصّ ما يأتي بعد ذلك {ثمّ اجعل على كلّ جبل منهنّ جزءاً} وهذا دليل على أنّ الطيور قد قطّعت أوّلاً وصارت أجزاء . ولعلّ الذين قالوا إنّ (صرهنّ إليك) تعني استمالتهنّ وايناسهنّ قد غفلوا عن لفظة «جزءاً» هذه ، وكذلك الهدف من هذا العمل .
وبذلك قام إبراهيم بهذا العمل وعندما دعاهنّ تجمّعت أجزائهنّ المتناثرة وتركبّت من جديد وعادت إلى الحياة ، وهذا الأمر أوضح لإبراهيم (عليه السلام) أنّ المعاد يوم القيامة سيكون كذلك على شكل واسع وبمقياس كبير جدّاً .
ويرى بعضهم أنّ كلمة (سعيّاً) تعني أنّ الطيور بعد أن عادت إليهنّ الحياة لم يطرن ، بل مشين مشياً إلى إبراهيم (عليه السلام) لئنّ السعي هو المشي السريع ، وينقل عن الخليل ابن أحمد الأديب المعروف أنّ إبراهيم (عليه السلام) كان يمشي عندما جاءت إليه الطيور ، أي أنّ (سعياً) حال من إبراهيم لا من الطيور(5) ، ولكن بالرغم من كلّ ذلك فالقرائن تشير إلى أنّ (سعياً) كناية عن الطيران السريع .
_______________________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج2 ، ص107-110 .
2-تفسير العياشي ، ج1 ، ص142 ، بحار الانوار ، ج7 ، ص36 و41 .
3- التفسير الكبير ، ذيل الاية مورد البحث .
4- تفسير المنار ، ذيل الاية مورد البحث .
5- تفسير البحر المحيط ، ج2 ، ص300 ، ذيل الاية مورد البحث ، وتفسير مجمع البيان ، ذيل الاية مورد البحث .
 الاكثر قراءة في سورة البقرة
الاكثر قراءة في سورة البقرة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)