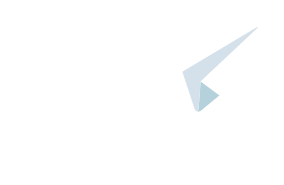تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير الاية (256-257) من سورة البقرة
المؤلف:
اعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
10-5-2017
20001
قال تعالى : { لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [البقرة: 255، 256].
لما تقدم ذكر اختلاف الأمم وأنه لوشاء الله لأكرههم على الدين ثم بين تعالى دين الحق والتوحيد عقبه بأن الحق قد ظهر والعبد قد خير إكراه بقوله {لا إكراه في الدين} وفيه عدة أقوال (أحدها) أنه في أهل الكتاب خاصة الذين يؤخذ منهم الجزية عن الحسن وقتادة والضحاك (وثانيها) أنه في جميع الكفار ثم نسخ كما تقدم ذكره عن السدي وغيره (وثالثها) أن المراد لا تقولوا لمن دخل في الدين بعد الحرب أنه دخل مكرها لأنه إذا رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره عن الزجاج (ورابعها) أنها نزلت في قوم خاص من الأنصار كما ذكرناه في النزول عن ابن عباس وغيره (وخامسها) أن المراد ليس في الدين إكراه من الله ولكن العبد مخير فيه لأن ما هو دين في الحقيقة هومن أفعال القلوب إذا فعل لوجه وجوبه فأما ما يكره عليه من إظهار الشهادتين فليس بدين حقيقة كما أن من أكره على كلمة الكفر لم يكن كافرا والمراد الدين المعروف وهو الإسلام ودين الله الذي ارتضاه.
{قد تبين الرشد من الغي} قد ظهر الإيمان من الكفر والحق من الباطل بكثرة الحجج والآيات الدالة عقلا وسمعا والمعجزات التي ظهرت على يد النبي {فمن يكفر بالطاغوت} فيه أقوال (أحدها) أنه الشيطان عن مجاهد وقتادة وهو المروي عن أبي عبد الله (وثانيها) أنه الكاهن عن سعيد بن جبير (وثالثها) أنه الساحر عن أبي العالية (ورابعها) أنه مردة الجن والإنس وكلما يطغي (وخامسها) أنه الأصنام وما عبد من دون الله وعلى الجملة فالمراد من كفر بما خالف أمر الله.
{ويؤمن بالله} أي يصدق بالله وبما جاءت به رسله {فقد استمسك} أي تمسك واعتصم {بالعروة الوثقى} أي بالعصمة الوثيقة وعقد لنفسه من الدين عقدا وثيقا لا يحله شبهة وعن مجاهد هو الإيمان بالله ورسوله وجرى هذه مجرى المثل لحسن البيان بإخراج ما لا يقع به الإحساس إلى ما يقع به {لا انفصام لها} أي لا انقطاع لها يعني كما لا ينقطع أمر من تمسك بالعروة كذلك لا ينقطع أمر من تمسك بالإيمان {والله سميع} لأقوالكم {عليم} بضمائركم .
ولما ذكر سبحانه المؤمن والكافر بين ولي كل واحد منهما فقال {الله ولي الذين آمنوا} أي نصيرهم ومعينهم في كل ما بهم إليه الحاجة وما فيه لهم الصلاح من أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم {يخرجهم من الظلمات إلى النور} أي من ظلمات الضلالة والكفر إلى نور الهدى والإيمان لأن الضلال والكفر في المنع من إدراك الحق كالظلمة في المنع من إدراك المبصرات ووجه إخراج الله تعالى المؤمنين من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والطاعة هو أنه هداهم إليه ونصب الأدلة لهم عليه ورغبهم فيه وفعل بهم من الألطاف ما يقوي به دواعيهم إلى فعله لأنا قد علمنا أنه لولا هذه الأمور لم يخرجوا من الكفر إلى الإيمان فصح إضافة الإخراج إليه تعالى لكون هذه الأمور التي عددناها من جهة الله تعالى كما يصح من أحدنا إذا أشار إلى غيره بدخول بلد من البلدان ورغبة فيه وعرفه ما له فيه من الصلاح أن يقول أنا أدخلت فلانا البلد الفلاني وأنا أخرجته من كذا وكذا.
{والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت} أي : متولي أمورهم وأنصارهم الطاغوت والطاغوت هاهنا واحد أريد به الجميع وهذا جائز في اللغة إذا كان في الكلام دليل على الجماعة قال الشاعر :
بها جيف الحسرى فأما عظامها *** فبيض وأما جلدها فصليب(2)
فجلدها في معنى جلودها وقال العباس بن مرداس :
فقلنا أسلموا وأنا أخوكم *** فقد فرئت من الإحن الصدور(3)
والمراد به الشيطان عن ابن عباس وقيل رؤساء الضلالة عن مقاتل {يخرجونهم من النور إلى الظلمات} أي من نور الإيمان والطاعة والهدى إلى ظلمات الكفر والمعصية والضلالة وأضاف إخراجهم من النور إلى الظلمات إلى الطواغيت على ما تقدم ذكره من أنهم يغوونهم ويدعونهم إلى ذلك ويزينون فعله لهم فصح إضافته إليهم وهذا يدل على بطلان برهان قول من قال إن الإضافة الأولى تقتضي أن الإيمان من فعل الله تعالى بالمؤمن لأنه لوكان كذلك لاقتضت الإضافة الثانية أن الكفر من فعل الشيطان.
وعندهم لا فرق بين الأمرين في أنهما من فعله تعالى عن ذلك وأيضا فلوكان الأمر على ما ظنوا لما صار الله تعالى وليا للمؤمنين وناصرا لهم على ما اقتضته الآية والإيمان من فعله لا من فعلهم ولما كان خاذلا للكفار ومضيفا لولايتهم إلى الطاغوت والكفر من فعله فيهم ولم يفصل بين الكافر والمؤمن وهو المتولي لفعل الأمرين فيهما ومثل هذا لا يخفى على منصف فإن قيل كيف يخرجونهم من النور وهم لم يدخلوا فيه قلنا قد ذكر فيه وجهان (أحدهما) أن ذلك يجري مجرى قول القائل أخرجني والدي من ميراثه فمنعه من الدخول فيه إخراج ومثله قوله في قصة يوسف إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ولم يكن فيها قط وقوله ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وقال الشاعر :
فإن تكن الأيام أحسن مرة *** إلى فقد عادت لهن ذنوب
ولم يكن لها ذنوب قبل ذلك والوجه الآخر أنه في قوم ارتدوا عن الإسلام عن مجاهد والأول أقوى وقوله {أولئك أصحاب النار} إلى آخره قد مضى تفسيره .
_________________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج2 ، ص163-166.
2- الحسرى : جمع الحسير.
3- الاحن كعنب جمع الاحنة : الحقد.
{لا إِكْراهً فِي الدِّينِ} . لو نظرنا إلى هذه الكلمة مستقلة عن السياق لفهمنا منها ان اللَّه سبحانه لم يشرع حكما فيه شائبة الإكراه ، وان ما يكره عليه الإنسان من أقوال أو أفعال لا يترتب عليه أي شيء في نظر الشرع لا في الدنيا ، ولا في الآخرة . . ولكن قوله تعالى : {قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} الذي هو تعليل لعدم الإكراه يعين ان في هنا بمعنى على ، أي الإكراه على الدين ، مثل {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71]. أي على جذوع النخل . . وعليه يكون المعنى ان الإسلام لا يلزم أحدا باعتناقه قسرا واجبارا ، وانما يلزم الجاحد بالحجة والبرهان فقط : {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ } [الكهف: 29]: {أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} [يونس: 99].
وتسأل : ان الدين لا يمكن أن يتعلق به إكراه ، لأنه من شؤون القلب الخارجة عن القدرة ، تماما كالتصورات الذهنية ، وانما يتعلق الإكراه بالأقوال والأفعال التي يمكن صدورها عن إرادة القائل والفاعل . . إذن ، ما هو الوجه المسوغ للنهي عن الإكراه على الدين ؟ .
الجواب : ان قوله تعالى : {لا إِكْراهً فِي الدِّينِ} . جاء بصيغة الاخبار فان كان هو المراد فلا يتجه السؤال من الأساس ، حيث يكون المعنى ان الدين هو الاعتقاد ، وهو أمر يرجع إلى الاقتناع الذي لا إكراه عليه . . وان كان المراد به الإنشاء والنهي عن الإكراه في الدين يكون المعنى أيها المسلمون لا تكرهوا أحدا على قول : لا إله إلا اللَّه ، محمد رسول اللَّه بعد أن قامت الدلائل والبينات على التوحيد والنبوة .
ولكن يتولد من هذا الجواب سؤال جديد ، وهوان هذا لا يجتمع مع قول الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله) : (أمرت ان أقاتل الناس ، حتى يقولوا : لا إله إلا اللَّه ، فان قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم) .
وجوابه : ان الإسلام أجاز القتال لأسباب : منها الدفاع عن النفس ، قال تعالى : {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ } [البقرة: 190] . ومنها البغي قال تعالى : { فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9]. ومنها اظهار الإسلام ، ولو باللسان من المعاندين له وللمسلمين ، لمصلحة تعود على الجميع ، لا على المسلمين وحدهم ، وهذه المصلحة يقدرها المعصوم ، أو نائبه ، ولا يجوز لأي مسلم كائنا من كان أن يقاتل من أجل النطق بكلمة الإسلام ، أو انتشارها إلا بأمر المعصوم ، أومن ينوب عنه ، وهو الحاكم المجتهد العادل ، وعلى هذه الصورة وحدها يحمل حديث : (أمرت أن أقاتل الناس) . أي اني أقاتلهم حين أرى أنا أومن يقوم مقامي ان مصلحة الانسانية تحتم القتال من أجل كلمة لا إله إلا اللَّه ، وفيما عدا ذلك لا يجوز لأحد كائنا من كان ان يكره أحدا على قول لا إله إلا اللَّه . . وتجمل الإشارة إلى ان القتال دفاعا عن النفس ، أوعن الدين والحق لا يتوقف على إذن الحاكم ولا غيره . وتقدم الكلام عن ذلك في تفسير الآية 193 ، فقرة الإسلام حرب على الظلم والفساد .
{قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} . لقد بين اللَّه سبحانه الحق بأوضح بيان ، وأقوى برهان ، حتى لم يبق حجة لكافر ، ولا عذرا لمعتذر . . ومن عرف طريق الرشد والحق عرف طريق الغي والباطل ، إذ لا شيء بعد الحق الا الضلال .
قال الملا صدرا ما توضيحه : ان معنى تبيين الرشد من الغي هو تمييز الحق من الباطل ، والايمان من الكفر بالأدلة والبراهين ، مع تفهمها وتدبرها ، أما من يعتقد بالحق عن تقليد فلا فرق بينه وبين الحيوان إلا الاعتقاد . . أجل ، ان من يقتدي بالصالحين عن صدق نية ، وصفاء طوية يناله نصيب مما ينالونه غدا .
{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ويُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها} .
تعددت الأقوال في تفسير الطاغوت ، وقد أنهاها بعض المفسرين إلى تسعة ، منها ان المراد به الشيطان ، ومنها الدنيا الدنية ، وأقربها إلى الفهم ، ودلالة اللفظ تفسير الشيخ محمد عبده ، وهوان الطاغوت ما تكون عبادته والايمان به سببا للطغيان والخروج عن الحق ، والمراد من الاستمساك بالعروة الوثقى السير على الصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ، تماما كالمتعلق بعروة هي أوثق العرى وأحكمها ، والمراد بلا انفصام لها قوتها وعدم انقطاعها ، ومحصل المعنى ان الايمان باللَّه عروة وثيقة متينة لا تنقطع أبدا ، وان المتمسك بها لا يضل طريق النجاة ، وفي صحيح مسلم ان رسول اللَّه قال : اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ، أحدهما أعظم من الآخر ، وهو كتاب اللَّه حبل ممدود من السماء إلى الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، لن يفترقا ، حتى يردا عليّ الحوض .
ورواه الترمذي أيضا .
ولكن في زماننا ترك الأمران معا ، واليه أشار الإمام علي (عليه السلام) بقوله : يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ، ومن الإسلام إلا اسمه .
{واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} . يسمع كلمة التوحيد من المؤمنين ، وقول الكفر من الكافرين ، ويعلم ما في قلب الاثنين ، ويجزي كلا بأعماله .
{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ} . اختلف المفسرون في المراد من هذه الآية اختلافا كبيرا ، وتولد من بعض الأقوال إشكالات عقائدية ، حتى قال الملا صدرا : ان في المقام اشكالا عظيما يعسر حله على ذوي الافهام ، وقال الشيخ محمد عبده : ان بعض التفاسير هي من تفسير العوام الذين لا يفهمون أساليب اللغة العالية ، أو تفسير الأعاجم الذين هم أجدر بعدم الفهم .
أما السبب لاختلاف المفسرين ، وما تولد منه من الإشكالات فهوانهم فهموا من الآية ان اللَّه سبحانه يتولى ويدبر أمور المؤمنين دون غيرهم ، لا ان المؤمنين هم الذين يتخذونه وليا لهم دون غيره ، والفرق كبير بين المعنيين ، ومن هنا ورد الاشكال على فهم المفسرين بأن ولاية اللَّه وعنايته تشمل جميع الخلائق على نسق واحد ، لا المؤمنين فقط .
وكيف كان ، فان أقوال المفسرين ، أو أكثرهم لا تلتئم مع السياق ، وان المعنى السليم الذي لا ترد عليه أية شبهة ، ويلتئم مع قوله تعالى : {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ويُؤْمِنْ بِاللَّهِ} الخ هوان المؤمنين لا يتخذون لهم وليا من دون اللَّه ، ولا يجعلون لأحد سلطانا عليهم الا له وحده . . إليه يلجئون ، وبكتابه وسنة نبيه يهتدون في عقائدهم ، وجميع أقوالهم وأفعالهم ، ولا يثقون بأهل الضلالة والطغيان ، مهما علت منزلتهم . . على العكس من الكافرين الذين يتخذون الطاغوت أولياء لهم من دون اللَّه .
وليس من شك ان من آمن باللَّه ، وصمم على طاعته والاهتداء بآياته وبيناته عن صدق واخلاص فإنه يسلم بتوفيق اللَّه وعنايته من ظلمة البدع والضلالات ، والأهواء والجهالات ، ويستضئ بنور المعرفة الحقة ، والايمان الصحيح ، وهذا هو معنى يخرجهم من الظلمات إلى النور .
{والَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ} . قال الرازي : {الطاغوت مصدر كالملكوت ، ويقع على المفرد والجمع} وعليه فلا يرد السؤال ، أو الاشكال بأن المناسب أن يلائم بين لفظه ولفظ الأولياء ، فيقول : أولياؤهم الطواغيت ، أو وليهم الطاغوت . والمعنى ان الكافرين يتخذون أهل الضلالة والطغيان أولياء لهم من دون اللَّه ، فيأتمرون بأمرهم ، وينتهون بنهيهم ، وهؤلاء يسيرون بهم في طريق المهالك ، ويخرجونهم من نور العقل والفطرة إلى ظلمات الكفر والبدع .
الخلود في النار :
نص القرآن الكريم في أكثر من آية على ان نوعا من العصاة مخلدون في النار ، وبين ان من هذا النوع من كفر باللَّه وكذب بآياته ، قال جلت كلمته : { وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 39]. ومن قتل مؤمنا متعمدا ، قال جل جلاله : {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا } [النساء: 93] . {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا } [النساء: 14]. ومن أحاطت به خطيئته : {بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } [البقرة: 81].
وليس من شك ان اللَّه بموجب عدله لا يعذب الا من يستحق العذاب ، وان عذابه يختلف شدة وضعفا على حسب الجريمة والمعصية ، فجريمة من سعى في الأرض فسادا ، وأهلك الحرث والنسل غير جريمة من سرق درهما ، أو استغاب منافسا له في المهنة ، ومع هذا لنا أن نتساءل : ان في خلود الإنسان في النار إلى ما لا نهاية ، تقذف رأسه بشرر كالقصر ، وتلهب ظهره بمقامع من حديد ، وتملأ جوفه بماء الصديد ، ثم لا يقضى عليه فيستريح ، ولا يخفف عنه فيسترد بعض أنفاسه ، وهو على ما هومن الضعف تؤلمه البقة ، وتقتله الشرقة ، وتنتنه العرقة ، كما قال علي أمير المؤمنين (عليه السلام) ، نتساءل : هل هذا الأليم العظيم من العذاب لهذا العاجز الضعيف يلتئم مع ذات اللَّه التي هي محض الخير والرحمة ، والكرم والامتنان ، واللطف والإحسان ؟ . . ومن المعقول أن يعذب إلى حين ، أو يحرم إطلاقا من النعيم . . أما هكذا أبدا كلما نضجت جلودهم بدّلهم جلودا غيرها ، دون انقطاع وبلا فترة استراحة ، أما هكذا أبدا ودائما فمحل تساؤل .
وإذا قال قائل : وأي عذاب مهما كان نوعه ، وطال أمده يكثر على قاتل الحسين بن علي (عليه السلام) ، أو على من ألقى قنبلة ذرية أو هيدروجينية على شعب فأفناه بكامله ، أو على من سن سنة سيئة طال أمدها ، وكثرت مفاسدها ؟
قلنا في جوابه : أجل ، لا يكثر على من ذكرت أي أليم من العذاب ، ولكن ليس كل العصاة {يزيد} ، ولا كل القنابل ذرية وهيدروجينية ، ولا كل السنن
تفرق الناس شيعا وأحزابا متناحرة . . ولكن السؤال لم يقع عن هؤلاء ومن إليهم بل عن تخليد من هو دونهم بمراتب ومراتب .
وتقول : وما ذا تصنع بنصوص القرآن والسنة النبوية على التخليد بالنار ؟ .
وأجيب : لا شيء منها يرفض التأويل و يأباه .
وتقول ثانية : كل ما جاء به النص ، وكان الأخذ به ممكنا يجب بقاؤه على ظاهره ، وتخليد بعض العصاة في النار ليس محالا في ذاته ؟
وأقول : أجل ، ولكن حمل الخلود على طول الأمد ، دون الأبد جمعا بين النص ، وبين أدلة الرحمة لا تأباه الصناعة ، ولا يرفضه الشرع والعقل .
وتقول مرة ثالثة : ان الفقهاء لا يرتضون هذا الجواب ، لأنهم لا يجيزون حمل اللفظ على غير ظاهره الا بأسباب ثلاثة : قرينة عرفية ، كحمل العام على الخاص ، أو شرعية ، كالنقل الصريح الثابت عن المعصوم ، أو عقلية لا تقبل احتمال الخلاف ، ولا شيء منها فيما نحن فيه .
الجواب أولا : أحسب ان الفقهاء الذين اطلعوا على أدلة رحمة اللَّه تعالى يوافقونني على انها تصلح لصرف أدلة الخلود في النار عن ظاهرها بالنسبة إلى بعض العصاة . . ومن تلك الأدلة الحديث القدسي : سبقت رحمتي غضبي ، والحديث الشريف : ان الشفعاء يوم القيامة كثيرون ، وآخر من يشفع هو أرحم الراحمين . . وان اللَّه ينشر رحمته يوم القيامة ، حتى يطمع بها إبليس ، ويمتد لها عنقه . . وفي بعض الروايات : ان الحسن البصري قال : ليس العجب ممن هلك كيف هلك ، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا ، فقال الإمام زين العابدين (عليه السلام) : أما أنا فأقول : ليس العجب ممن نجا كيف نجا ، وانما العجب ممن هلك كيف هلك ، مع سعة رحمة اللَّه . فإذا عطفنا هذه الروايات على الآية 53 من سورة الزمر :
{قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهً يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً} . إذا عطفنا روايات الرحمة على هذه الآية تشكل لدينا قرينة قطعية على صرف أدلة الخلود في النار عن ظاهرها واختصاصها ببعض العصاة .
ثانيا : نحن نتكلم في الأمور العقائدية القطعية ، لا في المسائل الفرعية الظنية ، والفقهاء على ورعهم وقوة ايمانهم فإنهم علماء بأحكام اللَّه الشرعية ، لا بالأمور العقائدية ، بل ان الكثير منهم بمنزلة المقلدين فيما يعود إلى صفات اللَّه وأفعاله ، أما فيما يعود إلى الأدلة على وجود الباري سبحانه فيعلمون منها دليل الدور والتسلسل ، والبعرة والبعير (ملحوظة نحن من القائلين بصحة التقليد في أصول العقائد ، مع موافقتها للواقع) .
ثالثا : ان العقل يستقبح الخلف بالوعد دون الوعيد ، فإذا قلت لآخر : سأحسن إليك ، ثم أخلفت كنت ملوما عند العقل والعقلاء ، أما إذا قلت لمن يلزمه أداء حقك : سآخذ حقي منك ، ثم سامحت وصفحت ، فأنت ممدوح عند اللَّه والناس ، بخاصة إذا كان من له الحق غنيا عنه ، ومن عليه الحق فقيرا إلى التسامح ، واللَّه غني عن العالمين وعذابهم ، وهم في أمس الحاجة إلى رحمته وعفوه .
سؤال رابع وأخير : بماذا تؤول آيات الخلود في النار ؟ . وعلى أي معنى تحملها ؟ .
الجواب : يمكن حملها على طول الأمد ، لا على الأبد ، أو على البقاء في النار من غير عذاب ، تماما كخيمة حاتم الطائي (2) أو وجود إبراهيم في النار ، ويعزز هذا ما جاء في بعض الأحاديث ان بعض أهل النار يتلاعبون بجمراتها كالأكرة ، ويقذف بها بعضهم بعضا . وليس من شك ان هذه اللعبة لا تجتمع أبدا مع خفيف العذاب فضلا عن شدته ، وليس على اللَّه بعزيز أن يجعل النار بردا وسلاما على غير إبراهيم كما جعلها على إبراهيم (عليه السلام) . قال محيي الدين ابن العربي في الجزء الثاني من كتاب الفتوح المكية ص 127 : (لا يبقى في النار موحد ممن بعث إليه رسول اللَّه (صلى الله عليه واله) ، لأن النار ترجع بردا وسلاما على الموحدين ببركة أهل البيت في الآخرة ، فما أعظم بركة أهل البيت) .
______________________
1- الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج1 ، ص396-402.
2- في بعض الروايات ان حاتما يدخل النار لكفره ، ولكنه في خيمة تقيه حرها لكرمه .
قوله تعالى: {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي}، الإكراه هو الإجبار والحمل على الفعل من غير رضى، والرشد بالضم والضمتين: إصابة وجه الأمر ومحجة الطريق ويقابله الغي، فهما أعم من الهدى والضلال، فإنهما إصابة الطريق الموصل وعدمها على ما قيل، والظاهر أن استعمال الرشد في إصابة محجة الطريق من باب الانطباق على المصداق، فإن إصابة وجه الأمر من سالك الطريق أن يركب المحجة وسواء السبيل، فلزومه الطريق من مصاديق إصابة وجه الأمر، فالحق أن معنى الرشد والهدى معنيان مختلفان ينطبق أحدهما بعناية خاصة على مصاديق الآخر وهو ظاهر، قال تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا } [النساء: 6] ، وقال تعالى: { وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ} [الأنبياء: 51] ، وكذلك القول في الغي والضلال، ولذلك ذكرنا سابقا: أن الضلال هو العدول عن الطريق مع ذكر الغاية والمقصد، والغي هو العدول مع نسيان الغاية فلا يدري الإنسان الغوي ما ذا يريد وماذا يقصد.
وفي قوله تعالى: {لا إكراه في الدين}، نفى الدين الإجباري، لما أن الدين وهو سلسلة من المعارف العلمية التي تتبعها أخرى عملية يجمعها أنها اعتقادات، والاعتقاد والإيمان من الأمور القلبية التي لا يحكم فيها الإكراه والإجبار، فإن الإكراه إنما يؤثر في الأعمال الظاهرية والأفعال والحركات البدنية المادية، وأما الاعتقاد القلبي فله علل وأسباب أخرى قلبية من سنخ الاعتقاد والإدراك، ومن المحال أن ينتج الجهل علما، أو تولد المقدمات غير العلمية تصديقا علميا، فقوله: {لا إكراه في الدين}، إن كان قضية إخبارية حاكية عن حال التكوين أنتج حكما دينيا بنفي الإكراه على الدين والاعتقاد، وإن كان حكما إنشائيا تشريعيا كما يشهد به ما عقبه تعالى من قوله: {قد تبين الرشد من الغي}، كان نهيا عن الحمل على الاعتقاد والإيمان كرها، وهو نهي متك على حقيقة تكوينية، وهي التي مر بيانها أن الإكراه إنما يعمل ويؤثر في مرحلة الأفعال البدنية دون الاعتقادات القلبية.
وقد بين تعالى هذا الحكم بقوله: {قد تبين الرشد من الغي}، وهو في مقام التعليل فإن الإكراه والإجبار إنما يركن إليه الأمر الحكيم والمربي العاقل في الأمور المهمة التي لا سبيل إلى بيان وجه الحق فيها لبساطة فهم المأمور ورداءة ذهن المحكوم، أو لأسباب وجهات أخرى، فيتسبب الحاكم في حكمه بالإكراه أو الأمر بالتقليد ونحوه، وأما الأمور المهمة التي تبين وجه الخير والشر فيها، وقرر وجه الجزاء الذي يلحق فعلها وتركها فلا حاجة فيها إلى الإكراه، بل للإنسان أن يختار لنفسه ما شاء من طرفي الفعل وعاقبتي الثواب والعقاب، والدين لما انكشفت حقائقه واتضح طريقه بالبيانات الإلهية الموضحة بالسنة النبوية فقد تبين أن الدين رشد والرشد في اتباعه، والغي في تركه والرغبة عنه، وعلى هذا لا موجب لأن يكره أحد أحدا على الدين.
وهذه إحدى الآيات الدالة على أن الإسلام لم يبتن على السيف والدم، ولم يفت بالإكراه والعنوة على خلاف ما زعمه عدة من الباحثين من المنتحلين وغيرهم أن الإسلام دين السيف استدلوا عليه: بالجهاد الذي هو أحد أركان هذا الدين.
وقد تقدم الجواب عنه في ضمن البحث عن آيات القتال وذكرنا هناك أن القتال الذي ندب إليه الإسلام ليس لغاية إحراز التقدم وبسط الدين بالقوة والإكراه، بل لإحياء الحق والدفاع عن أنفس متاع للفطرة وهو التوحيد،، وأما بعد انبساط التوحيد بين الناس وخضوعهم لدين النبوة ولو بالتهود والتنصر فلا نزاع لمسلم مع موحد ولا جدال، فالإشكال ناش عن عدم التدبر.
ويظهر مما تقدم أن الآية أعني قوله: {لا إكراه في الدين} غير منسوخة بآية السيف كما ذكره بعضهم.
ومن الشواهد على أن الآية غير منسوخة التعليل الذي فيها أعني قوله: {قد تبين الرشد من الغي}، فإن الناسخ ما لم ينسخ علة الحكم لم ينسخ نفس الحكم، فإن الحكم باق ببقاء سببه، ومعلوم أن تبين الرشد من الغي في أمر الإسلام أمر غير قابل للارتفاع بمثل آية السيف، فإن قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ } [التوبة: 5] مثلا، أو قوله: { وقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ } [آل عمران: 167] الآية لا يؤثران في ظهور حقية الدين شيئا حتى ينسخا حكما معلولا لهذا الظهور.
وبعبارة أخرى الآية تعلل قوله: {لا إكراه في الدين} بظهور الحق: وهو معنى لا يختلف حاله قبل نزول حكم القتال وبعد نزوله، فهو ثابت على كل حال، فهو غير منسوخ.
قوله تعالى: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى} "إلخ"، الطاغوت هو الطغيان والتجاوز عن الحد ولا يخلو عن مبالغة في المعنى كالملكوت والجبروت، ويستعمل فيما يحصل به الطغيان كأقسام المعبودات من دون الله كالأصنام والشياطين والجن وأئمة الضلال من الإنسان وكل متبوع لا يرضى الله سبحانه باتباعه، ويستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والتثنية والجمع.
وإنما قدم الكفر على الإيمان في قوله: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله}، ليوافق الترتيب الذي يناسبه الفعل الواقع في الجزاء أعني الاستمساك بالعروة الوثقى، لأن الاستمساك بشيء إنما يكون بترك كل شيء والأخذ بالعروة، فهناك ترك ثم أخذ، فقدم الكفر وهو ترك على الإيمان وهو أخذ ليوافق ذلك، والاستمساك هو الأخذ والإمساك بشدة، والعروة: ما يؤخذ به من الشيء كعروة الدلو وعروة الإناء، والعروة هي كل ما له أصل من النبات وما لا يسقط ورقه، وأصل الباب التعلق يقال: عراه واعتراه أي تعلق به.
والكلام أعني قوله: {فقد استمسك بالعروة الوثقى}، موضوع على الاستعارة للدلالة على أن الإيمان بالنسبة إلى السعادة بمنزلة عروة الإناء بالنسبة إلى الإناء وما فيه، فكما لا يكون الأخذ أخذا مطمئنا حتى يقبض على العروة كذلك السعادة الحقيقية لا يستقر أمرها ولا يرجى نيلها إلا أن يؤمن الإنسان بالله ويكفر بالطاغوت.
قوله تعالى: {لا انفصام لها والله سميع عليم}، الانفصام: الانقطاع والانكسار، والجملة في موضع الحال من العروة تؤكد معنى العروة الوثقى، ثم عقبه بقوله: {والله سميع عليم}، لكون الإيمان والكفر متعلقا بالقلب واللسان.
قوله تعالى: {الله ولي الذين آمنوا يخرجهم} إلى آخر الآية، قد مر شطر من الكلام في معنى إخراجه من النور إلى الظلمات، وقد بينا هناك أن هذا الإخراج وما يشاكله من المعاني أمور حقيقية غير مجازية خلافا لما توهمه كثير من المفسرين وسائر الباحثين أنها معان مجازية يراد بها الأعمال الظاهرية من الحركات والسكنات البدنية، وما يترتب عليها من الغايات الحسنة والسيئة، فالنور مثلا هو الاعتقاد الحق بما يرتفع به ظلمة الجهل وحيرة الشك واضطراب القلب، والنور هو صالح العمل من حيث إن رشده بين، وأثره في السعادة جلي، كما أن النور الحقيقي على هذه الصفات.
والظلمة هو الجهل في الاعتقاد والشبهة والريبة وطالح العمل، كل ذلك بالاستعارة.
والإخراج من الظلمة إلى النور الذي ينسب إلى الله تعالى كالإخراج من النور إلى الظلمات الذي ينسب إلى الطاغوت نفس هذه الأعمال والعقائد فليس وراء هذه الأعمال والعقائد، لا فعل من الله تعالى وغيره كالإخراج مثلا ولا أثر لفعل الله تعالى وغيره كالنور والظلمة وغيرهما، هذا ما ذكره قوم من المفسرين والباحثين.
وذكر آخرون: أن الله يفعل فعلا كالإخراج من الظلمات إلى النور وإعطاء الحياة والسعة والرحمة وما يشاكلها ويترتب على فعله تعالى آثار كالنور والظلمة والروح والرحمة ونزول الملائكة، لا ينالها أفهامنا ولا يسعها مشاعرنا، غير أنا نؤمن بحسب ما أخبر به الله – وهو يقول الحق - بأن هذه الأمور موجودة وأنها أفعال له تعالى وإن لم نحط بها خبرا، ولازم هذا القول أيضا كالقول السابق أن يكون هذه الألفاظ أعني أمثال النور والظلمة والإخراج ونحوها مستعملة على المجاز بالاستعارة، وإنما الفرق بين القولين أن مصاديق النور والظلمة ونحوهما على القول الأول نفس أعمالنا وعقائدنا، وعلى القول الثاني أمور خارجة عن أعمالنا وعقائدنا لا سبيل لنا إلى فهمها، ولا طريق إلى نيلها والوقوف عليها.
والقولان جميعا خارجان عن صراط الاستقامة كالمفرط والمفرط، والحق في ذلك أن هذه الأمور التي أخبر الله سبحانه بإيجادها وفعلها عند الطاعة والمعصية إنما هي أمور حقيقية واقعية من غير تجوز غير أنها لا تفارق أعمالنا وعقائدنا بل هي لوازمها التي في باطنها، وقد مر الكلام في ذلك، وهذا لا ينافي كون قوله تعالى: {يخرجهم من الظلمات إلى النور}، وقوله تعالى: {يخرجونهم من النور إلى الظلمات}، كنايتين عن هداية الله سبحانه وإضلال الطاغوت، لما تقدم في بحث الكلام أن النزاع في مقامين: أحدهما كون النور والظلمة وما شابههما ذا حقيقة في هذه النشأة أو مجرد تشبيه لا حقيقة له، وثانيهما: أنه على تقدير تسليم أن لها حقائق وواقعيات هل استعمال اللفظ كالنور مثلا في الحقيقة التي هي حقيقة الهداية حقيقة أو مجاز؟ وعلى أي حال فالجملتان أعني: قوله تعالى: {يخرجهم من الظلمات إلى النور}، وقوله تعالى: {يخرجونهم من النور إلى الظلمات}، كنايتان عن الهداية والإضلال وإلا لزم أن يكون لكل من المؤمن والكافر نور وظلمة معا، فإن لازم إخراج المؤمن من الظلمة إلى النور أن يكون قبل الإيمان في ظلمة وبالعكس في الكافر، فعامة المؤمنين والكفار - وهم الذين عاشوا مؤمنين فقط أو عاشوا كفارا فقط - إذا بلغوا مقام التكليف فإن آمنوا خرجوا من الظلمات إلى النور، وإن كفروا خرجوا من النور إلى الظلمات، فهم قبل ذلك في نور وظلمة معا وهذا كما ترى.
لكن يمكن أن يقال: إن الإنسان بحسب خلقته على نور الفطرة، هو نور إجمالي يقبل التفصيل، وأما بالنسبة إلى المعارف الحقة والأعمال الصالحة تفصيلا فهو في ظلمة بعد لعدم تبين أمره، والنور والظلمة بهذا المعنى لا يتنافيان ولا يمتنع اجتماعهما، والمؤمن بإيمانه يخرج من هذه الظلمة إلى نور المعارف والطاعات تفصيلا، والكافر بكفره يخرج من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر والمعاصي التفصيلية، والإتيان بالنور مفردا وبالظلمات جمعا في قوله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله تعالى: يخرجونهم من النور إلى الظلمات، للإشارة إلى أن الحق واحد لا اختلاف فيه كما أن الباطل متشتت مختلف لا وحدة فيه، قال تعالى: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ } [الأنعام: 153].
__________________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج2 ، ص291-295.
الدين ليس إجباريّاً :
إنّ آية الكرسيّ في الواقع هي مجموعة من توحيد الله تعالى وصفاته الجمالية والجلالية التي تشكّل أساس الدين، وبما أنّها قابلة للأستدلال العقلي في جميع المراحل وليست هناك حاجة للإجبار والإكراه تقول هذه الآية : {لا إكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي}.
(الرشد) لغوياً تعني الهداية للوصول إلى الحقيقة، بعكس (الغيّ) التي تعني الانحراف عن الحقيقة والإبتعاد عن الواقع.
ولمّا كان الدين يهتّم بروح الإنسان وفكره ومبنيّ على أساس من الإيمان واليقين، فليس له إلاّ طريق المنطق والاستدلال وجملة : {لا إكراه في الدين} في الواقع إشارة إلى هذا المعنى، مضافاً إلى أنّ المستفاد من شأن نزول هذه الآية وأنّ بعض الجهلاء طلبوا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقوم بتغيير عقائد الناس بالإكراه والجبر فجاءت الآية جواباً لهؤلاء وأنّ الدين ليس من الاُمور التي تفرض بالإكراه والإجبار وخاصّة مع كلّ تلك الدلائل الواضحة والمعجزات البيّنة التي أوضحت طريق الحقّ من طريق الباطل، فلا حاجة لأمثال هذه الاُمور.
وهذه الآية ردٌّ حاسم على الذين يتهمّون الإسلام بأنّه توسّل أحياناً بالقوّة وبحدّ السيف والقدرة العسكرية في تقدّمه وإنتشاره، وعندما نرى أنّ الإسلام لم يسوّغ التوسل بالقوّة والإكراه في حمل الوالد لولده على تغيير عقيدته الدينيّة فإنّ واجب الآخرين بهذا الشأن يكون واضحاً، إذ لوكان حمل الناس على تغيير أديانهم بالقوّة والإكراه جائزاً في الإسلام، لكان الأولى أن يجيز للأب ذلك لحمل إبنه على تغيير دينه، في حين أنّه لم يعطه مثل هذا الحقّ.
ومن هنا يتّضح أنّ هذه الآية لا تنحصر بأهل الكتاب فقط كما ظنّ ذلك بعض المفسّرين، وكذلك لم يمسخ حكم هذه الآية كما ذهب إلى ذلك آخرون، بل أنّه حكم سار وعام ومطابق للمنطق والعقل.
ثمّ أنّ الآية الشريفة تقول كنتيجة لما تقدّم {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد إستمسك بالعروة الوثقى لا إنفصام لها}.
(الطاغوت) صيغة مبالغة من طغيان، بمعنى الإعتداء وتجاوز الحدود، ويطلق على كلّ ما يتجاوز الحدّ. لذلك فالطاغوت هو الشيطان والصنم والمعتدي والحاكم الجبّار والمتكبّر، وكلّ معبود غير الله، وكلّ طريق لا ينتهي إلى الله. وهذه الكلمة تعني المفرد وتعني الجمع.
أمّا المقصود بالطاغوت، فالكلام كثير بين المفسّرين. قال بعض إنّه الصنم، وقال بعض إنّه الشيطان، أو الكهنة، أو السحرة، ولكن الظاهر أنّ المقصود هو كلّ أُولئك، بل قد تكون أشمل من كلّ ذلك، وتعني كلّ متعدّ للحدود، وكلّ مذهب منحرف ضال.
إنّ الآية في الحقيقة تأييد للآيات السابقة التي قالت أن {لا إكراه في الدين}، وذلك لأنّ الدين يدعو إلى الله منبع الخير والبركة وكلّ سعادة، بينما يدعو الآخرون إلى الخراب والإنحراف والفساد. على كلّ حال، إنّ التمسّك بالإيمان بالله هو التمسّك بعروة النجاة الوثقى التي لا تنفصم.
{والله سميعٌ عليم}.
الإشارة في نهاية الآية إلى الحقيقة القائلة إنّ الكفر والإيمان ليسا من الأُمور الظاهرية، لأنّ الله عالم بما يقوله الناس علانية ـ وفي الخفاء ـ وكذلك هو عالم بما يكنّه الناس في ضمائرهم وقلوبهم.
وفي هذه الجملة ترغيب للمؤمنين الصادقين، وترهيب للمنافقين.
نور الإيمان وظلمات الكفر :
بعد أن أشير في الآيات السابقة إلى مسألة الإيمان والكفر وإتضاح الحقّ من الباطل والطريق المستقيم عن الطريق المنحرف توضّح هذه الآية الكريمة إستكمالاً للموضوع أنّ لكل من المؤمن والكافر قائداً وهادياً فتقول : {الله وليّ الذين آمنوا} فهم يسيرون في ظلّ هذه الولاية من الظلمات إلى النور (يخرجهم من الظلمات إلى النور).
كلمة (وليّ) في الأصل بمعنى القرب وعدم الإنفصال ولهذا يقال للقائد والمربّي (ولي) ـ وسيأتي شرحها في تفسير آية {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [المائدة: 55] ـ
تطلق أيضاً على الصديق والرفيق الحميم، إلاّ أنّه من الواضح أنّ الآية مورد البحث تعني في هذه الكلمة المعنى الأوّل، ولذلك تقول {الله وليّ الذين آمنوا...}.
ويمكن أن يقال أنّ هداية المؤمنين من الظلمات إلى النور هو تحصيل للحاصل، ولكن مع الإلتفات إلى مراتب الهداية والإيمان يتّضح أنّ المؤمنين في مسيرهم نحو الكمال المطلق بحاجة شديدة إلى الهداية الإلهيّة في كلّ مرحلة وفي كلّ قدم وكلّ عمل، وذلك مثل قولنا في الصلاة كلّ يوم : {إهدنا الصراط المستقيم}.
ثمّ تضيف الآية إنّ أولياء الكفّار هم الطاغوت (الأوثان والشيطان والحاكم الجائر وأمثال ذلك) فهؤلاء يسوقونهم من النور إلى الظلمات {والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات} ولهذا السبب {اُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون}.
_______________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج2 ، ص91-97.
 الاكثر قراءة في سورة البقرة
الاكثر قراءة في سورة البقرة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)