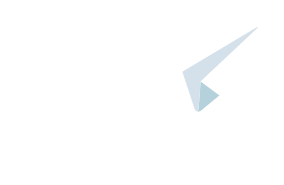تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
الاستدلالُ في القُرآن مزيج أُسلوبين : الخطابة والبرهان
المؤلف:
محمّد هادي معرفة
المصدر:
تلخيص التمهيد
الجزء والصفحة:
ج2 ، ص440-448.
5-11-2014
2591
امتاز القرآن في استدلالاته بالجمع بين أُسلوبين يختلفان في شرائطهما ، هما : أُسلوب الخطابة وأُسلوب البرهان ذاك إقناع للعامّة بما يتسالمون به من مقبولات مظنونات ، وهذا إفهام للخاصّة بما يتصادقون عليه من أَوليات يقينيات .
ومن الممتنع عادةً أن يقوم المتكلّم بإجابة ملتمس كلا الفريقين ، ليجمع بين الظنّ واليقين في خطاب واحد ... الأمر الذي حقّقه القرآن فعلاً بعجيب بيانه وغريب أُسلوبه .
والبرهان : ما تركّب من مقدّمات يقينية ، سواء أكانت ضروريةً ( بديهيةً أو فطريةً ) أم كانت نظريةً ( منتهية إلى الضروريات ) ، والقضايا الضرورية ستّة أنواع :
1 ـ أوّليات وهي قضايا قياساتها معها ، يكفي في الجزم بالحكم مجرّد تصوّر الطرفين ، كقولنا : ( الكلّ أعظم من الجزء ) . أو مع تصوّر الواسطة وحضورها في الذهن ، كقولنا : ( الأربعة زوج ) ؛ لأنّه ينقسم إلى متساويين .
2 ـ مشاهدات ، هي قضايا محسوسة بالحواس الظاهرة كإضاءة الشمس .
3 ـ وجدانيات ، منشأها الحسّ الباطني كالإحساس بالخوف والغضب .
4 ـ متواترات ، أخبار جماعة يمتنع عادةً تواطؤهم على الكذب والاختلاق .
5 ـ مجرّبات ، يحصل الجزم بالنتيجة على أثر تكرر المحسوس .
6 ـ حدسيات ، هي سرعة الانتقال من المبادئ إلى المطالب ، ويقابلها الفكر ، الذي هو حركة الذهن نحو المبادئ ثمّ رجوعه إلى المطالب ، فلابدّ فيه من حركتين ، على خلاف الحدس ؛ إذ لا حركة فيه ، لأنّ الحركة تدريجية ، والانتقال آني .
أمّا الخطابة فهي ما تركّب من مقدّمات كانت مقبولةً معتقداً بها لأمر سماوي أو لمزيد عقل ودين .
ونظيرها الجدل ، المتركّب من قضايا مشهورات تقبّلتها العامّة وخضعت لها أعرافهم ونسجت عليها طبائعهم ، فألفوها وأذعنوا بها إذعاناً .
أو قضايا مسلّمات تسلّم بها المخاطبون كأُصول مفروضة مسلّم بها .
والقرآن الكريم قد استفاد في دلائله من كلّ هذه الأساليب ، وفي الأكثر جمع بينها في خطاب مع العامّة يشترك معهم الخواصّ .
هذا غاية في القدرة على الاستدلال وإقامة البرهان .
ولنضرب لذلك أمثلة :
1 ـ قال سبحانه وتعالى ـ بصدد نفي آلهة غير الله ـ : {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء : 22].
هذه الآية ـ بهذا النمط من الاستدلال ـ في ظاهرها البدائي احتجاج على أساس الخطابة والإقناع ، قياساً على العرف المعهود ، إنّ التعدّد في مراكز القرار سوف يؤدّي إلى فساد الإدارة .
ونظيرها آية أُخرى : {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ } [المؤمنون : 91].
يقول العلاّمة الطباطبائي : وتقرير الحجّة في الآية أنّه لو فُرض للعالَم آلهة فوق الواحد لكانوا مختلفين ذاتاً ، متباينين حقيقةً . وتباين حقائقهم يقضي بتباين تدبيرهم ، فتتفاسد التدابير ، وتفسد السماء والأرض (1) .
وهذا النمط من الاستدلال ، طريقة عقلانية يتسلّمها العرف العام قياساً على ما ألفوه في أعرافهم .
ولكن إلى جنب هذا ، فهو استدلال برهاني دقيق ، قوامه الضرورة واليقين ، وليس مجرّد قياس إقناعي صرف .
ذلك أنّ الآية دلّت العقول على أنّ تعدّد الآلهة ، المستجمعة لصفات الإلوهية الكاملة ، يستدعي إمّا عدم وجود شيء على الإطلاق ، وذلك هو فساد الأشياء حال الإيجاد ... أو أنّها إذا وُجدت وُجدت متفاوتة الطبائع متنافرة الجنسيات ، الأمر الذي يقضي بفسادها ، إثر وجودها وعدم إمكان البقاء .
وذلك لأنّه لو توجهت إرادتان مستقلّتان من إلهين مستقلّين ـ في الخلق والتكوين ـ إلى شيء واحد يريدان خلقه وتكوينه ، فهذا ممّا يجعله ممتنع الوجود ؛ لامتناع صدور الواحد إلاّ من الواحد ، إذ الأثر الواحد لا يصدر إلاّ ممّا كان واحداً ، ولا تتوارد العلّتان على معلول واحد أبداً .
وفرض وجوده عن إرادة أحدهما ـ مع استوائهما في القدرة والإرادة ـ فرض ممتنع ؛ لأنّه ترجيع من غير مرجّح ، بل ترجّح من غير مرجّح ، وهو مستحيل .
ولو توجّهت إرادة أحدهما إلى إحداث شيء ، وأراد الآخر عدم إحداثه ! فلو تحقّقت الإرادتان كان جمعاً بين النقيضين ، أو غلبت إحداهما الأُخرى فهذا ينافي الكمال المطلق المفروض في الإلهين ، وإلاّ فهو ترجيح من غير مرجّح .
ولو توجّهت إرادة أحدهما إلى إحداث نظام ومخلوق ، والآخر إلى نظام ومخلوق غيره ... إذاً لذهب كل إله بما خلق ... ولكان هناك نظامان وعالَمان مختلفان في الخلق والنظام ، وهذا الاختلاف في البنية والنظام يستدعي عدم التآلف والوئام والانسجام ، وسوف يؤدّي ذلك إلى تصادم وأن يطغي أحدهما على الآخر ولعلا بعضهم فوق بعض ، الأمر الذي يقضي بالتماحق والتفاسد جميعاً .
وكل أُولئك باطل بالمشاهدة ؛ إذ نرى العالم قد وُجد غير فاسد ، وبقي غير فاسد ، ونراه بجميع أجزاءه ، وعلى اختلاف عناصره وتفاوت أوضاعه ـ من علوّ وسفل وخير وشر ـ يؤدّي وظيفة جسم واحد ، تتعاون أعضاؤه مع بعضها البعض ، وكل عضو يؤدّي وظيفته بانتظام ، يؤدّي إلى غرض واحد وهدف واحد ، وهذه الوحدة المتماسكة ـ غير المتنافرة ـ في نظام الأفعال دليل قاطع على الفاعل الواحد المنظّم لها بتدبيره الحكيم ، وهو الله ربّ العالمين .
وهذا هو البرهان القائم على قضايا يقينية في بديهة العقل .
3 ـ وقال تعالى ـ بصدد نفي المثل ـ : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى : 11] .
جاءت الدعوى مشفوعة ببرهان الامتناع ، على طريقة الرمز إلى كبرى القياس .
ذلك أنّ ( المِثل ) المضاف إليه تعالى رمز إلى الكمال المطلق ، أي الذي بلغ النهاية في الكمال في جميع أوصافه ونعوته ، الذي هو مقتضي الإلوهية والربوبية المطلقة ؛ لأنّك إذا حقّقت معنى الإلوهية فقد حقّقت معنى التقدّم على كل شيء والمسيطر على كل شيء ، {فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الأنعام : 14] ، {لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الزمر : 63] .
إذاً فلو ذهبت تفترض الاثنينية في هذا المجال ، وفرضت اثنين يشتركان في هذه الصفات التي هي غايات لجميع الأوصاف والنعوت ، فقد نقضت وتناقضت في افتراضك ؛ ذلك أنّك فرضت من كل منهما تقدّماً وتأخّراً في نفس الوقت وأنّ كلاً منهما مُنشِئاً ومُنشَأً ، ومستعلٍ ومستعلىً عليه ؛ إذ النقطة النهائية من الكمال لا تحتمل اثنين ، لأنّ النقطة الواحدة لا تنحلّ إلى نقطتين ، وإلاّ فقد أَحلت الكمال المطلق إلى كمال مقيّد في الطرفين ، إذ تجعل كل واحد منهما بالإضافة إلى صاحبه ليس سابقاً ولا مستعلياً فأنّى يكون كل منهما إلهاً ، وللإله المثل الأعلى ؟!
ورجع تقرير الاستدلال إلى البيان التالي :
إنّ الإله هو ما استُجمع فيه صفات الكمال وبلغ النهاية في الكمال .
ومثل هذا الوصف ( مجمع الكمال ) لا يقبل تعدّداً لا خارجاً ولا وهماً .
إذاً فلا تعدّد في الإله ، وليس له فردان متماثلان .
وهذا من أروع الاستدلال على نفي المثيل .
وكلمة ( المثل ) هذه تكون إشارة إلى ما حواه المثيل من صفات وسِمات خاصّة تجعله أهلاً لهذا النعت ( إيجابياً أو سلباً ) في القضية المحكوم بها .
مثلاً لو قيل ـ خطاباً لشخصية بارزة ـ : ( أنت لا تبخل ) كان ذلك دعوى بلا برهان ، أمّا لو قيل له : ( مثلك لا يبخل ) فقد قرنت الدعوى بحجّتها ؛ إذ تلك خصائصه ومميّزاته هي التي لا تدعه أن يبخل ، فكأنّك قلت : ( إنّك لا تبخل ، لأنّك حامل في طيّك صفاتٍ ونعوتاً تمنعك من البخل ) .
وهكذا جاءت الآية الكريمة : إنّ مَن كان على أوصاف الإلوهية الكاملة فإنّ هذا الكمال والاستجماع لصفات الكمال هو الذي يجعل وجود المثيل له ممتنعاً ( بالبيان المتقدّم ) .
وعليه ، فليست زائدة ، كما زعم البعض ؛ لأنّ المثل ـ على مفروض البيان ـ إشارة إلى تلك الصفات والسمات التي تحملها الذات المقدّسة ، ولم يكن المراد من المثل التشبيه ، فهو بمنزلة ( هو ) محضاً .
فكان المعنى : ليس يشبه مثله تعالى شيء ، أي ليس يشبهه في كمال أوصافه ونعوته شيء .
قال الأُستاذ درّار : الآية لا ترمي نفي الشبيه له تعالى فحسب ؛ إذ كان يكفي لذلك أن يقول : ( ليس كالله شيء ) أو ( ليس مثله شيء ) ، بل ترمي وراء ذلك دعم النفي بما يصلح دليلاً على الدعوى والإنعات إلى وجه حجّة هذا الكلام وطريق برهانه العقلي ، أَلا ترى أنّك إذا أردت أن تنفي نقيصة عن إنسان فقلت : ( فلان لا يكذب ) أو ( لا يبخل ) كان كلامك هذا مجرّد دعوى لا دليل عليها ، أمّا إذا زدت كلمة المثل وقلت : ( مثل فلان لا يكذب ) أو ( لا يبخل ) فكأنّك دعمت كلامك بحجّة وبرهان ؛ إذ مَن كان على صفاته وشيمه الكريمة لا يكون كذلك ؛ لأنّ وجود هذه الصفات والنعوت ممّا تمنع الاستفسال إلى رذائل الأخلاق ، وهذا منهج حكيم وضع عليه أُسلوب كلامه تعالى ، وأنّ مثله تعالى ذا الكبرياء والعظمة لا يمكن أن يكون له شبيه ، أو أنّ الوجود لا يتّسع لاثنين من جنسه (2) .
فقد جيء بأحد التشبيه ركناً في الدعوى ، وبالآخر دعامةً لها وبرهاناً عليها ، وهذا من جميل الكلام وبديع البيان ، ومن الوجيز الوافي .
3 ـ وقال تعالى ـ بصدد بيان لا نهائية فيوضه عزّت آلاؤه ـ {لَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} [لقمان : 27].
هذه مقارنة بين المحدود واللامحدود ، وأنّ المحدود مهما بلغ عدده وتضخّم حجمه فإنّه لا يقاس بغير المحدود ؛ إذ ذاك ينتهي وهذا لا ينتهي ، ولا مناسبة بين ما ينتهي إلى أمد مهما طال أو قصر ، وما يمتدّ إلى ما لا نهاية أبداً .
والكلمة ـ في هذه الآية ـ يراد بها الوجود المفاض بأمره تعالى ، المتحقّق بقوله : ( كن ) .
قال تعالى : {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس : 82] .
وكلّ موجود ـ في عالم الخلق ، وهو ما سوى الله ـ فهو كلمته تعالى ، كما أطلق على المسيح ( عليه السلام ) كلمة الله : {وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ} [النساء : 171] (3) .
والمعنى : أنّه لو جُعلت الأشجار أقلاماً والأبحر مداداً ـ ليُكتب بها كلمات الله ـ لنفدت الأقلام والمداد قبل أن تنفد كلمات الله ؛ لأنّها غير متناهية ... وذلك لأنّ كلماته تعالى إفاضات ، ولا ينتهي فيضه تعالى إلى أمد محدود أبداً .
4 ـ وقال تعالى ـ ردّاً على احتجاج اليهود ـ : {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ } [البقرة : 91].
امتنعت اليهود من اعتناق الإسلام بحجّة أنّهم على طريقة نبيّهم موسى ( عليه السلام ) وعلى شريعته ، ولذلك لا يمكنهم اتّخاذ سيرة أُخرى والإيمان بشريعة سواها .
هذا اعتذار زعمت اليهود وجاهته في منابذة الإسلام ... وقد فنّد القرآن هذا التذرّع الكاسد والاحتجاج الفاسد ؛ إذ لا منافرة بين الشريعتين ولا منافاة بين الطريقين ، والكل يهدف مرمىً واحداً ويرمي هدفاً واحداً ، وقد جاء الأنبياء جميعاً لينيروا الدرب إلى صراط الله المستقيم ، صراطاً واحداً وهدفاً واحداً ، لا تنافر ولا تنافي ولا تعدّد ولا اختلاف .
والدليل على ذلك أنّ هذا القرآن يُصدّق بأنبياء سالفين وبشرائعهم وكتبهم وما بلّغوا مِن رسالات الله ، ولو كان هناك تنافٍ وتنافر لما صحّ هذا التصديق .
وقد جاء هذا التصديق بلفظة {مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} [البقرة : 97] في ثمانية مواضع من القرآن (4) .
وبلفظة {مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ} [البقرة : 89] في ثلاثة مواضع .
وبلفظة {مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ} [البقرة : 41] في ثلاثة مواضع .
ومِن ثَمّ قال : { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ} [آل عمران : 19].
{فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ} [آل عمران : 20].
{وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ} [آل عمران : 20].
وفي الآية وما يتعقّبها نكات وظرف دقيقة :
منها : قوله : ( مصدّقاً لما معهم ) أو ( مصدّقاً لما معكم ) ـ في آية أُخرى ـ وهذا تنويه بأنّ المتبقّي من التوراة ليس كلّها وإنّما هو بعضها ... لكنّه لم يقل : ( لما بقى من التوراة عندكم ) وعبّر ( بما معكم ) ؛ لئلاّ يتنبّه اليهود إلى ذريعة أُخرى لعلّهم يتذرّعون بها ، هو أنّ المنافرة إنّما كانت بين القرآن وما ذهب مِن التوراة ، فيجادلون الإسلام بهذه الطريقة ... وهي طريقة أخذ ما تسالم الخصم دليلاً عليه ... .
ولم يقل : ( مصدّقاً بالتوراة عندكم ) ؛ لأنّه حينذاك كان اعترافا ًبأنّ الموجود هو تمامها لا بعضها .
فأتى بما لا يمكّنهم المخاصمة جدلاً ، ولا كان اعترافاً بصدق ما عندهم أنّه توراة كلّه ، وهذا من دقيق التعبير الذي خصّ به القرآن الكريم .
وأيضاً في التعقيب بقوله : {فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ} [البقرة : 91] ، نسبة القتل إليهم بالذات ؛ لأنّهم رضوا بفعل آبائهم ومشوا على طريقتهم ، ولو قال : ( فلم قتل آباؤكم ... ) لكان فيه حديث أخذ الجار بذنب الجار ، وكان أشبه بمحاجّة الذئب : عدا على حَمَل صغير ، بحجّة أنّ أباه قد عكّر الماء عليه في قناة كان يشرب منها (5) .
_______________________
(1) الميزان : ج17 ص267 ط بيروت .
(2) النبأ العظيم : ص128 .
(3) الميزان : ج16 ص245 .
(4) البقرة : 97 ، آل عمران : 3 ، المائدة : 46 مرّتين و48 ، الأنعام : 92 ، فاطر : 31 ، الأحقاف : 30 .
(5) النبأ العظيم : ص117 .
 الاكثر قراءة في الإعجاز البلاغي والبياني
الاكثر قراءة في الإعجاز البلاغي والبياني
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)