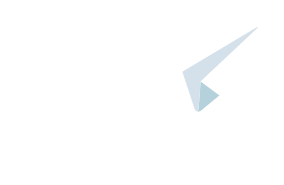التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته


صفات الله تعالى


الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه


العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة


النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

مواضيع متفرقة

القرآن الكريم


الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم ومودتهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة


المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة


فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية


شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية


أسئلة وأجوبة عقائدية


التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد


القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة


الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم


أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات


احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة


أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات


اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة


الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة
الإرادة (الصفات الثبوتية الذاتية)
المؤلف:
الشيخ جعفر السبحاني
المصدر:
محاضرات الاستاذ الشيخ جعفر السبحاني
الجزء والصفحة:
ص 166
25-10-2014
2465
إِنَّ الإِرادة من صفاته سبحانه ، والمُريد من أَسمائه ، و لا يشك في ذلك أَحد من الإِلهيين أَبداً. و إِنَّما اختلفوا في حقيقة إِرادته تعالى. و لأجل ذلك يجب علينا الخوض في مقامين :
الأول : استعراض الآراء المطروحة في تفسير الإِرادة على وجه الإِطلاق.
الثاني : تفسير خصوص الإِرادة الإِلهية.
1 ـ ما هي حقيقة الإِرادة؟
إِنَّ الإِرادة والكراهة كيفيتان نفسانيّتان كسائر الكيفيات النفسانيّة ، يجدهما الإِنسان بذاتهما بلا توسط شيء مثل اللذَّة و الأَلم و غيرهما من الأمور الوجدانية. غير أنَّ الهدف تحليل ذلك الأَمر الوجداني تحليلا علمياً و صياغته في قالب علمي. و إليك الآراء المطروحة في هذا المجال.
أ ـ فسَّرت المعتزلة الإِرادة ب ـ « اعتقاد النَّفع » و الكراهة ب ـ « اعتقاد
الضرر » ، قائلين بأَنَّ نسبة القدرة إلى طرفي الفعل و الترك متساوية ، فإِذا حصل في النفس الإِعتقاد بالنفع في أَحد الطرفين ، يرجُح بسببه ذلك الطرف و يصير الفاعل مؤثرّاً فيه.
و يلاحظ عليه : أَنّه ناقص جداً ، لأَن مجرد الإِعتقاد بالنفع لا يكون مبدأ للتأثير و الفعل ، إذ كثيراً ما يعتقد الإِنسان بوجود النفع في كثير من الأَفعال و لا يريدها ، و ربما لا يعتقد بوجوده فيها ، بل يعتقد بوجود الضرر و مع ذلك يريدها لموافقتها لبعض القوى الحيوانية.
ب ـ فسرت جماعة أخرى الإِرادة بأَنها شوق نفساني يحصل في الإِنسان تلو اعتقاده النفع.
ويلاحظ عليه : أَنَّ تفسير الإِرادة بالشوق ناقص جداً إِذ ربما تتحقق الإِرادة و لا يكون ثمَّة شوقٌ كما في تناول الأَدوية المُرَّة لأَجل العلاج. و قد يتحقق الشوق المؤكَّد و لا تكون هناك إِرادة موجدة للفعل كما في المحرَّمات و المشتَهَيَات المحظورة للرجل المتقي.
ولأَجل ذلك صارت النسبة بين الإِرادة و الشوق عموماً و خصوصاً من وجه.
ج ـ الإِرادة كيفية نفسانيّة متخللة بين العلم الجازم و الفعل و يعبر عنها بالقصد والعزم تارة ، و بالإِجماع و التصميم أخرى. و ليس ذلك القصد من مقولة الشوق بقسميه المؤكَّد و غير المؤكَّد ، كما أَنَّه ليس من مقولة العلم رغم حضوره لدى النفس كسائر الكيفيّات النفسانيّة.
وباختصار ، حقيقة الإِرادة « القصد و الميل القاطع نحو الفعل ».
هذه بعض التفاسير المختلفة حول حقيقة الإِرادة و هناك نظريات أُخرى طوينا عنها الكلام.
وعلى كل تقدير ، لا يمكن تفسير الإِرادة الإِلهية بواحدة منها ، أما
أوّلُها فقد عرفت أنَّ تفسير الإِرادة باعتقاد النفع ملازم لإِنكار الإِرادة مطلقاً في الموجودات الإِمكانية فضلا عن الله سبحانه و ذلك لأَنَّ مرجعها إلى العلم بالنفع ، مع أنَّا نجد في أَنفسنا شيئاً وراء العلم و الإِعتقاد بالنفع ، والقائل بهذه النظرية يثبت العلم و ينكر الإِرادة. فإِذا بطل تفسير الإِرادة بالإِعتقاد بالنفع في الموجودات الإِمكانية يبطل تفسير إرادته سبحانه به أيضاً...
وأَما التفسير الثاني ، أَعني الشوق أو خصوص الشوق المؤكد ، فلو صح في الإِنسان فلا يصح في الله سبحانه ، لأَن الشوق من مقولة الإِنفعال تعالى عنه سبحانه. فإِنَّ الشوق إلى الشيء شأن الفاعل الناقص الذي يريد الخروج من النقص إلى الكمال ، فيشتاق إلى الشيء شوقاً أكيداً.
وأما التفسير الثالث ، فسواء أفسرت بالقصد و العزم ، أو الإِجماع و التصميم ، فحقيقتها الحدوث بعد العدم ، والوجود بعد اللاوجود و هي بهذا المعنى يستحيل أن تقع وصفاً لذاته لاستلزامه كون ذاته معرضاً للحوادث.
ولأَجل عدم مناسبة هذه التعاريف لذاته سبحانه ، صار المتألهون على طائفتين : طائفة تحاول جعلها من صفات الذات لكن بمعنى آخر ، و طائفة تجعلها من صفات الفعل فتذهب إلى أنَّ الإِرادة كالخلق و الرزق تنتزع من فعله سبحانه و إعمال قدرته وهذه الطائفة أراحت نفسها من الإِشكالات الواردة على كونها من الصفات الذاتية...
2 ـ تفسير خصوص الإِرادة الإِلهية :
لما كانت الإِرادة بالمعاني المتقدمة غير مناسبة لساحته سبحانه ، و من جانب آخر إِنَّ الإِرادة و كون الفاعل فاعلا مريداً ـ في مقابل كونه فاعلا مضّطراً ـ كمال فيه ، و عدمها يعد نقصاً فيه ، حاول الحكماء و المحققون توصيفه سبحانه بها بمعنى يصح حملُه عليه و توصيفُه به. و إِليك تفسير هذه المحاولة بصور مختلفة.
أ ـ إرادته سبحانه علمُه بالنظام الأَصلح :
إنَّ إرادَته سبحانه علمُه بالنظام الأَصلح و الأَكمل و الأَتم. و إِنما فسّروها بها فراراً من توصيفه سبحانه بأمر حدوثي و تدرُّجي ، و ما يستلزم الفعل و الإِنفعال ، كما هو الحال في الإِرادة الإِنسانية.
قال صَدْر المتأَلهين : « معنى كونه مريداً أَنَّه سبحانه يَعْقِل ذاتَه و يعقِلُ نظامَ الخَيْر الموجود في الكُلَّ من ذاته ، و أَنَّه كيف يكون. و ذلك النظام يكون لا محالة كائناً و مستفيضاً » (1).
وقال أيضاً : « إِنَّ إرادته سبحانه بعينها هي علمه بالنظام الأَتم ، و هو بعينه هو الداعي لا أمرٌ آخر » (2).
وقال المحقق الطوسي : « إِنَّ إرادته سبحانه هي العلم بنظام الكلُ على الوجه الأَتم ، و إِذا كانت القدرة والعلم شيئاً واحداً ، مقتضياً لوجود الممكنات على النظام الأَكمل كانت القدرة و العلم و الإِرادة شيئاً واحداً في ذاته مختلفاً بالإِعتبارات العقلية » (3).
مناقشة هذه النظرية :
لا شك أَنَّه سبحانه عالم بذاته و عالم بالنظام الأَكمل و الأَتَمّ و الأَصلح ولكن تفسير الإِرادة به ، يرجع إلى إِنكار حقيقة الإِرادة فيه سبحانه. فإِنكارها في مرتبة الذات مساوق لإِنكار كمال فيه ، إذ لا ريب أَنَّ الفاعل المريد أَكمل من الفاعل غير المريد ، فلو فسّرنا إِرادته سبحانه بعلمه بالنظام ، فقد نفينا ذلك الكمال عنه و عرَّفناه فاعلا يشبه الفاعل المضطر في فعله. و بذلك يظهر النظر فيما أفاده المحقق الطوسي حيث تصورَّ أَنَّ القدرة و العلم شيء واحد بذاته مختلفان بالإِعتبارات العقلية. و لأَجل عدم صحة هذا التفسير نرى أَنَّ ائمة أَهل البيت ( عليهم السَّلام ) ينكرون تفسيرها بالعلم. قال بُكَيْر بن أعْيَن : قلت لأبي عبدالله الصادق ( عليه السَّلام ) : علمه و مشيئته مختلفان أَو متّفقان؟
فقال ( عليه السَّلام ) : « العلم ليس هو المشيئة ، ألا ترى أَنك تقول سأفعل كذا إنْ شاءَ الله ، و لا تقول سأفعل كذا إِنْ عَلِمَ الله » (4).
وإنْ شئت قلت : إِنَّ الإِرادة صفة مخصِّصة لأحد المقدوريْن أَي الفعل و الترك ، و هي مغايرة للعلم و القدرة. أمّا القدرة ، فخاصيّتُها صحة الإِيجاد و اللا إيجاد ، و ذلك بالنسبة إلى جميع الأَوقات وإلى طرفي الفعل و التَّرك على السواء ، فلا تكون نفسُ الإِرادة التي من شأنها تخصيص أَحد الطرفين و إِخراج القدرة عن كونها متساوية بالنسبة إلى الطرفين.
وأَما العلم فهو من المبادئ البعيدة للإِرادة ، و الإِرادة من المبادئ القريبة إلى الفعل ، فلا معنى لعدِّهما شيئاً واحداً.
نعم ، كون علمه بالمصالح و المفاسد مخصصاً لأَحد الطرفين ، و إِنْ كان أَمراً معقولا ، لكن لا يصح تسميتُه إِرادةً و إِن اشترك مع الإِرادة في
النتيجة و هي تخصيص الفاعل قدرته بأَحد الطرفين ، إِذ الإِشتراك في النتيجة لا يوجب أنْ يقوم العلم مقام الإِرادة و يكون كافياً عن توصيفه بذلك الكمال أَي الإِرادة.
سؤال و جواب :
ربما يقال : لماذا لا تكون حقيقة الإِرادة نفس علمه سبحانه؟ إذ لو كانت واقعية الأَول غير واقعية الثاني للزمت الكثرة في ذاته سبحانه. و الكثرة آية التركيب ، و التركيب يلازم الإِمكان ، لضرورة احتياج الكُلِّ إلى الأَجزاء ، و هو تعالى منزه عن كل ذلك.
والجواب : إِنَّ معنى اتحاد الصفات بعضها مع بعض ، و الكل مع الذات ، أن ذاته سبحانه علم كلها ، قدرة كلها ، حياة كلها و أَن تلك الصفات بواقعياتها ، موجودة فيها على نحو البساطة ، و ليس بعضها حياة و بعضها الآخر علماً ، و بعضها الثالث قدرة ، لاستلزام ذلك التركيب في الذات. و لا يُراد من ذلك إِرجاع واقعية إِحدى الصفات إلى الأُخرى بأَنْ يقال مثلا : علمه قدرته. فإِنَّ مردّ ذلك إلى إِنكار جميع الصفات و إِثبات صفة واحدة.
وباختصار إِنَّ هناك واقعية واحدة بحتة و بسيطة اجتمع فيها العلم و الحياة و القدرة بواقعياتها من دون أنْ يحدث في الذات تكثر وتركّب. وهذا غير القول بأنَّ واقعية إِرادته هي واقعية علمه ، ليلزم من ذلك نفي واقعية الإِرادة و المشيئة. فإنَّ مرد ذلك إلى نفي الإِرادة. كما أَنَّ القول بأَنَّ واقعية قدرته ترجع إلى علمه مردّه إلى نفي القدرة لا إِثبات الوحدة و لتوضيح المطلب نقول:
إنَّه يمكن أن تنتزع مفاهيم كثيرة من الشيء البسيط و يكون لكل مفهوم واقعية فيه من دون طروء التكثّر و التركُّب. و ذلك مثل الإِنسان الخارجي بالنسبة إلى الله سبحانه ، فهو كله مقدور لله ، كما أنَّ كلّه معلوم لله. لا أنَّ بعضاً منه مقدور ، و بعضاً منه معلوم. فالكل مقدور ، و في الوقت نفسه
معلوم. و مع ذلك ليست واقعية المعلوميّة نفس واقعية المقدوريّة.
وبهذا تقدر على تجويز أن تكون ذاتُه سبحانه علماً كلُّها ، و قدرةً كلُّها ، و يكون لكل وصف واقعية من دون طروء الكثرة و التركب (5).
ب ـ إرادته سبحانه ابتهاجُهُ بفعِلِه :
إِنَّ إِرادته سبحانه ابتهاجُ ذاته المقدسة بفعلها و رضاها به. و ذلك لأَنه لما كانت ذاته سبحانه صرف الخير و تمامه ، فهو مبتهج بذاته أتَمَّ الإِبتهاج و ينبعث من الإِبتهاج الذاتي ابتهاج في مرحلة الفعل ، فإِنَّ من أَحبَّ شيئاً أَحب آثاره و لوازمه و هذه المحبة الفعلية هي الإِرادة في مرحلة الفعل ، وهي الّتي وردت في الأَخبار الّتي جعلت الإرادة من صفات فعله. فللإِرادة مرحلتان : إِرادة في مقام الذات ، و إِرادة في مقام الفعل : فابتهاجه الذاتي إِرادة ذاتية ، و رضاه بفعله إِرادة في مقام الفعل.
يلاحظ عليه : إِنَّ هذه النظرية كسابقتها لا ترجع إلى محصّل. فإِنَّ حقيقة الإِرادة غير حقيقة الرضا ، و غير حقيقة الإِبتهاج. و تفسير أَحدهما بالآخر إِنكار لهذا الكمال في ذاته سبحانه. و قد مرّ أَنَّ كون الفاعل مريداً ، في مقابل كونه فاعلا مضطراً موجباً ، أَفضل و أَكمل. فلا يمكن نفي هذا الكمال عن ذاته على الإِطلاق ، بل يجب توصيفها بها على التصوير الخاص الذي مرّ مثله في تفسير الحياة ...
ج ـ إِرادته سبحانه إِعمال القدرة و السلطنة :
إِنَّ جماعة من المتكلمين لما وقفوا على أَنَّه لا يمكن توصيفه سبحانه بالإِرادة و جعلها من صفات ذاته لاستلزامه بعض الإِشكالات التي مرت عليك ، عمدوا إلى جعلها من صفات الفعل كالخالقية و الرازقية.
قالوا : إِنَّا لا نتصور لإِرادته تعالى معنى غير إِعمال القدرة و السلطَنَة ، و لما كانت سلطنته تعالى تامة من جميع الجهات و النواحي ، و لا يتصور النقص فيها أَبداً ، فبطبيعة الحال يتحقق الفعل في الخارج و يوجد صِرْفُ إِعمال القدرة من دون توقفه على أيّة مقدمة أخرى ، كما هو مقتضى قوله سبحانه : {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس: 82].
يلاحظ عليه : إِنَّ إعمال القدرة و السلطنة إِما إِختياريُّ له سبحانه أو اضطراريٌّ ، و لا سبيل إلى الثاني لأَنه يستلزم أنْ يكون تعالى فاعلا مضطراً و لا يصح توصيفه بالقدرة و لا تسميته بالقادر. و على الأَول ، فما هو مِلاك كونه فاعلا مختاراً؟. لا بد أن يكون هناك قبل إعمال السلطنة و تنفيذ القدرة شيءٌ يدور عليه كونه فاعلا مختاراً ، فلا يصح الإكتفاء بإِعمال القدرة.
وباختصار ، إِنَّ الإِكتِفاء بإِعمال القدرة من دون إِثبات اختيار له في مقام الذات بنحو من الأَنحاء ، غير مفيد.
د ـ إرادته سبحانه نسبة تمامية السبب إلى الفعل :
جعل العلامة الطباطبائي إرادته تعالى من صفات فعله ، و حاصل نظريته : إنَّ الصفة الوحيدة من بين الصفات النفسانية التي يجدها الإِنسان في صميم ذاته ، القابلة للإِنطباق على عنوان « الإِرادة»، هي صفة « القصد ».
و« القصد » الذي هو واسطة بين العلم بالفعل و تحققه ، عبارة عن الميل النفسي للفاعل إلى الإِتيان بالفعل.
ولا يصح أبداً تفسير الإِرادة بصفة العلم. لأننا ندرك بالوجدان أنّ ارادتنا متوسطة بين علمنا بالفعل و الاتيان به ، لا نفس العلم.
وعلى هذا ، فإذا أردنا توصيفه تعالى بالإِرادة ـ بعد تجريدها من النقائص ـ لا يمكننا تطبيقها على علمه تعالى ، لأن ماهية و حقيقة العلم غير ماهية الإِرادة.
وتجريد الإِرادة عن النقائص لا يجعلها متحدة مع العلم حقيقة.
ثم إن الإِرادة ـ بعد تجريدها من النقائص ـ تكون صفة فعلية لله تعالى ، كصفات الخلق و الإِيجاد و الرحمة.
بيان ذلك : عندما تكتمل جميع مقدمات و أسباب إيجاد الفعل ، تنتزع عند ذاك صفة الإِرادة ، فيكون تعالى « مريداً » ، و الفعل « مراداً » ، من دون أن تكون هناك واقعية ما بإزاء صفة الإِرادة سوى حالة تمامية الأسباب.
وبعبارة أُخرى : الإِرادة في الله تعالى صفة منتزعة من اجتماع علل و مقتضيات وجود الشيء. إذا عند ذاك ، تارة ينسب اكتمال مقدمات الفعل و تماميتها إلى الفعل ، وأخرى ينسب إلى الله تعالى. فإذا نسب إلى الفعل سميت هذه الحالة (اكتمال المقدمات) : « إرادة الفعل » ، ونفس الفعل : « مراد الله ». وإذا نسب إلى الله تعالى سميت هذه الحالة : « إرادة الله » ، و الله تعالى : « مريداً ».
ويقول العلامة ( قدس سره ) : إن البراهين التي أقامها الحكماء لإِثبات كون الإِرادة إحدى صفات الذات ، لا تثبت أزيد من أن جميع مظاهر الوجود مستندة إلى قدرته تعالى و علمه بالنظام الأَصلح، و لا تثبت أن إرادته تعالى عين علمه أو قدرته. (6)
يلاحظ عليه : إِنَّه لو كان الملاك لإِطلاق الإِرادة هو تماميّة الفعل من حيث السَّبب ، يلزم صحة إِطلاقها فيما إِذا كان الفاعل المضطر تاماً في سببيَّته ، و هو كما ترى.
أَضف إلى ذلك أنَّ تمامية السبب فيما إِذا كان الفاعل عالماً و شاعراً ، حقيقةٌ ، و الإِرادةُ حقيقةٌ أُخرى. و قد قلنا إِنَّه يجب إِجراء الصفات على الله سبحانه بعد التجريد عن شوائب الإِمكان و المادية ، مع التَّحفُّظ على معناها ، لا سَلْخها عن حقيقتها و واقعيتها.
هـ ـ الحق في الموضوع :
الحق أنَّ الإِرادة من الصفات الذاتية و تجري عليه سبحانه على التطوير الذي ذكرناه في « الحياة » و لأَجل توضيح المطلب نأتي بكلمة مفيدة في جميع صفاته سبحانه و هي :
يجب على كل إلهي ـ في إجراء صفاته سبحانه عليه تجريدها من شوائب النقص و سمات الإِمكان ، و حملها عليه بالمعنى الذي يليق بساحته مع التحفظ على حقيقتها و واقعيتها حتى بعد التجريد.
مثلا ، إنّا نصفه سبحانه بالعلم ، و نُجريه عليه مُجَرَّداً عن الخصوصيات و الحدود الإِمكانية ولكن مع التحفّظ على واقعيته ، و هو حضور المعلوم لدى العالم. و أما كَونُ علمه كَيْفاً نفسانيِاً أو إضافةً بين العالِم و المعلوم ، فهو مُنَزّه عن هذه الخصوصيات. ومثل ذلك الإِرادة ، فلا شك أنها وصف كمال له سبحانه ، و تجري عليه سبحانه مجرّدة عن سِمات الحدوث و الطُروء و التَدرّج و الانقضاء بعد حصول المراد ، فإنَّ ذلك كلَّه من خصائص الإِرادة الإِمكانية. و إنما يُراد من توصيفه بالإِرادة كونه فاعلا مختاراً في مقابل كونه فاعلا مضطراً. و هذا هو الأصل المُتّبع في إجراء صفاته سبحانه و إليك توضيحه في مورد الإِرادة :
إِنَّ الفاعل إمّا أنْ يكون مؤثّراً بِطَبْعِه غيرَ عالم بفعله ، و هو الفاعل الطبيعي ، كالنار بالنسبة إلى الإِحراق. و إِمَّا أن يكون عالماً بفعله غير مُريد له فيصدر منه الفعل عن شعور بلا إرادة كرعشة المرتعش. و إما أن يكون عالماً مريداً عن كراهة لمراده وإنما أراده لأجل أنَّه أقل الخطيرن وأضعف الضررين ، كما في الفاعل المكره. وإمّا أن يكون عالماً مريداً لكن لا عن كراهة بل عن رضا بفعله و هو الفاعل المريد الراضي بفعله. و القسمان الأخيران و إن كانا يشتركان في كون الفاعل فيهما مريداً لكن لمّا كان الفاعل في القسم الأول منهما مقهوراً بعامل خارجي ، لا يُعد فعله مظهر للإِختيار التام ، بخلاف الثاني فالفاعل فيه فاعل مختار تام وفعله مَجْلىً للإِختيار.
وهذا الحصر الحقيقي الذي يدور بين النفي و الإِثبات يجرّنا إلى القول بأنَّ فاعليته سبحانه بأحد الوجوه الأربعة :
إمَّا أن يكون فاعلا فاقداً للعلم ، أو يكون عالماً فاقداً للإِرادة ، أو يكون عالماً و مريداً ولكن عن كراهة لفعله لأجل إحاطة قدرة قاهرة عليه ، أو يكون عالماً و مريداً راضياً بفعله. و فاعلية الباري سبحانه غير خارجة عن إحدى هذه الوجوه. والثلاثة الأَول غير لائقة بساحته سبحانه فتعيّن كونه فاعلا مريداً مالكاً لزمام فعله و عمله ، و لا يكون مقهوراً في الإِيجاد و الخلق. هذا من جانب.
ومن جانب آخر إنَّ الإِرادة في المراتب الإِمكانية لا تنفك عن الحدوث و التدرّج و الانقضاء بعد حصول المراد ، و من المعلوم إِنَّ إجراءها بهذه السِمات على الله سبحانه ، محال لاستلزامه طروء الحدوث على ذاته. فيجب علينا في إجرائها عليه سبحانه حذف هذه الشوائب ، فيكون المراد من إرادته حينئذ اختياره و عدم كونه مضطراً في فعله و مجبوراً بقدرة قاهرة.
فلو صح تسمية هذا الإِختيار بالإِرادة فنعم المراد ، و إلاّ وجب القول بكونها من صفات الفعل.
وبعبارة أُخرى : إِنَّ الإِرادة صفة كمال لا لأجل كونها حادثة طارئة منقضية بعد حدوث المراد ، و إنما هي صفة كمال لكونها رمز الإِختيار و سِمَةَ عدم المَقْهُوريّة حتى إن الفاعل المريد المُكْرهَ له قِسْط من الإِختيار ، حيث يختار أحد طرفي الفعل على الآخر تلو محاسبات عقلية فيرجح الفعل على الضرر المتوعد به. فإِذا كان الهدف و الغاية من توصيف الفاعل بالإِرادة هو إثبات الإِختيار و عدم المقهوريّة فتوصيفه سبحانه بكونه مختاراً غير مقهور في سلطانه ، غير مجبور في إعمال قدرته ، كاف في جري الإِرادة عليه ، لأن المختار واجد لكمال الإِرادة على النحو الأتم و الأكمل. و قد مرّ أنه يلزم في إجراء الصفات ترك المبادي و الأخذ بجهة الكمال ، فكمال الإِرادة ليس في كونها طارئة زائلة عند حدوث المراد أو كون الفاعل خارجاً بها عن القوة إلى الفعل أو من النقص إلى الكمال. بل كمالها في كون صاحبها مختاراً ، مالكاً لفعله آخذاً بزمام عمله ، فلو كان هذا هو كمال الإِرادة ، فالله سبحانه واجد له على النحو الأكمل إذْ هو الفاعل المختار غير المقهور في سلطانه ، {وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ} [يوسف: 21].
الإِرادة في السُنَّة :
يظهر من الروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السَّلام ) أنَّ مشيئته و إرادته من صفات فعله ، كالرازقيّة و الخالقيّة ، و إليك نُبَذاً من هذه الروايات :
1 ـ روى عاصِم بن حُمَيْد عن أبي عبدالله ( عليه السَّلام )قال : « قلت : لم يَزَل الله مريداً؟. قال : إِنَّ المريد لا يكون إلاّ لمراد معه. لم يزل الله عالماً قادراً ، ثم أراد » (7).
يبدو أنَّ الإِرادة التي كانت في ذهن الراوي وسأل عنها الارادة بمعنى العزم على الفعل ، الذي لا ينفك غالباً عن الفعل. فأراد الإِمام هدايته إلى أنَّ الإِرادة بهذا المعنى لا يمكن أن تكون من أوصافه الذاتية ، لأنه يستلزم قدم المراد أو حدوث المريد. ولأجل أن يتلقى الراوي معنى صحيحاً للإِرادة ، يناسب مستوى تفكيره ، فَسّر ( عليه السَّلام ) الإِرادة بالمعنى الذي يجري عليه سبحانه في مقام الفعل و قال : « لم يزل الله عالماً قادراً ثم أراد » أي ثم خلق. ولكن ما جاءت به الرواية لا ينفي أن تكون الإِرادة من أوصافه الذاتية بشكل لا يستلزم قدم المراد ، و هو كونه سبحانه مختاراً بالذات غير مضطر و لا مجبور.
وبذلك ظهر أنَّ لإِرادته سبحانه مرحلتان كعلمه ، ولكل تفسيره
الخاص.
2 ـ روى صَفْوان بن يَحيى قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السَّلام ) : « أخْبِرْني عن الإِرادة من الله، و من الخلق ».
قال : فقال ( عليه السَّلام ) : « الإِرادة من الخلق الضمير ، و ما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل ، و أما من الله تعالى فإِرادته ، إحداثه لا غير ذلك ، لأنه لا يُروّي و لا يَهمّ و لا يتفكّر ، و هذه الصفات منفية عنه ، و هي صفات الخلق. فإِرادة الله الفعل لا غير ذلك ، يقول له كن فيكون ، بلا لفظ ، ولا نُطْق بلسان ، و لا هِمَّة ، و لا تَفَكُّر و لا كَيْف لذلك ، كما أنَّه لا كَيْف له » (8).
وهذه الرواية تتحد مع سابقتها في التفسير و التحليل. فالإِرادة التي كان البحث يدور عليها بين الإِمام والراوي هي الإِرادة بمعنى « الضمير و ما يبدو للمريد بعد الضمير من الفعل ». و من المعلوم أنَّ الإِرادة بهذا المعنى سمة الحدوث ، و آية الإِمكان ، و لا يصح توصيفه سبحانه به. و لأجل ذلك ركّز الإِمام على نفيها بهذا المعنى عن الباري ، فقال : « لأنه لا يروّي ولا يهمّ و لا يتفكّر ».
ولكن ـ لأجل أن يتلقى الراوي مفهوماً صحيحاً عن الإِرادة يناسب مستوى عقليّته فسّر الإِمام الإِرادة، بالإِرادة الفعليّة ، فقال : « فإِرادة الله الفعل لا غير ذلك ، يقول له كن فيكون ... ». فمع ملاحظة هذه الجهات لا يصح لنا أن نقول إنَّ الإِمام بصدد نفي كون الإِرادة من صفات الذات ، حتى بالمعنى المناسب لساحة قدسه سبحانه.
3 ـ روى محمد بن مسلم عن أبي عبدالله ( عليه السَّلام ) قال : « المشيئة مُحْدَثَة » (9).
والهدف من توصيف مشيئته سبحانه بالحدوث هو إبعاد ذهن الراوي
عن تفسيرها بالعزم على الفعل و جعلها و صفاً للذّات ، فإنَّ تفسير الإِرادة بهذا المعنى لا يخلو عن مفاسد ، منها كون المُراد قديماً. فلأجل ذلك فسّر الإِمام الإِرادة بأحد معنييها و هو الإِرادة في مقام الفعل و قال : « المشيئة مُحَدَثَة » ، كناية عن حدوث فعله وعدمِ قدمه.
وبذلك تقدر على تفسير ما ورد حول الإِرادة من الروايات التي تركز على كونها و صفاً لفعله سبحانه (10).
ثم إِنَّ ها هنا أسئلة حول كون إرادته سبحانه من صفاته الذاتية ، و أنت بعد الإِحاطة بما ذكرنا تقدر على الإِجابة عنها. و إليك بعض تلك الأسئلة :
1 ـ إِنَّ الميزان في تمييز الصفات الذاتيّة عن الصفات الفعلية ـ كما ذكره الشيخ الكليني في ذيل باب الإِرادة ـ هو أنَّ الأُولى لا تدخل في إطار النفي و الإِثبات بل تكون أحادية التعلق ، فلا يقال إنَّ الله يعلم و لا يعلم ، بخلاف الثانية فإنها تقع تحت دائرة النفي والإِثبات فيقال إِنَّ الله يُعطي و لا يعطي. فعلى ضوء هذا ، يجب أن تكون الإِرادة من صفات الفعل إذ هي مما يتوارد عليها النفي و الإِثبات. يقول سبحانه : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
والجواب عن هذا السؤال بوجهين :
أحدهما : إِنَّ الإِرادة التي يتوارد عليها النفي و الإِثبات هي الإِرادة في مقام الفعل ، و أما الإِرادة في مقام الذات التي فسّرناها بكمال الإِرادة و هو الإِختيار ، فلا تقع في إطار النفي و الإِثبات.
وثانيهما : ما أجاب به صدر المتألهين معتقداً بأنَّ لله سبحانه إرادةً بسيطةً مجهولةَ الكُنه و أن الذي يتوارد عليه النفي و الإِثبات ، الإِرادة العددية الجزئية المتحققة في مقام الفعل. و أما أصل الإِرادة البسيطة ، و كونه سبحانه فاعلا عن إرادة لا عن اضطرار و إيجاب ، فلا يجوز سلبه عن الله سبحانه. و أنَّ منشأ الاشتباه هو الخلط بين الإِرادة البسيطة في مقام الذات ، الّتي لا تتعدد ولا تتثنى، وبين الإرادة العددية المتحققة في مقام الفعل التي تتعدد و تتثنى ويرد عليها النفي و الإِثبات.
قال : « فرق بين الإِرادة التفصيليّة العددية التي يقع تعلّقها بجُزْئِيٍّ من أعداد طبيعة واحدة أو بكل واحد من طَرَفَيْ المقدور كما في القادرين من الحيوانات ، و بين الإِرادة البسيطة الحقّة الإِلهية التي يَكِلّ عن إدراكها عقول أكثر الحكماء فضلا عن غيرهم » (11).
2 ـ لو كانت الإِرادة نفس ذاته سبحانه لزم قدم العالم ، لأَنَّها متحدة مع الذات ، و الذات موصوفة بها، و هي لا تنفك عن المراد.
يلاحظ عليه :
أولا ـ إنَّ الإِشكال لا يختص بمن جعل الإِرادة بمعناها الحقيقي وصفاً لذاته سبحانه ، بل الإِشكال يتوجه أيضاً على من فسّر إرادته بالعلم بالأصلح لاستناد وجود الأشياء إلى العلم بالنظام الأتمّ الذي هو عَيْن ذاته ، و استحالة انفكاك المعلول عن العلّة أمر بَيِّن من غير فرق بين تَسْمِيَة هذا العلم إرادة أو غيرها ، فلو كان النظام الأصلح معلولا لعلمه ، والمفروض أنَّ علمه قديم ، للزم قدم النظام لقدم علّته.
وثانياً ـ إذا قلنا بأنَّ إرادته سبحانه عبارة عن كونه مختاراً غير ملزم بواحد من الطرفين ، لا يلزم عندئذ قِدَم العالم إذا اختار إيجاد العالم متأخراً عن ذاته.
وثالثاً ـ إِنَّ لصدر المتألهين و من حذا حذوه من الاعتقاد بالإِرادة الذاتية البسيطة المجهولة الكُنْه ، أنْ يجيب بأنَّ جهْلَنا بحقيقة هذه الإِرادة و كيفيّة إعمالها يصُدّنا عن البحث عن كيفية صدور فعله عنه و أنَّه لماذا خلق حادثاً و لم يخلق قديماً.
وها هنا نكتة نعلقها على هذا البحث بعد التنبيه على أمر و هو أنَّ الزمان كمٌّ مُتّصل يُنتزع من حَرَكة الشيء و تغيّره من حال إلى حال و من مكان إلى مكان و من صورة نوعية إلى أخرى ، فمقدار الحركة عبارة عن الزمان ، و لولا المادة و حركتها لما كان للزمان مفهومٌ حقيقيٌ بل مفهوم وهمي.
هذا ما أثبتته الأبحاث العميقة في الزمان و الحركة. و قد كان القدماء يزعمون أنَّ الزمان يتولد من حركة الأفلاك و النيّرين و غير ذلك من الكواكب السيارة ، ولكن الحقيقة أَنَّ كل حركة حليفة الزمان وراسمته و مولدته.
وبعبارة ادقّ : إِنَّ التبدّلات عنصرية كانت أو أثيرية ، مشتملة على أمرين : الأول ، حالة الانتقال من المبداً إلى المنتهى ، سواء أكان الإِنتقال في الوصف أم في الذات. الثاني ، كَوْن ذلك الانتقال على وجه التدريج و السيلان لا على نحو دَفْعي.
فباعتبار الأمر الأول تُوصف بالحركة ، و باعتبار الثاني تُوصف بالزمان.
فكأنَّ شيئاً واحداً باسم التغير و التبدل و الإِنتقال ، يكون مبدءً لانتزاع مفهومين منه ، لكن كل باعتبار خاص ، هذا من جانب.
ومن جانب آخر ، إِنَّ المادة تتحقق على نحو التدريج و التجزئة و لا يصح وقوعها بنحو جمعي ، لأن حقيقتها حقيقة سيّالة متدرجة أشبه بسيلان الماء ، فكل ظاهرة ماديّة تتحقق تلو سبب خاص ، و ما هذا حاله يستحيل عليه التحققق الجمعي أو تقدم جزء منه أو تأخره بل لا مناص عن تحقُّق كل جزء في ظرفه و موطنه ، و بهذا الاعتبار تشبه الأرقام و الأعداد ، فالعدد « خمسة » ليس له موطن إلاّ الوقوع بين « الأربعة و الستة ». و تقدمه على موطنه كتأخره عنه مستحيل. و على ذلك فالأسباب والمسببات المترتبة بنظام خاص يستحيل عليها خروج أي جز من أجزائها عن موطنه و محله.
إذا عرفت هذا الأمر نرجع إلى بيان النكتة و هي : ماذا يريد القائل من قوله لو كانت الإِرادة صفة ذاتية لله سبحانه يلزم قدم العالم؟. فإن أراد أنَّه يلزم تحقق العالم في زمان قبله وفي فترة ماضية ، فهذا ساقط بحكم المطلب الأول ، لأنَّ المفروض أنَّه لازمان قبل عالم المادة لما عرفت من أنَّ حركة
المادة ترسم الزمان و تولده.
وإن أراد لزوم تقديم بعض أجزائه على البعض الآخر أو على مجموع العالم فقد عرفت استحالته ، فإِنَّ إخراج كل جزء عن إطاره أمرٌ مستحيل مستلزم لانعدامه.
ثم إِنَّ لصدر المتألهين في هذا المقام كلاماً عميقاً فمن أراد الإِطلاع فليرجع إليه (12).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ الأسفار الأربعة ، ج 6 ، ص 316.
2 ـ المصدر السابق ، ص 333.
3 ـ المصدر نفسه ، ص 331.
4 ـ الكافي ، ج 1 ، ص 109 ، باب الإِرادة.
5 ـ إِنَّ للشيخ المحقق الأصفهاني في تعليقاته على الكفاية كلاماً في المقام ينفعك جداً ، فراجع نهاية الدراية ج 1 ، ص 116 ـ 117 ، ط طهران.
6 ـ ما أوردناه هو تقرير واضح لما أفاده ( قدس سره ) في تعاليق الأسفار ج 6 ، ص 315 و 316. و نهاية الحكمة ص 300.
7 ـ الكافي ج 1 ، باب الإِرادة ، ص 109 ، الحديث الأول.
8 ـ المصدر السابق ، الحديث 3.
9 ـ الكافي ، ج 1 ، باب الإِرادة ، الحديث 7.
10 ـ لا حظ الكافي ، لثقة الإِسلام الكلينى ، ج 1 ، ص 109 ـ 111.
11 ـ الاسفار ، ج 6 ، ص 324.
12 ـ الأسفار ، ج 6 ، ص 368.
 الاكثر قراءة في الارادة
الاكثر قراءة في الارادة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)