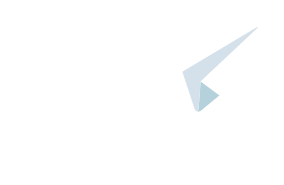تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
خلاصة القول في التفسير بالرأي
المؤلف:
محمد هادي معرفة
المصدر:
التأويل في مختلف المذاهب والآراء
الجزء والصفحة:
ص101-111.
13-10-2014
7115
يتلخّص القول في تفسير حديث «من فسّر القرآن برأيه...» : أنّ الشيء المذموم أو الممنوع شرعاً ، الذي استهدفه هذا الحديث ، أمران :
أحدهما : أن يعمد قوم إلى آية قرآنيّة ، فيحاولوا تطبيقها على ما قصدوه من رأي أو عقيدة ، أو مذهب أو مسلك ، تبريراً لما اختاروه في هذا السبيل ، أو تمويهاً على العامّة في تحميل مذاهبهم أو عقائدهم ، تعبيراً على البسطاء الضعفاء.
وهذا قد جعل القرآن وسيلة لإنجاح مقصوده بالذات ، ولم يهدف تفسير القرآن في شيء. وهذا هو الذي عُنِيَ بقوله (عليه السلام) : «فقد خَرَّ بوجهه أبعد من السماء» ، أو «فليتبوّأ مقعده من النار».
وثانيهما : الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن ، محايداً طريقة العقلاء في فهم معاني الكلام ، ولاسيّما كلامه تعالى. فإنّ للوصول إلى مراده تعالى من كلامه وسائلَ وطرقاً ، منها : مراجعة كلام السلف ، والوقوف على الآثار الواردة حول الآيات ، وملاحظة أسباب النزول ، وغير ذلك من شرائط يجب توفّرها في مفسّر القرآن الكريم. فإغفال ذلك كلّه ، والاعتماد على الفهم الخاصّ ، مخالف لطريقة السلف والخلف في هذا الباب. ومن استبدّ برأيه هلك ، ومن قال على الله بغير علم فقد ضلّ سواء السبيل ، ومن ثمّ فإنّه قد أخطأ وإن أصاب الواقع ـ فرضاً أو صدفةً ـ لأنّه أخطأ الطريق ، وسلك غير مسلكه القويم!
قال سيّدنا الأستاذ الإمام الخوئي ـ طاب ثراه ـ : «إنّ الأخذ بظاهر اللفظ ، مستنداً إلى قواعد وأصول يتداولها العرف في محاوراتهم ، ليس من التفسير بالرأي ، وإنّما هو تفسير بحسب ما يفهمه العرف ، وبحسب ما تدلّ عليه القرائن المتّصلة والمنفصلة ، وإلى ذلك أشار الإمام جعفر بن محمّـد الصادق (عليه السلام) بقوله : «إنّما هلك الناس في المتشابه; لأنّهم لم يقفوا على معناه ، ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم ، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء...» (1).
قال : «ويحتمل أنّ معنى التفسير بالرأي ، الاستقلال في الفتوى من غير مراجعة الأئمّة (عليهم السلام) مع أنّهم قرناءُ الكتاب في وجوب التمسّك ، ولزوم الانتهاء إليهم. فإذا عمل الإنسان بالعموم أو الإطلاق الوارد في الكتاب ، ولم يأخذ التخصيص أو التقييد الوارد عن الأئمّة (عليهم السلام) كان هذا من التفسير بالرأي.
وعلى الجملة ، حمل اللفظ على ظاهره بعد الفحص عن القرائن المتّصلة والمنفصلة ، من الكتاب والسنّة أو الدليل العقلي ، لا يُعدّ من التفسير بالرأي ، بل ولا من التفسير نفسه» (2).
قلت : وعبارته الأخيرة إشارة إلى أنّ الأخذ بظاهر اللفظ ، مستنداً إلى دليل الوضع أو العموم أو الإطلاق ، أو قرائن حاليّة أو مقاليّة ونحو ذلك ، لا يكون تفسيراً; إذ لا تعقيد في اللفظ حتّى يكون حلّه تفسيراً ، وإنّما هو جري على المتعارف المعهود ، في متفاهم الأعراف.
إذ قد عرفت أنّ التفسير ، هو : كشف القناع عن اللفظ المشكل ، ولا إشكال حيث وجود أصالة الحقيقة أو أصالة الإطلاق أو العموم ، أو غيرُها من أُصول لفظيّة معهودة.
نعم ، إذا وقع هناك إشكال في اللفظ; بحيث أبهم المعنى إبهاماً ، وذلك لأسباب وعوامل قد تدعو إبهاماً أو إجمالا في لفظ القرآن ، فيخفى المراد خفاءً في ظاهر التعبير ، فعند ذلك تقع الحاجة إلى التفسير ورفع هذا التعقيد.
والتفسير ـ في هكذا موارد ـ لا يمكن بمجرّد اللجوء إلى تلكم الأُصول المقرَّرة لكشف مرادات المتكلّمين حسب المتعارف; إذ له طرق ووسائل خاصّة غير ما يتعارفه العقلاء في فهم معاني الكلام العادي ، على ما يأتي في كلام السيّد الطباطبائي.
والتفسير بالرأي المذموم عقلا والممنوع شرعاً ، إنّما يعني هكذا موارد متشابهة أو متوغّلة في الإبهام ، فلا رابط ـ ظاهراً ـ لما ذكره سيّدنا الأُستاذ ، مع موضوع البحث ، وعبارته الأخيرة ربّما تشي بذلك.
وقال سيّدنا العلاّمة الطباطبائي : الإضافة ـ في قوله : برأيه ـ تفيد معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال ، بأن يستقلّ المفسّر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربيّ ، فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس ، فإنّ قطعةً من الكلام من أيّ متكلّم إذا ورد علينا ، لم نلبث دون أن نُعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي ، ونحكم بذلك أنّه أراد كذا ، كما نجري عليه في الأقارير والشهادات وغيرهما. كلّ ذلك لكون بياننا مبنيّاً على ما نعلمه من اللّغة ، ونعهده من مصاديق الكلمات ، حقيقة ومجازاً.
والبيان القرآنيّ غير جار هذا المجرى ، بل هو كلام موصول بعضها بعض ، في حين أنّه مفصول ، ينطق بعضُه ببعض ، ويشهد بعضُه على بعض ، كما قاله عليّ (عليه السلام) (3).
فلا يكفي ما يتحصّل من آية واحدة بإعمال القواعد المقرَّرة ، دون أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة لها ، ويجتهد في التدبّر فيها.
فالتفسير بالرأي المنهيّ عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المنكشف. فالنهي إنّما هو عن تفهّم كلامه تعالى على نحو ما يُتفهّم به كلام غيره ، حتّى ولو صادف الواقع; إذ على فرض الإصابة يكون الخطأ في الطريق.
قال : ويؤيّد هذا المعنى ، ما كان عليه الأمر في زمن النبيّ (صلى الله عليه وآله) فإنّ القرآن لم يكن مؤلّفاً بعدُ ، ولم يكن منه إلاّ سور أو آيات متفرّقة في أيدي الناس ، فكان في تفسير كلّ قطعة قطعة منه خطر الوقوع في خلاف المراد.
قال : والمحصّل أنّ المنهيّ عنه إنّما هو الاستقلال في تفسير القرآن ، واعتماد المفسّر على نفسه من غير رجوع إلى غيره ، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه.
قال : وهذا الغير ـ لا محالة ـ إمّا هو الكتاب أو السنّة. وكونه هي السنّة ، ينافي كون القرآن هو المرجع في تبيان كلّ شيء ، وكذا السنّة الآمرة بالرجوع إلى القرآن عند التباس الأُمور ، وعرض الحديث عليه لتمييز صحيحه عن سقيمه ، فلم يبق للمراجعة والاستمداد في تفسير القرآن سوى نفس القرآن. فإنّ القرآن يفسّر بعضُه بعضاً ، وينطق بعضُه ببعض ، ويشهد بعضُه على بعض (4).
وهذا الذي ذكره سيّدنا العلاّمة هنا تحقيق عريق بشأن طريقة فهم معاني كلامه تعالى.
قال في مقدّمة التفسير : إنّ الاتّكاء على الأنس والعادة في فهم معاني الآيات ، يشوّش على الفاهم سبيله إلى إدراك مقاصد القرآن; إذ كلامه تعالى ناشئ من صميم ذاته المقدّسة ، التي لا مثيل لها ولا نظير {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } [الشورى : 11] ، {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ } [الأنعام : 103] ، {سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} [المؤمنون : 91].
وهذا هو الذي دعا بالنابهين أن لا يقتصروا على الفهم المتعارف لمعاني الآيات الكريمة ، وأجازوا لأنفسهم الاعتماد ـ لإدراك حقائق القرآن ـ على البحث والنظر والاجتهاد.
وذلك على وجهين : إمّا بحثاً علميّاً أو فلسفيّاً أو غيرهما ، للوصول إلى مراده تعالى في آية من الآيات; وذلك بعرض الآية على ما توصّل إليه العلم أو الفلسفة من نظريّات أو فرضيّات مقطوع بها ، وربّما المظنون منها ظنّاً راجحاً ، وهذه طريقة يرفضها ملامح القرآن الكريم.
وإمّا بمراجعة ذات القرآن ، واستيضاح فحوى آية من نظيرتها ، وبالتدبّر في نفس القرآن الكريم; فإنّ القرآن ينطق بعضُه ببعض ، ويشهد بعضُه على بعض ، كما قال عليّ (عليه السلام).
قال تعالى : {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل : 89] ، وحاشا القرآن أن يكون تبياناً لكلّ شيء ولا يكون تبياناً لنفسه ، وقد نزل القرآن ليكون هدىً للناس ونوراً مبيناً وبيّنةً وفُرقاناً ، فكيف لا يكون هادياً للناس إلى معالمه ، ومرشداً لهم على دلائله؟! وقد قال تعالى : {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت : 69] ، وأيّ جهاد أعظم من بذل الجهد في سبيل فهم كتاب الله ، واستنباط معانيه واستخراج لآلئه. نعم ، القرآن هو أهدى سبيل إلى نفسه ، لا شيء أهدى منه إليه. وهذه هي الطريقة التي سلكها النبيّ وعترته الأطهار صلوات الله عليهم في تفسير القرآن والكشف عن حقائقه ـ على ما وصل إلينا من دلائلهم في التفسير ـ ولا يوجد مورد واحد استندوا لفهم آية ، على حجّة نظريّة عقليّة أو فرضيّة علميّة ، ونحو ذلك (5).
وتوضيحاً لما أفاده سيّدنا العلاّمة في هذا المجال ، نعرض ما يلي :
كان للبيان القرآني أُسلوبه الخاصّ في التعبير والأداء ، ممتازاً على سائر الأساليب ، ومختلفاً عن سائر البيان; ممّا يبدو طبيعيّاً ، شأن كلّ صاحب فنّ جديد كان قد أتى بشيء بديع. ومن ثمّ كان للقرآن لغته الخاصّة به ، ولسانه الذي يتكلّم به ، ولهجته التي يلهج بها ، ممتازةً عن سائر اللهجات.
نعم ، إنّ للقرآن مصطلحات في تعابيره واستهداف مراميه ، كانت تخصّه ، ولا تُعرف مصطلحاته إلاّ من قبل نفسه ، شأن كلّ صاحب اصطلاح.
ومن المعلوم أنّ الوقوف على مصطلحات أيّ فنّ من الفنون ، لا يمكن بالرجوع إلى اللغة وقواعدها ، ولا إلى الأُصول المقرّرة لفهم الكلام في الأعراف; لأنّها أعراف عامّة ، وهذا عُرف خاصّ. فمن رام الوقوف على مصطلحات علم النحو ـ مثلا ـ فلابدّ من الرجوع إلى النحاة أنفسهم لا غيرهم ، وهكذا سائر العلوم والفنون من ذوي المصطلحات.
ومن ثَمَّ فإنّ القرآن هو الذي يُفسّر بعضه بعضاً ، ويَنْطِقُ بعضُه ببعض ، ويَشْهَدُ بعضُه على بعض.
نعم يختصّ ذلك بالتعابير ذوات الاصطلاح ، وليس في مطلق تعابيره التي جاءت وَفق العرف العامّ.
وبعبارة أُخرى : ليس كلّ تعابير القرآن ممّا لا يُفهم إلاّ من قِبَله ، إنّما تلك التعابير التي جاءت وَفق مصطلحه الخاصّ ، وكانت تحمل معاني غير معاني سائر الكلام. أمّا التي جاءت وَفق اللّغة أو العرف العامّ ، فطريق فهمها هي اللغة والأُصول المقرّرة عرفيّاً لفهم الكلام.
وبعبارة ثالثة : الحاجة إلى عرفان مصطلحات القرآن ، إنّما تكون في موارد التفسير; حيث الغموض والإبهام في ظاهر التعبير ، دون ترجمة الألفاظ والكلمات ، وإدراك مفاهيم الكلام وَفق الأعراف العامّة ، ممّا يعود إلى البحث عن حجيّة الظواهر ، فإنّها حجّة بلا كلام ، سواء في القرآن أم في غيره ، سواء بسواء.
وهذا غير المبحوث عنه هنا ، حيث خفاء المراد وراء ستار اللفظ ، المعبّر عنه بالبطن المختفي خلف الظهر. فالظهر لعامّة الناس حيث متفاهمهم ، ويكون حجّة لهم ومستنداً يستندون إليه في التكليف ، أمّا البطن فللخاصّة ممّن يتعمّقون في خفايا الأسرار ، ويستخرجون الخبايا من وراء الستار.
ومن ثمّ كان المطلوب من الأُمّة (العلماء والأئمّة) التفكّر في الآيات والتدبّر
فيها ، وتعقّلها ومعرفتها حقّ المعرفة ، قال تعالى : {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ} [النحل : 44]. وقال : {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى } [محمد : 24]. وقال : {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص : 29].
وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «له ظهر وبطن ، فظاهره حكمةٌ وباطنه علم ، ظاهره أنيق وباطنه عميق ، لا تحصى عجائبه ولا تُبلى غرائبه ، فليجل جال بَصَرَهُ ، وليبلغ الصفة نظره ، فإنّ التفكّر حياة قلب البصير» (6).
قال العلاّمة الفيلسوف ابن رشد الأندلسي : «وقد سلك الشرع في تعاليمه وبرامجه الناجحة مسلكاً ينتفع به الجمهور ، ويخضع له العلماء. ومن ثمّ جاء بتعابير يفهمها كلّ من الصنفين : الجمهور يأخذون بظاهر المثال ، فيتصوّرون عن
الممثَّل له ما يشاكل الممثَّل به ، ويقتنعون بذلك. والعلماء يعرفون الحقيقة التي جاءت في طيّ المثال» (7).
وإليك بعض الأمثلة ، شاهداً لما ذكره سيّدنا العلاّمة :
قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ } [الأنفال : 24].
هذا خطاب عامّ يشمل كافّة الّذين آمنوا ، يدعوهم إلى الإيمان الصادق والاستجابة ـ عقيدةً وعملا ـ لدعوة الإسلام ، والاستسلام العامّ للشريعة الغرّاء; إذ في ذلك حياة القلب ، والطمأنينة في العيش ، والالتذاذ بنعمة الوجود.
أمّا الحائد عن طريقة الدين ، والمخالف لمنهاج الشريعة ، فإنّه في قلق من الحياة ، يعيش مضطرباً ، قد سلبت راحتَه كوارثُ الدهر ، يخشى مفاجئتها في كلّ لحظة وأوان.
وأمّا المتّكل على الله ، فهو آمن في الحياة ، يداوم مسيرته ، فارغ البال في كنفه تعالى {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ } [الطلاق : 3] ، {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} [الرعد : 28].
هذا تفسير الدعوة إلى ما فيه الحياة ، ولعلّه ظاهر لا غبار عليه.
وأمّا قوله تعالى بعد ذلك : {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال : 24] فيعلوه غبار إبهام; إذ يبدو أنّه تهديد بأُولئك الحائدين عن جادّة الحقّ ، أن سوف يُجازَوْن بحيلولة بينهم وبين أنفسهم.
والسؤال : كيف هذه الحيلولة ، وما وجه كونها عقوبة لمن نبذ أحكام
الشريعة؟
وللإجابة على هذا السؤال وقع اختلاف عنيف بين أهل الجبر وأصحاب القول بالاختيار ، كما تناوشها كلّ من الأشاعرة وأهل الاعتزال ، كلٌّ يجرّ النار إلى قرصه ، كما اختلف أرباب التفسير على وجوه أوردناها في الجزء الثالث من التمهيد ، عند الكلام عن المتشابهات ، ضمن آيات الهداية والضلال برقم (80).
والذي رجحّناه في تأويل الآية ، هو معنىً غير ما ذكره جلّ المفسّرين ، استفدناه من مواضع من القرآن نفسه : إنّ هذه الحيلولة كناية عن إماتة القلب ، فلا يعي شيئاً بعد فقد الحياة.
لا تُعجِبَنَّ الجَهُولَ حُلَّتُهُ *** فذاك مَيْتٌ وَثَوْبُهُ الكَفَنُ
الإسلام دعوة إلى الحياة ، وفي رفضها رفض للحياة ، تلك الحياة المنبعثة عن إدراكات نبيلة ، والملهمة للإنسان شعوراً فيّاضاً يسعد به في الحياة ، ويُحظى بكرامته الإنسانيّة العليا.
أمّا إذا عاكس فطرته ، وأطاح بحظّه ، فإنّه سوف يشقى في الحياة ، ولم يزل يتخبّط في ظلمات غيّه وجهله {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ} [البقرة : 257].
فالإنسان التائه في ظلمات غيّه قد فقد شعوره ، وافتقد كرامته العليا في الحياة ، فهذا قد نسي نفسه وذُهل عن كونه إنساناً ، يحسب من نفسه موجوداً ذا حياة بهيميّة سفلى ، إنّما يسعى وراء نهمه وشبع بطنه ، لا هدف له في الحياة سواه.
وهذا التسافل في الحياة كانت نتيجة تساهله بشأن نفسه وإهمال جانب كرامته ، وهذا هو معنى قوله تعالى : {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ} [الأنعام : 110] ، قال تعالى : { وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ} [الحشر : 19].
فإنّ نسيان النفس كناية عن الابتعاد عن معالم الإنسانيّة والشرف التليد {وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ} [الأعراف : 176].
وقال تعالى : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [المائدة : 38].
اختلف الفقهاء في موضع القطع من يد السارق; حيث الإبهام في ذات اليد ، أنّها من الكتف أم من المرفق أم الساعد أم الكرسوع (طرف الزند) أم الأشاجع (أُصول الأصابع)؟
روى أبو النضر العيّاشي في تفسيره بالإسناد إلى زرقان صاحب ابن أبي داود ، قاضي القضاة ببغداد ، قال : أُتي بسارق إلى المعتصم وقد أقرّ بالسرقة ، فسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ ، فجمع الفقهاء يستفتيهم في إقامة حدّ السارق عليه ، وكان ممّن أُحضر الإمام محمّـد بن عليّ الجواد (عليه السلام) ، فسألهم عن موضع القطع.
فقال ابن أبي داود : من الكرسوع ، استناداً إلى آية التيمّم; حيث المراد من اليد في ضربتيه هو الكفّ ، ووافقه قوم. وقال آخرون : من المرفق ، استناداً إلى آية الوضوء.
فالتفت الخليفة إلى الإمام الجواد يستعلم رأيه ، فاستعفاه الإمام ، فأبى وأقسم عليه أن يخبره برأيه.
فقال (عليه السلام) : أمّا إذا أقسمت علَيّ بالله ، إنّي أقول : إنّهم أخطأوا فيه السنّة ، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع ، فيُترك الكفّ.
قال المعتصم : وما الحجّة في ذلك؟
قال الإمام : قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) : السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين ، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق ، لم يبق له يدٌ يسجد عليها ، وقد قال الله تعالى : {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله} يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها {فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا } [الجن : 18] ، وما كان لله لم يُقطع.
فأعجب المعتصم هذا الاستنتاج البديع ، وأمر بالقطع من الأشاجع (8).
انظر إلى هذه الالتفاتة الرقيقة ، يجعل من آية المساجد ، بتأويل ظاهرها (هي المعابد) إلى باطنها (الشمول لما يُسْجَدُ به ، أي يَتَحَقَّقُ به السُّجود) ، منضمّةً إلى كلام الرسول في بيان مواضع السجدة ، يجعل من ذلك كلّه دليلا على تفسير آية القطع وتعيين موضعه ، بهذا النمط البديع.
وقد استظهر (عليه السلام) من الآية أنّ راحة الكفّ ، وهي من مواضع السجود ، كانت لله ، فلا تشملها عقوبة الحدّ التي هي جزاء سيئة ، لاتحلّ فيما لا يعود إلى مرتكبها ، فإنّ راحة الكفّ موضع السجود لله!.
وللأُستاذ الذهبي ـ هنا ـ محاولة غريبة يجعل من التفسير بالرأي قسمين : قسماً جائزاً و ممدوحاً ، وآخر مذموماً غير جائز. وحاول تأويل حديث المنع إلى القسم المذموم.
قال : «والمراد بالرأي هنا الاجتهاد ، وعليه فالتفسير بالرأي عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد ، بعد معرفة المفسّر لكلام العرب ومناحيهم في القول ، ومعرفته للألفاظ العربيّة ووجوه دلالتها ، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ، ووقوفه على أسباب النزول ، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن ، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر».
قال : «واختلف العلماء قديماً في جواز تفسير القرآن بالرأي ، فقوم تشدّدوا في ذلك ولم يجيزوه ، وقوم كان موقفهم على العكس ، فلم يروا بأساً من أن يُفسّروا القرآن باجتهادهم ، والفريقان على طرفي نقيض فيما يبدو ، وكلّ يعزّز رأيه بالأدلّة والبراهين».
ثمّ جعل يسرد أدلّة لكلّ من الفريقين ، ويجيب عليها واحدة واحدة بإسهاب ، وأخيراً قال : «ولكن لو رجعنا إلى أدلّة الفريقين ، وحلّلنا أدلّتهم تحليلا دقيقاً; لظهر لنا أنّ الخلاف لفظيّ ، وأنّ الرأي قسمان : قسمٌ جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول ، مع موافقة الكتاب والسنّة ، ومراعاة سائر شروط التفسير ، وهذا القسم جائز لاشكّ فيه. وقسمٌ غير جار على قوانين العربيّة ، ولا موافقة للأدلّة الشرعيّة ، ولا مستوف لشرائط التفسير ، هذا هو مورد النهي ومحطّ الذمّ» (9).
قلت : أمّا تورّع بعض السلف عن القول في القرآن ، فلعدم ثقته بذات نفسه ، وضآلة معرفته بمعاني كلام الله. أمّا العلماء العارفون بمرامي الشريعة ، فكانوا يتصدّون التفسير عن جرأة علميّة وإحاطة شاملة لجوانب معاني القرآن.
وأمّا التفسير بالرأي فأمر وقع المنع منه على إطلاقه ، وليس على قسم منه ، كما زعمه هذا الأُستاذ.
والذي أوقعه في هذا الوهم ، أنّه حسب التفسير بالرأي هنا بمعنى الاجتهاد ، في مقابلة التفسير بالمأثور ، ولاشكّ من جواز الاجتهاد في استنباط معاني الآيات الكريمة إن وقع عن طريقه المألوف.
وبعد ، فقد ذكر الراغب الأصبهاني هنا شرائط يجب توفّرها في المفسّر ، حتّى لا يكون تفسيره تفسيراً بالرأي الممنوع شرعاً والممقوت عقلا ، نذكره بتفصيله ، فإنّ فيه الفائدة المتوخّاة في هذا الباب.
____________________
1 . وسائل الشيعة 27 : 201 باب صفات القاضي رقم 62 ، بحار الأنوار 9 : 12.
2 . البيان : 287 ـ 288.
3 . نهج البلاغة : 192 الخطبة 133.
4 . تفسير الميزان 3 : 77 ـ 79 ، وراجع : 1 : 10 أيضاً.
5 . تفسير الميزان 1 : 9 ـ 10.
6 . محمّد(صلى الله عليه وآله) ( 47 ) : 24.
7 . مقدّمة تفسير الميزان 1 : 10 ، الكافي الشريف 2 : 599.
7 . رسالة الكشف عن مناهج الأدلّة : 97.
8 . تفسير العياشي 1 : 319 ـ 320.
9 . التفسير والمفسّرون 1 : 255 و264.
 الاكثر قراءة في منهج التفسير بالرأي
الاكثر قراءة في منهج التفسير بالرأي
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)