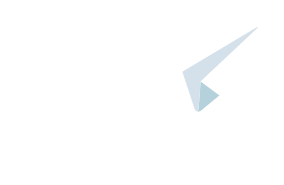تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
ماهية الشفاعة واقسامها
المؤلف:
الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الاملي
المصدر:
تسنيم في تفسير القران
الجزء والصفحة:
ج4 ص237 - 249
2023-04-07
2515
{وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ} [البقرة: 48]
إن الشفاعة مأخوذة من "الشفع" وهو بمعنى الزوج، والشفيع هو الذي يضم المشفوع له إليه فيكون زوجه.
وتوضيح ذلك هو: إذا قرر أن يُنجز عمل للمشفوع له لكن مشكلة عرضت وهي أن قابلية المشفوع له تعاني من النقص ولا تبلغ حد النصاب اللازم أو أن فاعليّة الفاعل تفتقد السعة الكافية ولابد لبعض أوصاف الفاعل الأخرى من أن تنزل إلى الساحة لتوسع من فاعليته، فإن دور الشفيع في مثل هذه المواقف يكون إما في تكميل قابلية القابل وإظهار عجزه ومسكنته - على سبيل المثال - ممّا يؤدي إلى انعطاف في الفاعل، وإما في جعل فاعلية الفاعل أوسع فتضم مثلاً إحسانه وكرمه إلى عدله كي يتعامل مع المتهم أو المجرم من منطلق عنوان "المحسن" وينتهج معه منهج الفضل وليس بعنوان "العادل" وفي كسوة الممكن أن "العدل"، ومن ينجز الشفيع كلتا المهمتين معاً.
ومن جملة الشفعاء التوبة: "لا شفيع أنجح من التوبة" (1) وعندما يُقال في حال التوبة: "إلهي ! أنت عفو غفور رؤوف، أهل الفضل والإحسان والجود، أهل العفو والصفح، فاصفح عن عبدك" فهو من قبيل القسم الثاني، وعندما تذكر أحياناً أوصاف العبد فيقال على سبيل المثال: "عبيدك بفنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك" (2)، فهو من قبيل القسم الأول، وإن الجمع بين الاثنين هو نظير ما يُقال: أنت المالك وأنا المملوك، وأنت الرب وأنا العبد وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت المعطي وأنا السائل، وأنت الجواد وأنا البخيل، و..." (3).
فإن دعي العبد إلى محكمة الله لوحده فإنّه سيدان؛ كما أنه لو أراد الله العادل أن يحكم بصفة عدله وحسب فسيدان العبد أيضاً. لكن لو حضر العبد في المحكمة مشفوعاً بصفة الذلة والمسكنة، أو حكم الحاكم العادل بإضافة صفة فضله وإحسانه إليه، فإنّه سيكمل سبيل إيصال الفيض من الفاعل من جهة وطريق تقبله من قبل القابل من جهة أخرى.
يتضح من هذا البيان أنه لا دور للشفيع سوى تكميل قابلية القابل أو الإتيان بوصف من أوصاف الفاعل؛ أي ليس الأمر أن للشفيع فاعلية بذاته كي يطرح طريقاً ثالثاً يكون في عرض الطريقين المذكورين، وإذا طرح الشفيع في بعض الأحيان - حقه هو وتوسل بجاهه ووجاهته فإن ذلك يكون لمجرد التمهيد لأحد الطريقين الآنفي الذكر، وليس لشق طريق ثالث في عرضهما. وبتعبير آخر، فإن الشفيع لا يأتي ليقول: بما أن لديّ جاهاً عندك، أسألك أن تحل هذه المشكلة، بل إن كونه مقرباً لله و"وجيهاً عند الله يكون سبباً لأن يستخدم أحد السبيلين (على نحو القضية المانعة للخلو).
ما قيل إلى الآن إنما يتعلق بالشفاعة التشريعية. أما الشفاعة التكوينية، فبغض الطرف عن المعنى السابق، فمن الممكن أن تكون لها خصوصيتها. الأمور في عالم التكوين هي في عهدة الله تعالى وملكه: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} [الملك: 1]. وفي الوقت ذاته فإن العالم الذي نعيش فيه نحن هو عالم الحركة والتصادم والتغيير والتبديل من هذا المنطلق من الممكن أن يشكل فيض معين واسطةً فينضم إلى القابل ليكمل قابليته ويكون بالنتيجة سبباً لارتقائه واستعداده لتلقي الفيض، أو أن يُشفع وصف من أوصاف الفاعل ويُضمّ إلى وصف آخر له فيبعث على إفاضة فيض جديد منه. أو إذا اعتبرنا أن واسطة الفيض هي الشفيع فإن كافة العلل والأسباب التكوينية للشفيع هي معلولة وإن معنى الشفع والازدواج - بنفس التقريب المذكور سيكون محفوظاً وسيأتي توضيحه فيما بعد.
تنويه: إن القدرة على الشفاعة حالها حال امتلاك هذا الحق، هما من الكمالات الوجودية وإن كلّ كمال وجودي إذا كان ممكناً ذاتاً ولم يكن هناك محذور من وقوعه أي إنه حائز على الإمكان الذاتي والوقوعي - فإن إمكانه يكون بالمعنى العام للإمكان حيث يكون مصحوباً بالضرورة وبتحققه بالفعل وليس إمكاناً خاصاً. تأسيساً على ذلك فإن ثبوته وتحققه بالنسبة لله سبحانه وتعالى الذي هو فوق التمام بالذات وبالأصالة هو حتمي، وبالنسبة للموجودات المجردة التامة، كالناس الكامل والملائكة التامين وحقيقة القرآن وغيرها من الأمور التي تتمتع بالتجرد التام بالعرض وبالتبع، يكون قطعياً، إلا أن التنزل العيني لهذا الكمال وهذا الحق الوجودي، وإن لم تكن له حالة منتظرة من ناحية نفسه، لكنه لما كان وصول القابل إلى حد نصاب القبول أمراً ضرورياً فهو من هذه الناحية - محتاج إلى تمامية نصاب الاستعداد لتقبل الشفاعة، وما لم يكن أو لم يصبح الشخص المشفوع له قابلاً للشفاعة، فإن شفاعة أولياء الله لن تكون نافذة في حقه.
تُطرح الشفاعة في القرآن تارة بصورة فقهية وأخرى بنحو كلامي. فالشفاعة الفقهية هي أن يتوسط المرء في الدنيا بين شخصين كي ينجز للمشفوع له أمراً؛ سواء كان دفعاً لضرر أو جلباً لمنفعة. مثل هذه الشفاعة، التي يكون محورها الفعل الاختياري للمكلف، تكون إما حسنة أو سيئة؛ وذلك لأنها إذا كانت من أجل إنجاز فعل واجب، أو ترك محرم، أو ما شابه أو كانت نظير إيصال النفع إلى الشخص أو المجتمع أو دفع الضرر عنهم فهي تمتاز بالحسن وتكون إما واجبة أو مستحبّة وإذا كانت من أجل ترك واجب، أو فعل محرّم، أو إلحاق ضرر بمسلم، أو كانت سبباً لتبليغ السوء أو تعطيل حد إلهي، أو إخفاء حكم الله، أو صد عن سبيله، أو إقامة سد في مقابل الكوثر الجاري لدين الله فهي حرام، وإذا كانت مما يلحق ضرراً ضعيفاً ولم يصل إلى النصابات المذكورة فهي مكروهة، وما الآية الكريمة: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا} [النساء: 85] إلا ناظرة إلى ذلك.
إن الوجوه المتعددة المبينة لهذه الشفاعة تنضوي جميعها تحت اللواء الجامع ل "فعل المكلف في الدنيا، وحكم مثل ذلك فقهي ودليله - بقطع النظر عن الوضوح الذي يعطيه التدبّر التام بالمبادئ التصورية للمسألة، وبصرف النظر عن الآية المذكورة التي بإمكانها إثبات قسم منه هو الأحاديث المأثورة التي دفعت الفقهاء للإفتاء في ذلك.
يقول النبي الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم): "أفضل الصدقة صدقة اللسان... الشفاعة تفك بها الأسير، وتحقن بها الدم، وتجرّ بها المعروف والإحسان إلى أخيك، وتدفع بها الكريهة" (4) ، "من أفضل الشفاعة أن تشفع بين اثنين في النكاح" (5). ويُستفاد من مثل هذه الأحاديث رجحان الشفاعة الحسنة، الواجبة منها والمستحبة؛ كما ويُستظهر من الحديث القائل: "أيّما رجل حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى لم يزل في سخط الله حتى ينزع" (6) كون الشفاعة السيّئة، سواء المحرمة أو المكروهة مرجوحة، هذا وإن كانت الشفاعة في تعطيل الحدود الإلهية محرمة"
القسم الآخر من الشفاعة هو الشفاعة الكلامية حيث يكون الجزء المهم منها مطروحاً في الآخرة وسيتولى البحث الحالي ذلك وملخصه: أن الأمر الذي لا يقع موضوعاً للقاعدة الاعتبارية القائلة: "ينبغي ولا ينبغي من الممكن أن يُطرح تحت العنوان الكلامي للشفاعة؛ كفعل الله تعالى، وفعل الملائكة الإلهيين سواء كان في الدنيا أو الآخرة، وكفعل الناس أجمعين في الآخرة التي لا تكون ظرفاً للاعتبار وما ينبغي وما لا ينبغي. وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث مستفيضة عن أهل بيت العصمة ناظرة إلى هذا القسم من الشفاعة.
إذا نظرنا للشفاعة من زاوية أخرى فهي تنقسم إلى صنفين: تكوينية وتشريعية (اعتبارية)؛ فتلك المطروحة في دائرة العرف هي من قبيل القسم الثاني، أما ما يُبحث في القرآن تحت عنوان الشفاعة فمعظمه من قبيل القسم الأول، ولا ينتمي إلا في جزء منه إلى القسم الثاني.
وتوضيح ذلك انه في في الثقافة العامة لا تُطرح الشفاعة في الأمور التكوينية؛ بمعنى أنه إذا احتاج أحد لطبيب مثلاً فهو يداوي مرضه بالاستمداد من العلل العادية ومن كان جائعاً فهو يعمد إلى إزالة جوعه من خلال الاستمداد من الوسائل الطبيعية؛ أي إنّه في المشاكل الطبيعية والتكوينية يلجأ الناس إلى العلل التكوينية ولا يعبرون عن ذلك بالشفيع والشفاعة، لكنه في المسائل الاجتماعية والاعتبارية، حيث الأمر بيد الناس، فالحديث يدور حول واضع القوانين والقانون، ومخالفته، ومراعاته، والعفو، والانتقام على يد شخص حقيقي أو حقوقي، فهم يتوسلون بالشفاعة ويقيمون الوساطات لحل مشكلاتهم؛ سواء كان القانون المذكور منزلاً من جانب الله عز وجل أم هو من القوانين البشرية.
والفرق الأساسي بين الشفاعة والرجوع إلى الأسباب والعلل هو أنه في الاستعانة بالعلل والاستمداد من الأسباب فإن نفس هذه العلة وهذا السبب يُطرحان على أنهما العامل في تلبية الحاجة وأن تأثيره، بعنوان أنه مبدأ يعتمد عليه، يكون سبباً للاستمداد منه، أما في الشفاعة فالبناء يقوم على أن مبدأ التأثير هو موجود آخر وما الشفيع إلا رابط وواسطة من أجل تتميم نصاب القبول أو تكميل نصاب سعة الفيض.
ففي ثقافة البشر العامة لا يكون لجوء الظمآن إلى الماء أو الجائع إلى الخبز من سنخ الاستشفاع أبداً. بالطبع إذا التفت المرء إلى أن الشافي والساقي والمطعم الأصلي هو الله عز اسمه: {هُوَ يُطْعَمُني ويسقين * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ} [الشعراء: 80] ثم تقرب، في هذه الحال، إلى ولي من أولياء الله بإذن الله تعالى كي يهدي فكر الطبيب إلى تشخيص المرض وتحديد الدواء المعالج ويهيئ سائر الوسائل والأسباب، فإن معنى الشفاعة التكوينيّة يكون صادقا في هذا المورد.
إن القسم الأعظم من الشفاعة في اللسان القرآني ناظر إلى المسائل التكوينية؛ وذلك لأن الجانب الأهم من الشفاعة التي تم نفيها في القرآن الكريم إنما تعود إلى رد شبهة عباد الأوثان وهي متعلقة بالشفاعة التكوينية. وتوضيحاً لذلك فإنّه على الرغم من أن السواد الأعظم من عباد الأصنام كانوا يقولون، عن عمى، وانطلاقاً من سنتهم وعاداتهم الجاهلية: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23] ، بيد أن محققيهم كانوا يقيمون بضعة أدلة على عبادتهم للأصنام بحيث إن جميعها أو أغلبها يرجع إلى الشفاعة التكوينية للأصنام، وقد أورد القرآن الكريم بعض هذه الأدلة وأخضعها للنقد أيضاً.
أحد أدلة الوثنيين يتلخص في أنه لما كان الله سبحانه وتعالى يمثل حقيقة غير محدودة، ونحن لا نعرفه، ولا هو في متناول أيدينا، فليس بمقدورنا عبادته، ومن هنا فإنه يتحتم علينا اتخاذ وسائط بيننا وبين الله لتتلقى منه الفيض وتوصله إلينا هؤلاء الوسطاء - الذين هم مقربون من الله تعالى، وهم شفعاؤنا عند الله: {هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس: 18]، وإِن تدبير شؤوننا بأيديهم - هم إما الملائكة، أو النجوم، أو عظماء البشر، أو ما شابه ذلك. بالطبع إن معبودات هؤلاء كانت تلك الوسائط، ولم تكن الأصنام التي كانوا يصنعونها إلا تماثيل لتلك المعبودات، لا أنهم يعبدون ذات الأصنام، هذا على الرغم من أن الجُهّال من الوثنيين قد تغير موقفهم تدريجيّاً بحيث كانوا ينظرون إلى الأوثان نظرة استقلال وكانوا يعبدونها هي بذاتها.
والقرآن الكريم، في الوقت الذي روى ونقد عصارة فكر الجهلة ولامهم قائلاً: {أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا} [الأعراف: 195]، {ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ} [الحج: 73]، فَإِن سَلَبَ أحد من الأصنام شيئاً فليس بأيديها صنع شيء لاسترداد ما سلب منها، أو يقول: لماذا تكتفون بالتقليد ولا تكونون من الباحثين المحققين في مسائل الدين؟ لماذا تستندون إلى سُنن أسلافكم الباطلة و... الخ، فقد شن حرباً ثقافية على آراء العلماء الضالين ممن كانوا يعتقدون حقيقة بربوبية الله بالنسبة للعالم بأسره إلا أنهم في الأمور الجزئية، كانوا يقولون بأرباب جزئية كالملائكة، فيقول: لابد للشفيع أن يكون مأذوناً له من جانب الله؛ أقرب إلى كل امرئ من شريان حياته. فهو ليس ببعيد كي لأت الله هو يحتاج إلى واسطة، بل إنه رب العالمين وإله جميع الكون من جهة، وارب كل شيء وكل الأمور، كليها وجزئيها، من جهة أخرى.
كيف يمكن اتخاذ غير الله تعالى رباً والحال أن الله عز وجل هو ربّ كل شيء من ناحية: {أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام: 164]، وهو قريب من الجميع من ناحية أخرى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ} [البقرة: 186]، وهو أقرب إلينا من الآخرين من ناحية ثالثة: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ} [الواقعة: 85]، وهو أقرب إلينا من قربنا نحن لأنفسنا من ناحية رابعة: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ } [ق: 16]، {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} [الأنفال: 24]، كما وإنه يعلم ما نريده قبل أن نعلم نحن ذلك من ناحية خامسة؛ أي ليس إنه عليم بما تُخفي الصدور فحسب، بل إنه مطلع على مكنون القلب قبل اطلاع صاحب القلب عليه: "ويعلم ضمير الصامتين" (7).
يقول القرآن الكريم في جوابه للمشركين: ليس في يد الأغيار صنع إلا بإذن الله، هذا إن كان الأغيار من المقربين عند الله، وأما الذين شيء اتخذتموهم واسطة وطفقتم على عبادتهم فهم إما أنهم غير مقربين؛ كالأوثان أو أنهم إذا كانوا مقربين كالملائكة فليس لديهم القدرة على التصرف باستقلالية وما لم يأذن الله لهم فليس لهم أن ينبسوا ببنت شفة أو أن يقوموا بفعل شيء: {لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} [الأنبياء: 27] ولن يأذن الله لهؤلاء من أجل الشفاعة لكم أيها المشركون الوثنيون: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48].
من الجلي أن مثل هذه الشفاعة تكوينية؛ وذلك لأن المشركين كانوا يعتبرون الأصنام شفعاء ووسطاء في توزيع الأرزاق والنعم التكوينية، لا في المسائل الحقوقية والاجتماعية والقضائية، خصوصاً إذا التفتنا إلى أنهم كانوا منكرين للمعاد. محصلة ذلك، أن كل الآيات النازلة شفاعة الأوثان ونفيها إنّما ترتبط بالشفاعة التكوينية.
كما أن هناك آيات كثيرة تطرح موضوع الشفاعة التشريعية وتتحدث عن القيامة، والنجاة من جهنم، وترفيع الدرجات في الجنة التي تمتد جذورها في التشريع، إلا أنّه من الممكن أن يُقال إن ظهورها في يرجع إلى الشفاعة التكوينية؛ لأن الآخرة هي دار التكوين لا دار الاعتبار والجعل، وأن الجزاء الأخروي هو جزاء تكويني وليس اعتبارياً؛ وذلك لأن جزاء كجزاء السرقة: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وإن كان في الدنيا على هيئة الجزاء الاعتباري في قطع اليد، لكنه ليست عقوبتها في القيامة سوى تجسم لهذه السرقة على هيئة نار؛ نظير ما جاء في التصرف ظلماً بمال اليتيم حيث يقول عز من قائل: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10]
بعد هذا البيان من الممكن أن يُقال إن الشفاعة المطروحة في القرآن بالنسبة للمعاد هي شفاعة تكوينيّة ليس غير ولمّا كان لمثل هذه الشفاعة سبيل إلى الآخرة فإنّها تجري في الدنيا أيضاً؛ وذلك لأت الآية: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ} [يونس: 3] تنطوي على إطلاق وتشمل الدنيا والآخرة، ومن الواضح أن ما طرح في الآية: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس: 18] مرتبط بالشفاعة التكوينية في الدنيا، إذ أن الوثنيين المقصودين في هذه الآية لم يكن لديهم اعتقاد بالآخرة أصلاً كي يقولوا: {هؤلاء شُفَعَوْنَا} في الآخرة.
تنويه: وفقاً لقرينة جملة: {وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ} في الآية 123 من سورة "البقرة" (التي تشبه الآية مدار البحث إلا باختلاف بسيط) حيث يكون عود الضمير في تنفعها إلى "النفس" الثانية قطعاً (أي النفس المشفوع لها)، فإن ضمير منها الذي تكرر مرتين في هذه الآية، عائد إلى "النفس" الثانية أيضاً أي إن الجملتين {لا يُقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل} تكونان بهذا المعنى إذا أرادت النفس الثانية المبتلاة بالعذاب أن تتخذ شفيعاً فلن تقبل شفاعته، وإن أرادت أن "عدلاً" تدفع وفدية فلن تؤخذ منها أيضاً ولن يحل ذلك مشكلتها. إذن فاحتمال أن ضمير منها الأولى يعود إلى "النفس" الأولى، وأن معنى الآية يكون: "أن هذا الجازي والمؤدي للحقوق ليس بمقدوره أن يكون شفيعاً وإن شفع لأحد فلن تسمع شفاعته" سيصبح من خلال هذه القرينة احتمالاً ضعيفاً، ومن دون تلك القرينة الخارجيّة فإن الاحتمال المذكور لن يكون مستبعداً جداً، على الرغم من أن رجوع الضمير إلى النفس الثانية هو أظهر.
الإطلاق والتقييد في آيات الشفاعة
إن التعبير عدم القبول في جملة {ولا يُقبل منها شفاعة} (وكون الشفاعة لا تقبل في القيامة؛ نطير التعبير بعدم النفع في الآية 123 من سورة البقرة) عوضاً عن التصير بنفى الشفاعة بشكل مطلق، وعلى الرغم من عدم منافاته لإثبات الشفاعه، وعدم التعارف - بالنتيجة بين هذه الآية والآيات التي تثبت الشفاعة، إلا أن له نارضاً مع الآيات التي تنفي الشفاعة بشكل مطلق نظير الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 254] وحيث إن التعارض المذكور هو بصورة الإطلاق ،والتقييد، فإن تعارضهما ابتدائي وليس هو تعارضاً مستقراً، وعلاج التعارض الابتدائي هو أن جملة { وَلَا شَفَاعَةٌ} تقيدها جملة {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ}؛ كما قد قيدت بجملة: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255] أيضاً؛ لأن لهذه الجملة دلالة أيضاً على أنه في القيامة توجد شفاعة في الجملة، وإن كانت غير نافعة لحال المشركين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الكافي، ج 8، ص 19؛ وبحار الأنوار، ج6، ص 19.
(2) الإرشاد، ج 2، ص 143؛ وبحار الأنوار، ج 46، ص 75.
(3) مصباح الكفعمي، ص 379؛ وبحار الأنوار، ج 83 ، ص333.
(4) نهج الفصاحة، ج1، ص 513
(5) نهج الفصاحة، ج1، ص514
(6) نهج الفصاحة، ج 1، ص 513.
(7) البلد الأمين، ص178؛ وبحار الأنوار، ج 87، ص213.
 الاكثر قراءة في الشفاعة والتوسل
الاكثر قراءة في الشفاعة والتوسل
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)