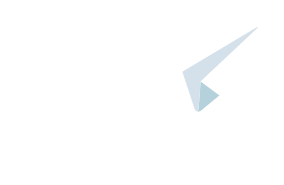التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته


صفات الله تعالى


الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه


العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة


النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

مواضيع متفرقة

القرآن الكريم


الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم ومودتهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة


المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة


فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية


شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية


أسئلة وأجوبة عقائدية


التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد


القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة


الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم


أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات


احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة


أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات


اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة


الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة
التوبة والاستغفار
المؤلف:
الشيخ الطوسي
المصدر:
الاقتصاد
الجزء والصفحة:
ص 124
11-08-2015
2242
ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ... ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ... ﺗﻔﻀﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻭﻟﻮﻻ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺫﻟﻚ، [ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻷﻧﻬﺎ ﻃﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ].
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻘﻼ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﺃﺳﻘﻄﺖ ﻟﻢ ﻳﺨﻠﻮ ﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺃﻭ ﻟﻮﺟﻪ ﺁﺧﺮ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻘﺪ ﺃﻓﺴﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻓﺴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻻﺣﺒﺎﻁ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﻻ ﻟﻠﺠﻬﻮﺩ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ - ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻷﻧﺎ ﻻ ﻧﺴﻠﻢ. ﻭﻣﺘﻰ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻭﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﺆﺍﺧﺬﺓ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻛﻤﺎ ﻧﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ. ﻭﻣﺘﻰ ﻗﻴﻞ: ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻘﺒﺢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻀﺎ. ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻓﻴﺠﺐ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻟﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﺽ ﻟﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﻥ ﻣﻌﺎ، ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ... ﻭﻟﻮ ﺻﺢ ﻟﻜﻢ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻟﺼﺢ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻢ، ﻭﻟﻮ ﺻﺢ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻨﻰ ﺍﻟﺸﺊ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ، ﺑﺄﻥ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻘﻞ. ﻭﻟﻮ ﺧﻠﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﻞ ﻟﻤﺎ ﺃﻭﺟﺒﻨﺎ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻤﺎ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻮﺟﻮﺑﻬﺎ ﻭﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻭﻟﻄﻔﺎ، ﻭﻟﻮﻻ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻟﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ. ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﻳﻌﻠﻢ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﺍﻷﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﻤﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻧﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻭﻋﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﺪﻫﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻔﻴﻪ ﺧﻼﻑ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﺢ ﺃﻭ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻋﻘﻼ...
ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﺴﻖ ﻓﺈﻧﺎ ﻻ ﻧﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﺑﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﺗﻔﻀﻼ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﺎ ﺩﻟﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻣﻨﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﻨﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻨﻪ، ﻷﻧﺎ ﺳﺒﺮﻧﺎ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻠﻢ ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ، ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ. ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻣﻌﺎﻗﺒﻮﻥ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻭﺃﻧﻪ ﻳﺸﻔﻊ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ، ﻓﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺫﻟﻚ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺷﻔﺎﻋﺘﻪ ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ(1) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺎﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﻓﻌﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﻳﻄﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻟﻔﻈﺎ ﻭﻻ ﻣﻌﻨﻰ. ﻭﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﻴﻦ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ، ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ. ﻓﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻐﻼﻣﻪ ﺍﻟﻖ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﻖ ﺍﻟﺤﺎﺭﺱ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﺎﻝ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺩﻧﻲ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﻟﻮﺟﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ. ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ: ﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﻷﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺳﺆﺍﻟﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ. ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ " ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ " ﻭ " ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﺮﺩﻭﺩﺓ "، [ﻓﻴﺴﻤﻮﻧﻬﺎ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﺒﻠﺖ ﺃﻭ ﺭﺩﺕ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻭﻛﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ] ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ، ﻭﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺷﺎﻓﻌﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:
* ﻓﻬﻞ ﻷﻧﻔﺲ ﻟﻴﻠﻰ ﺷﻔﻴﻌﻬﺎ *
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺃﺻﻼ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﺒﺮﻳﺮﺓ: ﺗﺼﺎﻟﺤﻲ ﺯﻭﺟﻚ ﻭﺍﺭﺟﻌﻲ ﺇﻟﻴﻪ. ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ: ﺃﺗﺄﻣﺮﻧﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ. ﻓﻘﺎﻝ: ﻻ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﺷﺎﻓﻊ (2). ﻓﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺷﺎﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻳﺮﺓ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻧﻪ، ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺃﺻﻼ. ﻭﺃﻣﺎ ﺗﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻹﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ﻓﻼ ﺧﻼﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻮ ﺳﻠﻤﻨﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻓﺨﺼﺼﻨﺎﻫﻤﺎ ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺃﺩﺧﺮﺕ ﺷﻔﺎﻋﺘﻲ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻲ. ﻭﻓﻲ ﺧﺒﺮ ﺁﺧﺮ: ﺃﻋﺪﺩﺕ ﺷﻔﺎﻋﺘﻲ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻲ (3).
ﻭﻫﺬﺍ ﺧﺒﺮ ﺗﻠﻘﺘﻪ ﺍﻷﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻤﻦ ﺗﺎﺏ ﻷﻣﺮﻳﻦ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻧﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ، ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﺃﻥ ﻳﺸﻔﻊ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻣﻊ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺭ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻓﻼ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻛﻤﺎﻝ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻦ ﺗﺎﺏ ﻣﻦ ﻛﻔﺮﻩ ﻛﺎﻓﺮﺍ، ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﺮﺭ. ﻭﻻ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ} [غافر: 18] ﻭﻗﻮﻟﻪ { وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } [البقرة: 270] ﻭﻗﻮﻟﻪ {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} [الأنبياء: 28] ﻭﻗﻮﻟﻪ {وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 48] ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ: ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻻ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ، ﻓﻤﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻻ ﻧﻄﻮﻝ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻫﻬﻨﺎ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺭ، ﻭﻗﺪ ﺳﻤﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻇﻠﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} [لقمان: 13].
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻧﻔﻰ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺷﻔﻴﻌﺎ ﻣﻄﺎﻋﺎ، ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻒ ﺷﻔﻴﻌﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ {وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ} ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀ. ﺛﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺒﺪﺃﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ {يُطَاعُ} ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺑﻌﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ { ﻳﻌﻠﻢ }، ﻭﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﻳﻄﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻛﺎ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ.
ﻭﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻈﺎﻟﻤﻴﻦ ﺃﻧﺼﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺼﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻳﻘﺘﺮﻥ ﺑﻬﺎ ﺧﻀﻮﻉ ﻭﺧﺸﻮﻉ. ﻭﻗﻮﻟﻪ {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى} ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻔﻊ ﻓﻴﻪ، ﻭﻧﻈﻴﺮﻩ ﻗﻮﻟﻪ {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ } [البقرة: 255] ﻭﻗﻮﻟﻪ {لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى} [النجم: 26]، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﺗﺮﻛﺎ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﻀﻰ ﻣﺤﺬﻭﻑ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ، ﻓﻬﻢ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﺪﺭ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺃﻥ ﻳﺸﻔﻊ ﻓﻴﻪ، ﻭﺍﺳﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭﺳﻘﻄﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﺍﻟﻤﻠﻲ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﺗﻀﻰ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺎﻋﺎﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ " ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻋﻨﺪﻱ " ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ. ﻭﻗﻮﻟﻪ {وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 123] ﻣﺘﺮﻭﻙ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻷﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﻬﻨﺎ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻌﻮﺍ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﻨﻌﻨﺎ ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ. ﺃﻭ ﻧﻘﻮﻝ: ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻭﻻ ﺗﻨﻔﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﺓ. ﻓﺄﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﺭﻏﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻬﻮ ﻛﺮﻏﺒﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻔﺮﻳﻦ، ﻓﻜﻤﺎ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ [ﻓﻜﺬﻟﻚ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ] ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﺔ.
ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﺇﻥ ﺍﺗﻔﻖ ﻣﻨﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﺬﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﺸﺮﻭﻁ. ﻭﻣﺘﻰ ﻗﺎﻟﻮﺍ: ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻓﻲ ﺁﻱ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا } [النساء: 14] ﻭﻗﻮﻟﻪ {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا } [الفرقان: 19] ﻭ {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] ﻭ {َإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ } [الانفطار: 14] ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻵﻳﺎﺕ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻼﻡ:
(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ ﻻ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻪ، ﺑﻞ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺣﺘﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﻓﺴﺎﻕ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻧﻄﻮﻝ ﺑﺬﻛﺮﻩ ﻫﻬﻨﺎ.
(ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺃﻥ ﻳﻌﺎﺭﺽ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [النساء: 48] ﻭﻗﻮﻟﻪ {َإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} [الرعد: 6] ﻭﻗﻮﻟﻪ {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا } [الزمر: 53] ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ.
(ﻭﺛﺎﻟﺜﻬﺎ) ﺃﻥ ﻧﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻵﻳﺎﺕ ﻣﺘﺮﻭﻛﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻧﻬﻢ ﺷﺮﻃﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺷﺮﻃﻮﺍ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﺷﺮﻃﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀﺍ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ.
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻢ ﻳﻨﻒ ﻏﻔﺮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ، ﺑﻞ ﻧﻔﻰ ﺃﻥ ﻳﻐﻔﺮﻩ ﺗﻔﻀﻼ، ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﻐﻔﺮ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻙ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻼ ﺑﻞ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﻘﻮﻟﻪ {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ }ﺃﻱ ﻳﻐﻔﺮﻩ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺑﻞ ﺗﻔﻀﻼ، ﻷﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻷﻭﻝ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ " ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺭﻛﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﻛﺐ ﺇﻟﻲ ﻭﺃﺭﻛﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺩﻭﻧﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺮﻛﺐ ﺇﻟﻲ " ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻝ " ﻻ ﺃﺗﻔﻀﻞ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺃﻋﻄﻲ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠﻲ " ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺴﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ " ﻭﺃﻋﻄﻲ ﺍﻟﻴﺴﻴﺮ ﺗﻔﻀﻼ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ". ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻪ {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ} ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﻤﻮﻣﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻔﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺻﻐﻴﺮﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﺗﺎﺏ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺘﺐ، ﻷﻥ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻋﺎﻫﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺨﺼﻮﺍ ﻋﻤﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﻳﺎﺗﻬﻢ، ﻷﻧﺎ ﻧﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﺨﺺ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﺭ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻔﻮ. ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻐﻔﻮﺭ ﻟﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻳﻐﻔﺮ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ، ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺑﺨﻼﻓﻪ. ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸﻴﺌﺘﻪ. ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻴﺌﺔ، ﻭﻇﺎﻫﺮ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺗﻔﻀﻼ، ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﻴﺌﺔ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ: ﺃﻧﺎ ﺃﺭﺩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ. ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺃﻧﺎ ﺃﺗﻔﻀﻞ ﺇﻥ ﺷﺌﺖ. ﻭﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺧﺒﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻔﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﻇﻠﻤﻬﻢ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ. ﻭﻳﺠﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺮﻯ ﻗﻮﻟﻬﻢ: ﻟﻘﻴﺖ ﻓﻼﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻠﻪ ﻭﺃﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺬﺭﻩ. ﻭﻣﺘﻰ ﺷﺮﻃﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻛﺎ ﻟﻠﻈﺎﻫﺮ.
ﻭﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﻔﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ، ﻓﻤﻦ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ. ﻭﻗﻮﻟﻪ {وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ } [الزمر: 54] ﻛﻼﻡ ﻣﺴﺘﺄﻧﻒ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻷﻥ ﻋﻄﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻃﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ: ﺇﻧﻤﺎ ﺷﺮﻃﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﻋﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻳﺴﻘﻂ ﺻﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﻌﻔﻮ، ﻭﻛﻼﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻘﻼ ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻘﻼ ﻓﻘﺪ ﻣﻀﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺟﺎﺋﺰﺍ ﻋﻘﻼ ﻣﺴﻘﻄﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﻭﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺸﺮﻁ ﺃﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻟﻮﺍ: ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻔﻮ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻛﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺏ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻌﻔﻮ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ [ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻔﻮ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭ] ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺨﺘﺎﺭﻫﺎ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻔﻮ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻻ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻷﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮ. ﻭﻣﺘﻰ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻌﻔﻮ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﻼ ﻣﻨﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺻﻲ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺴﻘﻂ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻈﻴﻢ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻷﻧﻜﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻤﻨﻌﻮﻥ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ، ﻓﻴﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ.
ﻭﻗﺪ ﻓﺮﻏﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﺠﻤﻞ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻫﻬﻨﺎ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ.
ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺎﻡ ﺣﺪ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ. ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} [المائدة: 38] ﻭﻗﻮﻟﻪ {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 2] ﻓﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻋﺬﺍﺏ ﻭﻧﻜﺎﻝ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻟﺒﻄﻞ ﺫﻟﻚ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻳﻘﻄﻊ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﺍﻕ ﻧﻜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ، ﺑﻞ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻣﺘﻰ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﻗﻄﻌﻨﺎﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻕ ﻋﺎﻗﻼ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺻﺎﺩﻗﻴﻦ ﺃﻭ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻓﺈﻧﻤﺎ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎ، ﻭﻣﺘﻰ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻩ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻁ. ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﺑﻂ ﻣﻦ ﻛﻔﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻇﻬﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ، ﻷﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻻﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻔﺮ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺑﺎﻻﺟﻤﺎﻉ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ. ﻓﺈﺫﺍ ﻋﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﻇﻬﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧﺎ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﻇﻬﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﻔﺮﺍ ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻷﻥ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻳﻤﺎﻥ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻔﺮ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ.
ﻭﻓﻲ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻔﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻛﻔﺮﺍ ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻲ ﺑﻪ. ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﺼﺤﻴﺢ ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺒﺠﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻇﻬﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ. ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺃﺻﻼ ﺑﻞ ﻻ ﻛﻔﺮ ﻳﻮﺍﻓﻲ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺑﻜﻔﺮ ﻻ ﻳﻮﺍﻓﻲ ﺑﻪ. ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺆﻣﻦ، ﻷﻥ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﻠﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺩﺍﺋﻢ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻄﻊ. ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻳﻘﺴﻢ ﺑﺄﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺍﻓﻲ ﺑﻪ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻄﻊ، ﻷﻥ ﻣﻊ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ. ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻓﻘﻮﻟﻪ {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا} [النساء: 137] ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻇﻬﺮﻭﺍ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺛﻢ ﻛﻔﺮﻭﺍ. ﻭﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻦ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ} [الممتحنة: 10] ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﻨﻬﻦ، ﻭﻗﻮﻟﻪ {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92] ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﻖ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﺑﻼ ﺗﻘﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﻣﺮ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮﺍ ﻭﻓﺎﺳﻘﺎ، ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻷﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺑﺨﻼﻓﻪ.
ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻈﻬﺮﺍ ﻟﻠﻜﻔﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺳﻘﺎ ﻣﺼﺮﺍ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺟﻮﺯﻧﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺳﻘﻂ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﺗﻔﻀﻼ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻧﻘﻄﻊ ﺑﻪ ﻭﻧﺬﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻔﻮ. ﻭﻣﺘﻰ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺑﻪ ﻭﺫﻣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﻕ ﻓﺈﻧﺎ ﻧﺬﻣﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻔﻮ، ﻭﻣﻦ ﻏﺎﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﻕ ﻧﺬﻣﻪ ﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻌﻔﻮ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺧﺒﺮﻩ. ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻬﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻘﻄﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﺩﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻭﺃﻣﻨﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ.
________________
(1) ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻲ.
(2) ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﺪ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ 5 / 409.
(3) ﺍﻟﺒﺤﺎﺭ 8 / 34، ﻭﻟﻔﻈﻪ ﻓﻴﻪ " ﺇﻧﻤﺎ ﺷﻔﺎﻋﺘﻲ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺃﻣﺘﻲ ".
 الاكثر قراءة في التوبة
الاكثر قراءة في التوبة
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)