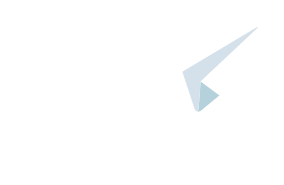التوحيد

النظر و المعرفة

اثبات وجود الله تعالى و وحدانيته


صفات الله تعالى


الصفات الثبوتية

القدرة و الاختيار

العلم و الحكمة

الحياة و الادراك

الارادة

السمع و البصر

التكلم و الصدق

الأزلية و الأبدية

الصفات الجلالية ( السلبية )

الصفات - مواضيع عامة

معنى التوحيد و مراتبه


العدل

البداء

التكليف

الجبر و التفويض

الحسن و القبح

القضاء و القدر

اللطف الالهي

مواضيع عامة


النبوة

اثبات النبوة

الانبياء

العصمة

الغرض من بعثة الانبياء

المعجزة

صفات النبي

النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

مواضيع متفرقة

القرآن الكريم


الامامة

الامامة تعريفها ووجوبها وشرائطها

صفات الأئمة وفضائلهم ومودتهم

العصمة

امامة الامام علي عليه السلام

إمامة الأئمة الأثني عشر

الأمام المهدي عجل الله فرجه الشريف

الرجعة


المعاد

تعريف المعاد و الدليل عليه

المعاد الجسماني

الموت و القبر و البرزخ

القيامة

الثواب و العقاب

الجنة و النار

الشفاعة

التوبة


فرق و أديان

علم الملل و النحل ومصنفاته

علل تكون الفرق و المذاهب

الفرق بين الفرق

الشيعة الاثنا عشرية

أهل السنة و الجماعة

أهل الحديث و الحشوية

الخوارج

المعتزلة

الزيدية

الاشاعرة

الاسماعيلية

الاباضية

القدرية

المرجئة

الماتريدية

الظاهرية

الجبرية

المفوضة

المجسمة

الجهمية

الصوفية

الكرامية

الغلو

الدروز

القاديانيّة

الشيخية

النصيرية

الحنابلة

السلفية

الوهابية


شبهات و ردود

التوحيـــــــد

العـــــــدل

النبـــــــوة

الامامـــــــة

المعـــاد

القرآن الكريم

الامام علي بن ابي طالب (عليه السلام)

الزهراء (عليها السلام)

الامام الحسين (عليه السلام) و كربلاء

الامام المهدي (عليه السلام)

إمامة الائمـــــــة الاثني عشر

العصمـــــــة

الغلـــــــو

التقية

الشفاعة والدعاء والتوسل والاستغاثة

الاسلام والمسلمين

الشيعة والتشيع

اديان و مذاهب و فرق

الصحابة

ابو بكر و عمر و عثمان و مشروعية خلافتهم

نساء النبي (صلى الله عليه واله و سلم)

البكاء على الميت و احياء ذكرى الصاحين

التبرك و الزيارة و البناء على القبور

الفقه

سيرة و تاريخ

مواضيع عامة

مقالات عقائدية

مصطلحات عقائدية


أسئلة وأجوبة عقائدية


التوحيد

اثبات الصانع ونفي الشريك عنه

اسماء وصفات الباري تعالى

التجسيم والتشبيه

النظر والمعرفة

رؤية الله تعالى

مواضيع عامة

النبوة والأنبياء

الإمامة

العدل الإلهي

المعاد


القرآن الكريم

القرآن

آيات القرآن العقائدية

تحريف القرآن

النبي محمد صلى الله عليه وآله

فاطمة الزهراء عليها السلام

الاسلام والمسلمين

الصحابة


الأئمة الإثنا عشر

الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام

أدلة إمامة إمير المؤمنين

الإمام الحسن عليه السلام

الإمام الحسين عليه السلام

الإمام السجاد عليه السلام

الإمام الباقر عليه السلام

الإمام الصادق عليه السلام

الإمام الكاظم عليه السلام

الإمام الرضا عليه السلام

الإمام الجواد عليه السلام

الإمام الهادي عليه السلام

الإمام العسكري عليه السلام

الإمام المهدي عليه السلام

إمامة الأئمة الإثنا عشر

الشيعة والتشيع

العصمة

الموالات والتبري واللعن

أهل البيت عليهم السلام

علم المعصوم


أديان وفرق ومذاهب

الإسماعيلية

الأصولية والاخبارية والشيخية

الخوارج والأباضية

السبئية وعبد الله بن سبأ

الصوفية والتصوف

العلويين

الغلاة

النواصب

الفرقة الناجية

المعتزلة والاشاعرة

الوهابية ومحمد بن عبد الوهاب

أهل السنة

أهل الكتاب

زيد بن علي والزيدية

مواضيع عامة

البكاء والعزاء وإحياء المناسبات


احاديث وروايات

حديث اثنا عشر خليفة

حديث الغدير

حديث الثقلين

حديث الدار

حديث السفينة

حديث المنزلة

حديث المؤاخاة

حديث رد الشمس

حديث مدينة العلم

حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه

احاديث متنوعة

التوسل والاستغاثة بالاولياء

الجبر والاختيار والقضاء والقدر

الجنة والنار

الخلق والخليقة

الدعاء والذكر والاستخارة

الذنب والابتلاء والتوبة

الشفاعة

الفقه

القبور

المرأة

الملائكة


أولياء وخلفاء وشخصيات

أبو الفضل العباس عليه السلام

زينب الكبرى عليها السلام

مريم عليها السلام

ابو طالب

ابن عباس

المختار الثقفي

ابن تيمية

أبو هريرة

أبو بكر

عثمان بن عفان

عمر بن الخطاب

محمد بن الحنفية

خالد بن الوليد

معاوية بن ابي سفيان

يزيد بن معاوية

عمر بن عبد العزيز

شخصيات متفرقة

زوجات النبي صلى الله عليه وآله

زيارة المعصوم

سيرة وتاريخ

علم الحديث والرجال

كتب ومؤلفات

مفاهيم ومصطلحات


اسئلة عامة

أصول الدين وفروعه

الاسراء والمعراج

الرجعة

الحوزة العلمية

الولاية التكوينية والتشريعية

تزويج عمر من ام كلثوم

الشيطان

فتوحات وثورات وغزوات

عالم الذر

البدعة

التقية

البيعة

رزية يوم الخميس

نهج البلاغة

مواضيع مختلفة


الحوار العقائدي

* التوحيد

* العدل

* النبوة

* الإمامة

* المعاد

* الرجعة

* القرآن الكريم

* النبي محمد (صلى الله عليه وآله)

* أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

* فضائل النبي وآله

* الإمام علي (عليه السلام)

* فاطمة الزهراء (عليها السلام)

* الإمام الحسين (عليه السلام) وكربلاء

* الإمام المهدي (عجل الله فرجه)

* زوجات النبي (صلى الله عليه وآله)

* الخلفاء والملوك بعد الرسول ومشروعية سلطتهم

* العـصمة

* التقيــة

* الملائكة

* الأولياء والصالحين

* فرق وأديان

* الشيعة والتشيع

* التوسل وبناء القبور وزيارتها

* العلم والعلماء

* سيرة وتاريخ

* أحاديث وروايات

* طُرف الحوارات

* آداب وأخلاق

* الفقه والأصول والشرائع

* مواضيع عامة
الجبر و الاختيار
المؤلف:
محمد حسن آل ياسين
المصدر:
أصول الدين ص147-167
الجزء والصفحة:
ص147-167
6-08-2015
3016
الحديث عن مسألة «الجبر و الاختيار» حديث طويل شائك لا تستوعبه صفحات، و لا يتسع لتفاصيله مجال محدود.
وعلى الرغم من ان
منشأ قصة «الجبر» سياسي بحت أريد به تصحيح تصرفات الحكام الطغاة الخارجين على
تعاليم الدين؛ و خلق الاعذار غير الاختيارية تبريرا لأعمالهم المنافية لأحكام
الاسلام، فان الموضوع قد تطور و تشعب حتى أصبح مسألة رئيسة من مسائل علم الكلام، و
بابا مهما من أبواب العقيدة، و قضية معقدة من قضايا الفكر الديني.
وكان أساس فكرة
«الجبر» أو شبهة ما ذهب إليه بعض المسلمين من ان أفعال الناس- كل الناس- لم تقع
بمحض ارادتهم واختيارهم ، وانما وقعت بفعل اللّه تعالى وارادته ، وليس للإنسان أي
ارتباط بها الا كونه معرضا لها و محلا لتحققها. و قد أطلق على هذا الرأي اسم
«الجبر» لأن نتيجته كون الانسان «مجبورا» على فعل الطاعة و المعصية و مكرها على
القيام بذلك سواء أراد أو لم يرد.
واستند هؤلاء
القائلون بالجبر- لتصويب ما زعموه- على ظاهر بعض الآيات القرآنيّة التي قد يستشعر
منها هذا المعنى، مثل قوله تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}
[الإنسان: 30] و قوله تعالى: { لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا}
[التوبة: 51] وقوله تعالى: {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ } [النساء: 78] وهي الآيات
التي ظنوا ان اطلاقها و تعميمها يشمل سائر أعمال الانسان و أفعاله و تصرفاته.
وتطرف بعض
المسلمين- انطلاقا من الاحساس بفساد هذا الرأي و بطلانه- فذهب الى عدم وجود أي
علاقة بين الانسان و ربه غير علاقة الخلق الاول، و ان اللّه تعالى ترك للإنسان-
بعد خلقه- كل حريته و ارادته، و فوض إليه كل شيء، و لم تعد له أية علاقة أو افاضة
أو ارتباط به. و كان الاساس النظري لهذه الفكرة ما ذهبوا إليه من أن العلة المحدثة
كافية في بقاء معلولاتها، حيث يستغني البقاء عن علة مستمرة معه، و لن يحتاج الا
الى علة الحدوث الاولى فقط. و قد أطلق علماء الكلام على هذه الشبهة اسم «التفويض»
الالهي المطلق للإنسان نتيجة انقطاع علاقته بربه.
و الحقيقة ان الرأي
الوسط بين الرأيين هو الصحيح، و قد عبر عنه الامام الصادق عليه السلام أجمل تعبير
و أدقه عند ما قال كلمته المأثورة المشهورة: «لا جبر و لا تفويض بل منزلة بين
المنزلتين».
و توضيح
ذلك:
ان كل انسان يدرك
بفطرته الذاتية انه قادر على فعل كثير من الاشياء، و ان بإمكانه أن يفعل منها ما
يريد فعله و يترك ما يشاء تركه، و لا أظن ان في الناس من يشك ببداهة هذا الادراك
الّذي هو من ابرز الادلة على الاختيار الكامل و الحرية المطلقة.
و ان كل انسان
يدرك أيضا بكل وضوح ان العقلاء بأجمعهم متفقون على مدح من يفعل الفعل الحسن و ذم
مرتكب الفعل القبيح، و ذلك برهان آخر على كون الانسان مختارا كل الاختيار في فعله،
اذ لا يصح من العقلاء- لولا الاختيار- اطلاق كلمات المدح و الذم.
كذلك فان كل انسان
يشعر- بإدراكه الشخصي- ان حركته حين يهبط من العلو بواسطة السلم تغاير حركته عند
سقوطه من شاهق الى الارض، حيث يحس انه مختار في الحالة الاولى و مجبور في الثانية.
و قد ثبت- في
العقل السليم- بما لا ريب فيه ان خالق هذه الشئون و القدرات في الانسان لم ينعزل
عن خلقه بعد الايجاد، و ان بقاء الاشياء و استمرارها في الوجود محتاج الى المؤثر
في كل آن، اذ ليس خالق الاشياء بالنسبة الى مخلوقاته من قبيل البنّاء الذي يبني
البيت و يقيم جدرانه ثم يستغني البيت عن مشيّده و يستمر وجوده و ان مات بانيه؛ أو
مثل الكتاب يحتاج الى كاتبه في حدوثه ثم يستغني عنه في مرحلة بقائه و استمراره، بل
ان موجد الكون بكل ما فيه و من فيه بالنسبة الى موجوداته من قبيل الطاقة
الكهربائية في الضوء حيث لا يوجد الا حين تمده هذه الطاقة بتيارها، و لا يزال
يفتقر في بقاء وجوده الى مدد هذه القوة في كل حين، فاذا انفصلت أسلاكه عن مصدر
الطاقة في آن ما انعدم الضوء في ذلك الحين. و هكذا تستمد جميع الاشياء و الكائنات
وجودها من مبدعها الاول في كل وقت و كل لحظة حدوثا و بقاء، و هي مفتقرة الى عونه و
مدده في كل حين.
وباتضاح ما سلف
يظهر ان أعمال الانسان وسط بين «الجبر» و «التفويض»؛ و له حظ من كل منهما، فان
إعمال قدرته في الفعل أو الترك و إن كان باختياره الا ان هذه القدرة- بسائر ما
تحتاج إليه من مبادي- انما تفاض من اللّه تعالى، فالفعل مستند الى الانسان من جهة
و الى اللّه جل و علا من جهة اخرى، و الآيات القرآنية التي استدل بها «الجبريون»
متجهة نحو بيان ان اختيار الانسان في فعله لا يمنع من نفوذ قدرة اللّه و سلطانه و
لا يعني استغناء الانسان عن اللّه و انقطاعه عن حوله و قوته.
وكان
استاذنا آية اللّه الامام الخوئي قد ضرب مثالا لتوضيح «المنزلة بين المنزلتين» في
مجلس درسه فقال ما فحواه:
لوان انسانا اصيبت
يده بالشلل فلم يعد يقدر على تحريكها بنفسه، ثم اتيح له- طبيا- أن تبعث فيها
الحركة بواسطة جهاز كهربائي يربط بيد هذا المريض، بحيث يصبح قادرا على تحريك يده
بنفسه في حالة اتصال يده بذلك الجهاز و تعود الى حالتها السابقة بمجرد انفصالها عن
مصدر حركتها. ففي حال الاتصال و القدرة على تحريك اليد و قيامها بأعمالها الاعتيادية
تكون الحركة أمرا بين أمرين، فهي ليست مستندة الى صاحبها بنفسه كل الاستناد، لان
قدرته بحاجة الى الاتصال بالجهاز الذي يمكّن من الحركة، و ليست مستندة الى الجهاز
وحده؛ لان الحركة انما تكون باختيار الرجل و ارادته.
و هكذا يوضح لنا
المثال السابق ما نحن بصدده من مسألة «الجبر» و «التفويض» فمن حيث كون الانسان
محتاجا الى المبادي الاساسية للفعل كالحياة و
القوة و ما شاكلها وهي مفاضة عليه من اللّه تعالى في كل آن فـ «لا تفويض»، و من
حيث كونه غير مجبور على الفعل و لا يقع منه بلا إرادة و اختيار فـ «لا جبر».
ولم يبق لدنيا-
على ضوء هذه المناقشة- غير الاختيار الكامل في الفعل و الترك، بلا شائبة تسيّب ولا
شبهة اكراه.
و لزيادة
الاستيعاب و التفصيل في دحض الشبهات و اثبات المطلوب نسوق فيما يلي طائفة من
الادلة على اختيار الانسان في افعاله، مستعرضين ما قيل في الرد على هذه الادلة و
ما نقوله في تفنيد تلك الردود:
1- الفرق بين الفعل الاختياري و الاضطراري :
لقد سبقت منا
الاشارة الى الاحساس بالفرق الجلي البديهي بين صدور الفعل من الانسان بقصد إليه و
رغبة فيه، و بين ما يقع منه بدون قصد إليه مطلقا، فارتعاش اليد و تحرّكها- مثلا-
ربما يكون مرضيا لا يستطيع الانسان السيطرة عليه فيحس بأنه خارج اختياره و
استطاعته، و ربما يكون اختياريا يتحكم فيه الانسان و يوقفه متى شاء.
وهكذا الأمر في
الأفعال بشكل عام و في الاحساس بالفرق الواضح بين ما يقع منها بالاختيار و غيره.
فإذا كانت أفعالنا
كلها- حسب الزعم- مخلوقة من قبل اللّه تعالى و ليس فيها أي اختيار، فلماذا نحس
بالفرق الكبير بين الاختيارية منها و الاضطرارية؟!.
و تفلسف بعض
المتكلمين في بيان الفرق بين الفعلين فذهب إلى أن الاضطراري منه انما يقع بفعل
اللّه تعالى من دون وجود قدرة للإنسان او إرادة في وقوعه، بخلاف الاختياري الذي
يوجده اللّه تعالى مقارنا لإرادة العبد له.
و هذا القول واضح
البطلان:
فإن القدرة المشار
إليها إن كانت بمعناها اللغوي المعروف القائم على أساس «إن شاء فعل و إن لم يشأ لم
يفعل» فإن ذلك مخالف للجبر المزعوم، بل هو الدليل على ما نقوله نحن من الاختيار،
و إن كانت بمعنى آخر لا ينافي الاكراه فهي ليست قدرة أبدا و لا يصح تسميتها بذلك
مطلقا.
و أما الإرادة
التي ذكرها هذا المتفلسف فإن كان معناها هو الاختيار في الفعل- كما هو الصحيح- فإن
الاختيار غير موجود في زعم القائل؛ لأن الفعل- حسب ادعائه- غير خاضع لاختيار العبد
و اشاءته، و ان قصد بها القائل معنى الرغبة النفسية في وقوع الفعل فإن الرغبة-
هذه- ليست ايجادا للفعل كما نحس بالوجدان، و كثيرا ما يرغب الانسان في شيء ما ولكنه
لا يتحقق بمجرد الرغبة، و إذا لم تكن الرغبة عين الفعل ... كان التفريق المشار
إليه بين الاختيار و الاضطرار بلا محصل أبدا.
2-
صراحة القرآن الكريم في الاختيار:
لعلّ من أبرز أدلة
الاختيار الذي نحن بصدد اثباته:
ذلك التأكيد
القرآني على نسبة العمل الى الانسان و التصريح باختياره الكامل و اضافة الفعل إليه
على وجه مطلق آب عن الحمل و التأويل:
{كُلُّ امْرِئٍ
بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ} [الطور: 21] {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ } [النساء:
123] {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا }
[الإسراء: 7] {فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} [الكهف: 29]
{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ } [الزلزلة: 7، 8]
{وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى
الْهُدَى} [فصلت: 17] {إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الطور: 16]
{أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ } [آل عمران: 195].
الى كثير من أمثال
هذه الآيات الشريفة و كلها نص قاطع على نسبة الفعل الى العبد بمحض اختياره و عدم
وقوعه إلا بمشيئته و إرادته.
وقد شذ
بعضهم فقال: ان قوله تعالى: {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62] صريح في
أن أفعال العباد كلها- و هي مشمولة لعموم «كُلِّ شَيْءٍ»- مخلوقة من قبل اللّه تعالى
و ليست من خلق الانسان نفسه، و هل هذا الا «الجبر» بعينه؟!.
و الصواب في الأمر
ان هذه الآية غير ناظرة الى افعال العباد و أعمالهم، لأنها في صدد الرد على اولئك القائلين
بتعدد الخالقين: خالق للأرض و خالق للأفلاك و خالق للناس .. الخ فكان الرد على
اولئك ان اللّه تعالى هو خالق هذه الاشياء كلها و ليس من خالق غيره.
أما اختصاص كلمة
«خالق» به تعالى فليست دليلا على صحة تعميم خلقه لكل شيء حتى أفعال العباد، فقد
ورد الخلق في القرآن منسوبا إلى الإنسان أيضا، مثل قوله تعالى: {وَإِذْ تَخْلُقُ
مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي } [المائدة: 110] و قوله تعالى: {أَنِّي
أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ
طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ} [آل عمران: 49]
و قوله تعالى: {وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا} [العنكبوت: 17] كما ان قوله تعالى: {فَتَبَارَكَ
اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} [المؤمنون: 14] و قوله تعالى: {وَتَذَرُونَ
أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ} [الصافات: 125]
دليل على أن الإنسان خالق أيضا و إن كان اللّه تعالى أحسن الخالقين.
وأما الاستدلال
على إيجاد اللّه لأفعال الناس بقوله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا
تَعْمَلُونَ } [الصافات: 96] حيث صرحت الآية بأن ما يعقله الناس انما هو من خلق
اللّه تعالى، فمردود أوضح رد، لأن هذه الآية الشريفة انما هي تتمة لآية سابقة
عليها هي قوله تعالى: {أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ} [الصافات: 95]، و كان جواب
هذا الاستفهام: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96].
ومن الجمع بين
الآيتين يظهر أن المقصود بهما الرد على اولئك الذين ينحتون الأصنام من الصخور أو
يعملونها من التمور- مثلا- ثم يتوجهون إليها بالعبادة و يقربون لها القرابين،
فأبان اللّه تعالى بهذه الآية أنه جل و علا قد خلق اولئك المشركين و خلق تلك
المواد التي ينحتون منها أصنامهم.
وليس
لذلك أي ارتباط بمسألة أفعال العباد و أعمالهم و تصرفاتهم.
3- العقاب دليل
الاختيار:
ان العقاب الإلهي
لفاعل المعصية- كما ورد في القرآن الكريم- دليل صريح على اختيار الانسان في فعله:
{لَئِنْ
أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [الزمر:
65] {فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
} [القصص: 84] {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النور: 24] {وَذُوقُوا عَذَابَ
الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [السجدة: 14]
{وَقِيلَ
لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ} [الزمر: 24] {فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } [النور: 63]
{وَمَنْ يَزِغْ
مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ} [سبأ: 12] أما أن يكون
اللّه تعالى هو الموجد للفعل في عبده ثم المعاقب له عليه فذلك مستحيل كل الاستحالة،
لأنه ظلم صارخ ننزه اللّه تعالى عنه كما نزه نفسه:
{وَمَا رَبُّكَ
بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] {وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ
لِلْعَبِيدِ} [آل عمران: 182] {وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ } [ق: 29] {
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ} [آل عمران: 108] {وَمَا اللَّهُ
يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ} [غافر: 31] {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ} [النساء: 40] {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا} [يونس: 44] {وَلَا
يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف: 49].
وقد حاول بعض
المتنطّعين من علماء الكلام تصحيح نسبة الظلم إلى اللّه فقال ما خلاصته: ان الظلم
ليس قبيحا على اللّه تعالى، لأن الظلم القبيح الذي يستنكره العقل هو التعدي على
الغير سواء كان ذلك تعديا على بدنه أو عرضه أو ماله. أما تصرف الانسان فيما يملك
فهو غير قبيح لما له من الحرية في التصرف المطلق فيه بلا قيد او شرط، و من ذلك
تصرف اللّه تعالى في مخلوقاته؛ باعتباره خالق الكون و مالكه؛ و باعتبار أن كل ما
في هذا الكون ملك له و خاضع لقدرته و سلطانه، فله أن يتصرف فيه كما يريد، فيعذب من
يشاء و لو كان مؤمنا، و ينعم من يشاء و لو كان كافرا، لأن الجميع ملكه و سلطانه {لَا
يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنبياء: 23] ، و لا يحق للعقل
الانساني أن يرقى الى المقام الإلهي فيحكم على أفعاله بحسن أو قبح.
وهذه
الشبهة مردودة من جهات:
أولا- انه ليس
المقصود بالبحث فرض حكم العقل على اللّه تعالى و انما هو بيان ما ينتظر من فضله و
لطفه في معاملة عباده. و اننا اذ نسلم كل التسليم ان التكليف بالمحال؛ و بما هو
فوق الطاقة؛ و ادخال العاصي الجنة و المطيع النار؛ مقدور للّه تعالى كل القدرة و
باستطاعته جل و علا أن يتصرف كذلك و يأمر بمثل ذلك، فإننا نقطع يقينا بأنه لن
يفعلها، لطفا منه و كرما، لا قصورا و عجزا.
و ثانيا- ان القول
بعدم قبح الظلم سيحمل الانسان على عدم امتثال أوامر اللّه تعالى، لعدم الثقة
بنزاهة الحكم و سلامة النتائج؛ و عدم الاطمئنان بأن اللّه تعالى سوف لن يخلف وعده
وان قال: {إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 9]، لان ذلك كله
يعتمد على قبح الظلم و الكذب و خلف الوعد، أما إذا انتفى موضوع القبح كما زعم
الزاعم فليس هناك من الثقة و الاطمئنان ما يحمل الانسان على الطاعة و مخالفة الهوى
و محاربة النفس الامارة.
وثالثا- ان معنى الظلم
ليس مختصا بالتعدي على الغير فحسب، بل ان كل خروج عن النهج الوسط و كل ميل الى
افراط او تفريط هو ظلم أيضا، و منه ما يقال من ان فلانا ظالم لنفسه؛ و يقصد به
خروجه عن حد الاعتدال في تصرفاته في مأكل أو ملبس او انفاق، مع ان ذلك كله ملك له؛
ولديه الحرية المطلقة في التصرف به كما يشاء، و لكنه على الرغم من ذلك ظلم في
العرف العام.
و لو أن رجلا ما
عذب حيوانا يملكه مع انقياده الكامل و عدم إيذائه أ كان يعذر على ذلك بأنه ملكه؟!.
4- الظلم قبيح:
لو لم يكن الانسان
مختارا في فعله و قادرا عليه و موجدا له بمحض إرادته؛ لكان اللّه أظلم الظالمين،
لأن عقاب فاعل المعصية حتمي، و حيث أن المعصية- حسب الزعم- لم تكن باختيار الانسان
فإن عقابه سيكون من أفظع ضروب الظلم.
و قد أجاب
القائلون بالجبر على ذلك بجوابين :
أولا- ان العقاب
ليس على الفعل و إنما هو على الكسب.
ونقول نحن في رد
ذلك:
انا المفهوم من
المعنى اللغوي و الاستعمال القرآني للفظ «الكسب» انه الفعل القائم على الاختيار،
قال تعالى:
{وَمَنْ يَكْسِبْ
إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ} [النساء: 111] {لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286] {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [المائدة: 38] {وَالَّذِينَ
كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا} [يونس: 27] {إِنَّ
الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ}
[الأنعام: 120] , الى كثير من الآيات الشريفة الدالة على أن الكسب هو العمل
بالاختيار و الطواعية؛ و ان من شروط القدرة النابعة من نفس الانسان، و عند ما أدرك
هؤلاء فساد ادعائهم على اطلاقه زعموا: ان الكسب الذي يوجب العقاب انما هو صدور
الفعل من اللّه تعالى مقارنا لإرادة الانسان لتحقق هذا الفعل في الخارج.
ونجيبهم على ذلك:
بأن هذه المقارنة خارجة عن الاختيار فلا يصح العقاب عليها، لان الانسان ليس له-
حسب فرض هؤلاء- الا الرغبة في تحقق الفعل، و أما ايجاد الفعل فهو- بزعمهم- من
اللّه تعالى، و المقارنة الواقعة بين رغبة العبد و ايجاد اللّه انما تحققت بإرادة
اللّه و فعله و قوته باعتباره الفاعل الحقيقي حسب ادعائهم، فكيف يصح منه جل وعلا
أن يعاقب العبد على فعل لم يوجده و مقارنة ليس له أي اختيار فيها.
وثانيا- ان ظلم
اللّه تعالى لعباده غير قبيح لأنه جزء من تصرف المالك فيما هو داخل في ملكه
وسلطانه - وقد سبق لنا تفنيد هذا القول و إيضاح وجوه
الخطأ فيه - ولان الأفعال ليست لها قيم ذاتية يصح وصفها بالحسن أو القبح،
بل ان الحسن و القبح في أفعال العباد مستفاد من الشرع، فما نهى عنه الشرع فهو
قبيح، و ما أمر به فهو حسن، و لو عاد الشرع الى ما نهى عنه فأمر به أو الى ما أمر
به فنهى عنه انقلب القبيح حسنا و الحسن قبيحا.
و اذا كان حسن
الأفعال و قبحها مستفادا من الشرع دون العقل- حسب الزعم- فان فعل اللّه تعالى لا
يحكم عليه بحسن أو قبح لأنه فوق الشرع و التكليف، و تكون النتيجة أن كل ما يفعله
اللّه- و ان انطوى على الظلم- حسن و جميل و ان العقل قاصر عن الحكم بقبح صدور
الظلم من اللّه جل شأنه.
و يجدر بنا قبل
بيان الرأي الصحيح في هذا الموضوع أن نشير الى ان الحسن و القبح معانيا ثلاثة.
المعنى الاول:
اطلاق الحسن و
القبح على معاني الكمال و النقص، فالعلم حسن و الجهل قبيح، و الشجاعة و الكرم
حسنان، و بقابلهما الجبن و البخل فهما قبيحان. و ليس في ذلك خلاف بين المفكرين لأنه
من القضايا اليقينية التي لها واقع خارجي يطابقها.
المعنى الثاني:
اطلاق الحسن والقبح
على ما يلائم النفس او ينافرها، فهذا منظر حسن و هذا صوت حسن و الاكل عند الجوع
حسن؛ و هكذا، كما يقال: هذا منظر قبيح و صوت الانين قبيح. و هذا المعنى مما لا
نزاع فيه بين أطراف المناقشة؛ لأنه مستمد من اعماق الشعور النفسي بعيدا عن حكم
الشرع و تكاليفه.
المعنى الثالث:
اطلاق الحسن و
القبح على ما يستحق المدح و الذم، و يقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية،
حيث يكون الحسن ما استحق فاعله المدح و الثواب عند العقلاء؛ و القبيح ما استحق
فاعله الذم و العقاب عندهم كافة.
وهذا المعنى-
الثالث- هو محل النزاع.
فالأشاعرة قد
ذهبوا الى نفي وجود حكم للعقل في حسن الافعال و قبحها، بل ان ما حسنه الشرع فهو
حسن و ما قبحه فهو قبيح، و لا دخل للعقل في كل ذلك.
ورفضت الامامية و
المعتزلة هذه الفكرة و قالوا: ان للأفعال قيما ذاتية عند العقل مع غض النظر عن حكم
الشرع، فمنها ما هو حسن في نفسه، و منها ما هو قبيح في نفسه، و منها ما ليس له أحد
هذين الوصفين، و الشرع المقدس لا يأمر الا بما هو حسن و لا ينهى الا عما هو قبيح.
فالصدق مثلا حسن
في نفسه و لحسنه أمر اللّه تعالى به ؛ لا أنه صار حسنا بعد أمر اللّه به ، والكذب
في نفسه قبيح و لذلك نهى اللّه عنه ؛ لا أنه قبح بعد النهي عنه.
ودليلنا على ذلك
أن غير الملتزمين بالدين- على اختلاف فصائلهم- يصفون الصدق بالحسن و ينعتون الكذب
بالقبح، من غير أن يكون للحكم الشرعي اي اثر في هذا التحسين و التقبيح.
ومنه يظهر ان
الحسن و القبح الذاتيين عقليان قبل أن يكونا شرعيين، و ان العدل حسن بما هو عدل و
الظلم قبيح لأنه ظلم، من دون أن يكون لتحسين هذا و تقبيح ذاك علاقة بالنص الشرعي والحكم
الديني.
واذن. فيجب أن
يكون اللّه تعالى عادلا بحكم العقل لان العدل حسن، و يستحيل ان يكون ظالما بحكم
العقل أيضا لأنه قبيح.
و خلاصة القول: ان
كل ادلة القرآن و العقل صريحة في اختيار الانسان في فعله؛ و حريته في سائر تصرفاته
بلا جبر ولا اكراه، و ان كل ما اثير من شبهات بشأن الجبر لن تقوى على الثبوت امام
تلك الادلة الصريحة و النصوص القاطعة. وصدق اللّه العلي العظيم حيث يقول:
{ وَنَفْسٍ وَمَا
سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا} [الشمس: 7 - 10].
 الاكثر قراءة في الجبر و التفويض
الاكثر قراءة في الجبر و التفويض
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)