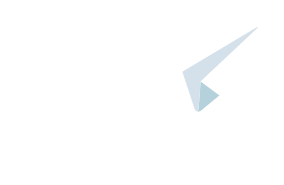تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير الآية (83-88) من سورة القصص
المؤلف:
إعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
.....
7-10-2020
6538
قال تعالى : { تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (84) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (85) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ } [القصص : 83 ، 88] .
تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير هذه الآيات (1) :
{تلك الدار الآخرة} يعني الجنة {نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض} أي تجبرا وتكبرا على عباد الله واستكبارا عن عبادة الله {ولا فسادا} أي عملا بالمعاصي عن ابن جريج ومقاتل وروى زاذان عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو دال يرشد الضال ويعين الضعيف ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا} ويقول نزلت هذه الآية في أهل العدل والمواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس .
وروى أبو سلام الأعرج عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا قال إن الرجل ليعجبه شراك نعله فيدخل في هذه الآية {تلك الدار الآخرة} الآية يعني أن من تكبر على غيره بلباس يعجبه فهو ممن يريد علوا في الأرض قال الكلبي يعني بقوله {فسادا} الدعاء إلى عبادة غير الله وقال عكرمة هو أخذ المال بغير حق .
{والعاقبة للمتقين} أي والعاقبة الجميلة المحمودة من الفوز بالثواب للذين اتقوا الشرك والمعاصي وقيل معناه الجنة لمن اتقى عقاب الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه {من جاء بالحسنة فله خير منها} مضى تفسيره {ومن جاء بالسيئة فلا يجزي الذين عملوا السيئات إلا ما يعملون} أي لا يزاد في عقابهم على قدر استحقاقهم بخلاف الزيادة في الفضل على الثواب المستحق فإنه يكون تفضلا فهو مثل قوله ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها .
{إن الذي فرض عليك القرآن} خطاب للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) والمعنى أن الذي أوجب عليك الامتثال بما تضمنه القرآن وأنزله عليك {لرادك إلى معاد} أي يردك إلى مكة عن ابن عباس ومجاهد والجبائي وعلى هذا فيكون في الآية دلالة على صحة النبوة لأنه أخبر به من غير شرط ولا استثناء وجاء المخبر مطابقا للخبر قال القتيبي معاد الرجل بلده لأنه يتصرف في البلاد ثم يعود إليه وقيل {إلى معاد} إلى الموت عن ابن عباس في رواية أخرى وعن أبي سعيد الخدري قيل إلى المرجع يوم القيامة أي يعيدك بعد الموت كما بدأك عن الحسن والزهري وعكرمة وأبي مسلم وقيل إلى الجنة عن مجاهد وأبي صالح فالمعنى أنه مميتك وباعثك ومدخلك الجنة والظاهر يقتضي أنه العود إلى مكة لأن ظاهر العود يقتضي ابتداء ثم عودا إليه على أنه يجوز أن يقال الجنة معاد وإن لم يتقدم له فيها كون كما قال سبحانه في الكفار {ثم إن مرجعهم لألى الجحيم} .
ثم ابتدأ سبحانه كلاما آخر فقال {قل} يا محمد {ربي أعلم من جاء بالهدى} الذي يستحق به الثواب {ومن هو في ضلال مبين} أي ومن لم يجيء بالهدى وضل عنه أي لا يخفى عليه المؤمن والكافر ومن هو على الهدى ومن هو ضال عنه وتأويله قل ربي يعلم أني جئت بالهدى من عنده وإنكم في ضلال سينصرني عليكم ثم ذكر نعمه فقال {وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب} أي وما كنت يا محمد ترجو فيما مضى أن يوحي الله إليك ويشرفك بإنزال القرآن عليك .
{إلا رحمة من ربك} قال الفراء هذا من الاستثناء المنقطع ومعناه إلا أن ربك رحمك وأنعم به عليك وأراد بك الخير كذلك ينعم عليك بردك إلى مكة فاعرف هذه النعم وقيل معناه وما كنت ترجو أن تعلم كتب الأولين وقصصهم تتلوها على أهل مكة ولم تشهدها ولم تحضرها بدلالة قوله وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا أي أنك تتلو على أهل مكة قصص مدين وموسى ولم تكن هناك ثاويا مقيما وكذلك قوله وما كنت بجانب الغربي وأنت تتلو قصصهم وأمرهم فهذه رحمة من ربك {فلا تكونن ظهيرا للكافرين} أي معينا لهم وفي هذا دلالة على وجوب معاداة أهل الباطل وفي هذه الآية وما بعدها وإن كان الخطاب للنبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فالمراد غيره وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول القرآن كله إياك أعني واسمعي يا جارة .
{ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك} أي ولا يمنعك هؤلاء الكفار عن اتباع آيات الله التي هي القرآن والدين بعد إذ نزلت إليك تعظيما لذكرك وتفخيما لشأنك {وادع إلى ربك} أي إلى طاعة ربك الذي خلقك وأنعم عليك وإلى توحيده {ولا تكونن من المشركين} أي لا تمل إليهم ولا ترض بطريقتهم ولا توال أحدا منهم {ولا تدع مع الله إلها آخر} أي لا تعبد معه غيره ولا تستدع حوائجك من جهة ما سواه {لا إله إلا هو} أي لا معبود إلا هو وحده لا شريك له .
{كل شيء هالك إلا وجهه} أي كل شيء فإن بائد إلا ذاته وهذا كما يقال هذا وجه الرأي ووجه الطريق وهذا معنى قول مجاهد {إلا هو} وفي هذا دلالة على أن الأجسام تفنى ثم تعاد على ما قاله الشيوخ في الفناء والإعادة وقيل معناه كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه فإن ذلك يبقى ثوابه عن عطا وابن عباس وعن أبي العالية والكلبي وهو اختيار الفراء وأنشد :
أستغفر الله ذنبا لست محصيه *** رب العباد إليه الوجه والعمل
أي إليه أوجه العمل وعلى هذا يكون وجه الله ما وجه إليه من الأعمال {له الحكم} أي له القضاء النافذ في خلقه وقيل له الفصل بين الخلائق في الآخرة دون غيره {وإليه ترجعون} أي تردون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم .
______________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج7 ، ص464-466 .
تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنية في تفسير هذه الآيات (1) :
{تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ ولا فَساداً والْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} . العلو في الأرض التعالي والتعاظم ، وإرادة التسلط على الناس بغير حق ، والفساد الظلم والعدوان ، والفسق والفجور ، والمعنى ان من تعالى وتعاظم على الناس ، أو اعتدى على شيء من حقوقهم فقد حرم اللَّه عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا {مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها ومَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ} . تقدم مثله في الآية 160 من سورة الأنعام ج 3 ص 290 .
{إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ} . يقول سبحانه لنبيه الكريم : ان الذي أوجب عليك العمل بالقرآن هو الذي سيعود بك إلى مكة التي أخرجك منها قومك . وقيل : ان النبي (صلى الله عليه واله وسلم) حين هاجر من مكة إلى المدينة اشتاق إلى وطنه ، وهو في أثناء الطريق ، فنزلت هذه الآية تبشره بالعودة إليه {قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى ومَنْ هُو فِي ضَلالٍ مُبِينٍ} . أعلم هنا بمعنى يعلم ، أي قل يا محمد لمن لا ترجو الهداية منه ، ويصر على أنه هو المهتدي وأنت الضال ، قل لهذا العنود : اللَّه ولا أحد سواه يميز بين المهتدي والضال ، والطيب والخبيث ، ويجزي كلا بما يستحق .
{وما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ} . الاستثناء هنا منقطع أي لكن اللَّه رحمك وتفضل عليك ، وهذا رد على من قال لرسول اللَّه :
لست مرسلا من عند اللَّه ، بل تفتري عليه ، وبيان الرد : كيف يقولون عنك يا محمد : انك تفتري على اللَّه بادعاء الرسالة مع أنها لم تمر بخاطرك من قبل ، ولا تطلعت إليها وحلمت بها في يوم من الأيام ، ولكن اللَّه سبحانه هو الذي أنعم عليك بها ، واصطفاك لها دون خلقه .
إخبار الغيب عن العملاء والخونة :
{فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ ولا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وادْعُ إِلى رَبِّكَ ولا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ولا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهً إِلَّا هُوَ} .
لقد اختارك اللَّه يا محمد لتكون حربا على الكافرين ، لا عونا لهم ، ولتبلغ رسالته إلى عباده ، ولا يأخذك في تبليغها لومة لائم ، ولتخلص للَّه وحده في جميع أقوالك وأعمالك .
وفيما تقدم قلنا ، ونحن نفسر هذا النوع من الآيات التي تخاطب المعصوم بالنهي عن المعصية ، قلنا : ان للأعلى ان ينهى من هو دونه بأي شكل أراد ، وعن أي شيء يختار ، بالإضافة إلى أن النهي عن الشيء لا يتوقف على إمكان وقوعه من المخاطب به ، أما الآن ، ونحن نفسر هذه الآية ، فقد استوحينا منها معنى آخر ، وهوان كل ما جاء في هذا الباب من الآيات فهو إخبار بالغيب وتعريض بما عليه اليوم وقبل اليوم بعض أرباب العمائم والقلانس الذين يتظاهرون بالدين والصلاح ، وهم جنود وأعوان للكفرة الفجرة . . وخصصنا البعض منهم بالذات مع أن العملاء والخونة يكونون منهم ومن كل نوع وصنف لأن الآيات تخاطب من يدعو إلى اللَّه وشريعته .
{كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} . هذا تهديد ووعيد لكل خائن وعميل يتآمر على دينه ووطنه مع أعداء اللَّه والإنسانية ، وانه بحكم المشرك الذي قامت عليه الحجة ، ومع ذلك يجحد ويعاند إذ لا فرق أبدا عند اللَّه بين من يدعو مع اللَّه إلها آخر ، ومن يوالي الظلمة الطغاة ، ويدافع عنهم ويبرر أعمالهم ، ويدعو إلى موالاتهم ومؤازرتهم .
وتسأل : هل معنى هذا ان العملاء والخونة يجب ان نعاملهم معاملة المشرك من النجاسة وعدم التوريث والتزويج والدفن في مقابر المسلمين ؟
الجواب : علينا أن نعامل كل من قال : أشهد ان لا إله إلا اللَّه وان محمدا رسول اللَّه - معاملة المسلم مهما كان عمله ، بل ومهما انطوى عليه قلبه . . ذلك ان لهذه الشهادة آثارها الموضوعية التي لا تنفك عنها بحال ، وهي الطهارة والتوريث والتزويج والدفن في مقابر المسلمين ، أما الآخرة فهي للَّه وحده ، ولا شأن فيها لأحد سواه ، وقد دل ظاهر العديد من الآيات ان الظالم يوم القيامة هو والمشرك سواء . أنظر ما قلناه عند تفسير الآية 55 من سورة الفرقان ، فقرة (الظالم كافر) .
_________________
1- تفسير الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج6 ، ص 89-91 .
تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير هذه الآيات (1) :
وقوله : {تلك الدار الآخرة} الإشارة إليها بلفظ البعيد للدلالة على شرفها وبهائها وعلو مكانتها وهو الشاهد على أن المراد بها الدار الآخرة السعيدة ولذا فسروها بالجنة .
وقوله : {نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا} أي نختصها بهم وإرادة العلو هو الاستعلاء والاستكبار على عباد الله وإرادة الفساد فيها ابتغاء معاصي الله تعالى فإن الله بنى شرائعه التي هي تكاليف للإنسان على مقتضيات فطرته وخلقته ولا تقتضي فطرته إلا ما يوافق النظام الأحسن الجاري في الحياة الإنسانية الأرضية فكل معصية تقضي إلى فساد في الأرض بلا واسطة أو بواسطة ، قال تعالى : {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ} [الروم : 41] .
ومن هنا ظهر أن إرادة العلو من مصاديق إرادة الفساد وإنما أفردت وخصت بالذكر اعتناء بأمرها ، ومحصل المعنى : تلك الدار الآخرة السعيدة تخصها بالذين لا يريدون فسادا في الأرض بالعلو على عباد الله ولا بأي معصية أخرى .
والآية عامة يخصصها قوله تعالى : {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} [النساء : 31] .
وقوله : {والعاقبة للمتقين} أي العاقبة المحمودة الجميلة وهي الدار الآخرة السعيدة أو العاقبة السعيدة في الدنيا والآخرة لكن سياق الآيتين يؤيد الأول .
قوله تعالى : {من جاء بالحسنة فله خير منها} أي لأنها تتضاعف له بفضل من الله ، قال تعالى : {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } [الأنعام : 160] .
قوله تعالى : {ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون} أي لا يزيدون على ما عملوا شيئا وفيه كمال العدل ، كما أن في جزاء الحسنة بخير منها كمال الفضل .
وكان مقتضى الظاهر في قوله : {فلا يجزى الذين عملوا} إلخ ، الإضمار ولعل في وضع الموصول موضع الضمير إشارة إلى أن هذا الجزاء إنما هو لمن أكثر من اقتراف المعصية وأحاطت به الخطيئة كما يفيده جمع السيئات ، وقوله : {كانوا يعملون} الدال على الإصرار والاستمرار ، وأما من جاء بالسيئة والحسنة فمن المرجو أن يغفر الله له كما قال : {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة : 102] .
وليعلم أن الملاك في الحسنة والسيئة على الأثر الحاصل منها عند الإنسان وبها تسمى الأعمال حسنة أو سيئة وعليها - لا على متن العمل الخارجي الذي هو نوع من الحركة - يثاب الإنسان أو يعاقب ، قال تعالى : {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ } [البقرة : 284] .
وبه يظهر الجواب عما استشكل على إطلاق الآية بأن التوحيد حسنة ولا يعقل خير منه وأفضل ، فالآية إما خاصة بغير الاعتقادات الحقة أو مخصصة بالتوحيد .
وذلك أن الأثر الحاصل من التوحيد يمكن أن يفرض ما هو خير منه وإن لم يقبله التوحيد بحسب الاعتبار .
على أن التوحيد أيا ما فرض يقبل الشدة والضعف والزيادة والنقيصة وإذا ضوعف عند الجزاء كما تقدم كان مضاعفه خيرا من غيره .
وقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (85) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [القصص : 85 - 88] .
الآيات خاتمة السورة وفيها وعد جميل للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن الله سبحانه سيمن عليه برفع قدره ونفوذ كلمته وتقدم دينه وانبساط الأمن والسلام عليه وعلى المؤمنين به كما فعل ذلك بموسى وبني إسرائيل ، وقد كانت قصة موسى وبني إسرائيل مسوقة في السورة لبيان ذلك .
قوله تعالى : {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد} إلى آخر الآية الفرض - على ما ذكره - بمعنى الإيجاب فمعنى {فرض عليك القرآن} أي أوجب عليك العمل به أي بما فيه من الأحكام ففيه مجاز في النسبة .
وأحسن منه قول بعضهم : إن المعنى أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به وذلك لكونه أوفق لقوله : {لرادك إلى معاد} بما سيجيء من معناه .
وقوله : {لرادك إلى معاد} المعاد اسم مكان أو زمان من العود وقد اختلفت كلماتهم في تفسير هذا المعاد فقيل : هو مكة فالآية وعد له أن الله سيرده بعد هجرته إلى مكة ثانيا ، وقيل : هو الموت ، وقيل : هو القيامة ، وقيل : هو المحشر ، وقيل هو المقام المحمود وهو موقف الشفاعة الكبرى ، وقيل : هو الجنة ، وقيل : هو بيت المقدس ، وهو في الحقيقة وعد بمعراج ثان يعود فيه إلى بيت المقدس بعد ما كان دخله في المعراج الأول : وقيل : هو الأمر المحبوب فيقبل الانطباق على جل الأقوال السابقة أوكلها .
والذي يعطيه التدبر في سياق آيات السورة هو أن تكون الآية تصريحا بما كانت القصة المسرودة في أول السورة تلوح إليه ثم الآيات التالية لها تؤيده .
فإنه تعالى أورد قصة بني إسرائيل وموسى (عليهما السلام) في أول السورة ففصل القول في أنه كيف من عليهم بالأمن والسلام والعزة والتمكن بعد ما كانوا أذلاء مستضعفين بأيدي آل فرعون يذبحون أبناءهم يستحيون نساءهم ، وقد كانت القصة تدل بالالتزام - ومطلع السورة يؤيده - على وعد جميل للمؤمنين أن الله سبحانه سينجيهم مما هم عليه من الفتنة والشدة والعسرة ويظهر دينهم على الدين كله ويمكنهم في الأرض بعد ما كانوا لا سماء تظلهم ولا أرض تقلهم .
ثم ذكر بعد الفراغ من القصة أن من الواجب في الحكمة أن ينزل كتابا يهدي الناس إلى الحق تذكرة وإتماما للحجة ليتقوا بذلك من عذاب الله كما نزله على موسى بعد ما أهلك القرون الأولى وكما نزل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن كذبوا به عنادا للحق وإيثارا للدنيا على الآخرة .
وهذا السياق يرجي السامع أنه تعالى سيتعرض صريحا لما أشار إليه في سرد القصة تلويحا فإذا سمع قوله : {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد} لم يلبث دون أن يفهم أنه هو الوعد الجميل الذي كان يترقبه وخاصة مع الابتداء بقوله : {إن الذي فرض عليك القرآن} وقد قدم تنظير التوراة بالقرآن وقد كان ما قصه في إنجاء بني إسرائيل مقدمة لنزول التوراة حتى يكونوا بالأخذ بها والعمل بها أئمة ويكونوا هم الوارثين .
فمعنى الآية : إن الذي فرض عليك القرآن لتقرأه على الناس وتبلغه وتعملوا به سيردك ويصيرك إلى محل تكون هذه الصيرورة منك إليه عودا ويكون هو معادا لك كما فرض التوراة على موسى ورفع به قدره وقدر قومه ، ومن المعلوم أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان بمكة على ما فيها من الشدة والفتنة ثم هاجر منها ثم عاد إليها فاتحا مظفرا وثبتت قواعد دينه واستحكمت أركان ملته وكسرت الأصنام وانهدم بنيان الشرك والمؤمنون هم الوارثون للأرض بعد ما كانوا أذلاء معذبين .
وفي تنكير قوله : {معاد} إشارة إلى عظمة قدر هذا العود وأنه لا يقاس إلى ما قبله من القطون بها والتاريخ يصدقه .
وقوله : {قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين} يؤيد ما قدمنا من المعنى فإنه يحاذي قول موسى (عليه السلام) - لما كذبوه ورموا آياته البينات بأنها سحر مفترى - : {ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار} فأمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يقول للفراعنة من مشركي قومه لما كذبوه ورموه بالسحر ما قال موسى لآل فرعون لما كذبوه ورموه بالسحر للتشابه التام بين مبعثيهما وسير دعوتهما كما يظهر من القصة ويظهر ذلك تمام الظهور بالتأمل في قوله تعالى : { إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا} [المزمل : 15] .
ولعل الاكتفاء بالشطر الأول من قول موسى (عليه السلام) والسكوت عن الشطر الثاني أعني قوله : {ومن تكون له عاقبة الدار} لبناء الكلام بحسب سياقه على أن لا يتعدى حد الإشارة والإيماء كما يستشم من سياق قوله : {لرادك إلى معاد} أيضا حيث خص الخطاب بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ونكر معادا .
وكيف كان فالمراد بقوله : {من جاء بالهدى} النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه وبقوله : {ومن هو في ضلال مبين} المشركون من قومه ، واختلاف سياق الجملتين - حيث قيل في جانبه (صلى الله عليه وآله وسلم) : {من جاء بالهدى} وفي جانبهم : {من هو في ضلال مبين} فقوبل بين ضلالهم وبين مجيئه بالهدى لا بين ضلالهم واهتدائه - لكون تكذيبهم متوجها بالطبع إلى ما جاء به لا إلى نفسه .
وقد ذكروا في قوله : {أعلم من جاء بالهدى} أن {من} منصوب بفعل مقدر يدل عليه {أعلم} والتقدير يعلم من جاء به بناء على ما هو المشهور أن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به ، وذكر بعضهم أنه منصوب بأعلم وهو بمعنى عالم ولا دليل عليه ، وما أذكر قائلا بأنه منصوب بنزع الخافض وإن لم يظهر فيه النصب لبنائه والتقدير ربي أعلم بمن جاء بالهدى ، ولا دليل على منعه .
قوله تعالى : {وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين} صدر الآية تقرير للوعد الذي في قوله : {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد} أي أنه سيردك إلى معاد - وما كنت ترجوه كما ألقى إليك الكتاب وما كنت ترجوه - .
وقيل : تذكرة استينافية لنعمته تعالى عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا وجه وجيه وتقريره أنه تعالى لما وعده بالرد إلى معاد وفيه ارتفاع ذكره وتقدم دعوته وانبساط دينه خط له السبيل التي يجب عليه سلوكها بجهد ومراقبة فبين له أن إلقاء الكتاب إليه لم يكن على نهج الحوادث العادية التي من شأنها أن ترتجى وتترقب بل كانت رحمة خاصة من ربه وقد وعده في فرضه عليه ما وعده فمن الواجب عليه قبال هذه النعمة وفي تقدم دعوته وبلوغها الغاية التي وعدها أن لا ينصر الكافرين ولا يطيعهم ويدعو إلى ربه ولا يكون من المشركين ولا يدعو معه إلها آخر .
وقوله : {إلا رحمة من ربك} استثناء منقطع أي لكنه ألقى إليك رحمة من ربك وليس بإلقاء عادي يرجى مثله .
وقوله : {فلا تكونن ظهيرا للكافرين} تفريع على قوله : {إلا رحمة من ربك} أي فإذا كان إلقاؤه إليك رحمة من ربك خصك بها وهو فوق رجائك فتبرء من الكافرين ولا تكن معينا وناصرا لهم .
ومن المحتمل قريبا أن يكون في الجملة نوع محاذاة لقول موسى (عليه السلام) - لما قتل القبطي : {رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين} وعلى هذا يكون في النهي عن إعانتهم إشارة إلى أن إلقاء الكتاب إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) نعمة أنعمها الله عليه يهدي به إلى الحق ويدعو إلى التوحيد فعليه أن لا يعين الكافرين على كفرهم ولا يميل إلى صدهم إياه عن آيات الله بعد نزولها عليه كما عاهد موسى (عليه السلام) ربه بما أنعم عليه من الحكم والعلم أن لا يكون ظهيرا للمجرمين أبدا ، وسيأتي أن قوله : {ولا يصدنك} إلخ ، بمنزلة الشارح لهذه الجملة .
قوله تعالى : {ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك} إلى آخر الآية ، نهي له (صلى الله عليه وآله وسلم) على الانصراف عن آيات الله بلسان نهي الكفار عن الصد والصرف ووجهه كون انصرافه مسببا لصدهم وهو كقوله لآدم وزوجه : {فلا يخرجنكما من الجنة} أي لا تخرجا منها بإخراجه لكما بالوسوسة .
والظاهر أن الآية وما بعدها في مقام الشرح لقوله : {فلا تكونن ظهيرا للكافرين} وفائدته تأكيد النهي بعد موارده واحدا بعد واحد فنهاه أولا عن الانصراف عن القرآن النازل عليه برميهم كتاب الله بأنه سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين اكتتبها ، وأمره ثانيا أن يدعو إلى ربه ، ونهاه ثالثا أن يكون من المشركين وفسره بأن يدعو مع الله إلها آخر .
وقد كرر صفة الرب مضافا إليه (صلى الله عليه وآله وسلم) للدلالة على اختصاصه بالرحمة والنعمة وأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) متفرد في عبادته لا يشاركه المشركون فيها .
قوله تعالى : {ولا تدع مع الله إلها آخر} قد تقدم أنه كالتفسير لقوله : {ولا تكونن من المشركين} .
قوله تعالى : {لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون} كلمة الإخلاص في مقام التعليل لقوله قبله : {ولا تدع مع الله إلها آخر} أي لأنه لا إله غيره وما بعدها في مقام التعليل بالنسبة إليها كما سيتضح .
وقوله : {كل شيء هالك إلا وجهه} الشيء مساو للموجود ويطلق على كل أمر موجود حتى عليه تعالى كما يدل عليه قوله : {قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ} [الأنعام : 19] ، والهلاك البطلان والانعدام .
والوجه والجهة واحد كالوعد والعدة ، ووجه الشيء في العرف العام ما يستقبل به غيره ويرتبط به إليه كما أن وجه الجسم السطح الظاهر منه ووجه الإنسان النصف المقدم من رأسه ووجهه تعالى ما يستقبل به غيره من خلقه ويتوجه إليه خلقه به وهو صفاته الكريمة من حياة وعلم وقدرة وسمع وبصر وما ينتهي إليها من صفات الفعل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والمغفرة والرحمة وكذا آياته الدالة عليه بما هي آياته .
فكل شيء هالك في نفسه باطل في ذاته لا حقيقة له إلا ما كان عنده مما أفاضه الله عليه وأما ما لا ينسب إليه تعالى فليس إلا ما اختلقه وهم المتوهم أو سرابا صوره الخيال وذلك كالأصنام ليس لها من الحقيقة إلا أنها حجارة أو خشبة أو شيء من الفلزات وأما أنها أرباب أو آلهة أو نافعة أو ضارة أو غير ذلك فليست إلا أسماء سماها عبدتهم وكالإنسان ليس له من الحقيقة إلا ما أودعه فيه الخلقة من الروح والجسم وما اكتسبه من صفات الكمال والجميع منسوبة إلى الله سبحانه وأما ما يضيفه إليه العقل الاجتماعي من قوة وسلطة ورئاسة ووجاهة وثروة وعزة وأولاد وأعضاد فليس إلا سرابا هالكا وأمنية كاذبة وعلى هذا السبيل سائر الموجودات .
فليس عندها من الحقيقة إلا ما أفاض الله عليها بفضله وهي آياته الدالة على صفاته الكريمة من رحمة ورزق وفضل وإحسان وغير ذلك .
فالحقيقة الثابتة في الواقع التي ليست هالكة باطلة من الأشياء هي صفاته الكريمة وآياته الدالة عليها والجميع ثابتة بثبوت الذات المقدسة .
هذا على تقدير كون المراد بالهالك في الآية الهالك بالفعل وعلى هذا يكون محصل تعليل كلمة الإخلاص بقوله : {كل شيء هالك إلا وجهه} أن الإله وهو المعبود بالحق إنما يكون إلها معبودا إذا كان أمرا ذا حقيقة واقعية غير هالك ولا باطل له تدبير في العالم بهذا النعت وكل شيء غيره تعالى هالك باطل في نفسه إلا ما كان وجها له منتسبا إليه فليس في الوجود إله غيره سبحانه .
والوثنيون وإن كانوا يرون وجود آلهتهم منسوبا إليه تعالى ومن جهته إلا أنهم يجعلونها مستقلة في التدبير مقطوعة النسبة في ذلك عنه من دون أن يكون حكمها حكمه ، ولذلك يعبدونها من دون الله ، ولا استقلال لشيء في شيء عنه تعالى فلا يستحق العبادة إلا هو .
وهاهنا وجه آخر أدق منه بناء على أن المراد بالوجه ذات الشيء فقد ذكر بعضهم ذلك من معاني الوجه كما يقال : وجه النهار ووجه الطريق لنفسهما وإن أمكنت المناقشة فيه ، وذكر بعض آخر : أن المراد به الذات الشريفة كما يقال : وجوه الناس أي أشرافهم وهومن المجاز المرسل أو الاستعارة وعلى كلا التقديرين فالمراد أن غيره تعالى من الموجودات ممكنة والممكن وإن كان موجودا بإيجاده تعالى فهو معدوم بالنظر إلى حد ذاته هالك في نفسه والذي لا سبيل للبطلان والهلاك إليه هو ذاته الواجبة بذاتها .
ومحصل التعليل على هذا المعنى : أن الإله المعبود بالحق يجب أن يكون ذاتا بيده شيء من تدبير العالم ، والتدبير الكوني لا ينفك عن الخلق والإيجاد فلا معنى لأن يوجد الحوادث شيء ويدبر أمرها شيء آخر - وقد أوضحناه مرارا في هذا الكتاب - ولا يكون الخالق الموجد إلا واجب الوجود ولا واجب إلا هو تعالى فلا إله إلا هو .
وقولهم : إنه تعالى أجل من أن يحيط به عقل أووهم فلا يمكن التوجه العبادي إليه فلا بد أن يتوجه بالعبادة إلى بعض مقربي حضرته من الملائكة الكرام وغيرهم ليكونوا شفعاء عنده .
مدفوع بمنع توقف التوجه بالعبادة على العلم الإحاطي بل يكفي فيه المعرفة بوجه وهو حاصل بالضرورة .
وأما على تقدير كون المراد بالهالك ما يستقبله الهلاك والفناء بناء على ما قيل : إن اسم الفاعل ظاهر في الاستقبال فظاهر الآية أن كل شيء سيستقبله الهلاك بعد وجوده إلا وجهه .
نعم استقبال الهلاك يختلف باختلاف الأشياء فاستقباله في الزمانيات انتهاء أمد وجودها وبطلانها بعده وفي غيرها كون وجودها محاطا بالفناء من كل جانب .
وهلاك الأشياء على هذا بطلان وجودها الابتدائي وخلو النشأة الأولى عنها بانتقالها إلى النشأة الأخرى ورجوعها إلى الله واستقرارها عنده ، وأما البطلان المطلق بعد الوجود فصريح كتاب الله ينفيه فالآيات متتابعة في أن كل شيء مرجعه إلى الله وأنه المنتهى وإليه الرجعى وهو الذي يبدىء الخلق ثم يعيده .
فمحصل معنى الآية – لو أريد بالوجه صفاته الكريمة - أن كل شيء سيخلي مكانه ويرجع إليه إلا صفاته الكريمة التي هي مبادىء فيضه فهي تفيض ثم تفيض إلى ما لا نهاية له والإله يجب أن يكون كذلك لا بطلان لذاته ولا انقطاع لصفاته الفياضة وليس شيء غيره تعالى بهذه الصفة فلا إله إلا هو .
ولو أريد بوجهه الذات المقدسة فالمحصل أن كل شيء سيستقبله الهلاك والفناء بالرجوع إلى الله سبحانه إلا ذاته الحقة الثابتة التي لا سبيل للبطلان إليها - والصفات على هذا محسوبة من صقع الذات - والإله يجب أن يكون بحيث لا يتطرق الفناء إليه وليس شيء غيره بهذه الصفة فلا إله إلا هو .
وبما تقدم من التقرير يندفع الاعتراض على عموم الآية بمثل الجنة والنار والعرش فإن الجنة والنار لا تنعدمان بعد الوجود وتبقيان إلى غير النهاية ، والعرش أيضا كذلك بناء على ما ورد في بعض الروايات أن سقف الجنة هو العرش .
وجه الاندفاع أن المراد بالهلاك هو تبدل نشأة الوجود والرجوع إلى الله المعبر عنه بالانتقال من الدنيا إلى الآخرة والتلبس بالعود بعد البدء ، وهذا إنما يكون فيما هو موجود بوجود بدئي دنيوي ، وأما الدار الآخرة وما هو موجود بوجود أخروي كالجنة والنار فلا يتصف شيء من هذا القبيل بالهلاك بهذا المعنى .
قال تعالى : {مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ } [النحل : 96] ، وقال : {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ } [آل عمران : 198] ، وقال : { سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ } [الأنعام : 124] ، ونظيرتهما خزائن الرحمة كما قال : {إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ} [الحجر : 21] ، وكذا اللوح المحفوظ كما قال : {وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ } [ق : 4] .
وأما ما ذكروه من العرش فقد تقدم الكلام فيه في تفسير قوله تعالى : {إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ } [الأعراف : 54] .
ويمكن أن يراد بالوجه جهته تعالى التي تنسب إليه وهي الناحية التي يقصد منها ويتوجه إليه بها ، وتؤيده كثرة استعمال الوجه في كلامه تعالى بهذا المعنى كقوله : {يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الأنعام : 52] ، وقوله : { إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى} [الليل : 20] ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة جدا .
وعليه فتكون عبارة عن كل ما ينسب إليه وحده فإن كان الكلام على ظاهر عمومه انطبق على الوجه الأول الذي أوردناه ويكون من مصاديقه أسماؤه وصفاته وأنبياؤه وخلفاؤه ودينه الذي يؤتى منه .
وإن خص الوجه بالدين فحسب - كما وقع في بعض الروايات إن لم يكن من باب التطبيق - كان المراد بالهلاك الفساد وعدم الأثر ، وكانت الجملة تعليلا لقوله : {ولا تدع مع الله إلها آخر} وكان ما قبلها قرينة على أن المراد بالشيء الدين والأعمال المتعلقة به وكان محصل المعنى : ولا تتدين بغير دين التوحيد لأن كل دين باطل لا أثر له إلا دينه .
والأنسب على هذا أن يكون الحكم في ذيل الآية بمعنى الحكم التشريعي أو الأعم منه ومن التكويني والمعنى : كل دين هالك إلا دينه لأن تشريع الدين إليه وإليه ترجعون لا إلى مشرعي الأديان الأخر .
هذا ما يعطيه التدبر في الآية الكريمة وللمفسرين فيها أقوال أخر مختلفة .
فقيل : المراد بالوجه ذاته تعالى المقدسة وبالهلاك الانعدام ، والمعنى : كل شيء في نفسه عرضة للعدم لكون وجوده عن غيره إلا ذاته الواجبة الوجود ، والكلام على هذا مبني على التشبيه أي كل شيء غيره كالهالك لاستناد وجوده إلى غيره .
وقيل : الوجه بمعنى الذات والمراد به ذات الشيء والضمير لله باعتبار أن وجه الشيء مملوك له ، والمعنى : كل شيء هالك إلا وجه الله الذي هو ذات ذلك الشيء ووجوده .
وقيل : المراد بالوجه الجهة المقصودة والضمير لله ، والمعنى : كل شيء هالك بجميع ما يتعلق به إلا الجهة المنسوبة إليه تعالى وهو الوجود الذي أفاضه الله تعالى عليه .
وقيل : الوجهة هو الجهة المقصودة والمراد به الله سبحانه الذي يتوجه إليه كل شيء والضمير للشيء ، والمعنى : كل شيء هالك إلا الله الذي هو الجهة المطلوبة له .
وقيل : المراد بالهلاك هلاك الموت والعموم مخصوص بذوي الحياة والمعنى : كل ذي حياة فإنه سيموت إلا وجهه .
وقيل : المراد بالوجه العمل الصالح والمعنى أن العمل كان في حيز العدم ، فلما فعله العبد ممتثلا لأمره تعالى أبقاه الله من غير إحباط حتى يثيبه أو أنه بالقبول صار غير قابل للهلاك لأن الجزاء قائم مقامه وهو باق .
وقيل : المراد بالوجه جاهه تعالى الذي أثبته في الناس .
وقيل : الهلاك عام لجميع ما سواه تعالى دائما لكون الوجود المفاض عليها متجددا في كل آن فهي متغيرة هالكة دائما في الدنيا والآخرة والمعنى كل شيء متغير الذات دائما إلا وجهه .
وهذه الوجوه بين ما لا ينطبق على سياق الآية وبين ما لا ينجح به حجتها وبين ما هو بعيد عن الفهم ، وبالتأمل فيما قدمناه يظهر ما في كل منها فلا نطيل .
وقوله : {له الحكم وإليه ترجعون} الحكم هو قضاؤه النافذ في الأشياء وعليه يدور التدبير في نظام الكون ، وأما كونه بمعنى فصل القضاء يوم القيامة فيبعده تقديم الحكم في الذكر على الرجوع إليه الذي هو يوم القيامة فإن فصل القضاء متفرع عليه .
وكلتا الجملتين مسوقتان للتعليل وكل واحدة منهما وحدها حجة تامة على توحده .
تعالى بالألوهية صالحة للتعليل كلمة الإخلاص ، وقد تقدم إمكان أخذ الحكم على بعض الوجوه بمعنى الحكم التشريعي .
_______________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج16 ، ص65-77 .
تفسير الامثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذه الآيات (1) :
نتيجة حبّ التسلط والفساد في الأرض :
بعد البيان المثير لما حدث لثري مستكبر ومتسلط ، وهو قارون ، تبدأ الآية الأُولى من هذا المقطع ببيان استنتاج كلي لهذا الواقع وهذا الحدث ، إذ تقول الآية {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً} .
أجل ، فهم غير مستكبرين ولا مفسدين في الأرض وليس هذا فحسب ، بل قلوبهم مطهّرة من هذه المسائل ، وأرواحهم منزهة من هذه الأوساخ ! فلا يريدون ذلك ولا يرغبون فيه .
وفي الحقيقة إنّ ما يكون سبباً لحرمان الإنسان من مواهب الدار الآخرة ، هو هذان الأمران : «الرغبة في العلو» أيّ الإستكبار و«الفساد في الأرض» وهما الذنوب . . لأنّ كل ما نهى الله عنه فهو على خلاف نظام خلق الإنسان وتكامل وجوده حتماً ، فارتكاب ما نهى الله عنه يدمر نظام حياة الإنسان ، لذا فهو أساس الفساد في الأرض ! حتى مسألة الإستعلاء ـ بنفسها ـ هي أيضاً واحدة من مصاديق الفساد في الارض ، إلاّ أن أهميته القصوى دعت إلى أن يذكر بالخصوص من بين جميع المصاديق للفساد في الأرض ! .
وقد رأينا في قصّة «قارون» وشرح حاله أنّ السبب الاساس في شقوته وهلاكه هو العلو و «الإستكبار» .
ونجد في الرّوايات الإسلامية اهتماماً بهذه المسألة حتى أنّنا نقرأ حديثا عن الإمام أمير المؤمنين على (عليه السلام) يقول : «إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها» (2) .
(وهذا أيضاً فرع صغير من الاستعلاء) .
ومن الطريف أنّ صاحب «تفسير الكشاف» يعلق بعد ذكر هذا الحديث فيقول : بعض الطامعين ينسبون «العلوّ» في الآية محل البحث لفرعون بمقتضى قوله : {إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ} [القصص : 4] والفساد لقارون بمقتضى قوله : { وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ} [القصص : 77] ويدعون بأن من لم يكن كمثل فرعون وقارون فهومن أهل الجنّة والدار الآخرة ، وعلى هذا فهم يبعدون فرعون وقارون وأمثالهما من الجنّة فحسب ، ويرون الباقين من أهل الجنّة ، إلاّ أنّهم لم يلاحظوا ذيل الآية (والعاقبة للمتقين} بدقة ـ كما لاحظها الإمام علي (عليه السلام) (3) .
وما ينبغى إضافته على هذا الكلام هو أن هؤلاء الجماعة اخطاؤا حتى في معرفة قارون وفرعون . . لأنّ فرعون كان عالياً في الأرض وكان من المفسدين{إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} [القصص : 4] وقارون أيضاً كان مفسداً وكان عالياً بمقتضى قوله : { فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ } [القصص : 79] .
ونقرأ في حديث آخر عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه كان يسير في الأسواق أيام خلافته الظاهرية ، فيرشد التائهين إلى الطريق ويساعد الضعفاء ، وكان يمرّ على الباعة والكسبة ويتلوا الآية الكريمة {تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً} . ثمّ يضيف سلام الله عليه : «نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من الناس» (4) .
ومعنى هذا الكلام ، أنّه كما لم يجعل الخلافة والحكومة وسيلة للاستعلاء ، فلا ينبغي أن تجعلوا أموالكم وقدرتكم وسيلة للتسلط على الآخرين ، فأنّ العاقبة لأولئك الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً وكما يقول القرآن في نهاية الآية {والعاقبة للمتقين} .
و«العاقبة» بمفهومها الواسع هي النتيجة الصالحة ، وهي الانتصار في هذه الدنيا ، والجنّة ونعيمها في الدار الأخرى . . . وقد رأينا أنّ قارون وأتباعه إلى أين وصلوا وأيّة عاقبة تحمّلوا ! مع أنّهم كانوا مقتدرين ولكن حيث كانوا غير متقين فقد ابتلوا بأسوأ العاقبة والمصير ! .
ونختم كلامنا في شأن هذه الآية بحديث للإمام الصادق (عليه السلام) وهو أنّ الإمام الصادق حين تلا هذه الآية أجهش بالبكاء وقال : «ذهبت والله الأماني عند هذه الآية» . (5) .
وبعد ذكر هذه الحقيقة الواقعية ، وهي أن الدار الآخرة ليست لمن يحب السلطة والمستكبرين ، بل هي للمتقين المتواضعين وطلبة الحق ، تأتي الآية الثّانية لتبيّن قانوناً كلياً وهو مزيج بين العدالة والتفضل ، ولتذكر ثواب الإحسان فتقول : {من جاء بالحسنة فله خير منها} .
وهذه هي مرحلة التفضل ، أي أنّ الله سبحانه لا يحاسب الناس كما يحاسب الإنسان نظيره بعين ضيّقة ، فإذا أراد الإنسان أن يعطي أجر صاحبه فإنّه يسعى أن يعطيه بمقدار عمله ، إلاّ أنّ الله قد يضاعف الحسنة بعشر أمثالها وقد يضاعفها بمئات الأمثال وربّما بالآلاف ، إلاّ أن أقلّ ما يتفضل الله به على العبد أن يجازيه عشرة أضعاف حسناته ، حيث يقول القرآن في الآية (160) من سورة الأنعام : {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام : 160]
أمّا الحدّ الأكثر من ثواب الله وجزائه فلا يعلمه إلاّ الله ، وقد جاءت الإشارة إلى جانب منه ـ وهو الإنفاق في سبيل الله ـ في الآية 261 من سورة البقرة . . . إذ يقول سبحانه في هذا الصدد . . . {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة : 261] .
وبالطبع فإنّ مضاعفة الأجر والثواب ليس أمراً اعتباطياً ، بل له إرتباط وثيق بنقاء العمل وميزان الإخلاص وحسن النيّة وصفاء القلب ، فهذه هي مرحلة التفضل الإلهي في شأن المحسنين .
ثمّ يعقّب القرآن ليذكر جزاء المسيئين فيقول : {ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلاّ ما كانوا يعملون} .
وهذه هي مرحلة العدل الإلهي ، لأنّ المسيء لا يجازى إلاّ بقدر إساءته ، ولا تضاف على إساءته أية عقوبة ! .
الطريف هنا عند ذكر جزاء السيئة أن القرآن يعبر عن الجزاء بالعمل نفسه {إلاّ ما كانوا يعملون} أي إن أعمالهم التي هي طبقاً لقانون بقاء الموجودات في عالم الوجود ، تبقى ولا تتغير ، وتبرز في يوم القيامة متجسمة دون خفاء ، فهو (يوم البروز) في شكل يناسب العمل ، وهذا الجزاء يرافق المسيئين ويعذبهم ! .
وقوله تعالى : {إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (85) وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ (86) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [القصص : 85 - 88]
الوعد بعودة النّبي إلى حرم الله الآمن :
هذه الآيات التي هي آخر الآيات في سورة القصص تخاطب نبيّ الإسلام (صلى الله عليه وآله) وتبشره بالنصر ، بعد أن جاءت الآيات الأُولى لتبيّن قصّة موسى وفرعون وما جرى له مع قومه ، كما أنّ هذه الآيات فيها ارشادات وتعليمات مؤكّدة لرسول الإسلام (صلى الله عليه وآله) .
قلنا : إنّ الآية الأُولى من هذه الآيات طبقاً لما هو مشهور بين المفسّرين نزلت في «الجحفة» في مسير النّبي (صلى الله عليه وآله) ، إلى المدينة إذ كان متوجهاً إلى يثرب لتتحول بوجوده إلى «مدينة الرّسول» . . . وأن يبذر النّواة الأصيلة . . . «لحكومة إسلامية» فيها ويجعلها مقرّاً لحكومة إلهية واسعة ، ويحقق فيها أهدافها .
لكن هذا الحنين والشوق والتعلق بمكّة يؤلمه كثيراً ، وليس من اليسير عليه الإبتعاد عن حرم الله الآمن .
وهنا يشرق في قلبه الطاهر نور الوحي ، ويبشّره بالعودة إلى وطنه الذي ألفه فيقول : {إنّ الذي فرض عليك القرآن لرآدك إلى معاد} .
فلا تكترث ولا تُذهب نفسك حسرات ، فالله الذي أعاد موسى إلى أُمّه هو الذي أرجعه أيضاً إلى وطنه بعد غياب عشر سنوات في مدين ، ليشعل مصباح التوحيد ويقيم حكومة المستضعفين ويقضي على الفراعنة ودولتهم وقوّتهم .
هو اللّه سبحانه الذي يردك إلى مكّة بكلّ قوّة وقدرة ، ويجعل مصباح التوحيد على يدك مشرقاً في هذه الأرض المباركة .
وهو الله الذي أنزل عليك القرآن ، وفرض عليك إبلاغه ، وأوجب عليك أحكامه .
أجل ، إنّ ربّ القرآن وربّ السماء والأرض العظيم ، يسيرٌ عليه أن يردّك إلى معادك ووطنك «مكّة» .
ثمّ يضيف القرآن في خطابه للنّبي (صلى الله عليه وآله) ، أن يجيب على المخالفين الضالين بما علّمه الله {قل ربّي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين} .
إنّ طريق الهداية واضح ، وضلالهم بيّن ، وهم يتعبون أنفسهم عبثاً ، فالله يعرف ذلك جيداً ، والقلوب التي تعشق الحق تعرف هذه الحقيقة أيضاً .
وبالطبع فإنّ التّفسير الواضح للآية كما بيّناه آنفاً ، إلاّ أن جمعاً من المفسّرين لديهم احتمالات أُخرى في كلمة «معاد» . . من قبيل «العودة للحياة بعد الموت» «المحشر» او «الموت» . كما فسّروه «بالجنّة» أو مقام «الشفاعة الكبرى» . . . أو «بيت المقدس» الذي عرج النّبي منه أوّل مرة ، وغير هذه المعاني .
إلاّ أنّه مع الإلتفات إلى محتوى مجموع هذه السورة ـ القصص ـ وما جاء في قصّة موسى وفرعون وبني إسرائيل ، وما سقناه من شأن نزول الآية ، فيبعد تفسير المعاد بغير العودة إلى مكّة كما يبدو ! .
أضف إلى ذلك أن المعاد في يوم القيامة لا يختصّ بالنّبي وحده ، والحال أن الآية تتحدث عن النّبي ـ هنا ـ وتخاطبه وحده . ووجود هذه الآية بعد الآية التي تتحدث عن الثواب والجزاء في يوم القيامة ، لا دلالة فيها على هذا المعنى ، بل على العكس من ذلك ، لأنّ الآية السابقة تتحدث عن الانتصار في الدار الآخرة ، ومن المناسب أن يكون الحديث في هذه الآية عن الإنتصار في هذه الدنيا .
أمّا الآية التالية فتتحدث عن نعمة أُخرى من نعم الله العظيمة على النّبي (صلى الله عليه وآله) فتقول : {وما كنت ترجو أن يُلقى إليك الكتاب إلاّ رحمة من ربّك} (6) .
كان كثير من الناس قد سمعوا بالبشارة بظهور الدين الجديد ، ولعل طائفةً من أهل الكتاب وغيرهم كانوا ينتظرون أن ينزل عليهم الوحي ويحمّلهم الله هذه المسؤولية ، ولكنّك ـ أيّها النّبي ـ لم تكن تظن أنّه سينزل عليك الوحي {وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب} . . إلاّ أن الله رآك أجدر بالأمر ، وأن هذا الدين الجديد ينبغي أن ينتشر ويتسع على يدك في هذا العالم الكبير ! .
وبعض المفسّرين يرون هذه الآية منسجمة مع آيات سابقة كانت تتحدث عن موسى (عليه السلام) ، وتخاطب النّبي ـ أيضاً ـ كقوله تعالى : {وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر . . وما كنت ثاوياً في أهل مدين . . . وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمةً من ربّك} .
فعلى هذا يكون المقصود بالكتاب هنا هو قصص الأنبياء السابقين . . إلاّ أن هذا التفسير لا منافاة فيه مع التفسير المتقدم ! بل يعدّ قسماً منه في الواقع ! .
ثمّ يضيف القرآن في خطابه للنّبي (صلى الله عليه وآله) أن طالما كنت في هذه النعمة {فلا تكونن ظهيراً للكافرين} .
ومن المُسلّم به أنّ النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يكن ظهيراً للكافرين أبداً ، إلاّ أن الآية جاءت في مقام التأكيد على النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبيان المسؤولية للآخرين ، وأن وظيفتهم أن يتأسوا بالنّبي ولا يكون أيّ منهم ظهيراً للكافرين .
وهذا الموضوع ينسجم تماماً مع الموضوع الذي قرأناه في شأن موسى (عليه السلام) ، إذ قال : {ربّ بما أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين} . . وبيّنا معناه في شأن إعانة الظالمين في الآية (17) من سورة القصص ، أمّا الآيتان اللتان تختتم بهما سورة القصص ، فهما تأكيد على مسألة التوحيد بتعابير واستدلالات متعددة ومختلفة .
التوحيد الذي هو أساس جميع المسائل الدينية . . . التوحيد الذي هو الأصل وهو الفرع وهو الكلّ وهو الجزء ! .
وفي هاتين الآيتين أربعة أوامر من الله لنبيّه (صلى الله عليه وآله) ، وأربعة صفات لله تعالى ، وبها يكتمل ما ورد في هذه السورة من أبحاث .
يقول أوّلا : {ولا يصدّنك عن آيات الله بعد إذ اُنزلت إليك} وبالرغم من أن النهي موجه إلى الكفار ، إلاّ أن مفهوم الآية عدم تسليم النّبي (صلى الله عليه وآله) أمام صدّ الكافرين ، وإحباطهم ومؤامراتهم ، وهذا تماماً يشبه ما لوقلنا مثلا : لا ينبغي أن يوسوس لك فلان ، فمعناه : لا تستسلم لوسوسته ! .
وبهذا الأسلوب يأمر الله النّبي (صلى الله عليه وآله) أن يقف راسخ القدم عند نزول الآيات ولا يتردد في الأمر ، وأن يزيل الموانع من قارعة الطريق مهما بلغت ، ولْيَسر نحو هدفه مطمئناً ، فإنّ الله حاميه ومعه أبداً .
ويقول ابن عباس : وإن كان المخاطب هو النّبي (صلى الله عليه وآله) ، إلاّ أنّ المراد عموم الناس ، وهومن قبيل المثل العربي المعروف «إيّاك أعني واسمعي يا جارة !» .
وبعد هذا الخطاب الذي فيه جنبة نهي ، يأتي الخطاب الثّاني وفيه سمة إثبات فيقول : (وادع إلى ربّك} . . فالله الذي خلقك وهو الذي ربّاك ورعاك . . .
والامر الثالث ، بعد الأمر بتوحيد الله ، هو نفي جميع أنواع الشرك وعبادة الأصنام {ولا تكونن من المشركين} . . . فإن طريق التوحيد واضحة بينة ، ومن ساروا عليها فهم على صراط مستقيم ! .
والأمر الرّابع تأكيد آخر على نفي جميع أنواع الشرك ، إذ يقول تعالى : {ولا تدع مع الله إلهاً آخر} .
وهذه الأوامر المتتابعة كل واحد منها يؤكّد الآخر ، يوضح أهمية التوحيد في المنهج الإسلامي ، إذ بدونه يكون كل عمل زيفاً ووهماً .
وبعد هذه الأوامر الأربعة تأتي أوصاف أربعة لله سبحانه ، وهي جميعاً تأكيد على التوحيد أيضاً .
فالأوّل قوله : {لا إله إلاّ هو} .
والثّاني قوله : {كل شيء هالك إلاّ وجهه} .
والوصف الثالث : {له الحكم} والحاكمية في عالمي التشريع والتكوين .
والرابع : أن معادنا إليه {وإليه ترجعون} .
والأوصاف الثلاثة الأخيرة يمكن أن تكون دليلا على إثبات التوحيد وترك جميع أنواع عبادة الأصنام ، الذي أشير إليه في الوصف الأول !
لأنّه طالما كنّا هالكين جميعاً وهو الباقي .
وطالما كان التدبير لنظام الوجود بيده والحكم له !
وطالما كان معادنا إليه وإليه نرجع ! . . . فما عسى أن يكون دور المعبودات غيره ، وأي أحد يستحق العبادة سواه !؟
والمفسّرون الكبار لديهم آراء مختلفة في تفسير جملة {كل شيء هالك إلاّ وجهه} تدور حول محور كلمتي «وجه» و«هالك» .
لأنّ الوجه يطلق ـ من حيث اللغة ـ على المحيّا أو ما يواجهه الإنسان من الشخص المقابل ، ولكن الوجه حين يطلق على الخالق فإنّه يعني عندئذ ذاته المقدسة ! .
وكلمة «هالك» مشتقّة من مادة «هلك» ومعناه الموت والعدم ، فعلى هذا يكون معنى الجملة المتقدمة فناء جميع الموجودات عدا ذات الخالق المقدسة . . . وهذا الفناء بالنسبة للموجودات الممكنة غير منحصر بفناء هذا العالم وانتهائه ، فالموجودات الآن فانية قبال الذات المقدسة ، وهي تحتاج إلى فيضه لحظة بعد لحظة ، وليس لديها في ذاتها أي شيء ، وكلّ ما لديها فمن الله !
ثمّ بعد هذا كلّه فإنّ موجودات هذا العالم جميعها متغير وفي معرض التبدل ، وحتى طبقاً لفلسفة «الحركة الجوهرية» فذاتها هي التغيير بعينه ، ونحن نعرف أن الحركة والتغيير معناهما الفناء والعودة الدائمية ، فكل لحظة تموت موجودات العالم وتحيا ! .
فعلى هذا فإنّ الموجودات هالكة وفانية الآن ـ أيضاً ـ غير أن الذات التي لا طريق الفناء إليها ولا تهلك ، هي الذات المقدسة !
كما نعلم أنّ الفناء أو العدم يتجلى بصورة واضحة في نهاية هذا العالم ، وكما يقول القرآن : { كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ } [الرحمن : 26 ، 27] .
ولا يخصُّ الفناء ما على الأرض ، بل يشمل حتى أهل السماء {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ} [الزمر : 68] .
فهذا التّفسير منسجم مع ظاهر الآية والآيات الأُخرى في القرآن ، غير أن بعض المفسّرين ذكروا تفاسير أُخرى غير ما تقدم بيانه ، ومنها :
1 ـ أنّ المقصود من كلمة (وجه) هو العمل الصالح ، ومفهوم هذه الآية يكون حينئذ أن جميع الأعمال تمضي مع الرياح سوى ما يكون خالصاً لله .
وقال بعضهم : إنّ المراد بالوجه هو انتساب الأشياء إلى الله ، فيكون مفهوم الآية أنّ كل شيء معدوم ذاتاً إلاّ من ناحية انتمائه إلى الله !
وقال بعضهم : المراد بالوجه هو الدين ، فيكون مفهوم الآية أن المذاهب كلها باطلة سوى دين الله .
وجملة (له الحكم} هي كما فسّروها بأنّها الحاكمية التشريعية . وهو تأكيد على التّفسير السابق ! .
كما أن جملة (واليه ترجعون} فسّروها بالرجوع إلى الله في أخذ الشريعة عنه ! وهذا تأكيد آخر على هذا المعنى (7) .
وهذه التفاسير مع ما بيّناه آنفاً لا نجد بينها منافاةً في الحقيقة ! . . . لأنّنا حين عرفنا أن الشيء الوحيد الذي يبقى في هذا العالم هو الذات المقدسة لله فحسب ! فيتّضح أن ما يرتبط بذات الله بنحو من الأنحاء فإنه يستحق البقاء والابدية .
فدين الله الصادر منه أبديّ ، والعمل الصالح الذي له أبديّ . . . والقادة الألهيّون الذين يرتبطون يتّسمون بالخلود .
والخلاصة ، كل ما هو مرتبط بالله ـ ولو بنحو من الأنحاء ـ فهو غير فان «فلاحظوا بدقّة» .
________________
2 ـ تفسير جوامع الجامع ، ذيل الآية محل البحث .
3 ـ تفسير الفخر الرازي ، ذيل الآية محل البحث .
4 ـ نقل هذه الرواية زاذان عن أمير المؤمنين «مجمع البيان (ذيل الآية محل البحث)» .
5 ـ تفسير علي بن إبراهيم ذيل الآية محل البحث .
6 ـ قال بعضهم : إن «إلاّ» هنا تفيد الإستثناء ، فاضطروا إلى أن يقولوا بحذف كلمة والتقدير لها من عندهم وهو تحكّم . . . إلاّ أن البعض الآخر فسّر «إلاّ» بمعنى «لكن» وأنّها تفيد الإستدراك ، وهذا الوجه أقرب للنظر ! . . .
7 ـ وردت روايات متعددة في تفسير «نور الثّقلين» في ذيل الآيات فسّرت بعضها الوجه بدين الله ، وبعضها برسل الله وما هو منسوب لله .
 الاكثر قراءة في سورة القصص
الاكثر قراءة في سورة القصص
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)