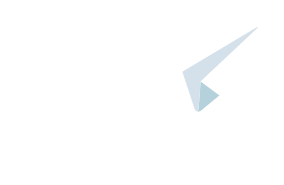تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير الآية (20-28) من سورة لقمان
المؤلف:
إعداد : المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
.....
11-8-2020
6624
قال تعالى : {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (20) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَو كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (21) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُومُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (22) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ (24) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26) وَلَوأَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} [لقمان : 20 - 28]
تفسير مجمع البيان
- ذكر الطبرسي في تفسير هذه الآيات (1)
ذكر سبحانه نعمه على خلقه ونبههم على معرفتها فقال {أ لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات} من الشمس والقمر والنجوم {وما في الأرض} من الحيوان والنبات وغير ذلك مما تنتفعون به وتتصرفون فيه بحسب ما تريدون {وأسبغ عليكم} أي أوسع عليكم وأتم عليكم نعمه {ظاهرة وباطنة} فالظاهرة ما لا يمكنكم جحده من خلقكم وإحيائكم وأقداركم وخلق الشهوة فيكم وغيرها من ضروب النعم والباطنة ما لا يعرفها إلا من أمعن النظر فيها وقيل الباطنة مصالح الدين والدنيا مما يعلمه الله وغاب عن العباد علمه عن ابن عباس وفي رواية الضحاك عنه قال سألت النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) عنه فقال : ((يا ابن عباس أما ما ظهر فالإسلام وما سوى الله من خلقك وما أفاض عليك من الرزق وأما ما بطن فستر مساوىء عملك ولم يفضحك به يا ابن عباس إن الله تعالى يقول ثلاثة جعلتهن للمؤمن ولم تكن له صلاة المؤمنين عليه من بعد انقطاع عمله وجعلت له ثلث ماله أكفر به عنه خطاياه والثالث سترت مساوىء عمله ولم أفضحه بشيء منه ولو أبديتها عليه لنبذه أهله فمن سواهم)) .
وقيل : الظاهرة تخفيف الشرائع والباطنة الشفاعة عن عطا وقيل الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم الآخرة وقيل الظاهرة نعم الجوارح والباطنة نعم القلب عن الربيع وقيل الظاهرة ظهور الإسلام والنصر على الأعداء والباطنة الأمداد بالملائكة عن مجاهد وقيل الظاهرة حسن الصورة وامتداد القامة وتسوية الأعضاء والباطنة المعرفة عن الضحاك وقيل الظاهرة القرآن والباطنة تأويله ومعانيه وقال الباقر (عليه السلام) النعمة الظاهرة النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) وما جاء به النبي من معرفة الله عز وجل وتوحيده وأما النعمة الباطنة ولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا ولا تنافي بين هذه الأقوال وكلها نعم الله تعالى ويجوز حمل الآية على الجميع {ومن الناس من يجادل} أي يخاصم {في الله بغير علم} بما يقوله {ولا هدى} أي ولا دلالة وحجة {ولا كتاب منير} أي ولا كتاب من عند الله ظاهر واضح وقد مضى هذا مفسرا في سورة الحج .
ولما أخبر سبحانه عمن جادل في الله بغير علم ولم يذكر النعمة زاد عقيبه في ذمهم فقال {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله} على محمد (صلى الله عليه وآله وسلّم) من القرآن وشرائع الإسلام {قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا} ذمهم على التقليد ثم قال منكرا عليهم {أ ولوكان الشيطان يدعوهم} إلى تقليد آبائهم واتباع ما يدعوهم {إلى عذاب السعير} أدخل على واو العطف همزة الاستفهام على وجه الإنكار وجواب لو محذوف تقديره أ ولوكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير لاتبعوهم والمعنى أن الشيطان يدعوهم إلى تقليد آبائهم وترك اتباع ما جاءت به الرسل وذلك موجب لهم عذاب النار فهو في الحقيقة يدعوهم إلى النار .
ثم قال {ومن يسلم وجهه إلى الله} أي ومن يخلص دينه لله ويقصد في أفعاله التقرب إليه {وهو محسن} فيها فيفعلها على موجب العلم ومقتضى الشرع وقيل إن إسلام الوجه إلى الله تعالى هو الانقياد لله تعالى في أوامره ونواهيه وذلك يتضمن العلم والعمل {فقد استمسك بالعروة الوثقي} أي فقد تعلق بالعروة الوثيقة التي لا يخشى انفصامها والوثقي تأنيث الأوثق {وإلى الله عاقبة الأمور} أي وعند الله ثواب ما صنع عن مجاهد والمعنى وإلى الله ترجع أواخر الأمور على وجه لا يكون لأحد التصرف فيها بالأمر والنهي .
{ومن كفر} من هؤلاء الناس {فلا يحزنك} يا محمد {كفره} أي لا يغمك ذلك {إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا} أي نخبرهم بأعمالهم ونجازيهم بسوء أفعالهم {إن الله عليم بذات الصدور} أي بما تضمره الصدور لا يخفى عليه شيء منه {نمتعهم قليلا} أي نعطيهم من متاع الدنيا ونعيمها ما يتمتعون به مدة قليلة {ثم نضطرهم} في الآخرة {إلى عذاب غليظ} أي ثم نصيرهم مكرهين إلى عذاب يغلظ عليهم ويصعب {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن} في جواب ذلك {الله} خلقهما {قل} يا محمد أو أيها السامع {الحمد لله} على هدايته لنا وتوفيقه إيانا لمعرفته وقيل معناه اشكر الله على دين يقر لك خصمك بصحته لوضوح دلالته عن الجبائي {بل أكثرهم لا يعلمون} ما عليهم من الحجة .
ثم أكد سبحانه ما تقدم من خلقه السماوات والأرض بقوله {لله ما في السماوات والأرض} أي له جميع ذلك خلقا وملكا يتصرف فيه كما يريده ليس لأحد الاعتراض عليه في ذلك {إن الله هو الغني} عن حمد الحامدين وعن كل شيء {الحميد} أي المستحق للحمد والتعظيم {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} أي لوكان شجر الأرض أقلاما وكان البحر مدادا ويمده سبعة أبحر مثله أي تزيده بمائها فكتب بتلك الأقلام والبحور لتكسرت تلك الأقلام ونفذ ماء البحور وما نفذت كلمات الله وقد ذكرنا تفسير كلمات الله في سورة الكهف والأولى أن يكون عبارة عن مقدوراته ومعلوماته لأنها إذا كانت لا تتناهى فكذلك الكلمات التي تقع عبارة عنها لا تتناهى .
{إن الله عزيز} في اقتداره على جميع ذلك {حكيم} يفعل من ذلك ما يليق بحكمته ثم قال {ما خلقكم ولا بعثكم} يا معشر الخلائق {إلا كنفس واحدة} أي كخلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة في قدرته فإنه لا يشق عليه ابتداء جميع الخلق ولا إعادتهم بعد إفنائهم قال مقاتل إن كفار قريش قالوا إن الله خلقنا أطوارا نطفة علقة مضغة لحما فكيف يبعثنا خلقا جديدا في ساعة واحدة فنزلت الآية {إن الله سميع} يسمع ما يقول القائلون في ذلك {بصير} بما يضمرونه .
_________________
1- مجمع البيان ، الطبرسي ، ج 8 ، ص88-92 .
تفسير الكاشف
- ذكر محمد جواد مغنية في تفسير هذه الآيات (1)
{أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهً سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وما فِي الأَرْضِ وأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وباطِنَةً} . ان نعم اللَّه كما وصفها سبحانه بقوله : وإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوها - 34 إبراهيم ج 4 ص 448 . ومن يحصي ويحيط بما في السماوات والأرض غير خالق السماوات والأرض ؟ ومثّل المفسرون للنعم الظاهرة بما تدركه الحواس ، وللباطنة بقوى النفس وغرائزها . وقال الملا صدرا في المجلد الثالث من أسفاره :
{ان أفاضل البشر عاجزون عن إدراك الأمور السماوية والأرضية على وجهها ، وعن الإحاطة بما فيها من الحكمة والعناية ، بل الأكثرون لا يعرفون حقيقة النفس التي هي ذات الشخص وتفاصيل أحوالها ، وما خفي على ذوي الاختصاص أكثر مما ظهر لهم ، وإذا كانت إحاطة الإنسان بنفسه وبدنه متعذرة فكيف يحيط بالعالم الجسماني والروحاني ، وما لنا مع هذا العجز إلا أن نتأمل ونتفكر في عجائب الخلقة وبدائع الفطرة} .
{ومِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ولا هُدىً ولا كِتابٍ مُنِيرٍ} . جمعت هذه الآية على إيجازها بين أسباب المعرفة الثلاثة : الأول الحس والتجربة ، وإليه الإشارة بالعلم ، والثاني العقل ، وهو المراد من الهدى ، والثالث الوحي الذي عبر عنه ، جلت عظمته ، بالكتاب المنير . وتقدمت هذه الآية بنصها الحرفي في سورة الحج الآية 3 و8 {وإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَو لَوكانَ الشَّيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ} . تقدم في الآية 170 من سورة البقرة ج 1 ص 259 .
من هو المستمسك بالعروة الوثقى ؟
{ومَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى وإِلَى اللَّهِ عاقِبَةُ الأُمُورِ} . العروة الوثقى الطرف القوي الذي لا ينقطع ، وهو كناية عن القرآن وعن حبل اللَّه ومرضاته ، وما إلى ذلك مما يكون معه الإنسان آمنا من عذاب اللَّه وغضبه . . وكل من اجتمع له وصفان فقد أخذ بهذا الطرف القوي الأمين : الأول أن يؤمن باللَّه ، ويفعل ما أمره به من العبادة كالصوم والصلاة ، ويترك ما نهاه عنه كالزنا والكذب والخمر . الثاني : أن يكون محسنا ، والمحسن هو الذي يتعدى إحسانه إلى الآخرين ، ولا يقف عند الإحسان لنفسه وذويه ، فيشارك الناس في آلامهم ، ويعمل لخلاص المظلومين والمحرومين ، ومن أجل الحق والعدل أينما كان ويكون ، وبالإيجاز ان المحسن تماما كالماء الطهور طاهر بنفسه ، مطهر لغيره .
وبهذا يتبين معنا ان الآمنين من غضب اللَّه وعذابه هم المؤمنون المحسنون ، أما من آمن باللَّه وتعبد له ولم يحسن إلى الآخرين بالتعاون معهم على ما فيه خير الجميع ، أو أحسن ولم يؤمن باللَّه ، أما هذا وذاك فلا أمان لهما من عذاب اللَّه وغضبه لأنهما لم يستمسكا بالعروة الوثقى . . وفي ذلك كثير من الأحاديث منها :
{من لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم . . لا يصدق ايمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . . أحب الناس إلى اللَّه أنفعهم للناس} . وكفى بقول الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم) : {اني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق} وقوله : {أنا رحمة مهداة} كفى بهذا شاهدا على أن رسالة الإسلام هي رسالة الإنسانية . . ومن خلالها حدد بعض العارفين المسلم بأنه {إنسان ممتد بمنافعه في معناه الاجتماعي حول أمته كلها لا إنسان ضيق حول نفسه بهذه المنافع} .
{ومَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا إِنَّ اللَّهً عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ} . علام تحزن وتتألم يا محمد لكفر من كفر ، وقد بلَّغت وأنذرت وأديت الرسالة كاملة ؟ فدع المجرمين ودنياهم ، فنحن أعلم بهم ، إلينا مصيرهم وعلينا حسابهم {نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ} ما هي إلا أيام يلعبون بها وتلعب بهم ، ثم يحيط بهم العذاب الشديد من حيث لا يشعرون .
وتقدم في مثله أكثر من آية ، منها الآية 176 من سورة آل عمران ج 2 ص 209 .
{ولَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ والأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ} . تقدم مثله في الآية 84 من سورة المؤمنون ج 5 ص 383 والآية 61 من سورة العنكبوت {لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ والأَرْضِ إِنَّ اللَّهً هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} له وحده الملك والحمد ، ولا غني إلا من استغنى به .
{ولَو أَنَّ ما فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ والْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نَفِدَتْ كَلِماتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهً عَزِيزٌ حَكِيمٌ} . سبعة أبحر كناية عن الكثرة ، والمراد بكلمات اللَّه قدرته تعالى على إيجاد الكائنات متى شاء ، والمعنى لو فرض ان البحر مداد ، والأشجار أقلام تكتب قدرة اللَّه على إيجاد ما يشاء لانتهت البحار والأقلام وبقيت قدرة اللَّه إلى ما لا نهاية . . وبكلمة ان الحد لقدرة اللَّه ان لا حد لها .
وتقدم مثله في الآية 110 من سورة الكهف ج 5 ص 166 .
وقال ابن عربي في المجلد الرابع من الفتوحات المكية : (البحار والأقلام من جملة الكلمات ، فلو كانت البحار مدادا ما انكتب بها سوى عينها ، وبقيت الأقلام والكلمات الحاصلة في الوجود ما لها ما تكتب به مع تناهيها بدخولها في الوجود ، فكيف بما لم يحصره الوجود من شخصيات الممكنات) . يريد لو كانت البحار حبرا ، وأردنا أن نكتب عن العجائب والأسرار التي أودعها اللَّه في البحار فقط لنفدت البحار بنفاد الكتابة عن عجائبها وأسرارها ، وإذا نفد الحبر بنفاد البحار تعطلت الأقلام عن الكتابة ، وعليه تظل بقية الكائنات الموجودة بلا كتابة عنها . . هذا بالنسبة إلى ما هو موجود بالفعل ، فكيف بما يدخل تحت قدرة اللَّه من الكائنات التي يوجدها بكلمة {كن} متى يشاء ؟
{ما خَلْقُكُمْ ولا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ واحِدَةٍ إِنَّ اللَّهً سَمِيعٌ بَصِيرٌ} . كل قادر غير اللَّه يقدر على شيء ، ويعجز عن أشياء ، والشيء الذي يقدر عليه منه ما لا يحتاج إلى جهد ، ومنه ما يحتاج إلى جهد يسير ، ومنه ما يحتاج إلى جهد كثير . .
واللَّه قادر على كل شيء ، ويتساوى عند قدرته الخطير والحقير ، وعليه يكون خلق الناس جميعا تماما كخلق واحد منهم ، وكذلك بعثهم للحساب والجزاء .
قال الإمام علي (عليه السلام) : (لا شيء إلا الواحد القهار الذي إليه مصير جميع الأمور بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها ، وبغير امتناع منها كان فناؤها ، ولو قدرت على الامتناع دام بقاؤها ، لم يتكاءده - أي لم يشق عليه - صنع شيء منها إذ صنعه ، ولم يؤده - أي لم يثقله - منها خلق ما خلقه وبرأه) .
_______________________
1- تفسير الكاشف ، محمد جواد مغنية ، ج6 ، ص ١٦٥-168 .
تفسير الميزان
- ذكر الطباطبائي في تفسير هذه الآيات (1)
رجوع إلى ما قبل القصة من آيات الوحدانية ونفي الشريك وأدلتها المنتهية إلى قوله : {هذا خلق الله فأروني ما ذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين} .
قوله تعالى : {أ لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة} رجوع إلى ما قبل قصة لقمان وهو الدليل على أن الخطاب للمشركين وإن كان ذيل الآية يشعر بعموم الخطاب .
وعليه فصدر الآية من تتمة كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ويتصل بقوله : {هذا خلق الله فأروني ما ذا خلق الذين من دونه} ولا التفات في قوله : {أ لم تروا} .
وعلى تقدير كونه من كلامه تعالى ففي قوله : {أ لم تروا} التفات من سياق الغيبة الذي في قوله : {بل الظالمون في ضلال مبين} إلى الخطاب ، والالتفات في مثل هذه الموارد يكون لاشتداد وجد المتكلم وتأكد غيظه من جهل المخاطبين وتماديهم في غيهم بحيث لا ينفعهم دلالة ولا ينجح فيهم إشارة فيواجهون بذكر ما هو بمرأى منهم ومسمع لعلهم يتنبهوا عن نومتهم وينتزعوا عن غفلتهم .
وكيف كان فالمراد بتسخير السماوات والأرض للإنسان وهم يرون ذلك ما نشاهده من ارتباط أجزاء الكون بعضها ببعض في نظام عام يدبر أمر العالم عامة والإنسان خاصة لكونه أشرف أجزاء هذا العالم المحسوس بما فيه من الشعور والإرادة فقد سخر الله الكون لأجله .
والتسخير قهر الفاعل في فعله بحيث يفعله على ما يستدعيه القاهر ويريده كتسخير الكاتب القلم للكتابة وكما يسخر المولى عبده والمخدوم خادمه في أن يفعل باختياره وإرادته ما يختاره ويريده المولى والمخدوم والأسباب الكونية كائنة ما كانت تفعل بسببيتها الخاصة ما يريده الله من نظام يدبر به العالم الإنساني .
ومما مر يظهر أن اللام في {لكم} للتعليل الغائي والمعنى لأجلكم والمسخر بالكسر هو الله تعالى دون الإنسان ، وربما احتمل كون اللام للملك والمسخر بالكسر هو الإنسان بمشية من الله تعالى كما يشاهد من تقدم الإنسان بمرور الزمان في تسخير أجزاء الكون واستخدامه لها في سبيل مقاصده لكن لا يلائمه تصدير الكلام بقوله : {أ لم تروا} .
وقوله : {وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة} الإسباغ الإتمام والإيساع أي أتم وأوسع عليكم نعمه ، والنعم جمع نعمة وهوفي الأصل بناء النوع وغلب عليه استعماله في ما يلائم الإنسان فيستلذ منه ، والمراد بالنعم الظاهرة والباطنة بناء على كون الخطاب للمشركين النعم الظاهرة للحس كالسمع والبصر وسائر الجوارح والصحة والعافية والطيبات من الرزق والنعم الغائبة عن الحس كالشعور والإرادة والعقل .
وبناء على عموم الخطاب لجميع الناس الظاهرة من النعم هي ما ظهر للحس كما تقدم وكالدين الذي به ينتظم أمور دنياهم وآخرتهم والباطنة منها كما تقدم وكالمقامات المعنوية التي تنال بإخلاص العمل .
وقوله : {ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير} رجوع الخطاب إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما كان في السياق السابق ، والمجادلة المخاصمة النظرية بطريق المغالبة ، والمقابلة بين العلم والهدى والكتاب تلوح بأن المراد بالعلم ما هو مكتسب من حجة عقلية ، وبالهدى ما يفيضه الله بالوحي أو الإلهام ، وبالكتاب الكتاب السماوي المنتهي إليه تعالى بالوحي النبوي ولذلك وصفه بالمنير فهذه طرق ثلاث من العلم لا رابع لها .
فمعنى قوله : يجادل في الله بغير كذا وكذا أنه يجادل في وحدانيته تعالى في الربوبية والألوهية بغير حجة يصح الركون إليها بل عن تقليد .
قوله تعالى : {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا} إلخ ، ضمائر الجمع راجعة إلى {من} باعتبار المعنى كما أن ضمير الإفراد في الآية السابقة راجع إليه باعتبار اللفظ .
وقوله : {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله} في التعبير بما أنزل الله من غير أن يقال : اتبعوا الكتاب أو القرآن إشارة إلى كون الدعوة دعوة ذات حجة لا تحكم فيها لأن نزول الكتاب مؤيد بحجة النبوة فكأنه قيل : وإذا دعوا إلى دين التوحيد الذي يدل عليه الكتاب المقطوع بنزوله من عند الله سبحانه ، وبعبارة أخرى إذا ألقى إليهم القول مع الحجة قابلوه بالتحكم من غير حجة فقالوا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا .
وقوله : {أ ولوكان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير} أي أ يتبعون آباءهم ولوكان الشيطان يدعوهم بهذا الاتباع إلى عذاب السعير؟ فالاستفهام للإنكار ولو وصلية معطوفة على محذوف مثلها والتقدير أ يتبعونهم لولم يدعهم الشيطان ولو دعاهم .
ومحصل الكلام : أن الاتباع إنما يحسن إذا كانوا على الحق وأما لو كانوا على الباطل وكان اتباعا يدعوهم به إلى الشقاء وعذاب السعير وهو كذلك فإنه اتباع في عبادة غير الله ولا معبود غيره .
قوله تعالى : {ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور} استئناف ويحتمل أن يكون حالا من مفعول {يدعوهم} وفي معنى الجملة الحالية ضمير عائد إليهم ، والمعنى : أولو كان الشيطان يدعوهم إلى كذا والحال أن من أسلم وجهه إلى الله كذا فقد نجا وأفلح والحال أن عاقبة الأمور ترجع إلى الله فيجب أن يكون هو المعبود .
وإسلام الوجه إلى الله تسليمه له وهو إقبال الإنسان بكليته عليه بالعبادة وإعراضه عمن سواه .
والإحسان الإتيان بالأعمال الصالحة عن إيقان بالآخرة كما فسره به في أول السورة {هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون} والعروة الوثقى المستمسك الذي لا انفصام له .
والمعنى : ومن وحد الله وعمل صالحا مع اليقين بالمعاد فهو ناج غير هالك البتة في عاقبة أمره لأنها إلى الله وهو الذي يعده بالنجاة والفلاح .
ومن هنا يظهر أن قوله : {وإلى الله عاقبة الأمور} في مقام التعليل لقوله : {فقد استمسك بالعروة الوثقى} بما أنه استعارة تمثيلية عن النجاة والفلاح .
قوله تعالى : {ومن كفر فلا يحزنك كفره - إلى قوله - إلى عذاب غليظ} تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وتطييب لنفسه أن لا يغلبه الحزن وهم بالآخرة راجعون إليه تعالى فينبؤهم بما عملوا أي يظهر لهم حقيقة أعمالهم وتبعاتها وهي النار .
وقوله : {نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ} كشف عن حقيقة حالهم ببيان آخر فإن البيان السابق {إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا} ربما أوهم أنهم ما داموا متنعمين في الدنيا خارجون من قدرة الله ثم إذا ماتوا أو بعثوا دخلوا فيما خرجوا منه فانتقم منهم بالعذاب جيء بهذا البيان للدلالة على أنهم غير خارجين من التدبير قط وإنما يمتعهم في الدنيا قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ فهم مغلوبون مقهورون على كل حال وأمرهم إلى الله دائما لن يعجزوا الله في حال التنعم ولا غيرها .
قوله تعالى : {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون} إشارة إلى أنهم مفطورون على التوحيد معترفون به من حيث لا يشعرون ، فإنهم إن سئلوا عمن خلق السماوات والأرض اعترفوا بأنه الله عز اسمه وإذا كان الخالق هو هو فالمدبر لها هو هو لأن التدبير لا ينفك عن الخلق ، وإذا كان مدبر الأمر والمنعم الذي يبسط ويقبض ويرجى ويخاف هو فالمعبود هو هو وحده لا شريك له فقد اعترفوا بالوحدة من حيث لا يعلمون .
ولذلك أمره (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحمد الله على اعترافهم من حيث لا يشعرون فقال : {قل الحمد لله} ثم أشار إلى أن كون أكثرهم لا يعلمون معنى اعترافهم أن الله هو الخالق وما يستلزمه فقال : {بل أكثرهم لا يعلمون} نعم قليل منهم يعلمون ذلك ولكنهم لا يطاوعون الحق بل يجحدونه وقد أيقنوا به كما قال تعالى : {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ } [النمل : 14] .
قوله تعالى : {لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد} لما كان اعترافهم بأن الخالق هو الله سبحانه إنما يثبت التوحد بالربوبية والألوهية إذا كان التدبير والتصرف إليه تعالى وكان نفس الخلق كافيا في استلزامه اكتفى به في تمام الحجة واستحمد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واستجهل القوم لغفلتهم .
ثم احتج عليه ثانيا من طريق انحصار الملك الحقيقي فيه تعالى لكونه غنيا محمودا مطلقا وتقريره أنه تعالى مبدىء كل خلق ومعطي كل كمال فهو واجد لكل ما يحتاج إليه الأشياء فهو غني على الإطلاق إذ لولم يكن غنيا من جهة من الجهات لم يكن مبدئا له معطيا لكماله هذا خلف ، وإذا كان غنيا على الإطلاق كان له ما في السماوات والأرض فهو المالك لكل شيء على الإطلاق فله أن يتصرف فيها كيف شاء فكل تدبير وتصرف يقع في العالم فهوله إذ لوكان شيء من التدبير لغيره لا له كان مالكه ذلك الغير دونه وإذا كان التدبير والتصرف له تعالى فهورب العالمين والإله الذي يعبد ويشكر إنعامه وإحسانه .
وهذا هو الذي يشير إليه قوله : {لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني} فقوله : {لله ما في} إلخ ، حجة على وحدانيته وقوله : {إن الله هو الغني} تعليل للملك .
وأما قوله : {الحميد} أي المحمود في أفعاله فهو مبدأ آخر للحجة وذلك أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري وكل جميل في العالم فهوله سبحانه فإليه يعود الثناء فيه فهو حميد على الإطلاق ولوكان شيء من هذا التدبير المتقن الجميل من غيره تعالى من غير انتساب إليه لكان الحمد والثناء لغيره تعالى لا له فلا يكون حميدا على الإطلاق وبالنسبة إلى كل شيء وقد فرض أنه حميد على الإطلاق هذا خلف .
قوله تعالى : {ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} إلخ ، {من شجرة} بيان للموصول والشجرة واحد الشجر وتفيد في المقام - وهي في سياق {لو} الاستغراق أي كل شجرة في الأرض ، والمراد بالبحر مطلق البحر ، وقوله : {يمده من بعده سبعة أبحر} أي يعينه بالانضياف إليه سبعة أمثاله والظاهر أن المراد بالسبعة التكثير دون خصوص هذا العدد والكلمة هي اللفظ الدال على معنى ، وقد أطلق في كلامه تعالى على الوجود المفاض بأمره تعالى ، وقد قال : {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ } [يس : 82] ، وقد أطلق على المسيح (عليه السلام) الكلمة في قوله : {وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ} [النساء : 171] .
فالمعنى : ولو جعل أشجار الأرض أقلاما وأخذ البحر وأضيف إليه سبعة أمثاله وجعل المجموع مدادا فكتب كلمات الله - بتبديلها ألفاظا دالة عليها - بتلك الأقلام من ذلك المداد لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله لكونها غير متناهية .
ومن هنا يظهر أن في الكلام إيجازا بالحذف وأن قوله : {إن الله عزيز حكيم} في مقام التعليل ، والمعنى : لأنه تعالى عزيز لا يعزه ولا يقهره شيء فهذه الكتابة لا ينفد بها ما هومن عنده حكيم لا يفوض التدبير إلى غيره .
والآية متصلة بما قبلها من حيث دلالته على كون تدبير الخلق له سبحانه لا لغيره فسيقت هذه الآية للدلالة على سعة تدبيره وكثرة أوامره التكوينية في الخلق والتدبير إلى حيث ينفد البحر الممدود بسبعة أمثاله لو جعل مدادا وكتبت به أشجار الأرض المجعولة أقلاما قبل أن ينفد أوامره وكلماته .
قوله تعالى : {ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير} سوق للكلام إلى إمكان الحشر وخاصة من جهة استبعادهم المعاد لكثرة عدد الموتى واختلاطهم بالأرض من غير تميز بعضهم من بعض .
فقال تعالى : {ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة} في الإمكان والتأتي فإنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يعجزه كثرة ولا يتفاوت بالنسبة إليه الواحد والجمع ، وذكر الخلق مع البعث للدلالة على عدم الفرق بين البدء والعود من حيث السهولة والصعوبة بل لا يتصف فعله بالسهولة والصعوبة .
ويشهد لما ذكر إضافة الخلق والبعث إلى ضمير الجمع المخاطب والمراد به الناس ثم تنظيره بالنفس الواحدة ، والمعنى : ليس خلقكم معاشر الناس على كثرتكم ولا بعثكم إلا كخلق نفس واحدة وبعثها فأنتم على كثرتكم والنفس الواحدة سواء لأنه لو أشكل عليه بعث الجميع على كثرتهم والبعث لجزاء الأعمال فإنما يشكل من جهة الجهل بمختلف أعمالكم على كثرتها واختلاط بعضها ببعض لكنه ليس يجهل شيئا منها لأنه سميع لأقوالكم بصير بأعمالكم وبعبارة أخرى عليم بأعمالكم من طريق المشاهدة .
وبما مر يندفع الاعتراض على الآية بأن المناسب لتعليل كون خلق الكثير وبعثهم كنفس واحدة أن يعلل بمثل قولنا : إن الله على كل شيء قدير أو قوي عزيز أو ما يشبه ذلك لا بمثل السميع البصير الذي لا ارتباط له بالخلق والبعث .
وذلك أن الإشكال الذي تعرضت الآية لدفعه هو أن البعث لجزاء الأعمال وهي على كثرتها واندماج بعضها في بعض كيف تتميز حتى تجزى عليها فالإشكال متوجه إلى ما ذكره قبل ثلاث آيات بقوله : {فننبئهم بما عملوا} وقد أجيب بأنه كيف يخفى عليه شيء من الأقوال والأعمال وهو سميع بصير لا يشذ عن مشاهدته قول ولا فعل .
وقد كان ذيل قوله السابق : {فننبئهم بما عملوا} بقوله : {إن الله عليم بذات الصدور} وهو مبني على أن الجزاء على حسب ما يحمله القلب من الحسنة والسيئة كما يشير إليه قوله : {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة : 284] ، وجواب عن هذا الإشكال لو وجه إلى ما تحمله القلوب على كثرته فيجاب عنه أن الله عليم بذات الصدور ولو وجه إلى نفس الأعمال الخارجية من الأقوال والأفعال فالجواب عنه بما في هذه الآية التي نحن فيها : {إن الله سميع بصير} ، فالإشكال والجواب بوجه نظير ما وقع في قوله تعالى : { قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى (51) قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى } [طه : 52] ، فافهم .
وقد أجابوا عن الاعتراض بأجوبة أخرى غير تامة من أراد الوقوف عليها فليراجع المطولات .
________________
1- الميزان ، الطباطبائي ، ج16 ، ص184-188 .
تفسير الامثل
- ذكر الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في تفسير هذه الآيات (1)
بعد إنتهاء مواعظ لقمان العشر حول المبدأ والمعاد وطريقة الحياة ، وخطط وبرامج القرآن الأخلاقية والإجتماعية ، ولأجل إكمال البحث ، تتّجه الآيات إلى بيان نعم الله تعالى لتبعث في الناس حسن الشكر . . الشكر الذي يكون منبعاً لمعرفة الله وطاعة أوامره (2) ، فيوجّه الخطاب لكلّ البشر ، فيقول : {ألم تروا أنّ الله سخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض} .
إنّ لتسخير الموجودات السماوية والأرضيّة للإنسان معنى واسعاً يشمل الاُمور التي في قبضته وإختياره ، ويستخدمها برغبته وإرادته في طريق تحصيل منافعه ككثير من الموجودات الأرضيّة ، كما تشمل الاُمور التي ليست تحت تصرّفه وإختياره ، لكنّها تخدم الإنسان بأمر الله جلّ وعلا كالشمس والقمر . وبناءً على هذا فإنّ كلّ الموجودات مسخّرة بإذن الله لنفع البشر ، سواءً كانت مسخّرة بأمر الإنسان أم لا ، وعلى هذا فإنّ اللام في (لكم) لام المنفعة (3) .
ثمّ تضيف الآية : {وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة} .
«أسبغ» من مادّة (سَبغ) وهي في الأصل بمعنى الثوب أو الدرع العريض الكامل ، ثمّ اُطلق على النعم الكثيرة الوفيرة أيضاً .
هناك إختلاف بين المفسّرين في المراد من النعم الظاهرة والباطنة في هذه الآية . .
فالبعض إعتقد أنّ النعمة الظاهرة هي الشيء الذي لا يمكن لأيّ أحد إنكاره كالخلق والحياة وأنواع الأرزاق ، والنعم الباطنة إشارة إلى الاُمور التي لا يمكن إدراكها من دون دقّة ومطالعة ككثير من القوى الروحية والغرائز المهمّة .
والبعض عدّ الأعضاء الظاهرة هي النعم الظاهرة ، والقلب هو النعمة الباطنة .
والبعض الآخر إعتبر حسن الصورة والوجه والقامة المستقيمة وسلامة الأعضاء النعمة الظاهرة ، ومعرفة الله هي النعمة الباطنة .
وفي حديث عن الرّسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) أنّ ابن عبّاس سأله عن النعم الظاهرة والباطنة فقال (صلى الله عليه وآله) : «يابن عبّاس ، أمّا ما ظهر فالإسلام وما سوّى الله من خلقك ، وما أفاض عليك من الرزق ، وأمّا ما بطن فستر مساويء عملك ولم يفضحك به» (4) .
وفي حديث آخر عن الباقر (عليه السلام) : «النعمة الظاهرة : النّبي (صلى الله عليه وآله) وما جاء به النّبي من معرفة الله ، وأمّا النعمة الباطنة ولايتنا أهل البيت وعقد مودّتنا» (5) .
إلاّ أنّه لا توجد أيّة منافاة بين هذه التفاسير في الحقيقة ، وكلّ منها يبيّن مصداقاً بارزاً للنعمة الظاهرة والنعمة الباطنة دون أن يحدّد معناها الواسع .
وتتحدّث الآية في النهاية عمّن يكفر بالنعم الإلهية الكبيرة العظيمة ، والتي تحيط الإنسان من كلّ جانب ، ويهبّ إلى الجدال ومحاربة الحقّ ، فتقول : {من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدىً ولا كتاب منير} وبدل أن يعرف ويقدّر هبة وعطاء كلّ هذه النعم الظاهرة والباطنة ، فإنّه يتّجه إلى الشرك والجحود نتيجة الجهل .
ولكن ما هو الفرق بين «العلم» و «الهدى» و «الكتاب المنير»؟
لعلّ أفضل ما يمكن أن يقال في ذلك هو أنّ «العلم» : إشارة إلى الإدراكات التي يدركها الإنسان عن طريق عقله ، و «الهدى» : إشارة إلى المعلّمين والقادة الربّانيين والسماويين ، والعلماء الذين يأخذون بيده في هذا المسير ويوصلونه إلى الغاية والهدف ، والمراد من «الكتاب المنير» : الكتب السماوية التي تملأ قلب الإنسان نوراً عن طريق الوحي .
إنّ هذه الجماعة العنيدة في الحقيقة لا يمتلكون علماً ، ولا يتّبعون مرشداً وهادياً ، ولا يستلهمون من الوحي الإلهي ، ولمّا كانت طرق الهداية منحصرة بهذه الاُمور الثلاثة فإنّ هؤلاء لمّا تركوها سقطوا في هاوية الضلال والضياع ووادي الشياطين .
وتشير الآية التالية إلى المنطق الضعيف السقيم لهذه الفئة ، فتقول : {وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا} ولمّا لم يكن اتّباع الآباء الجهلة المنحرفين جزءاً من أيّ واحد من الطرق الثلاثة المذكورة أعلاه للهداية ، فإنّ القرآن ذكره بعنوان الطريق الشيطاني ، وقال : {أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير} (6) .
إنّ القرآن ـ في الحقيقة ـ يزيح هنا الغطاء عن اتّباع سنّة الآباء والأجداد الزائفة ، ويبيّن الوجه الحقيقي لعمل هؤلاء والذي هو في حقيقته اتّباع الشيطان في مسير جهنّم .
أجل ، إنّ قيادة الشيطان بذاتها تستوجب أن يخالفها الإنسان وإن كانت مبطّنة بالدعوة إلى الحقّ ، فمن المسلّم أنّه غطاء وخدعة ، والدعوة إلى النار كافية لوحدها أيضاً للمخالفة بالرغم من أنّ الداعي مجهول الحال ، فإذا كان الداعي الشيطان ، ودعوته إلى نار جهنّم المستعرة ، فالأمر واضح .
هل يوجد عاقل يترك دعوة أنبياء الله إلى الجنّة ، ويلهث وراء دعوة الشيطان إلى جهنّم؟!
ثمّ تطرّقت الآية التالية إلى بيان حال مجموعتين : المؤمنين الخلّص ، والكفّار الملّوثين ، وتجعلهم مورد إهتمامها في المقارنة بينهم ، فقالت : {ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد إستمسك بالعروة الوثقى} .
والمراد من تسليم الوجه إلى الله سبحانه ، هو التوجّه الكامل وبكلّ الوجود إلى ذات الله المقدّسة ، لأنّ الوجه لمّا كان أشرف عضو في البدن ، ومركزاً لأهمّ الحواسّ الإنسانية ، فإنّه يستعمل كناية عن ذاته .
والتعبير بـ (وهو محسن) من قبيل ذكر العمل الصالح بعد الإيمان .
والإستمساك بالعروة الوثقى تشبيه لطيف لهذه الحقيقة ، وهي أنّ الإنسان يحتاج لنجاته من منحدر الماديّة والإرتقاء إلى أعلى قمم المعرفة والمعنويات وتسامي الروح ، إلى واسطة ووسيلة محكمة مستقرّة ثابتة ، وليست هذه الوسيلة إلاّ الإيمان والعمل الصالح ، وكلّ سبيل ومتّكأ غيرهما متهرّيء متخرّق هاو وسبب للسقوط والموت ، إضافة إلى أنّ ما يبقى هو هذه الوسيلة ، وكلّ ما عداها فان ، ولذلك فإنّ الآية تقول في النهاية : {وإلى الله عاقبة الاُمور} .
جاء في حديث نقل في تفسير البرهان عن طرق العامّة عن الإمام علي بن موسى الرضا(عليهما السلام) عن النّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) : «وسيكون بعدي فتنة مظلمة ، الناجي منها من تمسّك بالعروة الوثقى ، فقيل : يا رسول الله ، وما العروة الوثقى؟ قال : ولاية سيّد الوصيّين ، قيل : يارسول الله ، ومن سيّد الوصيّين؟ قال : أمير المؤمنين ، قيل : يا رسول الله ومن أمير المؤمنين؟ قال : مولى المسلمين وإمامهم بعدي ، قيل : يا رسول الله ، ومن مولى المسلمين وإمامهم بعدك؟ قال : أخي علي بن أبي طالب» (7) .
وقد رويت روايات اُخرى في هذا الباب تؤيّد أنّ المراد من العروة الوثقى مودّة أهل البيت (عليهم السلام) ، أو حبّ آل محمّد (صلى الله عليه وآله) ، أو الأئمّة من ولد الحسين (عليهم السلام) (8) .
وقد قلنا مراراً : إنّ هذه التفاسير بيان للمصاديق الواضحة ، ولا تتنافى مع المصاديق الاُخرى كالتوحيد والتقوى وأمثال ذلك .
ثمّ تطرقت الآية التالية إلى بيان حال الفئة الثّانية ، فقالت : (ومن كفر فلا يحزنك كفره) لأنّك قد أدّيت واجبك على أحسن وجه ، وهو الذي قد ظلم نفسه .
ومثل هذه التعبيرات التي وردت مراراً في القرآن ، تبيّن أنّ النّبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)كان يتألّم ويتعذّب كثيراً عندما يرى الجاهلين العنودين يتركون سبيل الله مع تلك الدلائل البيّنة والعلامات الواضحة ، ويسلكون سبيل الغيّ والضلال ، وكان يغتمّ إلى درجة أنّ الله تعالى كان يسلّي خاطره في عدّة مرّات ، وهذا دأب وحال المرشد والقائد الحريص المخلص .
فلا تحزن أن تكفر جماعة من الناس ، ويظلموا ويجوروا وهم متنعّمون بالنعم الإلهيّة ولا يعاقبون ، فلا عجلة في الأمر ، إذ : {إلينا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا} فإنّنا مطّلعون على أسرارهم ونيّاتهم كإطّلاعنا على أعمالهم ، فـ : {إنّ الله عليم بذات الصدور} .
إنّ تعبير : إنّ الله ينّبىء الناس في القيامة بأعمالهم ، أو أنّه تعالى ينبّئهم بما كانوا فيه يختلفون ، قد ورد في آيات كثيرة من القرآن المجيد ، وبملاحظة أنّ (ننبّئكم) من مادّة (نبأ) والنبأ ـ على ما أورده الراغب في مفرداته ـ يقال للخبر الذي ينطوي على محتوى وفائدة مهمّة ، وهو صريح وخال من كلّ أشكال الكذب ، سيتّضح أنّ هذه التعبيرات تشير إلى أنّ الله سبحانه يفشي ويفضح أعمال البشر بحيث لا يبقى لأحد أيّ إعتراض وإنكار ، فهو يظهر ما عمله الناس في هذه الدنيا ونسوه أو تناسوه ، ويهيّؤه للحساب والجزاء ، وحتّى ما يخطر في قلب الإنسان ولم يطّلع عليه إلاّ الله تعالى ، فإنّه سبحانه سيذكرهم بها .
ثمّ يضيف بأنّ تمتّع هؤلاء بالحياة لا ينبغي أن يثير عجبك ، لأنّا {نمتّعهم قليلا ثمّ نضطرهم إلى عذاب غليظ} ذلك العذاب الأليم المستمر .
إنّ هذا التعبير لعلّه إشارة إلى أنّ هؤلاء لا يتصوّروا أنّهم خارجون عن قبضة قدرة الله سبحانه ، بل إنّه يريد أن يمهل هؤلاء للفتنة وإتمام الحجّة والأهداف الاُخرى ، وإنّ هذا المتاع القليل من جانبه أيضاً ، وكم يختلف حال هؤلاء الذين يجرّون ويُسحبون بذلّة وإكراه إلى العذاب الإلهي الغليظ ، وحال اُولئك الذين وضعوا كلّ وجودهم في طريق العبودية لله سبحانه ، وإستمسكوا بالعروة الوثقى ، فهم يعيشون في هذه الدنيا طاهرين صالحين ، وفي الآخرة يتنعّمون بجوار رحمة الله .
وقوله تعالى : {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (25) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (26) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (27) مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ } [لقمان : 25 - 28]
عشر صفات لله سبحانه :
بيّنت الآيات الستّة أعلاه مجموعة من صفات الله سبحانه ، وهي عشر صفات رئيسيّة ، أو عشرة أسماء من الأسماء الحسنى :
الغني ، الحميد ، العزيز ، الحكيم ، السميع ، البصير ، الخبير ، الحقّ ، العليّ ، والكبير .
هذا من جهة ، ومن جهة اُخرى فإنّ الآية الاُولى تتحدّث عن «خالقية» الله ، والآية الثّانية عن «مالكيته» المطلقة ، والثالثة عن «علمه» اللامتناهي ، والآية الرّابعة والخامسة عن «قدته» اللامتناهية . والآية الأخيرة تخلص إلى هذه النتيجة ، وهي أنّ الذي يمتلك هذه الصفات ويتمتّع بها هو الله تعالى ، وكلّ ما دونه باطل أجوف حقير .
مع ملاحظة هذا البحث الإجمالي نعود إلى شرح الآيات ، فتقول الآية الاُولى : {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولنّ الله} .
هذا التعبير ـ والذي يلاحظ في آيات القرآن الاُخرى ، كالآية (61 ـ 63) من سورة العنكبوت ، والآية (38) من الزمر ، والآية (9) من الزخرف ـ يدلّ من جهة على أنّ المشركين لم يكونوا منكرين لتوحيد الخالق مطلقاً ، ولم يكونوا يستطيعون ادّعاء كون الأصنام خالقة ، إنّما كانوا معتقدين بالشرك في عبادة الأصنام وشفاعتها فقط . ومن جهة اُخرى يدلّ على كون التوحيد فطريّاً وأنّ هذا النور كامن في طينة وطبيعة كلّ البشر .
ثمّ تقول : إذا كان هؤلاء معترفين بتوحيد الخالق فـ {قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون} .
ثمّ تتطرّق إلى «مالكية» الله ، لأنّه بعد ثبوت كونه خالقاً لا حاجة إلى دليل على كونه مالكاً ، فتقول : (لله ما في السموات والأرض) . ومن البديهي أنّ الخالق والمالك يكون مدبّراً لأمر العالم أيضاً ، وبهذا تثبت أركان التوحيد الثلاثة ، وهي : «توحيد الخالقية» و «توحيد المالكية» و «توحيد الربوبية» . والذي يكون على هذا الحال فإنّه غنيّ عن كلّ شيء ، وأهل لكلّ حمد وثناء ، ولذلك تقول الآية في النهاية : {إنّ الله هو الغني الحميد} .
إنّه غنيّ على الإطلاق ، وحميد من كلّ جهة ، لأنّ كلّ موهبة في هذا العالم تعود إليه ، وكلّ ما يملكه الإنسان فانّه صادر منه وخزائن كلّ الخيرات بيده ، وهذا دليل حيّ على غناه .
ولمّا كان «الحمد» بمعنى الثناء على العمل الحسن الذي يصدر عن المرء بإختياره ، وكلّ حسن نراه في هذا العالم فهو من الله سبحانه ، فإنّ كلّ حمد وثناء منه ، فحتّى إذا مدحنا جمال الزهور ، ووصفنا جاذبية العشق الملكوتي ، وقدّرنا إيثار الشخص الكريم ، فإنّنا في الحقيقة نحمده ، لأنّ هذا الجمال والجاذبية والكرم منه أيضاً . . إذن فهو حميد على الإطلاق .
ثمّ تجسّد الآية التالية علم الله اللامحدود من خلال ذكر مثال بليغ جدّاً ، وقبل ذلك نرى لزوم ذكر هذه المسألة ، وهي ـ طبقاً لما جاء في تفسير علي بن إبراهيم : إنّ قوماً من اليهود عندما سألوا النّبي (صلى الله عليه وآله) حول مسألة الروح ، وأجابهم القرآن بأن {قل الروح من أمر ربّي وما اُوتيتم من العلم إلاّ قليلا} صعب هذا الكلام عليهم ، وسألوا النّبي (صلى الله عليه وآله) : هل أنّ هذا في حقّنا فقط؟ فأجابهم النّبي (صلى الله عليه وآله) : «بل الناس عامّة» ، قالوا : فكيف يجتمع هذا يامحمّد؟! أتزعم أنّك لم تؤت من العلم إلاّ قليلا ، وقد اُوتيت القرآن واُوتينا التوراة ، وقد قرأت : {ومن يؤت الحكمة ـ وهي التوراة ـ فقد اُوتي خيراً كثيرا} هنا نزلت الآية {ولو أنّ ما في الأرض من شجرة أقلام . . .} ـ الآية مورد البحث ـ وأوضحت أنّ علم الإنسان مهما كان واسعاً فإنّه في مقابل علم الله عزّوجلّ ليس إلاّ ذرّة تافهة ، والذي يعدّ كثيراً في نظركم ، هو قليل جدّاً عند الله (9) .
وقد بيّنا نظير هذه الرواية عن طريق آخر في ذيل الآية (109) من سورة الكهف .
وعلى كلّ حال ، فإنّ القرآن الكريم ولأجل تجسيد علم الله اللامتناهي يقول : {ولو أنّ ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إنّ الله عزيز حكيم} .
«يمدّه» من مادّة (المداد) وهي بمعنى الحبر أو المادّة الملوّنة التي يكتبون بها ، وهي في الأصل من (مدّ) بمعنى الخطّ ، لأنّ الخطوط تظهر على صفحة الورق بواسطة جرّ القلم .
ونقل بعض المفسّرين معنى آخر لها ، وهو الزيت الذي يوضع في السراج ويسبّب إنارة السراج . وكلا المعنيين في الواقع يرجعان إلى أصل واحد .
«الكلمات» جمع «كلمة» ، وهي في الأصل الألفاظ التي يتحدّث ويتكلّم بها الإنسان ، ثمّ اُطلقت على معنى أوسع ، وهو كلّ شيء يمكنه أن يبيّن المراد والمطلب ، ولمّا كانت مخلوقات هذا العالم المختلفة يبيّن كلّ منها ذات الله المقدّسة وعظمته ، فقد أطلق على كلّ موجود (كلمة الله) ، واستعمل هذا التعبير خاصّة في الموجودات الأشرف والأعظم ، كما نقرأ في شأن المسيح في الآية (171) من سورة النساء {إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ } [النساء : 171] ثمّ إستعملت كلمات الله بمعنى علم الله لهذه المناسبة .
والآن يجب أن نفكّر بدقّة وبشكل صحيح بأنّه قد يكفي أحياناً قلم واحد مع مقدار من الحبر لكتابة كلّ المعلومات التي تتعلّق بإنسان ما ، بل قد يكون من الممكن أن يسجّل أفراد آخرون مجموعة معلوماتهم على الأوراق بنفس ذلك القلم ، إلاّ أنّ القرآن يقول : لو أنّ كلّ الأشجار الموجودة على سطح الأرض تصبح أقلاماً ـ ونحن نعلم أنّه قد تصنع من شجرة ضخمة ، من ساقها وأغصانها ، آلاف ، بل ملايين الأقلام ، ومع الأخذ بنظر الإعتبار المقدار العظيم للأشجار الموجودة في الأرض ، والغابات التي تغطّي الكثير من الجبال والسهول ، وعدد الأقلام الذي سينتج منها . .
وكذلك لو كانت كلّ البحار والمحيطات الموجودة ، والتي تشكّل ثلاثة أرباع الكرة الأرضيّة تقريباً ، بذلك العمق الساحق ، تصبح حبراً ، عند ذلك يتّضح عظمة ما سيكتب ، وكم من العلوم يمكن كتابتها بهذا المقدار من الأقلام والحبر! سيّما مع ملاحظة مضاعفة ذلك بإضافة سبعة أبحر اُخرى ، وكلّ واحد منها يعادل كلّ محيطات الأرض ، وبالأخصّ إذا علمنا أنّ عدد السبعة هنا لا يعني العدد ، بل للكثرة والإشارة إلى البحار التي لا عدّ لها ، فعند ذلك ستّتضح سعة علم الله عزّوجلّ وترامي أطرافه ، ومع ذلك فإنّ كلّ هذه الأقلام والمحابر تنتهي ولكنّ علومه سبحانه لا تعرف النهاية .
هل يوجد تجسيد وتصوير للاّنهاية أروع وأبلغ وأجمل من هذا التجسيد؟ إنّ هذا العدد حيّ وناطق إلى الحدّ الذي يصطحب معه أمواج فكر الإنسان إلى الآفاق اللامحدودة ، ويغرقها في الحيرة والهيبة والجلال .
إنّ الإنسان يشعر مع هذا البيان البليغ الواضح أنّ معلوماته مقابل علم الله كالصفر مقابل اللانهاية ، ويليق به أن يقول فقط : إنّ علمي قد أوصلني إلى أن أطّلع على جهلي ، فحتّى التشبيه بالقطرة من البحر لتبيان هذه الحقيقة لا يبدو صحيحاً .
ومن جملة المسائل اللطيفة التي تلاحظ في الآية : أنّ الشجرة قد وردت بصيغة المفرد ، والأقلام قد وردت بصيغة الجمع ، وهذا تبيان لعدد الأقلام الكثيرة التي تنتج من شجرة واحدة بساقها وأغصانها .
وكذلك التعبير بـ (البحر) بصيغة المفرد مع (الف ولام) الجنس ليشمل كلّ البحار والمحيطات على وجه الأرض ، خاصّة وأنّ كلّ بحار العالم ومحيطاته متّصلة ببعضها ، وهي في الواقع بحكم بحر واسع .
والطريف في الأمر أنّه لا يتحدّث في مورد الأقلام عن أقلام إضافية ومساعدة ، أمّا فيما يتعلّق بالبحار فإنّه يتحدّث عن سبعة أبحر اُخرى ، لأنّ القلم يستهلك قليلا أثناء الكتابة ، والذي يستهلك أكثر هو الحبر .
إنتخاب كلمة (سبع) للكثرة في لغة العرب ، ربّما كان بسبب أنّ السابقين كانوا يعتقدون أنّ عدد كواكب المنظومة الشمسية سبعة كواكب ـ وفي أنّ ما يرى اليوم بالعين المجرّدة من المنظومة الشمسية سبعة كواكب لا أكثر ـ ومع ملاحظة أنّ الأسبوع دورة زمانية كاملة تتكوّن من سبعة أيّام لا أكثر ، وأنّهم كانوا يقسّمون كلّ الكرة الأرضية إلى سبع مناطق ، وكانوا قد وضعوا لها اسم الأقاليم السبعة ، سيتّضح لماذا إنتخب عدد السبعة كعدد كامل من بين الأعداد ، واستعمل لبيان الكثرة (10) .
بعد ذكر علم الله اللامحدود ، تتحدّث الآية الاُخرى عن قدرته اللامتناهية ، فتقول : {ما خلقكم ولا بعثكم إلاّ كنفس واحدة إنّ الله سميع بصير} .
قال بعض المفسّرين : إنّ جمعاً من كفّار قريش كانوا يقولون من باب التعجّب والإستبعاد لمسألة المعاد : إنّ الله قد خلقنا بأشكال مختلفة ، وعلى مدى مراحل مختلفة ، فكنّا يوماً نطفة ، وبعدها صرنا علقة ، وبعدها صرنا مضغة ، ثمّ أصبحنا تدريجيّاً على هيئات وصور مختلفة ، فكيف يخلقنا الله جميعاً خلقاً جديداً في ساعة واحدة؟! فنزلت الآية مورد البحث فأجابتهم .
إنّ هؤلاء كانوا غافلين في الحقيقة عن مسألة مهمّة ، وهي أنّ هذه المفاهيم كالصعوبة والسهولة ، والصغير والكبير يمكن تصوّرها من قبل موجودات لها قدرة محدودة كقدرتنا ، إلاّ أنّها أمام قدرة الله اللامتناهية تكون متساوية ، فلا يختلف خلق إنسان واحد عن خلق جميع البشر مطلقاً ، وخلق موجود ما في لحظة واحدة أو على مدى سنين طوال بالنسبة إلى قدرته المطلقة .
وإذا كان تعجّب كفّار قريش من أنّه كيف يمكن فصل الأجساد عن بعضها وإرجاع كلّ منها إلى محلّه بعد أن كانت الطبائع مختلفة ، والأشكال متغايرة ، والشخصيات متنوّعة ، وذلك بعد أن تحوّل بدن الإنسان إلى تراب وتطايرت ذرّات ذلك التراب؟! فإنّ علم الله اللامتناهي ، وقدرته اللامحدودة تجيبهم عن سؤالهم ، فإنّه قد جعل بين الموجودات روابط وعلاقات بحيث أنّ الواحد منها كالمجموعة ، والمجموعة كالواحد .
وأساساً فانّ إنسجام وترابط هذا العالم بشكل ترجع كلّ كثرة فيه إلى الوحدة ، وخلقة مجموع البشر تتّبع خلقة إنسان واحد .
وإذا كان تعجّب هؤلاء من قصر الزمان ، بأنّه كيف يمكن أن تطوى المراحل التي يطويها الإنسان خلال سنين طوال من كونه نطفة إلى مرحلة الشباب ، في لحظات قصيرة؟! فإنّ قدرة الله تجيب على هذا التساؤل أيضاً ، فإنّنا نرى في عالم الأحياء أنّ أطفال الإنسان يحتاجون لمدّة طويلة ليتعلّموا المشي بصورة جيّدة ، أو يصبحوا قادرين على الإستفادة من كلّ أنواع الأغذية ، في حين أنّنا نرى الفراخ بمجرّد أن تخرج من البيضة تنهض وتسير ، وتأكل دونما حاجة حتّى للاُمّ ، وهذه الظاهرة تبيّن أنّ هذه الاُمور لا تعني شيئاً أمام قدرة الله عزّوجلّ .
إنّ ذكر كون الله «سميعاً وبصيراً» في نهاية الآية قد يكون جواباً عن إشكال آخر من جانب المشركين ، وهو على فرض أنّ جميع البشر على إختلاف خلقتهم ، وبكلّ خصوصياتهم يبعثون ويحيون في ساعة واحدة ، لكن كيف ستخضع أعمالهم وكلامهم للحساب ، فإنّ الأعمال والأقوال اُمور تفنى بعد الوجود؟!
فيجيب القرآن بأنّ الله سميع وبصير ، قد سمع كلّ كلامهم ، ورأى كلّ أعمالهم ، علاوة على أنّ الفناء المطلق لا معنى ولا وجود له في هذا العالم ، بل إنّ أعمالهم وأقوالهم موجودة دائماً .
وإذا تجاوزنا ذلك فإنّ الجملة أعلاه تهديد لهؤلاء المعاندين ، بأنّ الله سبحانه مطّلع على أقوالكم ومؤامراتكم ، بل وحتّى على ما في قلوبكم وضمائركم .
__________________
1- الامثل ، ناصر مكارم الشيرازي ، ج10 ، ص245-255 .
2 ـ إعتقد بعض المفسّرين كالآلوسي في روح المعاني ، والفخر الرازي في التّفسير الكبير ، بأنّ هذه الآيات مرتبطة بالآيات التي سبقت مواعظ لقمان ، حيث تخاطب المشركين : (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) وتقول في الآيات مورد البحث : (ألم تروا أنّ الله سخّر لكم ما في السماوات وما في الأرض) . إلاّ أنّ آخر هذه الآية والآيات التي بعدها ، والروايات الواردة في تفسيرها تتناسب مع عموميّة الآية .
3 ـ كانت لنا بحوث اُخرى حول تسخير الموجودات للإنسان في ذيل الآية (2) من سورة الرعد .
4 ـ مجمع البيان ، ذيل الآية مورد البحث .
5 ـ المصدر السابق .
6 ـ إعتبر المفسّرون (لو) هنا شرطية كالمعتاد ، وجزاؤها محذوف ، والتقدير : لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أيتبعونه .
7 ـ تفسير البرهان ، الجزء 3 ، صفحة 279 ذيل الآية مورد البحث .
8 ـ لمزيد الإيضاح راجع تفسير البرهان ، الجزء 3 ، صفحة 278 و279 .
9 ـ تفسير البرهان ، الجزء 3 ، صفحة 279 .
10 ـ تحدّثنا حول (علم الله المطلق) في ذيل الآية (109) من سورة الكهف .
 الاكثر قراءة في سورة لقمان
الاكثر قراءة في سورة لقمان
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)