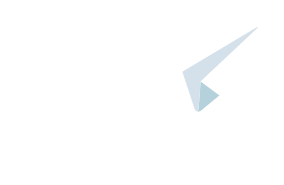تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
تفسير آية (11-18) من سورة الأعراف
المؤلف:
المرجع الإلكتروني للمعلوماتية
المصدر:
تفاسير الشيعة
الجزء والصفحة:
......
30-4-2019
10378
قال تعالى : {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأعراف : 11 - 18] .
قال تعالى : {وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} [الأعراف : 11] .
ذكر سبحانه نعمته في ابتداء الخلق ، فقال : (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) قال الأخفش : ثم هاهنا في معنى الواو .
وقال الزجاج : وهذا خطأ لا يجيزه الخليل ، وسيبويه ، وجميع من يوثق بعلمه ، إنما ثم للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله ، لا غير ، وإنما المعنى في هذا الخطاب ذكر ابتداء الخلق أولا ، فالمراد : إنا بدأنا خلق آدم ، ثم صورناه . فابتداء خلق آدم عليه السلام من التراب ، ثم وقعت الصورة بعد ذلك ، فهذا معنى (خلقناكم ثم صورناكم) . (ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم) بعد الفراغ من خلق آدم ، فثم إنما هو لما بعد ، وهذا مروي عن الحسن . ومن كلام العرب : فعلنا بكم كذا وكذا ، وهم يعنون أسلافهم . وفي التنزيل (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور) أي : ميثاق أسلافكم . وقد قيل في ذلك أقوال أخر منها : إن معناه خلقنا آدم ثم صورناكم في ظهره ، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، عن ابن عباس ، ومجاهد ، والربيع ، وقتادة والسدي . ومنها : إن الترتيب وقع في الإخبار ، فكأنه قال : خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم ، إنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، كما يقول القائل : أنا راجل ، ثم أنا مسرع ، وهذا قول جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى ، والقاضي أبو سعيد السيرافي ، وغيرهما .
وعلى هذا فقد قيل : إن المعنى : خلقناكم في أصلاب الرجال ، ثم صورناكم في أرحام النساء ، عن عكرمة ، وقيل : خلقناكم في الرحم ، ثم صورناكم بشق السمع والبصر ، وسائر الأعضاء ، عن يمان ، وقول الشاعر :
سئلت ربيعة من خيرها أبا ، ثم أما ، فقالت ليه فمعناه لتجيب أولا عن الأب ، ثم الأم . وقوله (فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين) قد مضى الكلام فيه في سورة البقرة .
- {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ} [الأعراف : 12 - 13] .
ثم حكى سبحانه خطابه لإبليس ، حين امتنع من السجود لآدم ، بقوله (قال) أي : قال الله تعالى (ما منعك أن لا تسجد) أي : ما دعاك إلى أن لا تسجد ، وما اضطرك إليه ، أو ما منعك أن تسجد (إذ أمرتك) بالسجود لآدم (قال) إبليس : (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) ، وهذا الجواب غير مطابق ، لأنه كان يجب أن يقول : منعني كذا ، لأن قوله (أنا خير منه) جواب لمن يقول :
أيكما خير ؟ ولكن فيه معنى الجواب ، ويجري ذلك مجرى أن يقول القائل لغيره :
كيف كنت ؟ فيقول : أنا صالح . وكان يجب أن يقول : كنت صالحا ، لكنه جاز ذلك لأنه أفاد أنه صالح في الحال ، مع أنه كان صالحا فيما مضى .
قال ابن عباس : (أول من قاس إبليس فأخطأ القياس ، فمن قاس الدين بشيء من رأيه ، قرنه الله بإبليس) . وقال ابن سيرين : (أول من قاس إبليس ، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس) . ووجه دخول الشبهة على إبليس أنه ظن أن النار إذا كانت أشرف من الطين ، لم يجز أن يسجد الأشرف للأدون ، وهذا خطأ لأن ذلك تابع لما يعلم الله سبحانه من مصالح العباد . وقد قيل أيضا : إن الطين خير من النار ، لأنه أكثر منافع للخلق من حيث إن الأرض مستقر الخلق ، وفيها معايشهم ، ومنها يخرج أنواع أرزاقهم ، والخيرية إنما يراد بها كثرة المنافع ، دون كثرة الثواب ، لأن الثواب لا يكون إلا للمكلف المأمور ، دون الجماد .
(قال) أي : قال الله سبحانه لإبليس (فاهبط) أي : انزل وانحدر (منها) أي : من السماء ، عن الحسن . وقيل : من الجنة . وقيل : معناه انزل عما أنت عليه من الدرجة الرفيعة ، والمنزلة الشريفة ، التي هي درجة متبعي أمر الله سبحانه ، وحافظي حدوده ، إلى الدرجة الدنية التي هي درجة العاصين ، المضيعين أمر الله (فما يكون لك أن تتكبر ، عن أمر الله (فيها) أي : في الجنة ، أو في السماء ، فإنها ليست بموضع المتكبرين ، وإنما موضعهم النار كما قال (أليس في جهنم مثوى للمتكبرين) (فاخرج) من المكان الذي أنت فيه ، أو المنزلة التي أنت عليها (إنك من الصاغرين) أي : من الأذلاء بالمعصية في الدنيا ، لأن العاصي ذليل عند من عصاه ، أو بالعذاب في الآخرة ، لأن المعذب ذليل .
وهذا الكلام إنما صدر من الله سبحانه على لسان بعض الملائكة ، عن الجبائي . وقيل : إن إبليس رأى معجزة تدله على أن ذلك كلام الله ، وقوله سبحانه :
(فما يكون لك أن تتكبر فيها) لا يدل على أنه يجوز التكبر في غير الجنة ، فإن التكبر لا يجوز على حال ، لأنه إظهار كبر النفس على جميع الأشياء ، وهذا في صفة العباد ذم ، وفي صفة الله سبحانه مدح ، إلا أن إبليس تكبر على الله سبحانه في الجنة ، فأخرج منها قسرا ، ومن تكبر خارج الجنة ، منع من ذلك بالأمر والنهي .
- {قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (17) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأعراف : 11 - 17] .
(قال) يعني إبليس (أنظرني) أي : أمهلني وأخرني في الأجل ، ولا تمتني (إلى يوم يبعثون) أي : يبعث الخلق من قبورهم للجزاء . وقيل : معناه أنظرني في الجزاء إلى يوم القيامة ، فكأنه خاف أن يعاجله الله سبحانه بالعقوبة . يدل عليه قوله : (إلى يوم يبعثون) ولم يقل إلى يوم يموتون ، ومعلوم أن الله تعالى لا يبقي أحدا حيا إلى يوم القيامة . قال الكلبي : أراد الخبيث أن لا يذوق الموت في النفخة الأولى مع من يموت ، فأجيب بالإنظار إلى يوم الوقت المعلوم ، وهي النفخة الأولى ، ليذوق الموت بين النفختين ، وهو أربعون سنة .
وأما الوجه ، في مسألة إبليس الإنظار ، مع علمه بأنه مطرود ملعون ، فعلمه بأنه سبحانه يظاهر إلى عباده بالنعم ، ويعمهم بالفضل والكرم ، فلم يصرفه ارتكابه المعصية عن المسألة والطمع في الإجابة .
(قال) أي : قال الله سبحانه لإبليس : (إنك من المنظرين) أي : من المؤخرين (قال) إبليس لما لعنه الله وطرده ، ثم سأله الإنظار فأجابه الله تعالى إلى شئ منه (فبما أغويتني) أي : فبالذي أغويتني . قيل في معناه أقوال أحدها : إن معناه : بما خيبتني من رحمتك وجنتك ، كما قال الشاعر :
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره * ، ومن يغولا يعدم على الغي لائما
أي : من يخب وثانيها : إن المراد امتحنتني بالسجود لآدم فغويت عنده ، فلذلك قال : (أغويتني) كما قال : (فزادتهم رجسا إلى رجسهم) وثالثها : إن معناه حكمت بغوايتي ، كما يقال : أضللتني أي . حكمت بضلالتي ، عن ابن عباس ، وابن زيد ورابعها : إن معناه أهلكتني بلعنك إياي ، كما قال الشاعر :
معطفة الأثناء ليس فصيلها برازئها درا ، ولا ميت غوى (2)
أي ولا ميت هلاكا بالقعود عن شرب اللبن ، ومنه قوله (فسوف يلقون غيا) أي : هلاكا وقالوا : غوى الفصيل : إذا فقد اللبن فمات ، والمصدر غوى مقصور وخامسها : أن يكون الكلام على ظاهره من الغواية ، ولا يبعد أن يكون إبليس قد اعتقد أن الله تعالى يغوي الخلق بأن يضلهم ، ويكون ذلك من جملة ما كان اعتقده من الشر (لأقعدن) أي : لأجلسن (لهم) أي : لأولاد آدم (صراطك المستقيم) أي على طريقك المستوي ، وهو طريق الحق ، لأصدنهم عنه بالإغواء حتى أصرفهم إلى طريق الباطل ، كيدا لهم ، وعداوة . وقول من قال : إنه لو كان ما يفعل به الإيمان ، هو بعينه ما يفعل به الكفر ، لكان قوله (فبما أغويتني) مساويا لقوله فبما أصلحتني ، يفسد بأن صفة الآلة إذا وقع بها الكفر ، صفتها إذا وقع بها الإيمان ، وإن كانت الآلة واحدة ، كما أن السيف واحد ، ويصلح لأن يستعمل في قتل المؤمن ، كما يصلح أن يستعمل في قتل الكافر ، ولا يجب من ذلك أن تكون الصفتان واحدة من أجل أنه واحد ، فلا يمتنع أن يكون متى استعملت آلة الإيمان في الضلال والكفر ، تسمى إغواء ، وإن استعمل في الإيمان سميت هداية ، وإن كان ما يصح به الإيمان هو بعينه ما يصح به الكفر ، والضلال .
{ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ} [الأعراف : 17] قيل في ذلك أقوال أحدها : إن المعنى من قبل دنياهم وآخرتهم ، ومن جهة حسناتهم وسيئاتهم ، عن ابن عباس ، وقتادة ، والسدي ، وابن جريج ، وتلخيصه : إني أزين لهم الدنيا ، وأخوفهم بالفقر ، وأقول لهم : لا جنة ، ولا نار ، ولا بعث ، ولا حساب ، وأثبطهم عن الحسنات ، وأشغلهم عنها ، وأحبب إليهم السيئات ، وأحثهم عليها ، قال ابن عباس : وإنما لم يقل ومن فوقهم ، لأن فوقهم جهة نزول الرحمة من السماء ، فلا سبيل له إلى ذلك ، ولم يقل من تحت أرجلهم ، لأن الإتيان منه موحش .
وثانيها : إن معنى (من بين أيديهم) (وعن أيمانهم) : من حيث يبصرون (ومن خلفهم) (وعن شمائلهم) : من حيث لا يبصرون عن مجاهد .
وثالثها : ما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال : (ثم لآتينهم من بين أيديهم) معناه : أهون عليهم أمر الآخرة ، (ومن خلفهم) . آمرهم بجمع الأموال ، والبخل بها عن الحقوق ، لتبقى لورثتهم ، (وعن أيمانهم) أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة ، وتحسين الشبهة ، (وعن شمائلهم) بتحبيب اللذات إليهم ، وتغليب الشهوات على قلوبهم ، وإنما دخلت (من) في القدام والخلف ، و (عن) في اليمين والشمال ، لأن في القدام والخلف معنى طلب النهاية ، وفي اليمين والشمال الانحراف عن الجهة .
(ولا تجد أكثرهم شاكرين) هذا أخبار من إبليس ، أن الله تعالى لا يجد أكثر خلقه شاكرين . وقيل : إنه يمكن أن يكون قد قال ذلك من أحد وجهين : إما من جهة الملائكة ، بإخبار الله تعالى إياهم ، وإما عن ظن منه ، كما قال سبحانه : (ولقد صدق عليهم إبليس ظنه) فإنه لما استنزل آدم ظن أن ذريته أيضا سيجيبونه لكونهم أضعف منه ، والقول الأول : اختيار الجبائي ، والثاني : عن الحسن ، وأبي مسلم .
- {قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأعراف : 18] .
ثم بين سبحانه ما فعله بإبليس من الإهانة والإذلال ، وما آتاه آدم من الإكرام والإجلال ، بقوله : (قال اخرج منها) أي : من الجنة ، أو من السماء ، أو من المنزلة الرفيعة . (مذؤوما) أي : مذموما عن ابن زيد . وقيل : معيبا ، عن المبرد . وقيل : مهانا لعينا ، عن ابن عباس ، وقتادة . (مدحورا) أي : مطرودا ، عن مجاهد ، والسدي . (لمن تبعك منهم) أي : من بني آدم ، ومعناه : من أطاعك واقتدى بك من بني آدم ، (لأملأن جهنم منكم) أي : منك ، ومن ذريتك ، وكفار بني آدم .
(أجمعين) : وإنما جمعهم في الخطاب ، لأنه لا يكون في جهنم إلا إبليس وحزبه من الشياطين ، وكفار الإنس ، وضلالهم الذين انقادوا له ، وتركوا أمر الله لاتباعه .
_____________________________
1 . تفسير مجمع البيان ، ج4 ، ص 223- 231 .
2 . الأثناء جمع الثني : الناقة التي ولدت بطنين ، ويقال لولدها أيضا (الثني) . عطف الشيء : أماله . قوس معطفة : منحنية . قال في (اللسان) (وربما عطفوا عدة ذود على فصيل واحد فاحتلبوا ألبانهن على ذلك ليدررن) . الرزء : النقص والفقد . الدر : اللبن . وقال فيه يصف قوسا يعني القوس وسهما رمى به عنها ، وهذا من اللغز .
حول أصل الإنسان :
{ولَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ} . الخطاب لبني آدم ، ومعنى خلقناكم انه جل ثناؤه أنشأ أصلنا الأول من تراب ، وأنشأنا نحن من النطفة التي تنتهي إلى التراب ، والمراد بصورناكم انه جعل المادة الأولى التي خلقنا منها بشرا سويا على الهيئة التي هو عليه : {أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا} [الكهف - 37] ، فالفرق بين الخلق والتصوير ان خلق الشيء معناه إيجاده وإنشاؤه ، أما التصوير فهو إعطاء الشيء صورة خاصة بعد إيجاده .
وتسأل : ان أتباع دارون يقولون : إن الإنسان وجد أول ما وجد على غير صورته هذه ، ثم انتقل من نوع إلى نوع ، حتى انتهى إلى ما هو عليه الآن ؟
الجواب : نحن مع الدليل العلمي الذي لا يقبل الشك ، والاحتمال المضاد ، لأنه متى طرأ الاحتمال بطل الاستدلال ، وهذه حقيقة يقينية بديهية ، لا ينكرها حتى التجريبيون الذين حصروا مصدر المعرفة بالخبرة الحسية . . وأهم الأدلة التي اعتمدها أصحاب نظرية النشوء والارتقاء هي الحفريات ، حيث كشفت عن وجود أنواع من الحيوان بعضها أرقى من بعض ، وان زمن الأرقى متأخر عن زمن الأدنى ، وان بينها وبين الإنسان شبها في كثير من المزايا .
ونحن لا ننكر هذه الكشوف ، ولكنها لا تثبت نظرية دارون ، لأنها لا تحتم أن يكون الأرقى متطورا من الأدنى في يقين لا يقبل الشك ، بل لا يجوز ذلك ويجوز أن يكون كل من الأرقى والأدنى نوعا مستقلا بذاته عن الآخر أوجدته ظروف ملائمة له ، ثم انقرض حين تغيرت ظروفه ، كما انقرض غيره من أنواع الحيوان والنبات . . وإذا جاز الأمران ، فالأخذ بأحدهما دون الآخر تحكّم .
وقرأت فيما قرأت ان كثيرا من العلماء ، وفيهم الملحدون ، كانوا يؤمنون بالنظرية الداروينية ، ولما تقدموا في ميدان العلم عدلوا عنها ، لما ذكرنا ، ولأن في الإنسان خصائص عقلية وروحية تجعله مستقلا عن جميع المخلوقات وأنواعها .
{ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} .
تقدم نظيره في الآية 34 سورة البقرة ج 1 ص 82 .
{قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} . ولا هنا زائدة ، ويدل على زيادتها سقوطها من الآية 75 من سورة ص : {قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ولأن المعنى لا يستقيم مع وجودها اللهم إلا أن تكون كلمة منعك متضمنة معنى حملك ، ويكون تأويل الكلام هكذا : ما حملك على ترك السجود ، والمراد بالسجود سجود التحية ، لا سجود العبادة ، وهو طاعة للَّه تعالى ، لأنه بأمره .
{قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} . وما فعل إبليس فعلة إلا ابتدع لها مبررا ، والشرط الأساسي لكل مبرر في منطقه أن يخالف إرادة اللَّه ومرضاته ، هذا هو الأصل الأول الذي يعتمده إبليس في جميع أقواله وأفعاله . . يجتهد الفقيه في البحث ليهتدي إلى ما شرع اللَّه من أحكام ، أما إبليس فيشرع أحكاما ترتكز على قال اللَّه . . وأقول . . أمره اللَّه بالسجود لآدم فرفض ولم يعتذر ، بل اعترض بجرأة وصلافة ، وقال : كيف اسجد لمن أنا خير منه ؟ ! وكأنه يقول للَّه تعالى علوا كبيرا : كان الأولى ان تأمر آدم بالسجود لي ، دون أن تأمرني بالسجود له . . وابتدع مبررا لهذه الأولية ، وهو افتخاره بخلقه ، وتعصبه لأصله : {خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} .
فالعزة والكرامة في منطق إبليس بالتعصب للأصل ، لا بتقوى اللَّه وطاعته ، وعند اللَّه بالفعل والتقوى ، لا بالأصل ، والعلم عند إبليس هو القياس والأهواء ، وعند اللَّه هو الوحي وحكم العقل الذي لا يختلف فيه اثنان لبداهته ووضوحه .
فمن تعصب لأصله ، أو قاس الدين برأيه فقد اقتدى بإبليس ، من حيث يريد أو لا يريد ، قال صاحب تفسير المنار : روي عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده ان رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : أول من قال قاس أمر الدين برأيه إبليس ، قال اللَّه تعالى له : اسجد لآدم ، فقال : أنا خير منه الخ . ثم قال جعفر : فمن قاس أمر الدين برأيه قرنه اللَّه تعالى يوم القيامة إبليس .
وتسأل : تدل هذه الآية على ان الحياة توجد من النار ، ومثلها الآية 15 من سورة الرحمن : وخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ . المارج الشعلة ذات اللهب الشديد . . وكيف يجتمع هذا مع قوله تعالى : {وجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} ؟ .
الجواب : ان الكائنات الحية التي جاء ذكرها في القرآن الكريم على أنواع ، منها عالم الملائكة ، ومنها عالم الجان ، ومنها ما يعيش في هذه الأرض ، وهذا النوع الثالث منه ما يحيا بالماء كالحيوان والنبات والإنسان ، وهو المقصود من التعميم بقوله تعالى : {وجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} ومنه ما يحيا بالنار . .
وبكلمة ان الماء ضرورة لحياة الإنسان - بموجب طبعه وتكوينه - وكذلك سائر أفراد الحيوان وأنواعه ، والنبات وأصنافه ، وهذا لا يمنع أن يكون هناك مخلوقات تكون النار ضرورة لحياتها ، قال أهل الاختصاص بعلم الحشرات : ان نوعا منها لا يحيا إلا بالهواء السام ، وآبار البترول .
{قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ} .
قيل : ضمير منها يعود إلى الجنة . وقيل : إلى السماء . . ونحن لا نهتم بالتفاصيل إذا لم يرد لها ذكر في الكتاب أو السنة ، ونكتفي بالإجمال ، وسياق الكلام يدل على ان الضمير يعود إلى الدرجة الرفيعة عند اللَّه ، والمعنى ان اللَّه سبحانه طرد إبليس من رحمته إلى لعنته جزاء على تكبره وامتناعه عن طاعته ، فان السجود لآدم بأمر اللَّه هو طاعة للَّه ، وليس لآدم . . وكل من يرى لنفسه الحق في ان يرفض حكم اللَّه فقد حقت عليه اللعنة إلى يوم الدين .
{قالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} . لحاجة في نفس إبليس - سيصرح بها - طلب الامهال إلى يوم يبعثون قال - تعالى – {إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ} . قيل : ان إبليس طلب الامهال إلى اليوم الذي تحيا فيه جميع الأموات للحساب والجزاء ، فرفض اللَّه طلبه هذا ، وأمهله إلى اليوم الذي تموت فيه جميع الأحياء ، وهو المشار إليه بالآية 38 من الحجر : {قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ} وهذا اليوم هو ساعة النفخ في الصور الذي دلت عليه الآية 68 من الزمر : {ونُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ ومَنْ فِي الأَرْضِ} .
{قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} . قطع إبليس عهدا على نفسه انه سينتقم لمأساته من هذا المخلوق الذي كان السبب لطرده من رحمة اللَّه إلى لعنته ، وبيّن نوع هذا الانتقام بأنه سيقعد على الطريق المؤدية إلى اللَّه وطاعته ، ويصد عنها آدم وذريته .
{ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ومِنْ خَلْفِهِمْ وعَنْ أَيْمانِهِمْ وعَنْ شَمائِلِهِمْ ولا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ} . وإتيانه لهم من هذه الجهات الأربع كناية عن وسوسته ، وجده في اضلالهم واغوائهم ، بحيث لا يدع معصية إلا أغراهم بها ، ولا طاعة إلا ثبطهم عنها . . فان أمرهم اللَّه بالجهاد والتضحية بالنفس حبب إبليس إليهم الحياة ، وان حثهم سبحانه على بذل المال في سبيله خوّفهم اللعين من الفقر ، وان نهاهم الجليل عن الخمر والزنا والميسر ونحوه زيّن لهم الخبيث الملذات وحب الشهوات ، وان توعدهم اللَّه بالنار ، ووعدهم بالجنة قال لهم عدو اللَّه وعدوهم : لا جنة ولا نار . . وهكذا يعد لكل حق باطلا ، ولكل قائم مائلا . . وتنطبق هذه الصورة كل الانطباق على الذين باعوا دينهم للشيطان ، يبررون أعمال المستعمرين ، وقتل النساء والأطفال ، وتشريد الآمنين من ديارهم .
{قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً} . الذأم العيب والاحتقار ، والدحر الطرد ، وقد خص اللَّه بهما إبليس ، حيث أنزله اللَّه سبحانه من المقام الذي كان فيه ، أما جهنم فإنها له ولحزبه الذين أطاعوه ، وعصوا أمر اللَّه « لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ » ونحو هذه الآية قوله تعالى : لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ ومِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ .
وهنا تساؤلات تطلب أجوبتها ، وهي أولا : هل كان خطاب اللَّه لإبليس بواسطة أو بلا واسطة ؟ ثانيا : ان قول إبليس : « فَبِما أَغْوَيْتَنِي » يدل على ان إغواءه كان من اللَّه ، فكيف يعاقبه عليه ؟ ثالثا : لما ذا أمهل سبحانه إبليس وهو يعلم فساده وإفساده ؟ .
ونجيب عن هذه التساؤلات الثلاثة بإيجاز شديد . . فعن التساؤل الأول : نحن نؤمن بوجود هذا الحوار ، لأن الوحي دل عليه ، والعقل لا يأباه ، وما علينا أن نبحث عن هيئته وكيفيته ، ما دام الوحي لم يصرح به .
وعن التساؤل الثاني : ان الغواية من إبليس ، وليست من اللَّه تعالى ، وقد اعترف إبليس بنفسه على انه هو الغاوي في الآية 39 من الحجر : ولأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ . وكيف يغوي اللَّه العبد ، ثم يعاقبه على الغواية ؟ ! تعالى اللَّه عن ذلك علوا كبيرا ، أما قول إبليس : « فَبِما أَغْوَيْتَنِي » فمعناه بما امتحنتني به من الأمر بالسجود لآدم الذي أوقعني في الغي والعصيان فاني سأفعل كذا وكيت . . وبكلمة ان قول إبليس هذا هو تعبير ثان عن قوله : لأنك أمرتني وعصيت أمرك فسوف لا أدع أحدا يطيع لك أمرا .
وعن التساؤل الثالث : ان مشيئة اللَّه اقتضت أن يمد الإنسان بالعقل والتذكير على أيدي الرسل ، وبالقدرة على فعل الخير والشر ، وأن يدع له الخيار ، وأن يبتليه بالشهوات والمغريات التي يوسوس بها إبليس وجنوده تمييزا للطيب من الخبيث ، والمخلص من الخائن . . أنظر تفسير الآية 94 من المائدة ، فقرة معنى الاختبار من اللَّه ، والمجلد الثاني من تفسيرنا هذا ص 324 ، فقرة قرين الشيطان .
__________________________
1. تفسير الكاشف ، ج4 ، ص 305-308 .
قوله تعالى : {وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} صورة قصة تبتدئ من هذه الآية إلى تمام خمس عشرة آية يفصل فيها إجمال الآية السابقة وتبين فيها العلل والأسباب التي انتهت إلى تمكين الإنسان في الأرض المدلول عليه بقوله : {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ} .
ولذلك بدئ الكلام في قوله : {وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ} ( إلخ ) بلام القسم ، ولذلك أيضا سيقت القصتان أعني قصة الأمر بالسجدة ، وقصة الجنة في صورة قصة واحدة من غير أن تفصل القصة الثانية بما يدل على كونها قصة مستقلة كل ذلك ليتخلص إلى قوله : {قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ} إلى آخر الآيتين فينطبق التفصيل على إجمال قوله : {وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ} الآية .
وقوله : {وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ} الخطاب فيه لعامة الآدميين وهو خطاب امتناني كما مر نظيره في الآية السابقة لأن المضمون هو المضمون وإنما يختلفان بالإجمال والتفصيل .
وعلى هذا فالانتقال في الخطاب من العموم إلى الخصوص أعني قوله : {ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} بعد قوله : {وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ} يفيد بيان حقيقتين :
الأولى : أن السجدة كانت من الملائكة لجميع بني آدم أي للنشأة الإنسانية وإن كان آدم عليه السلام هو القبلة المنصوبة للسجدة فهو عليه السلام في أمر السجدة كان مثالا يمثل به الإنسانية نائبا مناب أفراد الإنسان على كثرتهم لا مسجودا له من جهة شخصه كالكعبة المجعولة قبلة يتوجه إليها في العبادات ، وتمثل بها ناحية الربوبية .
ويستفاد هذا المعنى أولا من قصة الخلافة المذكورة في سورة البقرة آية 30 ـ 33 فإن المستفاد من الآيات هناك أن أمر الملائكة بالسجدة متفرع على الخلافة ، والخلافة المذكورة في الآيات كما استفدناه هناك ـ غير مختصة بآدم بل جارية في عامة الآدميين فالسجدة أيضا للجميع .
وثانيا : أن إبليس تعرض لهم أي لبني آدم ابتداء من غير توسيط آدم ولا تخصيصه عليه السلام بالتعرض حين قال على ما حكاه الله سبحانه : {فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ} ( إلخ ) من غير سبق ذكر لبني آدم ، وقد ورد نظيره في سورة الحجر حيث قال : {رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} [ الحجر: 39] ، وفي سورة ص حيث قال : {فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} [ ص : 82 ] ، ولو لا أن الجميع مسجودون بنوعيتهم للملائكة لم يستقم له أن ينقم منهم هذه النقمة ابتداء وهو ظاهر .
وثالثا : أن الخطابات التي خاطب الله سبحانه بها آدم عليه السلام كما في سورة البقرة وسورة طه عممها بعينها في هذه السورة لجميع بنيه ، قال تعالى : {يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ} إلخ .
والحقيقة الثانية : أن خلق آدم عليه السلام كان خلقا للجميع كما يدل عليه أيضا قوله تعالى : {وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ} [السجدة : 8] وقوله : {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ} [المؤمن : 67] ، على ما هو ظاهر الآيتين أن المراد بالخلق من تراب هو الذي كان في آدم عليه السلام .
ويشعر بذلك أيضا قول إبليس في ضمن القصة على ما حكاه الله سبحانه في سورة إسراء : {لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً} الآية ، ولا يخلو عن إشعار به أيضا قوله تعالى : {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ} الآيات [الأعراف : 172] على ما سيجيء من بيانه .
وللمفسرين في الآية أقوال مختلفة قال في مجمع البيان : ثم ذكر سبحانه نعمته في ابتداء الخلق فقال : {وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ} قال الأخفش : {ثُمَ} هاهنا في معنى الواو ، وقال الزجاج : وهذا خطأ لا يجوزه الخليل وسيبويه وجميع من يوثق بعلمه إنما {ثم} للشيء الذي يكون بعد المذكور قبله لا غير ، وإنما المعنى في هذا الخطاب ذكر ابتداء الخلق أولا فالمراد أنا بدأنا خلق آدم ثم صورناه فابتدأ خلق آدم من التراب ثم وقعت السورة بعد ذلك فهذا معنى خلقناكم ثم صورناكم {ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} بعد الفراغ من خلق آدم ، وهذا مروي عن الحسن ، ومن كلام العرب : فعلنا بكم كذا وكذا وهم يعنون أسلافهم ، وفي التنزيل : {وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ} أي ميثاق أسلافكم .
وقد قيل في ذلك أقوال أخر : منها أن معناه خلقنا آدم ثم صورناكم في ظهره ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ، عن ابن عباس ومجاهد والربيع وقتادة والسدي .
ومنها : أن الترتيب واقع في الإخبار فكأنه قال : خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم كما يقول القائل : أنا راجل ثم أنا مسرع ، وهذا قول جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى والقاضي أبو سعيد السيرافي وغيرهما ، وعلى هذا فقد قيل : إن المعنى : خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء عن عكرمة وقيل خلقناكم في الرحم ثم صورناكم بشق السمع والبصر وسائر الأعضاء انتهى .
أما ما نقله عن الزجاج من الوجه ففيه أولا أن نسبة شيء من صفات السابقين أو أعمالهم إلى أعقابهم إنما تصح إذا اشترك القبيلان في ذلك بنوع من الاشتراك كما فيما أورده من المثال لا بمجرد علاقة النسب والسبق واللحوق حتى يصح بمجرد الانتساب النسلي أن تعد خلقة نفس آدم خلقا لبنيه من غير أن يكون خلقه خلقا لهم بوجه .
وثانيا : أن ما ذكره لو صح به أن يعد خلق آدم وتصويره خلقا وتصويرا لبنيه صح أن يعد أمر الملائكة بالسجدة له أمرا لهم بالسجدة لبنيه كما جرى على ذلك في قوله : {وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ} فما باله قال : {ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} ولم يقل : {ثم قلنا للملائكة اسجدوا للإنسان} .
وأما ما نقله أخيرا من أقوالهم فوجوه سخيفة غير مفهومة من لفظ الآية ، ولعل القائلين بها لا يرضون أن يتأول في كلامهم أنفسهم بمثل هذه الوجوه فكيف يحمل على مثلها أبلغ الكلام ؟ .
قوله تعالى : {فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} أخبر تعالى عن سجود الملائكة جميعا كما يصرح به في قوله : {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [الحجر : 30] ، واستثنى منهم إبليس وقد علل عدم ائتماره بالأمر في موضع آخر بقوله : {كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف : 50] ، وقد وصف الملائكة بمثل قوله : {بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} [الأنبياء : 27] ، وهو بظاهره يدل على أنه من غير نوع الملائكة .
ولهذا وقع الخلاف بينهم في توجيه هذا الاستثناء : أهو استثناء متصل بتغليب الملائكة لكونهم أكثر وأشرف أو أنه استثناء منفصل وإنما أمر بأمر على حدة غير الأمر المتوجه إلى جمع الملائكة وإن كان ظاهر قوله : {ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} أن الأمر لم يكن إلا واحدا وهو الذي وجهه الله إلى الملائكة .
والذي يستفاد من ظاهر كلامه تعالى أن إبليس كان مع الملائكة من غير تميز له منهم والمقام الذي كان يجمعهم جميعا كان هو مقام القدس كما يستفاد من قصة ذكر الخلافة {وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ} [البقرة : 30] ، وإن الأمر بالسجود إنما كان متوجها إلى ذلك المقام أعني إلى المقيمين بذلك المقام من جهة مقامهم كما يشير إليه قوله تعالى في ما سيأتي : {قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها} والضمير إلى المنزلة أو إلى السماء أو الجنة ومآلهما إلى المنزلة والمقام ولو كان الخطاب متوجها إليهم من غير دخل المنزلة والمقام في ذلك لكان من حق الكلام أن يقال : {فما يكون لك أن تتكبر} .
وعلى هذا لم يكن بينه وبين الملائكة فرق قبل ذلك ؟ وعند ذلك تميز الفريقان ، وبقي الملائكة على ما يقتضيه مقامهم ومنزلتهم التي حلوا فيها ، وهو الخضوع العبودي والامتثال كما حكاه الله عنهم : {بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ} فهذه حقيقة حياة الملائكة وسنخ أعمالهم ، وقد بقوا على ذلك وخرج إبليس من المنزلة التي كان يشاركهم فيها كما يشير إليه قوله : {كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} والفسق خروج التمرة عن قشرها فتميز منهم فأخذ حياة لا حقيقة لها إلا الخروج من الكرامة الإلهية وطاعة العبودية .
والقصة وإن سيقت مساق القصص الاجتماعية المألوفة بيننا وتضمنت أمرا وامتثالا وتمردا واحتجاجا وطردا ورجما وغير ذلك من الأمور التشريعية والمولوية غير أن البيان السابق على استفادته من الآيات يهدينا إلى كونها تمثيلا للتكوين بمعنى أن إبليس على ما كان عليه من الحال لم يقبل الامتثال أي الخضوع للحقيقة الإنسانية فتفرعت عليه المعصية ، ويشعر به قوله تعالى : {فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها} فإن ظاهره أن هذا المقام لا يقبل لذاته التكبر فكان تكبره فيه خروجه منه وهبوطه إلى ما هو دونه .
على أن الأمر بالسجود ـ كما عرفت ـ أمر واحد توجه إلى الملائكة وإبليس جميعا بعينه ، والأمر المتوجه إلى الملائكة ليس من شأنه أن يكون مولويا تشريعيا بمعنى الأمر المتعلق بفعل يتساوى نسبة مأمورة إلى الطاعة والمعصية والسعادة والشقاوة فإن الملائكة مجبولون على الطاعة مستقرون في مقر السعادة كما أن إبليس واقع في الجانب المخالف لذلك على ما ظهر من أمره بتوجيه الأمر إليه .
فلو لا أن الله سبحانه خلق آدم وأمر الملائكة وإبليس جميعا بالسجود له لكان إبليس على ما كان عليه من منزلة القرب غير متميز من الملائكة لكن خلق الإنسان شق المقام مقامين : مقام القرب ومقام البعد ، وميز السبيل سبيلين : سبيل السعادة وسبيل الشقاوة .
قوله تعالى : {قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} يريد ما منعك أن تسجد كما وقع في سورة ص من قوله : {قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} [ص : 75] ، ولذلك ربما قيل : إن {لا} زائدة جيء بها للتأكيد كما في قوله : {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ} [الحديد : 29] .
والظاهر أن {منع} مضمن نظير معنى حمل أو دعا ، والمعنى : ما حملك أو ما دعاك على أن لا تسجد مانعا لك .
وقوله : {قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} يحكي عما أجاب به لعنه الله ، وهو أول معصيته وأول معصية عصي بها الله سبحانه فإن جميع المعاصي ترجع بحسب التحليل إلى دعوى الإنية ومنازعة الله سبحانه في كبريائه ، وله رداء الكبرياء لا شريك له فيه ، فليس لعبد مخلوق أن يعتمد على ذاته ويقول : أنا قبال الإنية الإلهية التي عنت له الوجود ، وخضعت له الرقاب ، وخشعت له الأصوات ، وذل له كل شيء .
ولو لم تنجذب نفسه إلى نفسه ، ولم يحتبس نظره في مشاهدة إنيته لم يتقيد باستقلال ذاته ، وشاهد الإله القيوم فوقه فذلت له إنيته ذلة تنفي عنه كل استقلال وكبرياء فخضع للأمر الإلهي ، وطاوعته نفسه في الائتمار والامتثال ، ولم تنجذب نفسه إلى ما كان يتراءى من كونه خيرا منه لأنه من النار وهو من الطين بل انجذبت نفسه إلى الأمر الصادر عن مصدر العظمة والكبرياء ومنبع كل جمال وجلال .
وكان من الحري إذا سمع قوله : {ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} أن يأتي بما يطابقه من الجواب كأن يقول : منعني أني خير منه لكنه أتى بقوله : {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} ليظهر به الإنية ، ويفيد الثبات والاستمرار ، ويستفاد منه أيضا أن المانع له من السجدة ما يرى لنفسه من الخيرية فقوله : {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} أظهر وآكد في إفادة التكبر .
ومن هنا يظهر أن هذا التكبر هو التكبر على الله سبحانه دون التكبر على آدم .
ثم إنه في قوله : {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} استدل على كونه خيرا من آدم بمبدإ خلقته وهو النار وأنها خير من الطين الذي خلق منه آدم وقد صدق الله سبحانه ما ذكره من مبدإ خلقته حيث ذكر أنه كان من الجن ، وأن الجن مخلوق من النار قال تعالى : {كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف : 50] وقال : {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ} [الحجر : 27] ، وقال أيضا : {خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ} [الرحمن : 15].
لكنه تعالى لم يصدقه فيما ذكره من خيريته منه فإنه تعالى وإن لم يرد عليه قوله {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ} إلخ ، في هذه السورة إلا أنه بين فضل آدم عليه وعلى الملائكة في حديث الخلافة الذي ذكره في سورة البقرة للملائكة .
على أنه تعالى ذكر القصة في موضع آخر بقوله : {إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} الخ : [ص : 76] .
فبين أولا أنهم لم يدعوا إلى السجود له لمادته الأرضية التي سوي منها ، وإنما دعوا إلى ذلك لما سواه ونفخ فيه من روحه الخاص به تعالى الحاملة للشرف كل الشرف والمتعلقة لتمام العناية الربانية ، ويدور أمر الخيرية في التكوينيات مدار العناية الإلهية لا لحكم من ذواتها فلا حكم إلا لله .
ثم بين ثانيا لما سأله عن سبب عدم سجوده بقوله : {ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَ} أنه تعالى اهتم بأمر خلقته كل الاهتمام واعتنى به كل الاعتناء حيث خلقه بكلتا يديه بأي معنى فسرنا اليدين ، وهذا هو الفضل فأجاب لعنه الله بقوله : {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} فتعلق بأمر النار والطين ، وأهمل أمر تكبره على ربه كما أنه في هذه السورة سئل عن سبب تكبره على ربه إذ قيل له : {ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} فتعلق بقوله : {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} إلخ ، ولم يعتن بما سئل عنه أعني السبب في تكبره على ربه إذ لم يأتمر بأمره .
بلى قد اعتنى به إذ قال : {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} فأثبت لنفسه استقلال الإنية قبال الإنية الإلهية التي قهرت كل شيء فاستدعاه ذلك إلى نسيان كبريائه تعالى ووجد نفسه مثل ربه وأن له استقلالا كاستقلاله ، وأوجب ذلك أن أهمل وجوب امتثال أمره لأنه الله بل اشتغل بالمرجحات فوجد الترجيح للمعصية على الطاعة وللتمرد على الانقياد وليس إلا أن تكبره بإثبات الإنية المستقلة لنفسه أعمى بصره فوجد مادة نفسه وهي النار خيرا من مادة نفس آدم وهي الطين فحكم بأنه خير من آدم ، ولا ينبغي للفاضل أن يخضع بالسجود لمفضوله ، وإن أمر به الله سبحانه لأنه يسوي بنفسه نفس ربه بما يرى لنفسه من استقلال وكبرياء كاستقلاله فيترك الآمر ويتعلق بالمرجحات في الأمر .
وبالجملة هو سبحانه الله الذي منه يبتدئ كل شيء وإليه يرجع كل شيء فإذا خلق شيئا وحكم عليه بالفضل كان له الفضل والشرف واقعا بحسب الوجود الخارجي وإذا خلق شيئا ثانيا وأمره بالخضوع للأول كان وجوده ناقصا مفضولا بالنسبة إلى ذلك الأول فإن المفروض أن أمره إما نفس التكوين الحق أو ينتهي إلى التكوين فقوله الحق والواجب في امتثال أمره أن يمتثل لأنه أمره لا لأنه مشتمل على مصلحة أو جهة من جهات الخير والنفع حتى يعزل عن ربوبيته ومولويته ويعود زمام الأمر والتأثير إلى المصالح والجهات ، وهي التي تنتهي إلى خلقه وجعله كسائر الأشياء من غير فرق .
فجملة ما تدل عليه آيات القصة أن إبليس إنما عصى واستحق الرجم بالتكبر على الله في عدم امتثال أمره ، وأن الذي أظهر به تكبره هو قوله : {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ} وقد تكبر فيه على ربه كما تقدم بيانه وإن كان ذلك تكبرا منه على آدم حيث إنه فضل نفسه عليه واستصغر أمره وقد خصه الله بنفسه وأخبرهم بأنه أشرف منهم في حديث الخلافة وفي قوله : {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} وقوله : {خَلَقْتُ بِيَدَيَ} إلا أن العناية في الآيات باستكباره على الله لا استكباره على آدم .
ومن الدليل على ذلك قوله تعالى : {وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ} [الكهف : 50] حيث لم يقل : فاستنكف عن الخضوع لآدم بل إنما ذكر الفسق عن أمر الرب تعالى .
فتلخص أن آيات القصة إنما تعتني بمسألة استعلائه على ربه ، وأما استكباره على آدم وما احتج به على ذلك فذلك من المدلول عليه بالتبع ، والظاهر أنه هو السر في عدم التعرض للجواب عن حجته صريحا إلا ما يؤمي إليه بعض أطراف الكلام كقوله : {خَلَقْتُ بِيَدَيَ} وقوله : {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي} وغير ذلك .
فإن قلت : القول بكون الأمر بالسجود تكوينيا ينافي ما تنص عليه الآيات من معصية إبليس فإن القابل للمعصية والمخالفة إنما هو الأمر التشريعي وأما الأمر التكويني فلا يقبل المعصية والتمرد البتة فإنه كلمة الإيجاد الذي لا يتخلف عنه الوجود قال : {إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل : 40] .
قلت : الذي ذكرناه آنفا أن القصة بما تشتمل عليه بصورتها من الأمر والامتثال والتمرد والطرد وغير ذلك وإن كانت تتشبه بالقضايا الاجتماعية المألوفة فيما بيننا لكنها تحكي عن جريان تكويني في الروابط الحقيقية التي بين الإنسان والملائكة وإبليس فهي في الحقيقة تبين ما عليه خلق الملائكة وإبليس وهما مرتبطان بالإنسان ، وما تقتضيه طبائع القبيلين بالنسبة إلى سعادة الإنسان وشقائه ، وهذا غير كون الأمر تكوينيا .
فالقصة قصة تكوينية مثلت بصورة نألفها من صور حياتنا الدنيوية الاجتماعية كملك من الملوك أقبل على واحد من عامة رعيته لما تفرس منه كمال الاستعداد وتمام القابلية فاستخلصه لنفسه وخصه بمزيد عنايته ، وجعله خليفته في مملكته مقدما له على خاصته ممن حوله فأمرهم بالخضوع لمقامه والعمل بين يديه فلباه في دعوته وامتثال أمره جمع منهم ، فرضي عنهم بذلك وأقرهم على مكانتهم ، واستكبر بعضهم فخطأ الملك في أمره فلم يمتثله معتلا بأنه أشرف منه جوهرا وأغزر عملا فغضب عليه وطرده عن نفسه وضرب عليه الذلة والصغار لأن الملك إنما يطاع ملك بيده زمام الأمر وإليه إصدار الفرامين والدساتير ، وليس يطاع لأن ما أمر به يطابق المصلحة الواقعية فإنما ذلك شأن الناصح الهادي إلى الخير والرشد .
وبالتأمل في هذا المثل ترى أن خاصة الملك ـ أعم من المطيع والعاصي ـ كانوا متفقين قبل صدور الأمر في منزلة القرب مستقرين في مستوى الخدمة وحظيرة الكرامة من غير أي تميز بينهم حتى أتاهم الأمر من ذي العرش فينشعب الطريق عند ذلك إلى طريقين ويتفرقون طائفتين : طائفة مطيعة مؤتمرة ، وأخرى عاصية مستكبرة وتظهر من الملك بذلك سجاياه الكامنة ووجوه قدرته وصور إرادته من رحمة وغضب وتقريب وتبعيد وعفو ومغفرة وأخذ وانتقام ووعد ووعيد وثواب وعقاب ، والحوادث كالمحك يظهر باحتكاكه جوهر الفلز ما عنده من جودة أو رداءة .
فقصة سجود الملائكة وإباء إبليس تشير إلى حقائق تشابه بوجه ما يتضمنه هذا المثل من الحقائق والأمر بالسجدة فيها تشريفه تعالى آدم بقرب المنزلة ونعمة الخلافة وكرامة الولاية تشريفا أخضع له الملائكة وأبعد منه إبليس لمضادة جوهر السعادة الإنسانية فصار يفسد الأمر عليه كلما مسه ويغويه إذا اقترب منه كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله .
وقد عبر الله سبحانه عن إنفاذه أمر التكوين في مواضع من كلامه بلفظ الأمر أو ما يشبه ذلك كقوله : {فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ} [حم السجدة : 11] ، وقوله : {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها} [الأحزاب : 72] وأشمل من الجميع قوله : {إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [يس : 82] .
فإن قلت : رفع اليد عن ظاهر القصة وحملها على جهة التكوين المحضة يوجب التشابه في عامة كلامه تعالى ، ولا مانع حينئذ يمنع من حمل معارف المبدإ والمعاد بل والقصص والعبر والشرائع على الأمثال ، وفي تجويز ذلك إبطال للدين .
قلت : إنما المتبع هو الدليل فربما دل على ثبوتها وعلى صراحتها ونصوصيتها كالمعارف الأصلية والاعتقادات الحقة وقصص الأنبياء والأمم في دعواتهم الدينية والشرائع والأحكام وما تستتبعه من الثواب والعقاب ونظائر ذلك ، وربما دل الدليل وقامت شواهد على خلاف ذلك كما في القصة التي نحن فيها ، ومثل قصة الذر وعرض الأمانة وغير ذلك مما لا يستعقب إنكار ضروري من ضروريات الدين ، ولا يخالف آية محكمة ولا سنة قائمة ولا برهانا يقينيا .
والذي ذكره إبليس في مقام الاحتجاج : {أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} من القياس وهو استدلال ظني لا يعبأ به في سوق الحقائق ، وقد ذكر المفسرون وجوها كثيرة في الرد عليه لكنك عرفت أن القرآن لم يعتن بأمره ، وإنما أخذ الله إبليس باستكباره عليه في مقام ليس له فيه إلا الانقياد والتذلل ، ولذلك أغمضنا عن التعرض لما ذكروه .
قوله تعالى : {قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ} التكبر هو أخذ الإنسان مثلا الكبر لنفسه وظهوره به على غيره فإن الكبر والصغر من الأمور الإضافية ، ويستعمل في المعاني غالبا فإذا أظهر الإنسان بقول أو فعل أنه أكبر من غيره شرفا أو جاها أو نحو ذلك فقد تكبر عليه وعده صغيرا ، وإذ كان لا شرف ولا كرامة لشيء على شيء إلا ما شرفه الله وكرمه كان التكبر صفة مذمومة في غيره تعالى على الإطلاق إذ ليس لما سواه تعالى إلا الفقر والمذلة في أنفسهم من غير فرق بين شيء وشيء ولا كرامة إلا بالله ومن قبله ، فليس لأحد من دون الله أن يتكبر على أحد ، وإنما هو صفة خاصة بالله سبحانه فهو الكبير المتعال على الإطلاق فمن التكبر ما هو حق محمود وهو الذي لله عز اسمه أو ينتهي إليه بوجه كالتكبر على أعداء الله الذي هو في الحقيقة اعتزاز بالله ، ومنه ما هو باطل مذموم وهو الذي يوجد عند غيره بدعوى الكبر لنفسه لا بالحق .
والصاغرين جمع صاغر من الصغار وهو الهوان والذلة ، والصغار في المعاني كالصغر في الصور ، وقوله : {فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ} تفسير وتأكيد لقوله {فَاهْبِطْ مِنْها} لأن الهبوط هو خروج الشيء من مستقره نازلا فيدل ذلك على أن الهبوط المذكور إنما كان هبوطا معنويا لا نزولا من مكان جسماني إلى مكان آخر ، ويتأيد به ما تقدم أن مرجع الضمير في قوله : {مِنْها} وقوله : {فِيها} هو المنزلة دون السماء أو الجنة إلا أن يرجعا إلى المنزلة بوجه .
والمعنى : قال الله تعالى : فتنزل عن منزلتك حيث لم تسجد لما أمرتك فإن هذه المنزلة منزلة التذلل والانقياد لي فما يحق لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين أهل الهوان ، وإنما أخذ بالصغار ليقابل به التكبر .
قوله تعالى : {قالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ} استمهال وإمهال ، وقد فصل الله تعالى ذلك في موضع آخر بقوله : {قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ} [الحجر : 38] ، [ص : 81] ، ومنه يعلم أنه أمهل بالتقييد لا بالإطلاق الذي ذكره فلم يمهل إلى يوم البعث بل ضرب الله لمهلته أجلا دون ذلك وهو يوم الوقت المعلوم ، وسيجيء الكلام فيه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى .
فقوله تعالى : {إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ} إنما يدل على إجمال ما أمهل به ، وفيه دلالة على أن هناك منظرين غيره .
واستمهاله إلى يوم البعث يدل على أنه كان من همه أن يديم على إغواء هذا النوع في الدنيا وفي البرزخ جميعا حتى تقوم القيامة فلم يجبه الله سبحانه إلى ما استدعاه بل لعله أجابه إلى ذلك إلى آخر الدنيا دون البرزخ فلا سلطان له في البرزخ سلطان الإغواء والوسوسة وإن كان ربما صحب الإنسان بعد موته في البرزخ مصاحبة الزوج والقرين كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى : {وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ} [الزخرف : 39] ، وظاهر قوله : {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ} [الصافات : 22] .
قوله تعالى : {قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ} إلى آخر الآية . الإغواء هو الإلقاء في الغي والغي والغواية هو الضلال بوجه والهلاك والخيبة ، والجملة أعني قوله : {أَغْوَيْتَنِي} وإن فسر بكل من هذه المعاني على اختلاف أنظار المفسرين غير أن قوله تعالى في سورة الحجر فيما حكاه عنه : {قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} يؤيد أن مراده هو المعنى الأول ، والباء في قوله : {فَبِما} للسببية أو المقابلة ، والمعنى : فبسبب إغوائك إياي أو في مقابلة إغوائك إياي لأقعدن لهم إلخ ، وقد أخطأ من قال : إنها للقسم وكان القائل أراد أن يطبقه على قوله تعالى في موضع آخر حكاية عنه : {قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} [ص : 82] .
وقوله : {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} أي لأجلسن لأجلهم على صراطك المستقيم وسبيلك السوي الذي يوصلهم إليك وينتهي بهم إلى سعادتهم لما أن الجميع سائرون إليك سالكون لا محالة مستقيم صراطك فالقعود على الصراط المستقيم كناية عن التزامه والترصد لعابريه ليخرجهم منه .
وقوله : {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ} بيان لما يصنعه بهم وقد كمن لهم قاعدا على الصراط المستقيم ، وهو أنه يأتيهم من كل جانب من جوانبهم الأربعة .
وإذ كان الصراط المستقيم الذي كمن لهم قاعدا عليه أمرا معنويا كانت الجهات التي يأتيهم منها معنوية لا حسية والذي يستأنس من كلامه تعالى لتشخيص المراد بهذه الجهاد كقوله تعالى : {يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً} [النساء : 120] ، وقوله : {إِنَّما ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ} [آل عمران : 175] وقوله : {وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ} [البقرة : 168] ، وقوله : {الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ} [البقرة 268] إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة هو أن المراد مما بين أيديهم ما يستقبلهم من الحوادث أيام حياتهم مما يتعلق به الآمال والأماني من الأمور التي تهواه النفوس وتستلذه الطباع ، ومما يكرهه الإنسان ويخاف نزوله به كالفقر يخاف منه لو أنفق المال في سبيل الله أو ذم الناس ولومهم لو ورد سبيلا من سبل الخير والثواب .
والمراد بخلقهم ناحية الأولاد والأعقاب فللإنسان فيمن يخلفه بعده من الأولاد آمال وأماني ومخاوف ومكاره فإنه يخيل إليه أنه يبقى ببقائهم فيسره ما يسرهم ويسوؤه ما يسوؤهم فيجمع المال من حلاله وحرامه لأجلهم ، ويعد لهم ما استطاع من قوة فيهلك نفسه في سبيل حياتهم .
والمراد باليمين وهو الجانب القوي الميمون من الإنسان ناحية سعادتهم وهو الدين وإتيانه من جانب اليمين أن يزين لهم المبالغة في بعض الأمور الدينية ، والتكلف بما لم يأمرهم به الله وهو الذي يسميه الله تعالى باتباع خطوات الشيطان .
والمراد بالشمال خلاف اليمين ، وإتيانه منه أن يزين لهم الفحشاء والمنكر ويدعوهم إلى ارتكاب المعاصي واقتراف الذنوب واتباع الأهواء .
قال الزمخشري في الكشاف : فإن قلت : كيف قيل : {مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ} بحرف الابتداء ، و {عَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ} بحرف المجاوزة ؟ قلت : المفعول فيه عدي إليه الفعل نحو تعديته إلى المفعول به فكما اختلفت حروف التعدية في ذاك اختلفت في هذا وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس ، وإنما يبحث عن صحة موقعها فقط .
فلما سمعناهم يقولون : جلس عن يمينه وعلى يمينه وجلس عن شماله وعلى شماله قلنا :معنى على يمينه أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلى عليه ، ومعنى عن يمينه أنه جلس متجافيا عن صاحب اليمين منحرفا عنه غير ملاصق له ثم كثر حتى استعمل في المتجافي وغيره كما ذكرنا في {تعال} ، انتهى موضع الحاجة .
وقوله تعالى : {وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ} نتيجة ما ذكره من صنعه بهم بقوله : {لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ} إلخ ، وقد وضع في ما حكاه الله من كلامه في غير هذا الموضع بدل هذه الجملة أعني {وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ} جملة أخرى قال : {قالَ أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلاً} [إسراء : 62] فاستثنى من وسوسته وإغوائه القليل مطابقا لما في هذه السورة ، وقال : {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} [الحجر : 40] ، [ص : 83] .
ومنه يظهر أنه إنما عنى بالشاكرين في هذا الموضع المخلصين ، والتأمل الدقيق في معنى الكلمتين يرشد إلى ذلك فإن المخلصين ـ بفتح اللام ـ هم الذين أخلصوا لله فلا يشاركه فيهم أي في عبوديتهم وعبادتهم سواه ، ولا نصيب فيهم لغيره ، ولا يذكرون إلا ربهم وقد نسوا دونه كل شيء حتى أنفسهم فليس في قلوبهم إلا هو سبحانه ، ولا موقف فيها للشيطان ولا لتزييناته .
والشاكرون هم الذين استقرت فيهم صفة الشكر على الإطلاق فلا يمسون نعمة إلا بشكر أي بأن يستعملوها ويتصرفوا فيها قولا أو فعلا على نحو يظهرون به أنها من عند ربهم المنعم بها عليهم فلا يقبلون على شيء ـ أعم من أنفسهم وغيرهم ـ إلا وهم على ذكر من ربهم قبل أن يمسوه ومعه وبعده ، وأنه مملوك له تعالى طلقا ليس له من الأمر شيء فذكرهم ربهم على هذه الوتيرة ينسيهم ذكر غيره إلا بالله ، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه .
فلو أعطي اللفظ حق معناه لكان الشاكرون هم المخلصين ، واستثناء إبليس الشاكرين أو المخلصين من شمول إغوائه وإضلاله جرى منه على حقيقة الأمر اضطرارا ولم يأت به جزافا أو امتنانا على بني آدم أو رحمة أو لغير ذلك .
فهذا ما واجه إبليس به مصدر العزة والعظمة أعني قوله : {فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} ـ إلى قوله ـ {وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ} فأخبر أنه يقصدهم من كل جهة ممكنة ، ويفسد الأمر على أكثرهم بإخراجهم عن الصراط المستقيم ، ولم يبين نحو فعله وكيفية صنعه .
لكن في كلامه إشارة إلى حقيقتين : إحداهما : أن الغواية التي تمكنت في نفسه وهو ينسبها إلى صنع الله هي السبب لإضلاله وإغوائه لهم أي إنه يمسهم بنفسه الغوية فلا يودع فيهم إلا الغواية كالنار التي تمس الماء بسخونتها فتسخنه ، وهذه الحقيقة ظاهرة من قوله تعالى : {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواجَهُمْ} ـ إلى أن قال ـ {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ قالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنا عَنِ الْيَمِينِ قالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ} ـ إلى أن قال ـ {فَأَغْوَيْناكُمْ إِنَّا كُنَّا غاوِينَ} [الصافات : 32].
والثانية : أن الذي يمسه الشيطان من بني آدم ـ وهو نوع عمله وصنعه ـ هو الشعور الإنساني وتفكره الحيوي المتعلق بتصورات الأشياء والتصديق بما ينبغي فعله أو لا ينبغي ، وسيجيء تفصيله في الكلام في إبليس وعمله .
قوله تعالى : {قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ} ( إلخ ) المذءوم من ذامه يذامه ويذيمه إذا عابه وذمه ، والمدحور من دحره إذا طرده ودفعه بهوان .
وقوله : {لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ} إلخ ، اللام للقسم وجوابه هو قوله : {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ} إلخ ، لما كان مورد كلام إبليس ـ وهو في صورة التهديد بالانتقام ـ هو بني آدم وأنه سيبطل غرض الخلقة فيهم وهو كونهم شاكرين أجابه تعالى بما يفعل بهم وبه فقال : {لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ} محاذاة لكلامه ثم قال : {لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ} أي منك ومنهم فأشركه في الجزاء معهم .
وقد امتن تعالى في كلمته هذه التي لا بد أن تتم فلم يذكر جميع من تبعه بل أتى بقوله : {مِنْكُمْ} وهو يفيد التبعيض .
________________________
1. تفسير الميزان ، ج8 ، ص 17-29 .
قصّة عصيان إبليس :
لقد أشير إلى مسألة خلق الإنسان وكيفية إيجاده في سبع سور من سور القرآن الكريم ، والهدف من ذكر هذا الموضوع ـ كما سبق أن أشرنا في الآية السابقة ـ هو بيان شخصية الإنسان ، ومقامه ، ومنزلته بين كائنات العالم ، وبعث روح الشكر والحمد فيه .
لقد جاء ذكر خلق الإنسان من التراب ، وسجود الملائكة له ، وتمرّد الشيطان وعصيانه ، ثمّ موقفه تجاه النوع الإنساني في هذه السور بتعابير مختلفة .
وفي الآية المبحوثة الآن يقول الله تعالى : {وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) جدّكم الأوّل ، ومن المأمورين بالسجود إبليس الذين كان موجودا في صفوفهم وإن لم يكن منهم ، فامتثلوا لهذا الأمر جميعا وسجدوا لآدم إلّا إبليس : (فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} .
ويمكن أن يكون ذكر «الخلق» في الآية الحاضرة قبل «التصوير» إشارة إلى : أنّنا أوجدنا المادة الأصلية للإنسان أوّلا ، ثمّ أفضنا عليها الصورة الإنسانية .
كما قلنا في ذيل الآية (34) من سورة البقرة : إنّ سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة ، لأن العبادة مخصوصة الله سبحانه ، بل السجدة هنا بمعنى التواضع (أي الخضوع أمام عظمة آدم وسموّ منزلته في عالم الخليقة) أو بمعنى السجود لله الذي خلق مثل هذا المخلوق المتعادل المتوازن .
إنّ «إبليس» ـ كما قلنا في ذيل تلك الآية ـ لم يكن من الملائكة ، بل هو حسب صريح الآيات القرآنية من قسم آخر من الكائنات يدعى «الجنّ» (وللمزيد من التوضيح راجع المجلد الأوّل من هذا التّفسير في الحديث عن سجود الملائكة لآدم) .
في الآية اللاحقة يقول تعالى : أنه أخذ إبليس على عصيانه وطغيانه ، و {قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} . فتذرع ـ في مقام الجواب ـ بعذر غير وجيه إذ : {قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} .
وكأن إبليس كان يتصوّر أنّ النّار أفضل من التراب ، وهذه هي أكبر غلطاته وأخطائه ، ولعلّه لم يقل ذلك عن خطأ والتباس ، بل كذب عن وعي وفهم ، لأنّنا نعلم أنّ التراب مصدر أنواع البركات ، ومنبع جميع المواد الحياتية ، وأهم وسيلة لمواصلة الموجودات الحية حياتها ، على حين أن الأمر بالنسبة إلى النّار ليس على هذا الشكل .
صحيح أنّ النّار أحد عوامل التجزئة والتركيب في الكائنات الموجودة في هذا الكون ، ولكن الدور الأصلي والأساسي هو للمواد الموجودة في التراب ، وتعدّ النّار وسيلة لتكميلها فقط .
وصحيح ـ أيضا ـ أنّ الكرة الأرضية انفصلت ـ في بداية أمرها ـ عن الشمس ، وكانت على هيئة كرة نارية فبردت تدريجا ، ولكن يجب أن نعلم أن الأرض ما دامت مشتعلة ، وحارة لم يكن عليها أي كائن حيّ ، وإنّما ظهرت الحياة على سطح هذا الكرة عند ما حلّ التراب والطين محل النّار .
هذا مضافا إلى أنّ أية نار ظهرت على سطح الأرض كان مصدرها مواد مستفادة من التراب ، ثمّ إنّ التراب مصدر نموّ الأشجار ، والأشجار مصدر ظهور النّار ، وحتى المواد النفطية أو الدهون القابلة للاشتعال والاحتراق تعود ـ أيضا ـ إلى التراب أو إلى الحيوانات التي تتغذى من المواد النباتية .
على أنّ ميزة الإنسان ـ بغض النظر عن كل هذه الأمور ـ لم تكن في كونه من التراب ، بل إنّ ميزته الأصلية تكمن في «الروح الإنسانية» وفي خلافته لله تعالى .
وعلى فرض أنّ مادة الشيطان الأصلية كانت أفضل من مادة الإنسان ، فإن ذلك لا يعني تسويغ عدم السجود للإنسان الذي خلق بتلك الروح ، ووهبه الله تلك العظمة ، وجعله خليفة له على الأرض .
والظاهر أنّ الشيطان كان يعرف بكل هذه الأمور ، ولكن التكبر ، والأنانية هما اللذان منعاه عن امتثال أمر الله ، وكان ما أتى به من العذر حجة داحضة ، ومحض تحجج وتعلّل .
أوّل قياس هو قياس الشيطان :
القياس في الأحكام والحقائق الدينية مرفوض بشكل قاطع في أحاديث عديدة وردت عن أهل البيت عليهم السلام ، ونقرأ في هذه الأحاديث أنّ أوّل من قاس هو الشيطان .
قال الإمام الصادق عليه السلام لأبي حنيفة : «لا تقس ، فإن أوّل من قاس إبليس» (2) .
وقد روي هذا المطلب في تفاسير أهل السنة قديما وحديثا مثل تفسير «الطبري» عن «ابن عباس» وتفسير المنار و «ابن سيرين» و «الحسن البصري» (3) .
والمراد من القياس هو أن نقيس موضوع على آخر يتشابهان من بعض الجهات ، ونحكم للثّاني بنفس الحكم الموجود للموضوع الأوّل من دون أن نعرف فلسفة الحكم وأسراره كاملا ، كأن نقيس «بول» الإنسان المحكوم بالنجاسة ، ووجوب الاجتناب عنه بعرق الإنسان ، ونقول : بما أنّ هذين الشيئين يتشابهان من بعض الجهات وفي بعض الأجزاء ، لهذا يسري حكم الأوّل إلى الثاني فيكون كلاهما نجسين ، في حين أنّهما حتى لو تشابها من جهات فهما متفاوتان مختلفان من جهات أخرى أيضا ، فأحدهما أرق والآخر أغلظ ، والاجتناب من أحدهما سهل ، ومن الآخر صعب وشاق جدّا ، هذا مضافا إلى أنه ليست فلسفة الحكم الأوّل معلومة لنا بالكامل ، فمثل هذا القياس ليس سوى قياس تخميني لا أكثر .
ولهذا السبب منع أئمّتنا عليهم السلام من القياس بشدّة ، استلهاما من كلام النّبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبطلوه ، لأنّ فتح باب القياس يتسبب في أن يعمد كل أحد بالاعتماد على دراسته المحدودة وفكره القاصر وبمجرّد أن يعتبر موضوعين متساويين من بعض الجهات . . . أن يعمد إلى إجراء حكم الأوّل على الثاني ، وبهذا تتعرض قوانين الشرع وأحكام الدين إلى الهرج والمرج .
إنّ بطلان القياس عقلا ليس مقصورا على القوانين الدينية فحسب ، فالأطباء هم أيضا يؤكّدون في توصياتهم على أن لا تعطى وصفة أيّ مريض لمريض آخر مهما تشابها من بعض النواحي ، وفلسفة هذا النهي واضحة ، لأنّه قد يتشابه المريضان في نظرنا من بعض النواحي ، ولكن مع ذلك يتفاوتان من جهات عديدة ، مثلا من جهة القدرة على تحمّل الدواء ، وفئة الدم ، ومقدار السكر في الدم ، ولا يستطيع الأشخاص العادّيون من الناس أن يشخّصوا هذه الأمور ، بل تشخيصها يختص بالأطباء وذوي الاختصاص في الطب ، فلو أعطيت أدوية مريض لآخر دون ملاحظة هذه الخصوصيات ، فمضافا إلى احتمال عدم الانتفاع بها ، فإنّها ربّما تكون منشأ لسلسلة من الأخطار غير القابلة للجبران .
والأحكام الإلهية أدقّ من هذه الجهة ، ولهذا جاء في الأحاديث والأخبار أنه لو عمل بالقياس لمحق الدين ، أو كان فساده أكثر من صلاحه (3) .
أضف إلى ذلك أنّ اللجوء إلى القياس لاكتشاف الأحكام ومعرفتها دليل على قصور الدين ، لأنّه إذا كان لكل موضوع حكم في الدين لم يكن أية حاجة إلى القياس ، ولهذا فإنّ الشيعة حيث أنّهم أخذوا جميع احتياجاتهم من الأحكام الدينية من مدرسة أهل البيت ورثة النّبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم يروا حاجة إلى اللجوء إلى القياس ، ولكن فقهاء السنة حيث أنّهم تجاهلوا مدرسة أهل البيت الذين هم حسب نص النّبي الملجأ الثّاني للمسلمين بعد القرآن الكريم لذلك واجهوا نقصا في مصادر الأحكام الإسلامية وأدلتها ، ولم يروا مناصا من اللجوء إلى القياس .
لماذا كان الشيطان أول من قال بالقياس ؟
وأمّا في مورد الشيطان ، فنحن نقرأ في النصوص والرّوايات أنّه كان أوّل من قاس ، والنكتة فيها أنّه قاس خلقته ـ من الناحية المادية ـ بخلقة آدم ، وتمسك بأفضلية النّار على التراب في بعض الجهات ، واعتبر ذلك دليلا على أفضلية النّار من جميع النواحي ، من دون أن يلتفت إلى امتيازات التراب ، بل ومن دون أن يلتفت إلى امتيازات آدم الروحانية والمعنوية ، فحكم على طريق ما يسمّى بقياس الأولوية ، ولكن قياسا على أساس التخمين والظن والدراسة السطحية والمحدودة ، بأفضليته على آدم ، بل ودفعه هذا القياس الباطل إلى تجاهل الأمر الإلهي .
والملفت للنظر أنّه ورد في بعض الرّوايات المروية عن الإمام الصادق عليه السلام في مؤلفات الشيعة والسنة معا أنه قال : «من قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس» (4) .
وباختصار ، إنّ قياس موضوع بموضوع آخر من دون علم بجميع أسراره وفلسفته ، لا يصح أن يكون دليلا على اتحاد حكمهما ، ولو أنّ القياس تطرق إلى مسائل الدين وقضايا الشريعة لم تبق للأحكام ضابطة ثابتة ، إذ يمكن حينئذ أن يقيس شخص ما موضوعا بنحو ، ويصدر حكما بحرمته ، ويقيس شخص آخر الموضوع نفسه بنحو آخر ويصدر حكما بحليّته .
قياس منصوص العلة :
والمورد الوحيد الذي يمكن استثناؤه من هذا الأمر هو ما إذا ذكر المقنّن أو الطبيب نفسه دليل حكمه وفلسفة قانونه ، ففي هذه الحالة يجوز لنا إذا رأينا هذا الدليل وهذه الفلسفة في موضوع آخر أن نجري الحكم فيه ونعدّيه إليه أيضا ، وهذا هو ما اصطلح عليه بالقياس «المنصوص العلّة» مثلا : إذا قال الطبيب للمريض : يجب أن تتجنب تناول الفاكهة الفلانية لأنّها حامضة ، علم المريض بأنّ الحموضة تضرّه ، وأنّه يجب أن يتجنب الحموضة وإن كان في فاكهة أخرى .
وهكذا إذا صرّح القرآن الكريم أو صرّحت السنّة الشريفة بأن : تجنّبوا الخمر لأنّه مسكر ، علمنا أنّ كل مسكر حرام (وإن لم يكن خمرا) ويجب اجتنابه .
إنّ هذا القياس ليس باطلا ولا ممنوعا ، لأنّه معلوم الدليل ومنصوص العلّة مقطوع بها والقياس الممنوع هو فيما إذا لم نعلم بدليل الحكم وفلسفته بصورة القطع ومن جميع الجهات .
على أن مبحث القياس مبحث واسع الأطراف ، وما مضى من البحث ما إلّا هو عصارة منه ، ولمزيد التوضيح والاطلاع راجعوا كتب أصول الفقه وكتب الأخبار ، باب القياس ، ونحن نختم البحث الحاضر بذكر حديث في هذا المجال .
جاء في كتاب «علل الشرائع» دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق عليه السلام فقال له : «يا أبا حنيفة ، بلغني أنّك تقيس ؟ قال : نعم ، أنا أقيس . قال : لا تقس فإنّ أوّل من قاس إبليس حين قال : خلقتني من نار وخلقته من طين فقاس ما بين النّار والطين ، ولو قاس نورية آدم بنورية النّار عرف فضل من بين النّورين وصفاء أحدهما على الآخر» (5) .
كيف خاطب الشيطان الله تعالى :
بقي هنا سؤال وهو : كيف كان يتحدث الشيطان مع الله ، فهل كان ينزل عليه الوحي ؟
الجواب هو : أنّ كلام الله لا يكون بالوحي دائما ، فالوحي عبارة عن رسالة النبوّة ، فلا مانع من أن يكلّم الله أحدا لا بعنوان الوحي والرسالة ، بل عن طريق الباطني أو بواسطة بعض الملائكة ، سواء كان من يحادثه الله من الصالحين الأبرار مثل مريم وأمّ موسى ، أو من غير الصالحين مثل الشيطان !
ولنعد الآن إلى تفسير بقية الآيات : حيث أن امتناع الشيطان من السجود لآدم عليه السلام لم يكن امتناعا بسيطا وعاديا ولم يكن معصية عادّية ، بل كان تمرّدا مقرونا بالاعتراض والإنكار للمقام الربوبي ، لأنّه قال : أنا أفضل منه ، وهذه الجملة تعني في حقيقة الأمر أن أمرك بالسجود لآدم أمر مخالف للحكمة والعدالة وموجب لتقديم «المرجوح» على «الراجح» لهذا فإنّ مخالفته كانت تعني الكفر وإنكار العلم والحكمة الإلهيين ، فوجب أن يخسر جميع مراتبه ودرجاته ، وبالتالي كل ما له من مكانة عند الله ، ولهذا أخرجه الله من ذلك المقام الكريم ، وجرّده من تلك المنزلة السامقة التي كان يتمتع بها في صفوف الملائكة ، فقال له : {فَاهْبِطْ مِنْها} .
وقد ذهب جمع من المفسّرين في ضمير «منها» إلى إرجاعه إلى «السماء» أو «الجنّة» وذهب آخرون إلى إرجاعها إلى «المنزلة الدرجة» ، وهما لا يختلفان كثيرا من حيث النتيجة .
ثمّ إنّه تعالى شرح له منشأ هذا السقوط والتنزّل بالعبارة التّالية : {فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها} .
وأضاف للتأكيد قائلا : {فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ} يعني إنّك بعملك وموقفك هذا لم تصبح كبيرا ، بل على العكس من ذلك أصبته بالصغار والذلة .
إنّ هذه الجملة توضح بجلاء أن شقاء الشيطان كله كان وليد تكبره ، وإن أنانيته هذه التي جعلته يري نفسه أفضل ممّا هو ، هي التي تسببت في أن لا يكتفي بعدم السجود لأدم ، بل وينكر علم الله وحكمته ، ويعترض على أمر الله ، وينتقده ، فخسر على أثر ذلك منزلته ومكانته ، ولم يحصد من موقفه إلّا الذلة والصغار بدل العظمة وهذه يعني أنّه لم يصل إلى هدفه فحسب ، بل بات على العكس من ذلك .
ونحن نقرأ في نهج البلاغة «الخطبة القاصعة» في كلام أمير المؤمنين عليه السلام عند ذمّه للتكبر والعجب ما يلي : «فاعتبروا بما فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل ، وجهده الجهيد ، وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة . . . عن كبر ساعة واحدة ، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا ، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنّة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا ، إنّ حكمه في أهل السماء وأهل الأرض الواحد» (6) .
وقد جاء أيضا عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أنّه قال : «إنّ للمعاصي شعبا فأوّل ما عصي الله به الكبر ، وهي معصية إبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين ، والحرص وهي معصية آدم وحواء . . . ثمّ الحسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله» (7) .
وكذا نقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : «أصول الكفر ثلاثة : الحرص والاستكبار والحسد ، فأمّا الحرص فإن آدم حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن أكل منها ، وأمّا الاستكبار فإبليس حيث أمر بالسجود لآدم فأبى ، وأمّا الحسد فإبنا آدم حيث قتل أحدهما صاحبه» (8) .
ولكن قصّة الشيطان لم تنته إلى هذا الحدّ ، فهو عند ما عرف بأنه صار مطرودا من حضرة ذي الجلال زاد من طغيانه ولجاجته ، وبدل أن يتوب ويثوب إلى الله ويعترف بخطئه فإنّ الشيء الوحيد الذي طلبه من الله تعالى هو أن يمهله ويؤجّل موته إلى يوم القيامة : {قالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} .
ولقد استجاب الله لهذا الطلب ، ف {قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ} .
إنّ هذه الآيات وان لم تصرّح بالمقدار الذي استجيب من طلب الشيطان من حيث الزمن ، إلّا أننا نقرأ في الآية (3) من سورة الحجر أنه تعالى قال له : {فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ} وهذا يعني أن مطلب الشيطان لم يستجب له بتمامه وكماله ، بل استجيب إلى الوقت الذي يعلمه الله تعالى (وسوف نبحث عند تفسير الآية (3) من سورة الحجر حول معنى قوله {إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ} إن شاء الله .
غير أنّ الشيطان لم يبغ من مطلبه هذا (أي الإمهال الطويل) الحصول على فرصة لجبران ما فات منه أو ليعمّر طويلا ، إنّما كان هدفه من ذلك هو إغواء بني البشر و {قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ} أي لأغوينهم كما غويت ، ولأضلنّهم كما ضللت .
إبليس أوّل القائلين بالجبر :
يستفاد من الآية الحاضرة أن الشيطان لتبرئة نفسه نسب إلى الله الجبر إذ قال : {فَبِما أَغْوَيْتَنِي} لأغوينهم .
بعض المفسّرين أصرّ على تفسير جملة {فَبِما أَغْوَيْتَنِي} بنحو لا يفهم منه الجبر ، إلّا أن الظاهر هو أنه لا موجب لمثل هذا الإصرار . وشاهد هذا القول هو ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : «كان أمير المؤمنين جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفّين إذا أقبل شيخ فجثا بين يديه ثمّ قال له : يا أمير المؤمنين : أخبرنا عن مسيرنا إلى أهل الشام أبقضاء الله وقدره؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : «أجل مه يا شيخ ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد إلّا بقضاء من الله وقدر» .
فقال له الشّيخ : عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين .
فقال له عليه السلام : «يا شيخ فو الله لقد عظم الله تعالى لكم الأجر في مسيرتكم وأنتم سائرون وفي مقامكم وأنتم مقيمون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين» .
فقال له الشيخ : وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا . (فاستفاد السائل من هذه الإجابة الجبرية) .
فقال له عليه السلام : «أو تظن أنّه كان قضاء حتما وقدرا لازما أنّه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله تعالى وسقط معنى الوعد والوعيد فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب تلك مقالة اخوان عبدة الأوثان وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمّة ومجوسها . . .» (9) .
ومن هذا يتّضح أنّ أوّل من وقع في ورطة الاعتقاد بالجبر هو الشيطان .
ثمّ إنّ الشيطان أضاف ـ تأكيدا لقوله ـ بأنّه لن يكتفي بالقعود بالمرصاد لهم ، بل سيأتيهم من كل حدب وصوب ، ويسدّ عليهم الطريق من كل جانب {ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ} .
ويمكن أن يكون هذا التعبير كناية عن أنّ الشيطان يحاصر الإنسان من كل الجهات ويتوسل إلى إغوائه بكل وسيلة ممكنة ، ويسعى في إضلاله ، وهذا التعبير دارج في المحاورات اليومية أيضا ، فنقول : فلان حاصرته الديون أو الأمراض من الجهات الأربع .
وعدم ذكر الفوق والتحت إنّما هو لأجل أنّ الإنسان يتحرك عادة في الجهات الأربع المذكورة ، ويكون له نشاط في هذه الأنحاء غالبا .
ولقد نقل في حديث مروي عن الإمام الباقر عليه السلام تفسير أعمق لهذه الجهات الأربع حيث قال : «ثمّ قال : لآتينّهم من بين أيديهم ، معناه أهوّن عليهم أمر الآخرة ، ومن خلفهم ، آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقى لورثتهم . وعن أيمانهم ، أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين الشبهة . وعن شمائلهم ، بتحبيب اللذّات إليهم وتغليب الشّهوات على قلوبهم» (10) .
وفي آخر آية من الآيات المبحوثة هنا يصدر مرّة أخرى الأمر بخروج الشيطان من حريم القرب الإلهي والمقام الرفيع ، بفارق واحد هو أن الأمر بطرده هنا اتّخذ صورة أكثر ازدراء وتحقيرا ، وأشدّ عنفا ووقعا ، ولعلّ هذا كان لأجل العناد واللجاج الذي أبداه الشيطان بالإلحاح على الوسوسة للإنسان وإغوائه وإغرائه ، يعني أن موقفه الأثيم في البداية كان منحصرا في التمرد على أمر الله وعدم امتثاله ، ولهذا صدر الأمر بخروجه فقط ، ولكن عند ما أضاف معصية أكبر إلى معصيته بالعزم على إضلال الآخرين جاء الأمر المشدّد : {قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً} .
ثمّ حلف على أن يملأ جهنم منه ومن اتباعه {لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ} .
___________________________
1. تفسير الأمثل ، ج4 ، ص 312-321 .
2. نور الثقلين ، المجلد الثاني ، الصفحة 6 .
3. تفسير المنار ، المجلد 8 الصفحة 321 ، وتفسير الطبري ، الجزء 8 و 9 ، وتفسير القرطبي ، ج 4 الصفحة 2067 .
3. وسائل الشيعة ، المجلد 18 ، باب القياس .
4. تفسير المنار ، ج 8 ، ص 331 ونور الثقلين ، ج 2 ، ص 7 .
5. نور الثقلين ، ج 2 ، ص 6 ، وعلل الشرائع ، ص 86 .
6. إطلاق «الملك» على الشيطان إنما هو لأجل أنّه كان له مكان في صفوف الملائكة ، وكان رديفا لهم لا أنّه كان منهم ومن جنسهم كما قلنا سابقا .
7. سفينة البحار ، مادة كبر .
8. أصول الكافي ، ج 2 ، ص 219 ، باب أصول الكفر .
9. حق اليقين في معرفة اصول الدين ، ج 1 ، ص 72 .
10. تفسير مجمع البيان ، ج 4 ، ص 404 .
 الاكثر قراءة في سورة الأعراف
الاكثر قراءة في سورة الأعراف
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)