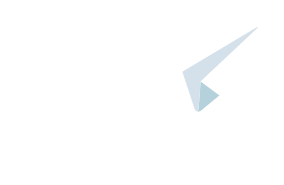تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم


علوم القرآن

أسباب النزول


التفسير والمفسرون


التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل


مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج


التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين


القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة


تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن


الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة


قصص قرآنية


قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله


سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة


حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية


العقائد في القرآن


أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية


التفسير الجامع


حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص


حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة


حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر


حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن


حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات


حرف الدال

سورة الدخان


حرف الذال

سورة الذاريات


حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن


حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة


حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ


حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح


حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف


حرف الضاد

سورة الضحى


حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق


حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر


حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية


حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق


حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش


حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون


حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل


حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد


حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس


حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة


حرف الواو

سورة الواقعة


حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس


آيات الأحكام

العبادات

المعاملات
الأقوال في تعيين مصداق العالم بالكتاب
المؤلف:
السيّد محمّد الحسين الحسينيّ الطهرانيّ
المصدر:
معرفة الإمام
الجزء والصفحة:
ج4/ص77-83
2025-12-07
552
قال الله الحكيم في كتابه الكريم: {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وبَيْنَكُمْ ومَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ}[1].
اتّفق علماء الشيعة على أنّ الذي عنده علم الكتاب في هذه الآية الكريمة هو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام. وأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مكلّف من قبل الله تعالى أن يقول للذين امتنعوا عن قبول القرآن والرسالة: أنّ أفضل شاهد بيني وبينكم على صدق دعواي وعلى أحقيّة القرآن هو الذات المقدّسة الربوبيّة، وأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام العالِم بكتاب الله، والمحيط بحقائقه وأسراره والخبير بدقائقه ولطائفه وظاهره وباطنه. وأجمعت الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام بلا أيّ خلاف في ذلك، أنّ الآية نزلت في عليّ عليه السلام. ووافقهم على ذلك جمع كثير من علماء العامّة، على الرغم من أنّ بعضهم قال بأنّ الذي عنده علم الكتاب، ذات الله نفسه، أو جبرئيل، أو علماء اليهود والنصارى العالمون بالتوراة والإنجيل، أو في خصوص عبد الله بن سلام الذي كان قد أسلم.
يقول أبو الفتوح الرازيّ: قال بعض المفسّرين: هو عبد الله بن سلام. ولكنّ أغلب المفسّرين من القدماء، والمحدّثين، وأهل الأخبار والأسناد والروايات من الموافقين والمخالفين ذهبوا إلى أنّ الذي عنده علم الكتاب، هو: أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب[2].
ويقول الزمخشريّ: المراد هو الذي عنده علم القرآن، وما ألف عليه من النظم المعجز الفائت لقوى البشر. ثمّ يبيّن سائر الاحتمالات والأقوال بقوله: و «قِيلَ»[3].
وقبل أن نخوض في الروايات المأثورة عن العامّة والخاصّة بشأن الآية، وكذلك قبل أن نتطرّق إلى الاجتماعات والأقوال المطروحة حول الآية، لا بدّ لنا من جولة مجملة في أجواء السورة المباركة التي تضمّ هذه الآية، وهي سورة الرعد، كي يتحدّد موقع هذه الآية، وفي هذه الجولة نفسها جواب تلقائيّ على بعض الاحتمالات أو الأقوال.
فقد نزلت هذه السورة لإثبات أحقيّة الكتاب الإلهيّ، وهو القرآن الكريم، حيال المنكرين الذين أنكروا القرآن بوصفه معجزة، وطلبوا من رسول الله معجزة اخرى محسوسة ومشهودة تنزل عليهم من السماء. وآيات هذه السورة من أوّلها حتى آخرها متّصلة ومترابطة فيما بينها كحبّات اللؤلؤ المنتظمة في خيط، إذ تؤلّف شكلًا خاصّاً وصورة جميلة أوّلها مرتبط بآخرها وآخرها ناظر ومرتبط بأوّلها. والآية المشار إليها واقعة في آخر السورة، وهي تتكفّل بالإجابة على جميع ما طرحه المشركون من مؤاخذات بحيث أنّنا لو رفعنا هذه الآية من السورة، فأنّ السورة تظلّ ناقصة كأنّها كأسٌ مثلوم، وتنحدر من ذروة عظمتها ورفعتها.
تبدأ الآية الاولى من السورة بهذا الخطاب: {المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ والَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ولكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ}.
وتنتقل بعد ذلك إلى ذكر الله الذي رفع السماوات بغير عمد مرئيّة واستوى على العرش، وسخّر الشمس والقمر كلٌّ يجري لأجلٍ مسمّى والذي مدّ الأرض، وجعل فيها رواسي وأنهاراً، وجعل فيها من كلّ الثمرات، وقسّم الأرض قطعاً متجاورات، وخلق فيها جنّات من أعناب ونخيل وزرع، تسقى بماء واحد. وهو الذي يحيى الموتى. وعجب قول المنكرين: {أَإِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} إلى أن تصل إلى الآية السابعة: {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ} (تنذر الناس من الشرك والكفر ومن العواقب الوخيمة للمعاصي والذنوب). {وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ}.
ويلاحظ هنا أنّ الكفّار لا يقرّون بالقرآن الكريم بوصفه معجزة وقد نزل بالحقّ، وهو معجزة حقّاً، فكانوا يبحثون عن معجزة اخرى من الامور الخارقة للعادة. ويجيبهم النبيّ الكريم بقوله: أنّ الإتيان بمعجزات اخرى خارقة للعادة كما تشتهون (وكما تريدون أن تلزموني بها من قبيل: تبديل الجبل ذهباً، أو إجراء نهر من الذهب المذاب، أو تبديل هذا البستان بستاناً من الجواهر واللآلئ، أو إحياء الموتى، أو نزول مَلَك من السماء ترونه، أو نزول كتاب سماويّ تلمسونه بأيدكم، كلّ هذه الأشياء التي تطلبونها مضافاً إلى أنّها غير صحيحة، فهي تستلزم التجسيم، وحلول الذات الإلهيّة في مكان معيّن. أنّ هذا اللون من المعجزات المتوالية لا يصبّ في مصلحة الإنسان. هذا مع أنّ معجزات قد صدرت عن جميع الأنبياء، بَيدَ أنّها لم تكن بشكل تتعطّل فيه السنن الكونيّة دائماً، ولم تكن بحيث يشغل الأنبياء أفكارهم تبعاً لآراء الناس وأفكارهم، فيأتون لهم بمعجزة متى شاءوا) وقد جئتكم نذيراً لكم من الشرك والكفر والأعمال القبيحة، وهذه هي رسالتي ومهمتى.
ولا بدّ للنبيّ هنا أن يقول لهم بأنّ معجزته الأبديّة العلميّة التي لا سبيل إلى إنكارها هي القرآن الذي يدعو الناس من منظار العقل والعلم ويتحدّاهم به، ويطلب من الجنّ والإنس صراحة أن يجتمعوا متظاهرين للإتيان بمثله، ويدعو الناس جميعهم إلى معارضته ولو بعشر سور أو بسورة واحدة. مضافاً إلى ذلك فأنّ الآيات نفسها معجزة بأسلوبها العجيب ومنطقها السليم المشتمل على الحقائق واللطائف والقوانين الإنسانيّة الفطريّة التي تريد مصلحة البشرية. وهي معجزة بندائها العالي إلى العدل والتقوى وعمل الخير والدعوة إلى الإيثار والإنفاق وغيرهما ... كلّها معجزة بنظمها الرائع وتلاحمها كحلقات السلسلة بعضها مع بعض. وإنّ ربه هو الذي أرسل هذه الآيات. وأعلن فيها عن رسالته، وأشهد عليها وصرّح بها بوصفها معجزة عقليّة ومعنويّة في أعلى درجات الإعجاز ... بَيدَ أنّ رسول الله لم يجب الكفّار بهذا، وتركه لفرصة اخرى، ثمّ ينشغل مرّة اخرى بوصف الله، فأنّه يعلم ما تحمل كلّ انثى، ويعلم الغيب والشهود ويعلم من أسرّ القول ومن جهر به بنحو سويّ وأنّه هو الذي خلق البرق في السماء وأنشأ السحاب الثقال، وأنّه هو الذي يسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثمّ يبيّن بعد ذلك أنّ لله دعوة الحقّ، وأنّ السعادة نصيب الذين يستجيبون لها، وأنّ مَن في السماوات والأرض يسجدون لله وأنّ المشركين الذين هم من خلقه وجعلوا له شركاء في ضلال، وهكذا يواصل كلامه حتى يصل إلى الآية التاسعة عشرة: {أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ}.
وهذه الآية، في الوقت الذي ترمي إلى دحض كلام المشركين والكفّار، فأنّها ناظرة إلى الآية الاولى في السورة، وقد وردت للتأكيد على أحقيّة الكتاب، وجاءت لتحكم على جميع الآيات الواقعة بينهما المبيّنة عظمة الله وقدرته، بل والمبيّنة قرآنه نفسه، وهي حقّ لا ريب فيه، وأنّ المنكر لها أعمى. ثمّ وصفت اولي الألباب الذين استجابوا للقرآن. فقالت بأنّهم يوفون بعهد الله، ولا ينقضون الميثاق، ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم، ويخافون سوء الحساب، ويقيمون الصلاة وينفقون أموالهم سرّاً وعلانية، وهكذا تستمر على هذا النسق حتى تبدأ الآية السابعة والعشرون: {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ ويَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ}.
وتبيّن الآية هنا للمرّة الثانيّة اعتراض الكفّار بسبب عدم نزول معجزة خارقة للعادة من ربّه، وتشعر أنّهم ثابتون على كلامهم، وأنّهم لا يعتبرون القرآن معجزة، ويتلمّسون معجزة اخرى. ونجد النبيّ هنا أيضاً لا يتحدّاهم في جوابه بالقرآن الذي هو أعلى المعجزات وأكبرها، ويُرجى ذلك مع شهادة الله على رسالته لفرصة اخرى. ويقول فقط: أنّ الهداية والضلالة بيد الله، فمن سلّم لله ورجع إليه قاشعاً غمائم الجهل عن عقله وقلبه فسيهديه الله، ومن لم يكن كذلك وسار في طريق الضلال، فسيضلّه الله. وبعد ذلك تبدأ الآيات بوصف العباد الذين يرجعون إلى ربّهم، ويسيرون على طريق الحقّ وهم الذين: تطمئنّ قلوبهم بذكر الله.
أمّا الذين لم تستسلم قلوبهم لله، فلا جدوى لهم في المعجزة أيضاً، فما لم ينقاد القلب للحقّ، فأنّه يؤوّل جميع المعجزات ويفسّرها على أنّها سحر وكذب. يقول تعالى في الآية الحادية والثلاثين: {وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً ولا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ}.
تبيّن هذه الآيات بشكل واضح أنّ عدم قبول القرآن نابع عن عدم تطويع القلب لقبول الحقّ والانقياد للواقع، وإن لم يؤمنوا بهذا القرآن الذي هو أعظم وأرقى معجزة، فبأيّ معجزة اخرى يؤمنون؟ بعد ذلك تنتقل السورة فتقدّم لنا شرحاً عن الامم الماضية التي لم تؤمن بأنبيائها من وحي العناد والغطرسة. وتتحدّث عن المؤمنين الذين يدخلون الجنّة بسبب إذعانهم للحقّ، وتتطرّق إلى الأنبياء الذين جاءوا بالمعجزة، والامم التي تعاملت معهم من منطلق المكر والخديعة، وتستمرّ السورة حتى تصل إلى آخر آية فيها، وهي قوله تعالى: {وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وبَيْنَكُمْ ومَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ}.
يلاحظ هنا أنّ الكفّار لمّا أنكروا القرآن، وهو أعظم معجزة، وطلبوا من النبيّ معجزات اخرى فلم يستجب لهم، أنكروا أصل النبوّة نهائيّاً وكانوا حتى تلك اللحظة لم ينكروها بل كانوا وراء معجزات اخرى، ولمّا خاب أملهم من تلك المعجزة، أنكروا النبوّة إنكاراً تامّاً. أمّا النبيّ فأنّ جوابه المتكرّر الذي ينبغي الإتيان به في تينك المرحلتين حول أحقيّة القرآن وإعجازه، والإتيان بشاهد على رسالته، فقد جاء هنا فقال: أيّها الكفّار، نزل عَلَيّ هذا القرآن وهو أعظم معجزة، وقد شهد الله فيه على رسالتي، وشهد الذي عنده علم القرآن على نبوّتي.
في ضوء ذلك فأنّ شهادة الله لا تمثّل إرجاعاً إلى الغيب وإلى أمر مجهول، وهي ليست دعوى بدون برهان، لأنّ شهادة الله في القرآن وشهادة العالم بالكتاب أمر مشهود ومعلوم، وهي واضحة عند الكفّار؛ والدليل على صحّة هذه الدعوى هو إعجاز القرآن، وهو ضروريّ. لذلك فأنّ هذه الآية المباركة ناظرة إلى السورة كلّها وفيها جواب على جميع اعتراضات المشركين والكافرين، وهي ناظرة إلى الآية الاولى، والآية التاسعة عشرة التي تثبت أحقيّة الكتاب، وينتظم صدرها ووسطها وذيلها بعضه مع بعض مع حُسن الافتتاح وحُسن الاختتام، بحيث لو رفعنا هذه الآية من السورة، فكأنّما هناك نقص فيها.
[1] الآية 43، من السورة 13: الرعد.
[2] «تفسير أبي الفتوح» ج 6، ص 53 (بالفارسيّة). وقد أوردنا ترجمة كلامه. (م)
[3] تفسير «الكشاف» ج 2، ص 536.
 الاكثر قراءة في مقالات قرآنية
الاكثر قراءة في مقالات قرآنية
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)