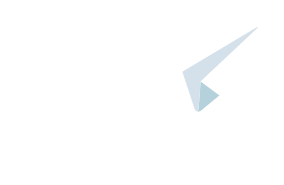علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

الأحاديث القدسيّة

علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)


علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري
أقسام الحديث / الحديث الصحيح
المؤلف:
الشيخ الدكتور صبحي الصالح
المصدر:
علوم الحديث ومصطلحه
الجزء والصفحة:
ص 145 ــ 155
2025-09-18
21
الفَصْلُ الثَّانِي: الحَدِيثِ الصَّحِيحُ:
عَرَّفُوا الحَدِيثَ الصَّحِيحَ بِأَنَّهُ: «الحَدِيثُ المُسْنَدُ الذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى حَتَّى يَنْتَهِي إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَوْ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ صَحَابِيٍّ أَوْ مَنْ دُونَهُ، وَلاَ يَكُونُ شَاذًّا، وَلاَ مُعَلَّلاً» (1).
وفي هذا التعريف أمور تنبغي ملاحظتها:
1 - أنّ الحديث الصحيح «مُسْنَدٌ» (2) - وهو ما اتّصل إسناده من راويه إلى منتهاه - ولذلك يقال في وصفه أيضًا: إنه متصل أو موصول: فالحديث المرسل الذي سقط منه الصحابي فقد الاتصال في السند، فهو على الأرجح ضعيف وليس بصحيح. وكذلك الحديث المنقطع ليس بصحيح؛ لأنّ رجلاً سقط من إسناده، أو لأنّ رجلاً مُبْهَمًا ذكر في هذا الإسناد، والإبهام أشبه بالسقوط. وَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي «المُعْضَلِ»؛ لأنّه الحديث الذي سقط من إسناده اثنان فأكثر.
2 - أنّ الحديث الصحيح لا يكون «شَاذًّا»، وهو ما رواه الثقة مُخَالِفًا رواية الثقات، كما سنرى في بحث الشذوذ.
3 - أنّ الحديث الصحيح لا يكون مُعَلَّلاً - وهو الذي اكتشفت فيه عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ تقدح في صِحَّتِهِ ' وإن كان يبدو في الظاهر سليمًا من العلل.
4 - أن رجال السند في الصحيح كلهم عدول ضابطون. فإن فقدت في أحدهم صفة من صفات العدالة أو الضبط ضُعِّفَ الحَدِيثُ وَلَمْ يُصَحَّحْ. وقد عرفنا في (فصل شروط الراوي) المراد من العدالة والضبط.
والصحيح على قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. فالصحيح لذاته هو ما اشتمل من صفات القبول على أعلاها، أما الصحيح لغيره فهو ما صُحِّحَ لأمر أجنبي عنه، إذا لم يشتمل من صفات القبول على أعلاها، كالحسن فإنه إذا رُوِيَ من غير وجه ارتقى بما عضده من درجة الحسن إلى منزلة الصحة (3).
وكما يوصف الصحيح بأنّه مُسْنَدٌ وَمُتَّصِلٌ، يوصف بأنّه متواتر أو آحادي، ويجوز وصفه بأنّه غريب أو مشهور (4).
وسنرى أن ثمة ألقابًا يشترك فيها كل من الصحيح والحسن، وأن اصطلاحات أخرى تشمل الصحيح والحسن والضعيف.
فالمتواتر هو الحديث الصحيح الذي يرويه جمع يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب، عن جمع مثلهم في أول السند ووسطه وآخره (5).
وإنّما قلنا في التعريف: «جَمْعٌ يُحِيلُ العَقْلُ وَالعَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الكَذِبِ» لنتخلص من تلك الآراء المتضاربة حول تحديد عدد هذا الجمع تحديدًا «كَيْفِيًّا» ليس عليه دليل صريح.
فمنهم من يرى أنّ أقل العدد الذي يثبت به التواتر: أربعة، لقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 13] في الشهادة على حصول الزنى، ومنهم من يقول: خمسة، كما في آيات الملاعنة (6).
ومنهم من يقول: عشرة؛ لأنّ ما دون العشرة آحاد، ولا يُسَمَّى الجمع جمعًا إلا بها أو بما فوقها.
ومنهم من يقول: اثنا عشر، لقوله تعالى: {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا} [المائدة: 12].
ومنهم من يقول: عشرون، لقوله تعالى: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65].
ومنهم من يقول: أربعون، لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 64]. وكان عددهم عند نزول الآية قد بلغ أربعين رجلاً.
ومنهم من يقول: سبعون، لقوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا} [الأعراف: 155].
وقال بعضهم: بل ثلاث مائة وثلاثة عشر رجلاً وامرأتان، على عدد أهل بَدْرٍ.
وهذه الاستدلالات كلّها - وإن تكُ مستنبطة من القرآن - ليست صريحة الدلالة؛ لأنّ لكل عدد منها علاقة بالحادثة الخاصّة التي ذكر فيها.
فالأرجح في تعريف المتواتر أن يلاحظ فيه مجرّد روايته لتعيّن عدد هذا الجمع. وقد قال ابن حجر: «لاَ مَعْنَى لِتَعْيِينِ العَدَدِ عَلَى الصَّحِيحِ» (7).
وينقسم المتواتر إلى لفظي ومعنوي، فالمتواتر اللفظي هو الذي رواه الجمع المذكور في أوّل السند ووسطه وآخره بلفظ واحد، وصورة واحدة وهو كما يقول ابن الصلاح: «عَزِيزٌ جِدًّا، بَلْ لاَ يَكَادُ يُوجَدُ. وَمَنْ سُئِلَ عَنْ إِبْرَازِ مِثَالٍ لِذَلِكَ أَعْيَاهُ تَطَلُّبُهُ» (8). والأكثرون على أنّه - باشتراط المطابقة اللفظيّة فيه من كلّ وجه - يستحيل وجوده في غير القرآن الكريم. وبعض العلماء يُؤَكِّدُونَ أنّ في الحديث النبوي نفسه غير قليل من المتواتر اللفظي، ويسوقون للدلالة على ذلك أمثال حديث «انْشِقَاقِ القَمَرِ»، وَ«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا»، وَ«مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا»، وَ«الشَفَاعَةِ»، وَ«أَنِينِ الجِذْعِ»، وَ«المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ»، وَ«الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ»، وَ«نَبْعِ المَاءِ مِنْ أَصَابِعِهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ -»، وَ«رَدِّ عَيْنِ قَتَادَةَ»، وَ«إِطْعَامِ الجَيْشِ الكَثِيرِ مِنَ الزَّادِ القَلِيلِ»(9). ومن الذين ذهبوا إلى هذا الرأي السيوطي (10) في "الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة" (11)، والقاضي عياض في "الشفاء".
ويبدو أنّ الحافظ ابن حجر نفسه يجنح إلى هذا المذهب، فقد ذكر في "شرح النخبة" أَنَّ «مِن أَحْسَنَ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كونُ المُتواتِرِ مَوجوداً، وُجودَ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ، أَنَّ الكُتُبَ المَشْهُورَةَ المُتَداوَلَةَ بأَيدي أَهْلِ العِلْمِ شَرْقاً وغَرْباً، المَقْطوعَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَى مُصَنِّفِيهَا، إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدُّداً تُحِيلُ العَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الكَذِبِ إِلَى آخِرِ الشُّرُوطِ، أَفَادَ العِلْمَ اليَقِينِيَّ بِصِحَّتِهِ إِلَى قَائِلِهِ» (12).
وأشار في "شرح البخاري" إلى أنّ حديث «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا» رواه أكثر من أربعين صحابيًّا، بينهم العشرة المُبَشَّرُونَ بالجنّة (13).
أمّا المتواتر المعنوي فمن الواضح أنّه لا يشترط في روايته المطابقة اللفظية، وإنّما يكتفي فيه بأداء المعنى ولو اختلفت رواياته، عن الجمع الذين يحيل العقل والعادة تواطؤهم على الكذب. وهو كثير جِدًّا ليس في وسع أحد إنكاره. ومثاله: «أَحَادِيثَ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ» فقد رُوِيَ عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - نحو مائة حديث فيه رفع يديه في الدعاء. وقد جمعها السيوطيّ في جزء لكنّها في قضايا مختلفة، فكلّ قضيّة منها لم تتواتر، والقدر المشترك فيها - وهو الرفع عند الدعاء - تواتر باعتبار المجموع (14). ويرى بعضهم أنّ تلك الأحاديث التي يستشهد بها نفر من العلماء على وجود التواتر اللفظي ليست في الحقيقة إلّا متواترة المعنى، ولكن استفاضة محتواها واشتهاره غطّيا على اختلاف الروايات في بعض ألفاظها.
ومن علماء الحديث من لا يرى بأسًا في أن يكون المتواتر المعنوي في أوله آحاديًّا(15)، ثُمَّ يشتهر بعد الطبقة الأولى ويستفيض فيسلكون حديث «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» في عداد ما تواتر معنى، مع أنّه لم يروه إلّا عمر بن الخطاب، ولم يروه عن عمر إلّا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلّا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن التيمي إلّا يحيى بن سعيد الأنصاري، وإنّما طرأت له الشهرة من عند يحيى (16).
والمحدّثون لا يذكرون «المُتَوَاتِرَ» باسمه الخاص المشعر بمعناه، وإنّما يتبعون فيه الفقهاء والأصوليّين؛ لأَنَّ التَّوَاتُرَ لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ، إِذْ عِلْمُ الإِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ صِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ، لِيُعْمَلَ بِهِ أَوْ يُتْرَكَ مِنْ حَيثُ صِفَاتُ الرِّجَالِ وَصِيَغُ الأَدَاءِ، وَالمُتَواتِرُ لاَ يُبْحَثُ عَنْ رِجالِهِ، بَلْ يَجِبُ العَمَلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ» (17).
ولا خلاف بين المحدّثين في أنّ كُلاًّ من المتواتر اللفظي والمعنوي يوجب العلم القطعي اليقيني، وإنّما هم يختلفون في الحديث الصحيح الآحاديّ هل يفيد الظنّ أم القطع، فالنووي في "التقريب" يراه ظنّي الثبوت، وأكثر أهل الحديث يقطعون منه بما أخرجه الشيخان، البخاري ومسلم، وبعضهم يُرَجِّحُونَ أنّ الآحاديّ الصحيح، سواء أأخرجه الشيخان أم سواهما، يفيد العلم القطعي اليقيني كالمتواتر بقسميه عَلَى حَدٍّ [سَوَاءٍ]. قال ابن حزم (18): «إنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ العَدْلِ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ - يُوجِبُ العِلْمَ وَالعَمَلَ مَعًا» (19).
ورأي ابن حزم أجدر بالاتباع، إذ لا معنى لتخصيص أحاديث "الصحيحين" بإفادة القطع؛ لأنّ ما ثبت صحّته في غيرهما ينبغي أن يحكم عليه بما حكم عليه فيهما، فما للكتابين من منزلة خاصّة في قلوب المؤمنين لا ينبغي أن يقلّل من قيمة الصحيح في الكتب الأخرى، كما أنّه لا معنى للقول بظنّيّة الحديث الآحادي بعد ثبوت صحّته؛ لأنّ ما اشترط فيه لقبول صحّته يزيل كلّ معاني الظن، ويستوجب وقوع العلم اليقيني به(20).
والحديث الصحيح يُسَمَّى «غَرِيبًا» إذا تفرّد بروايته واحد ثقة، وتكون غرابته في المتن تارة، وفي الإسناد تارة أخرى (21).
وَيُسَمَّى «مَشْهُورًا» إذا اشتركت جماعة في روايته عن الشيخ الثقة (22).
ومن غريب أمر المحدّثين أنّ بعضهم اشترط، في تعريف الصحيح، أن يكون «عَزِيزًا» (23)، وإليه يُومِئُ كلام الحاكم أبي عبد الله في "معرفة علوم الحديث" حيث قال: «وَصِفَةُ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنْ يَرْوِيَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ صَحَابِيُّ زَائِلٌ عَنْهُ اسْمُ الجَهَالَةِ وَهُوَ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ تَابِعِيَّانِ [عَدْلاَنِ]، ثُمَّ يَتَدَاوَلُهُ أَهْلُ الحَدِيثِ بِالْقَبُولِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ» (24).
ولا حاجة إلى هذا الاصطلاح الخاص بعد الذي أوضحناه من تفرقة العلماء بين تعديل الراوي وتزكية الشاهد.
والبخاري هو أوّل من صَنَّفَ في «الصَّحِيحِ المُجَرَّدِ» الذي يخلو من الإرسال والانقطاع والبلاغات. أمّا التعاليق التي أدخلها في "جامعه" فما أوردها إلّا استئناسًا، واستشهادًا، فَذِكْرُهَا فِيهِ لا يخرجه عن كونه جَرَّدَ الصحيح (25).
ولا يعد مالك أوّل من صنّف في الصحيح؛ لأنّه لم يفرده بل أدخل فيه - تَبَعًا لِمَنْهَجِهِ - المراسيل والمقاطيع والبلاغات.
ثُمّ تلا البخاري تلميذه مسلم في تصنيف الصحيح (26)، وتتابع التأليف بعد ذلك في الصحيح وما يقاربه على النحو الذي فَصَّلْنَاهُ في فصل «أَهَمِّ كُتُبِ الرِّوَايَةِ».
غير أنّ درجة الصحة ليست واحدة في كلّ ما سُمِّيَ صحيحًا، ولا في جميع الكتب المشتملة على الصحيح، بل المحدّثون يعرفون الصحيح والأصحّ، كما سنرى أنّهم يعرفون الضعيف والأضعف، وهو يعتقدون أنّ رُتَبَ الصحيح تتفاوت بتفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة (27)، ولم يسع النووي، تجاه هذا التفاوت، إلا أن يُقَسِّمَ الصحيح سبعة أقسام: 1 - أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، 2 - ما انفرد به البخاري، 3 - ثم ما انفرد به مسلم، 4 - ثم ما كان على شرطهما وإن لم يُخْرِجَاهُ، 5 - ثم على شرط البخاري، 6 - ثم على شرط مسلم، 7 - ثم ما صحّحه غيرهما من الأئمّة (28).
وتتفاوت كذلك رُتَبُ الصحيح بتفاوت الأمصار التي روته، ويوشك أكثر العلماء أن يجزموا بأنّ أصحّ الأحاديث ما رواه أهل المدينة فهي دَارُ السُنَّةِ المُشَرَّفَةِ. قال ابن تيمية (29): «اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ بِالحَدِيثِ عَلَى أَنَّ أَصَحَّ الأَحَادِيثِ مَا رَوَاهُ أَهْلُ المَدِينَةِ، ثُمَّ أَهْلُ البَصْرَةِ، ثُمَّ أَهْلُ الشَّامِ» وقال الخطيب: «أَصَحُّ طُرُقِ السُّنَنِ مَا يَرْوِيهِ أَهْلُ الحَرَمَيْنِ مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، فَإِنَّ التَّدْلِيسَ عَنْهُمْ قَلِيلٌ، وَالكَذِبَ وَوَضْعَ الْحَدِيثِ عِنْدَهُمْ عَزِيزٌ. وَلأَهْلِ اليَمَنِ رِوَايَاتٌ جَيِّدَةٌ، وَطُرُقٌ صَحِيحَةٌ، إِلاَّ أَنَّهَا قَلِيلَةٌ، وَمَرْجِعُهَا إِلَى أَهْلِ الحِجَازِ أَيْضًا. وَلأَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ السُّنَنِ الثَّابِتَةِ بِالأَسَانِيدِ الوَاضِحَةِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِمْ مَعَ إِكْثَارِهِمْ. وَالْكُوفِيُّونَ مِثْلُهُمْ فِي الكَثْرَةِ، غَيْرَ أَنَّ رِوَايَاتِهِمْ كَثِيرَةُ الدَّغَلِ، قَلِيلَةُ السَّلاَمَةِ مِنَ الْعِلَلِ. وَحَدِيثُ الشَّامِيِّينَ أَكْثَرُهُ مَرَاسِيلُ وَمَقَاطِيعُ، وَمَا اتَّصَلَ مِنْهُ مِمَّا أَسْنَدَهُ الثِّقَاتُ فَإِنَّهُ صَالِحٌ. وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَوَاعِظِ» (30).
واختلف أئمّة الحديث في أصحّ الأسانيد، فذكر كلّ منهم ما أدّى إليه اجتهاده. ولكلّ صحابي رواة من التابعين، ولهم أتباع وأكثرهم ثقات، فلا يمكن أن يُقْطَعَ الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد (31).
وقد يعدل نقاد الحديث عن قولهم «حَدِيثٌ صَحِيحٌ» إلى قولهم: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ»، قاصدين من ذلك إلى الحكم بصحّة السند من غير أن يستلزم صحّة المتن، لجواز أن يكون في المتن شذوذ أو علّة. وإذا أرادوا صحّة السند والمتن معًا أَوْرَدُوا العبارة المطلقة أرقى من قولهم: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ» بهذا التقييد. ولذلك قال السيوطي في "ألفيته": وَالحُكْمُ بِالصَّحِّةِ لِلإِسْنَادِ ... وَالحُسْنِ دُونَ المَتْنِ لِلنُّقَّادِ
لِعِلَّةٍ أَوْ لِشُذُوذٍ وَاحْكُمِ ... لِلْمَتْنِ إِنْ أُطْلَقَ ذُو حِفْظٍ نُمِي (32).
وإذا قال المُحَدِّثُونَ: «أَصَحُّ شَيْءٍ فِي البَابِ كَذَا» فلا يلزم من هذا التعبير صحّة الحديث، فإنّهم يقولونه وإن كان الحديث ضعيفًا، ومرادهم أرجح ما في الباب أو أَقَلُّهُ ضعفًا(33).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) " اختصار علوم الحديث ": ص 21.
(2) وَيُفَرِّقُ العلماء أحيانًا بين المسند والمتصل، بملاحظة الرفع في المسند، فهو مرفوع إلى النَّبِيِّ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّمَ -، أمّا المتصل فهو ما اتصل سنده بسماع كل واحد من رُوَاتِهِ مِمَّنْ فوقه سواء أكان مرفوعًا إلى النبي أم موقوفًا على التابعي: (راجع " التدريب ": ص 60) وسنعرض لهذا الموضوع بشيء من التفصيل في «القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف».
(3) " قواعد التحديث ": ص 56.
(4) " اختصار علوم الحديث ": ص 21.
(5) " شرح النخبة ": ص 3.
(6) وذلك في قوله تعالى في سورة النور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ } [النور: 6 - 9] [سورة المائدة، الآية: 12].
(7) " شرح النخبة ": ص 3.
(8) غير أنّ ابن الصلاح يستثني من ذلك حديث «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، ويذكر من رواته اثنين وستّين من الصحابة. (قارن بـ "التدريب": ص 190).
(9) انظر تفصيل ذلك في "التدريب": ص 190.
(10) هو العَلاَّمَةُ عبد الرحمن جلال السيوطي (911 هـ) صاحب التصانيف الكثيرة في التفسير والحديث واللغة، وله في مصطلح الحديث "ألفيّة"، و"تدريب الراوي".
(11) " التدريب ": ص 190.
(12) " شرح النخبة ": ص 4 ـ 5.
(13) ...قال بعض العلماء: «رَوَى هَذَا الحَدِيثَ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ نَفْسٍ، وَفِي " شَرْحِ النَّوَوِيِّ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ ": رَوَاهُ نَحْوُ مِائَتَيْنِ». قَالَ الحَافِظُ العِرَاقِيُّ: «وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ بِعَيْنِهِ، وَلَكِنَّهُ فِي مُطْلَقِ الكَذِبِ، وَالخَاصُّ بِهَذَا المَتْنِ رِوَايَةُ بِضْعَةٍ وَسَبْعِينَ صَحَابِيًّا: [العَشَرَةُ الْمَشْهُودُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ...]» وقد سرد السيوطي أسماءهم (في "التدريب": ص 190).
(14) " التدريب ": ص 191.
(15) والحديث الآحاديّ - في الاصطلاح - ما لم يجمع شروط التواتر، وقد يتفرّد به واحد فيكون غريبًا أو يعزّز برواية فأكثر فيكون عزيزًا، أو يستفيض فيكون مشهورًا. فلا يفيد وصفه بالآحاديّ أنّه خبر الواحد دائمًا. (قارن بـ"شرح النخبة": ص 6).
(16) "التدريب": ص 189. وقارن بـ"توضيح الأفكار": 1/ 24.
(17) " شرح النخبة ": ص 4.
(18) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري، عالم الأندلس في عصره. أشهر مصنّفاته " المُحَلّى " و"الفصل في الملل والأهواء والنحل". تُوُفِّيَ سَنَةَ 456 هـ.
(19) "الإحكام": 1/ 119 - 137 وفيه [بَحْثٌ] قَيِّمٌ في هذا الموضوع. وانظر "إغاثة اللهفان" لابن القيم: ص 160 (ط: الميمنيّة بالقاهرة).
(20) قارن بـ"الباعث الحثيث": ص 39.
(21) سيأتي تفصيل «الغَرِيبِ» في «القسم المشترك بين الصحيح والحسن والضعيف».
(22) وسنزيد «المَشْهُورَ» تفصيلاً في «القسم المشترك» أيضًا.
(23) وهو - كما سنرى - الحديث الذي لا يرويه أقل من اثنين، وَسُمِّيَ بذلك إمّا لقلّة وجوده وإمّا لكونه عَزَّ: أي قوي بمجيئه من طريق أخرى (" شرح النخبة ": ص 5).
(24) "معرفة علوم الحديث": ص 62 وقارن بـ"شرح النخبة": ص 5.
(25) " التدريب ": ص 24، 25.
(26) " التدريب ": ص 25.
(27) " شرح النخبة ": ص 9.
(28) " قواعد التحديث ": ص 59. وقد نقله القاسمي من " التدريب ": ص 37.
(29) هو تقي الدين أحمد بن تيمية الحرّانيّ الدمشقيّ وَتُوُفِّيَ سَنَةَ 728 هـ. وقد وضع المستشرق الفرنسيّ هنري لاوست كتابًا قَيِّمًا في سيرة ابن تيمية وعقائده السياسية والاجتماعية Henri Laoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn Taimaya.
(30) ذكره القاسمي في "قواعد التحديث": ص 58.
(31) "معرفة علوم الحديث": ص 54، 55 وقارن بـ "توضيح الأفكار": 1/ 33. وقد نصّوا - مع ذلك - على أسانيد جمعها العَلّامَةُ أحمد شاكر وزاد عليها قليلاً. (انظر: "الباعث الحثيث": ص 22 - 25).
(32) "ألفيّة السيوطي"، البيتان 104 و105 ص 55 (وانظر الهامش أيضًا).
(33) "قواعد التحديث": ص 59 نقلاً عن النووي.
 الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
الاكثر قراءة في علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة)
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام) قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)
قسم الشؤون الفكرية يصدر مجموعة قصصية بعنوان (قلوب بلا مأوى)