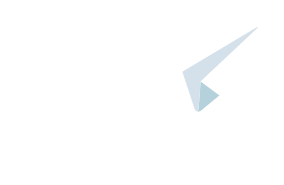الأدب


الشعر

العصر الجاهلي

العصر الاسلامي

العصر العباسي

العصر الاندلسي

العصور المتأخرة

العصر الحديث

النثر


النقد

النقد الحديث

النقد القديم


البلاغة

المعاني

البيان

البديع

العروض

تراجم الادباء و الشعراء و الكتاب
الأخذ والسرقة
المؤلف:
عبد القاهر الجرجاني
المصدر:
أسرار البلاغة
الجزء والصفحة:
ص: 226-266
23-1-2022
3985
فصل في الأخذ والسرقة
وما في ذلك من التعليل، وضروب الحقيقة والتخييل"
القسم العقلي
اعلم أن الُحكْم على الشاعر بأنه أخذ من غيره وسَرَق، واقتدى بمن تقدَّم وسبق، لا يخلو من أن يكون في المعنى صريحاً، أو في صيغة تتعلق بالعبارة، ويجب أن نتكلم أوّلاً على المعاني، وهي تنقسم أوَّلاً قسمين: عقليّ وتخييليّ، وكل واحدٍ منهما يتنوّع، فالذي هو العقلي على أنواع: أوّلها: عقليٌّ صحيحٌ مَجراه في الشعر والكتابة والبيانِ والخطابة، مَجْرَى الأدلّة التي تستنبطها العقلاء، والفوائد التي تُثيرها الحكماء، ولذلك تجدُ الأكثر من هذا الجنس مُنْتَزَعاً من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي اللَّه عنهم، ومنقولاً من آثار السلف الذين شأنُهم الصدق، وقصدُهم الحقُّ، أو ترى له أصلاً في الأمثال القديمة والحكم المأثورة عن القدماء، فقوله:
|
وَمَا الحسَبُ المورُوثُ لا دَرَّ دَرُّه |
|
بمُحْتَسَبٍ إلاّ بآخَرَ مُكْـتـسَـبْ |
ونظائرُه، كقوله:
|
إنّي وإن كنتُ ابنَ سَـيِّد عـامـرٍ |
|
وفي السِّرِّ منها والصَّريحِ المهذَّبِ |
|
لَمَا سوَّدتني عـامـرٌ عـن وِراثةٍ |
|
أَبَى اللَّه أن أسمُـو بـأُمٍّ ولا أب |
معنًى صريحٌ محضٌ يشهد له العقل بالصحة، ويُعطيه من نفسه أكرم النِّسبة، وتتفق العقلاء على الأخذ به، والحكم بموجَبه، في كل جيل وأمّة، ويوجد له أصل في كل لسَان ولُغة، وأعلى مَنَاسبه وأنورُها، وأجلُّها وأفخرها، قول اللَّه تعالى: "إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّه أَتْقَاكُمْ"" "الحجرات: 13"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أَبْطأَ به علمُه لم يُسْرِع به نسبُه"، وقوله عليه السلام: "يا بني هاشم، لا تجيئني الناسُ بالأعمال وتجيئوني بالأنساب"، وذلك أنه لو كانت القضيّة على ظاهرٍ يَغْترُّ به الجاهل، ويعتمدُه المنقوصُ، لأدَّى ذلك إلى إبطال النَّسب أيضاً، وإحالة التكثّر به، والرجوع إلى شَرَفه، فإن الأوّل لو عَدِمَ الفضائلَ المكتسَبة، والمساعيَ الشريفة، ولم يَبِنْ من أهل زمانه بأفعالٍ تُؤَْثر، ومناقب تُدَوَّن وتُسَطَّر، لما كان أَوَّلاً، ولكان المَعْلَم من أمره مَجْهلاً، ولما تُصُوّر افتخار الثاني بالانتماء إليه، وتعويلُه في المفاضلة عليه، ولكان لا يُتصوَّر فَرْقٌ بين أن يقول: هذا أبي، ومنه نسبي، وبين أن يُنسَب إلى الطين، الذي هو أصل الخلق أجمعين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "كلُّكم لآدم، وآدمُ من التراب"، وقال محمد بن الربيع الْمَوْصلي:
|
الناس في صورة التّشبيه أكفاءُ |
|
أبـوهُـمُ آدمٌ والأُمُّ حــوَّاءُ |
|
فإن يكن لهُم في أصلها شَرَفٌ |
|
يفاخرون به فالطِّين والـمـاءُ |
|
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهـمُ |
|
على الهُدَى لمن استهدَى أَدلاّءُ |
|
ووَزْنُ كل امرئ ما كان يُحسنه |
|
والجاهلون لأهل العلم أعـداءُ |
فهذا كما ترى باب من المعاني التي تُجمَع فيها النظائر، وتُذكَر الأبيات الدالّة عليها، فإنها تتلاقى وتتناظر، وتتشابه وتتشاكل، ومكانُه من العقل ما ظَهَر لك واستبان ووضح واستنار، وكذلك قوله:
|
وكل امرئ يُولِي الجميلَ محبَّبٌ |
صريحُ معنًى ليس للشعر في جوهره وذاته نصيب، وإنما له ما يُلْبَسه من اللفظ، ويكسوه من العبارة، وكيفيةِ التأدية من الاختصار وخلافه، والكشف أو ضدّه، وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "جُبلت القلوبُ على حُبّ من أحسن إليها"، بَل قول اللَّه عز وجل: "ادْفَعْ بالَّتِي هِيَ أحْسَنُ فَإذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ" "فصلت: 34"، وكذا قوله:
|
لاَ يَسْلَم الشَّرفُ الرَّفيع من الأَذَى |
|
حتَّى يُراقَ على جَوانِبِـه الـدَّمُ |
معنًى معقولٌ لم يزل العُقلاءُ يَقْضون بصحّته، ويرى العارفون بالسياسة الأخذَ بسنَّته، وبه جاءت أوامِر اللَّه سبحانه، وعليه جَرَت الأحكام الشرعية والسّنَن النبوية، وبه استقام لأهل الدِّين دينهم، وانتفى عنهم أذَى مَن يَفْتِنهم ويَضيرُهم، إذ كان موضوع الجبلَّة على أن لا تخلو الدنيا من الطُغاة المارِدين، والغُواة المعاندين، الذين لا يَعُونَ الحكمة فَتَرْدَعَهم، ولا يَتَصوَّرون الرشدَ فيكُفَّهم النُّصْحُ ويمنعهم، ولا يُحسّون بنقائص الغَيّ والضلال، وما في الجَوْر والظلم من الضَّعة والخَبال، فيجِدوا لذلك مَسَّ أَلَمٍ يحبِسُهم علَى الأمر، ويقف بهم عند الزجر، بل كانوا كالبهائم والسِّباع، لا يوجعهم إلاّ ما يَخْرِق الأبشار من حَدّ الحديد، وسَطْو البأس الشديد، فلو لم تُطبَع لأمثالهم السيوف، ولم تُطلَق فيهم الحتوف، لما استقام دينٌ ولا دنيَا، ولا نال أهلُ الشرف ما نالوه من الرتبة العليا، فلا يطيب الشُرب من مَنْهلٍ لم تُنفَ عنه الأَقذاء، ولا تَقَرُّ الروح في بدنٍ لم تُدفَع عنه الأَدواء. وكذلك قوله:
|
إذا أنت أكرمت الكـريم مَـلَـكْـتَـه |
|
وَإن أَنت أكرمْـت الـلَّـئيمَ تَـمَـرَّدا |
|
َوَضْعُ النَدى في مَوْضِع السيف بالعلَـى |
|
مُضرٌّ كَوضْع السَّيف في مَوْضِع الندَى |
لقسم التخييلي
وأما القسم التخييلي، فهو الذي لا يمكن أن يقال إنه صِدقٌ، وإنَّ ما أثبتَه ثابت وما نفاه منفيّ، وهو مفتنُّ المذاهب، كثير المسالك، لا يكاد يُحصَر إلاّ تقريباً، ولا يُحاط به تقسيماً وتبويباً، ثم إنه يجيء طبقاتٍ، ويأتي على درجاتٍ، فمنه ما يجيء مصنوعاً قد تُلُطِّف فيه، واستعين عليه بالرِفق والحِذق، حتى أُعطَي شَبَهاً من الحقّ، وغُشِّي رَوْنَقاً من الصّدق، باحتجاج تُمُحِّل، وقياسٍ تُصُنِّع فيه وتُعُمِّلَ، ومثالُه قول أبي تمام:
|
ا تُنكري عَطَلَ الكَريم من الغِنَى |
|
فالسَّيلُ حَرْبٌ للمكانِ العالـى |
فهذا قد خَيَّل إلى السامع أن الكريم إذا كان موصوفاً بالعلوّ، والرِّفعة في قدره، وكان الغِنَى كالغَيْث في حاجة الخلق إليه وعِظَمِ نَفْعه، وجب بالقياس أن يزِلَّ عن الكريم، زَلِيلَ السَّيل عن الطَّوْد العظيم، ومعلومٌ أنه قياسُ تخييلٍ وإيهامٍ، لا تحصيلٍ وإحكام، فالعلّة في أن السيل لا يستقرّ على الأمكنة العالية، أن الماء سيَّال لا يثبت إلا إذا حصل في موضع له جوانبُ تَدْفعه عن الانصباب، وتمنعه عن الانسياب، وليس في الكريم والمال، شيء من هذه الخلال، وأقوى من هذا في أن يُظنَّ حقّاً وصدقاً، وهو على التخيّل قوله:
|
لشيبُ كُرْهٌ وكُرْهٌ أن يفـارِقَـنـي |
|
أَعْجِبْ بشيءٍ على البَغْضَاء مَوْدودِ |
هو من حيث الظاهر صدق وحقيقة، لأن الإنسان لا يعجبه أن يُدركه الشيب، فإذا هو أدركه كره أن يفارقه، فتراه لذلك يُنكره ويتكرَّهه على إرادته أن يدومَ له، إلا أنك إذا رجعت إلى التحقيق، كانت الكراهةُ والبغضاء لاحقةُ للشيب على الحقيقة، فأما كونه مُرَاداً و مودوداً، فمتخيَّلٌ فيه، وليس بالحقَّ والصدق، بل المودود الحياة والبقاءُ، إلا أنه لما كانت العادة جاريةً بأنّ في زوال رؤية الإنسان للشيب، زوالَه عن الدنيا وخروجه منها، وكان العيش فيها محبَّباً إلى النفوس، صارت محبّته لما لا يَبْقَى له حتى يبقى الشيب، كأنّها محبّة للشيب. من ذلك صَنِيعهم إذا أرادوا تفضيلَ شيء أو َقْصَه، ومدحه أو ذمَّه، فتعلّقوا ببعض ما يشاركُه في أوصافٍ ليست هي سبب الفضيلة والنقيصة، وظواهرِ أُمورٍ لا تَصحّح ما قصدوه من التهجين والتزيين على الحقيقة، كما تراه في باب الشيب والشباب، كقول البحتري:
|
بَيَاضُ البازيِّ أصدقُ حسنـا |
|
إنْ تأمّلتِ من سَواد الغُرابِ |
وليس إذا كان البياضُ في البازي آنَقَ في العين وأخلق بالحسن من السواد في الغراب، وجب لذلك أن لايُذَمَّ الشيبُ ولا تنفرُ منه طباع ذوي الألباب، لأنه ليس الذنب كلَّه لتحوُّل الصِّبْغ وتبدُّل اللون، ولا أتَت الغواني ما أتت من الصدّ والإعراض لمجرَّد البياض، فإنهن يرينه في قُباطيّ مصر فيأنسن، وفي أنوار الرَّوض وأوراق النرجس الغضّ فلا يعبِسْن، فما أنكرن ابيضاض شَعَر الفتى لنفس اللون وذاته، بل لذهاب بَهجاته، وإدباره في حياته، وإنك لترى الصُّفرة الخالصةَ في أوراق الأشجار المتناثرة عند الخريف وإقبال الشتاء وهبوب الشَّمال، فتكرهها وتنفرُ منها، وتراها بعينها في إقبال الربيع في الزَّهر المتفتِّق، وفيما ينْشئه ويَشِيه من الديباج المُؤْنق، فتجد نفسَك على خِلاف تلك القضيّة، وتمتلئ من الأريحيّة، ذاك لأنك رأيت اللونَ حيُ النماءُ والزيادة، والحياةُ المستفادة، وحيث أبشرتْ أرواح الرياحين، وبشّرت أنواع التحاسين، ورأيته في الوقت الآخَر حين ولَّت السعود، واقشعرَّ العُود، وذهبت البَشَاشة والبشْر، وجاء العُبوس والعُسْر. هذا ولو عدِم البازي فضيلةَ أنه جارح، وأنه من عَتيق الطير، لم تجد لبياضه الحسن الذي تراه، ولم يكن للمحتجِّ به على من يُنكر الشيب ويذمُّه ما تراه من الاستظهار، كما أنه لولا ما يُهدي إليك المسك من رَيَّاه التي تتطلع إلها الأرواح، وتَهَشُّ لها النفوس وترتاح، ولضَعُفَت حُجّة المتعلق به في تفضيل الشَّباب، وكما لم تكن العلّةُ في كراهةِ الشيب بياضُهُ، ولم يكن هو الذي غَضَّ عنه الأبصار، ومنحه العيبَ والإنكار، كذلك لم يَحْسن سواد الشَعَر في العيون لكونه سواداً فقط، بل لأَنك رأيتَ رَوْنق الشباب ونضارتَه، وبَهْجتَه وطُلاَوتَه وَرأيت بريقَه وبصيصَه يَعِدانك الإقبال، ويُريانك الاقتبال، ويُحْضِرانك الثقَةَ بالبقاء، ويُبْعِدان عنك الخوفَ من الغناء، وإنّك لترى الرَّجُل وقد طَعَن في السنّ وشَعَرُه لم يبيضّ، وشيبه لم ينقضّ، ولكنه على ذاك قد عدِم إبهاجه الذي كان، وعاد لا يزينُ كما زان، وظهر فيه من الكمودوالجمود، ما يُريكَه غيرَ محمود. وهكذا قوله:
|
والصَّارمُ المَصْقُولُ أحسنُ حالةً |
|
يومَ الوغَى من صارمٍ لم يُصْقَل |
احتجاجٌ على فضيلة الشيب، وأنه أحسن منظراً من جهة التعلق باللون، وإشارةٌ إلى أن السواد كالصَدَأ على صفحة السيف، فكما أن السيف إذا صُقل وجُلي وأزيل عنه الصَّدَأ ونُقِّيَ كان أبهى وأحسن، وأعجبَ إلى الرائي وفي عينه أزين، كذلك يجب أن يكون حُكْمُ الشعَر في انجلاء صدأ السواد عنه، وظهور بياض الصِّقَالِ فيه، وقد ترك أن يفكّر فيما عدا ذلك من المعاني التي لها يُكرَه الشيب، ويُنَاط به العيب. وعلى هذا موضوع الشعر والخطابة، أن يجعلوا اجتماعَ الشيئين في وصفٍ عِلةً لحكمٍ يريدونه، وإن لم يكن كذلك في المعقول ومُقْتَضَيَات العقول، ولا يؤخذ الشاعر بأن يصحِّح كونَ ما جعله أصلاً وعلّة كما ادَّعاهُ فيما يُبْرِم أو يَنْقض من قضيّة، وأَن يأتي على ما صَيَّره قاعدةً وأساساً بيّنة عقلية، بل تُسلَّم مقدّمتُه التي اعتمدها بيّنةً، كتسليمنا أَنّ عائب الشيب لم ينكر منه إلاّ لونَه، وتناسِينا سائر المعاني التي لها كُره، ومن أجلها عِيب، وكذلك قول البحتري:
|
كَلَّفْتُمُونَا حُدُودَ مَـنْـطِـقـكُـم |
|
في الشِّعر يَكْفِي عن صِدْقِهِ كَذِبُهْ |
أراد كلّفتمونا أن نُجري مقاييس الشعر على حدود المنطق، ونأخذ نفوسَنا فيه بالقول المحقَّق، حتى لاَ ندَّعي إلا ما يقول عليه من العقل برهان يقطع به، ويُلجئ إلى موجَبه، ولا شكّْ أنه إلى هذا النحو قَصَد، وإيّاه عَمَد، إذ يبعُد أن يريد بالكذب إعطاءَ الممدوح حظَّاً من الفضل والسُّؤدد ليس له، ويُبلّغه بالصفة حظّاً من التعظيم ليس هو أهلَه، وأن يجاوز به من الإكثار محلَّه، لأن هذا الكذبَ لا يُبين بالحجَج المنطقية، والقوانين العقلية، وإنما يكذَّب فيه القائل بالرجوع إلى حال المذكور واختباره فيما وُصف به، والكشف عن قدره وخسّته، ورفعته أو ضَعَته، ومعرفة محلّه ومرتبته. وكذلك قول من قال خير الشعر أكذبه، فهذا مراده، لأن الشعر لا يكتسب من حيث هو شعرٌ فضلاً ونقصاً، وانحطاطاً وارتفاعاً، بأن يَنحَل الوضيعَ صفةً من الرفعة هو منها عارٍِ، أو يصفَ الشريف بنقص وعار، فكم جواد بخَّله الشعر وبخيلٍ سخَّاه؛ وشُجاعٍ وسمه بالجُبن وجبانٍ سَاوَى به الليث؛ ودَنِيٍّ أوطأه قِيمّة العيُّوق، وغَبيٍّ قضى له بالفهم، وطائش ادَّعى له طبيعة الحُكْم، ثم لم يُعتَبر ذلك في الشعر نفسه حيث تُنتقَدُ دنانيره وتُنشَر ديابيجه، ويُفتَق مسكه فيضوعُ أَريجُهُ. وأما من قال في معارضة هذا القول: خير الشعر أصدقه، كما قال:
|
وإنَّ أَحْسَن بيتٍ أنت قائلهُ |
|
بَيْتٌ يقالُ إذا أنشدتَه صَدَقَا |
فقد يجوز أن يراد به أن خير الشعر ما دلّ على حِكْمة يقبلها العقلُ، وأدبٍ يجب به الفضل، وموعظةٍ تُروِّض جماح الهوى وتبعث على التقوى، وتُبيّن موضع القُبح والحُسن في الأفعال، وتَفْصل بين المحمود والمذموم من الخصال، وقد يُنحَى بها نحو الصدق في مدح الرجال، كما قيل: كان زهير لا يمدح الرجل إلا بما فيه، والأول أولى، لأنهما قولان يتعارضان في اختيار نوعي الشعر. فمن قال خيره أصدقه كان تركُ الإغراق والمبالغة والتجوُّز إلى التحقيق والتصحيح، واعتمادُ ما يجرى من العقل على أصل صحيح، أحبَّ إليه وآثرَ عنده، إذ كان ثمره أحلى، وأثره أبقى، وفائدته أظهر، وحاصله أكثر، ومن قال أكذبُه، ذهب إلى أن الصنعة إنما تَمُدُّ باعها، وتنشر شُعَاعها، ويتّسع مَيْدانها، وتتفرّع أفنانها، حيث يعتمد الاتّساع والتخييل، ويُدَّعى الحقيقة فيما أصله التقريب والتخيل وحيث يُقصَد التلطف و التأويل ويذهب بالقول مذهب المبالغة والإغراق في المدح والذمّ والوصف والنعت والفخر والمباهاة وسائر المقاصد والأغراض، وهناك يجد الشاعرُ سبيلاً إلى أن يُبدع ويزيد، ويُبدي في اختراع الصّور ويُعيد، ويصادف مضطرباً كيف شاء واسعاً، ومَدَداً من المعاني متتابعاً، ويكون كالمغترف من عِدٍّ لا ينقطع، والمُسْتَخرج من مَعْدِنٍ لا ينتهي. وأما القبيل الأول فهو فيه كالمقصور المُدانَى قَيْدُه، والذي لا تتّسع كيف شاء يَدُه وأيْدُه، ثم هو في الأكثر يسرد على السامعين معانىَ معروفةً وصوراً مشهورة، ويتصرّف في أصول هي وإن كانت شريفةً، فإنها كالجواهر تُحفَظ أعدادها، ولا يُرْجَى ازديادها، وكالأعيان الجامدة التي لا تَنْمي ولا تزيد، ولا تربح ولا تُفيد، وكالحسناء العقيم، والشجرة الرَّائقة لا تُمتِّع بجَنًى كريم. هذا ونحوه يمكن أن يُتَعلَّق به في نصرة التخييل وتفضيله، والعقل بعدُ على تفضيل القبيل الأول وتقديمه وتفخيم قدره وتعظيمه، وما كان العقلُ ناصرَهُ، والتحقيقُ شاهدَه، فهو العزيز جانبه، المنيع مَنَاكبُه، وقد قيل الباطل مخصوم وإن قُضي له، والحقّ مُفْلجٌ وإن قُضي عليه، هذا ومَنْ سلَّم أنّ المعاني المُعرِقة في الصدق، المستخرَجة من مَعْدِن الحقّ، في حكم الجامد الذي لا يَنْمِي، والمحصور الذي لا يزيد؛ وإن أردت أن تعرف بُطْلان هذه الدعوى فانظر إلى قول أبي فراس:
|
وكنَّا كالسهامِ إذَا أصابَتْ |
|
مَرَامِيَها فَرَامِيهَا أَصَابَا |
ألست تراه عقليّاً عريقاً في نسبه، معترَفاً بقوّة سببه، وهو على ذلك من فوائد أبي فراسٍ التي هي أبو عُذْرِها، والسابق ُإلى إثارة سِرّها، واعلم أن الاستعارة لا تدخل في قبيل التخييل، لأن المستعير لا يقصد إلى إثبات معنى اللفظةِ المستعارة، وإنما يعمد إلى إثبات شَبَهٍ هناك، فلا يكون مَخْبَرُهُ على خلاف خَبَره، وكيف يعرض الشكُّ في أَنْ لا مدخل للاستعارة في هذا الفنّ، وهي كثيرة في التنزيل على ما لا يخفَى، كقوله عز وجل: "وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً" "مريم: 4"، ثم لا شبهةَ في أنْ ليس المعنى على إثبات الاشتعال ظاهراً، وإنما المراد إثبات شَبهه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، ليس على إثباته مِرآةً من حيث الجسم الصَّقيل، لكن من حيث الشَّبه المعقول، وهو كونها سبباً للعلم بما لولاها لم يعْلَم، لأن ذلك العلم طريقُه الرؤية، ولا سبيل إلى أن يرى الإنسان وجهَه إلا بالمرآة وما جرى مجراها من الأجسام الصَّقيلة، فقد جمع بين المؤمن والمرآة في صفة معقولة، وهي أن المؤمن ينصَح أخاه ويُريه الحسَن من القبيح، كما تري المرآةُ الناظرَ فيها ما يكون بوجهه من الحسن وخلافه، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم وخَضْراءَ الدِّمَن"، معلوم أن ليس القصدُ إثباتَ معنى ظاهر اللفظين، ولكن الشَّبهُ الحاصل من مجموعهما، وذلك ُحسن الظاهر مع خُبْثِ الأصل، وإذا كان هذا كذلك، بانَ منه أيضاً أنّ لك مع لُزوم الصدق، والثبوت على محض الحقّ، الميدانَ الفسيح والمجالَ الواسع، وأنْ ليس الأمر على ما ظنَّه ناصر الإغراق والتخييل الخارج إلى أن يكون الخَبَر على خلاف المَخْبَر، من أنه إنما يتّسع المقال ويَفْتَنّ، وتكثر موارد الصنعة ويغزُر يُنْبُوعها، وتكثر أغصانها وتتشعّب فروعها، إذا بُسِط من عنان الدعوى، فادُّعي ما لا يَِصحّ دعواه، وأثبت ما ينفيه العقل ويَأباه. وجملة الحديث أن الذي أريده بالتخييل ها هنا، ما يُثبت فيه الشاعر أمراً هو غير ثابتٍ أصلاً، ويدَّعي دعوَى لا طريقَ إلى تحصيلها، ويقولُ قولاً يخدع فيه نفسه ويُريها ما لا ترى، فأمَّا الاستعارة فإن سبيلَها سبيلُ الكلام المحذوف، في أنك إذا رجعت إلى أصله، وجدتَ قائله وهو يُبت أمراً عقليّاً صحيحاً، ويدّعي دعوَى لها سِنْخٌ في العقل، وستمرُّ بك ضروبٌ من التخييل هي أظهرُ أمراً في البُعد عن الحقيقة، وأكشفُ وجهاً في أنه خداعٌ للعقل، وضربٌ من التزويق، فتزداد استبانة للغَرَض بهذا الفصل، وأَزيدُك حينئذ إن شاء اللَّه، كلاماً في الفرق بين ما يدخل في حيّز قولهم خير الشعر أكذبه، وبين ما لا يدخل فيه مما يشاركه في أنه اتِّساع وتجوّزٌ فاعرفه. وكيف دار الأمرُ فإنهم لم يقولوا خير الشعر أكذبه، وهم يريدون كلاماً غُفْلاً ساذجاً يكذب فيه صاحبُه ويُفْرِط، نحو أن يصف الحارسَ بأوصاف الخليفة،ويقول للبائس المسكين إنّك أمير العِرَاقَيْن، ولكن ما فيه صنعةٌ يتعمَّل لها، وتدقيقٌ في المعاني يحتاج معه إلى فطنة لطيفةٍ وفهمٍ ثاقبٍ وغوصٍ شديد، واللَّه الموافق للصواب، وأعود إلى ما كنت فيه من الفصل بين المعنى الحقيقي وغير الحقيقي. واعلم أن ما شأنه التخييل، أمْرُه في عِظَم شجرته إذا تُؤُمِّلَ نَسَبُه، وعُرفت شُعُوبه وشُعَبُه، على ما أشرت إليه قُبَيلُ، لا يكاد تجيء فيه ِقِسْمةٌ تستوعبه، وتفصيل يَستغرقه، وإنما الطريق فيه أن يُتَّبَعَ الشيء بعد الشيءِ ويُجمع ما يحصُره الاستقراء، فالذي بدأتُ به من دعوى أصلٍ وعلّةٍ في حُكمٍ من الأحكام، هما كذلك ما تُرِكَتْ المضايقة، وأُخذ بالمسامحة، ونُظر إلى الظاهر، ولم يُنقَّر عن السرائر، وهو النَمَطُ العَدْل والنُمْرُقة الوُسطَى، وهو شيءٌ تراه كثيراً بالآداب والحِكم البريئة من الكذب، ومن الأمثلة فيه قول أبي تمام:
|
إنّ رَيْبَ الزمـان يُحْـسِـنُ أن يُه |
|
دِي الرَّزَايا إلى ذَوي الأحـسـابِ |
|
فَلِهذَا يَجـفُّ بَـعْـدَ اخـضـرارٍ |
|
قَبْلَ رَوْضِ الوِهادِ رَوْضُ الرَّوَابي |
وكذا قولُه يذكر أنّ الممدوح قد زاده، مَع بُعده عنه وغيبتِه، في العطايا على الحاضرين عنده اللاَّزمين خِدْمَته:
|
لَزِمُوا مَرْكَزَ الـنَّـدَى وذَراهُ |
|
وعَدَتْنا عَنْ مثْل ذاك العَوَادي |
|
غيرَ أنَّ الرُّبَى إلى سَبَل الأنو |
|
اءِ أدنَى والحظُّ حَظُّ الوِهَادِ |
لم يقصِد من الربى هاهنا إلى العلوّ، ولكن إلى الدنوّ فقط، وكذلك لم يُردْ بذكر الوهاد الضَّعةَ والتَّسفُّل والهُبوط، كما أشار إليه في قوله "والسَّيْلُ حَربٌ للمكان العالي" وإنما أراد أن الوهاد ليس لها قُرْبُ الرُّبَى من فيض الأنواء، ثم إنها تتجاوزُ الرُّبَى التي هي دانية قريبة إليها، إلى الوهاد التي ليس لها ذلك القُرْب. ومن هذا النَّمط، في أنه تخييل شبيةٌ بالحقيقة لاعتدال أمره، وأنّ ما تعلَّق به من العِلَّة موجود على ظاهرِ مَا ادَّعى، قولُه:
|
لَيْسَ الحجابُ بمُقْصِ عنك لي أمَلاً |
|
إنَّ السماءَ تُرَجَّى حِين تَحْتَجِـبُ |
فاستتارُ السماء بالغيم هو سبب رجاءِ الغَيْث الذي يُعَدُّ في مجرى العادة جُوداً منها ونعْمةً، صادرةً عنها، كما قال ابن المعتز:
|
ما تَرَى نعْمةَ السماءِ على الأَرْ |
|
ضِ وشُكْرَ الرِّياضِ للأمْطارِ |
وهذا نوعٌ آخرُ، وهو دعواهم في الوصف هو خِلقةٌ في الشيء وطبيعةٌ، أو واجبٌ على الجملة، من حيث هو أنّ ذلك الوصف حصل له من الممدوح ومنه استفادَهُ،، وأصل هذا التشبيهُ، ثم يتزايد فيبلُغ هذا الحدَّ، ولهم فيه عباراتٌ منها قولهم إن الشمس تستعير منه النور وتستفيد، أو تتعلّم منه الإشراق وتكتسب منه الإضاءة، وألطفُ ذلك أن قال: تسْرقُ، وأن نورها مسروق من الممدوح، وكذلك يقال المِسْكُ يَسْرِق منْ عَرْفِه، وأنّ طيبه مُسْتَرَقٌ منه ومن أخلاقه، قال ابن بابك:
|
ألا يا رياضَ الحَزْن من أَبرق الحِمَى |
|
نَسِيمُك مسروقٌ ووَصفُك مُنْتَـحَـلْ |
|
حكيتِ أبا سَعْدٍ فنَـشْـرُكِ نَـشْـرُهُ |
|
ولكنْ له صِدْقُ الهَوَى ولكِ المَلَـلْ |
ونوع آخر، وهو أن يدَّعيَ في الصفة الثانية للشيء أنه إنما كان لِعلَّةٍ يضعها الشاعر ويختلقُها، إمّا لأمرٍ يرجع إلى تعظيم الممدوح، أو تعظيم أمرٍ من الأمور، فمن الغريب في ذلك معنى بيت فارسيٍّ ترجَمَتُهُ:
|
لَوْ لَم تكن نِيَّةُ الجوزاءِ خِدْمتَهُ |
|
لَمَا رأيتَ عليها عِقْدَ مُنْتطقِ |
فهذا ليس من جنس ما مضى، أعني ما أصله التشبيه، ثم أريد التناهي في المبالغة والإغراق والإغراب. ويدخل في هذا الفن قول المتنبي:
|
لم يَحْكِ نائلَكَ السَّحابُ وإَّنما |
|
حُمَّتْ به فصبيبُها الرَُّحَضاءُ |
لأنه وإن كان أصله التشبيه، من حيث يشبّه الجَوَاد بالغَيْث، فإنه وَضَعَ المعنى وضعاً وصوَّره في صورةٍ خرج معها إلى ما لا أصل له في التشبيه، فهو كالواقع بين الضَرْبَين، وقريبٌ منه في أن أصله التشبيه ثم باعده بالصنعة في تشبيهه وخلع عنه صورته خلعاً، قولُهُ:
|
ومَا رِيحُ الرِّياض لَها ولكـن |
|
كَسَاها دَفْنُهُمْ في التُرْبِ طيبَا |
ومن لطيف هذا النوع قولُ أبي العباس الضبّي:
|
لا تركننَّ إلـى الـفـرا |
|
قِ وإن سَكَنْتَ إلى العِنَاقِ |
|
فالشمسُ عِنْدَ غروبـهـا |
|
تصفَرُّ من فَرَقِ الفِراقِ |
ادَّعَى لتعظيم شأن الفراق أنّ ما يُرَى من الصُفرة في الشمس حين يرِقُّ نورها بدنّوها من الأرض، إنما هو لأنها تُفارق الأُفٌق الذي كانت فيه، أو الناسَ الذين طلعت عليهم وأنِسَتْ بهم وأنِسوا بها وسَرَّتْهم رُؤْيتُها، ونوع منه قولُ الآخر:
|
قضيبُ الكَرْمِ نَقْطَعه فَيَبْكِي |
|
ولا تَبْكي وقد قَطَع الحبيبُ |
وهو منسوب إلى إنشاد الشّبلي، ويقال أيضاً أن أبا العباس أخذ معناه في بيته من قول بعض الصُّوفية وقيل له: لِمَ تصفرُّ الشمس عند الغروب؛ فقال من حَذَر الفراق، ومن لطيف هذا الجنس قول الصُّولي:
|
الرِّيح تَحْسُدُني عـلـي |
|
كِ ولم أخَلْهَا في العِدَا |
|
لَمَّا هَمَمْـتُ بـقُـبْـلةٍ |
|
رَدَت على الوَجْهِ الرِّدَا |
وذلك أن الريح إذا كان وجهها نحو الوَجْه، فواجب في طِباعها أن تردّ الرداء عليه، وأن تلُفّ من طرفيه، وقد ادّعى أن ذلك منها لحسدٍ بها وغَيْرَةٍ على المحبوبة، وهي من أجل ما في نفسها تَحُول بينه وبين أن ينال من وجهها. وفي هذه الطريقة قوله:
|
وحَارَبَني فيه رَيْبُ الزَّمانِ |
|
كأنَّ الزَّمانَ لهُ عاشـقُ |
إلاَّ أنه لم يضع عِلّة ومعلولاً من طريق النصّ على شيء، بل أثبت محاربةً من الزمان في معنى الحبيب، ثم جعل دليلاً على عِلَّتها جوازَ أن يكون شريكاً له في عشقه، وإذا حقَّقْنا لم يجب لأجل أن جَعَلَ العِشقِ عِلَّة للمحاربة، وجَمَع بين الزمان والريح، في ادعاء العداوةِ لَهُما أن يتناسب البيتان من طريق الخصوص والتفصيل. وذاك أن الكلام في وضع الشاعر للأمر الواجب علّةً غيرَ معقولٍ كونُها علّةً لذلك الأمر، وكونُ العشق علّةً للمعاداة في المحبوب معقولٌ معروف غير بِدْعٍ ولا مُنكَر، فإذا بدأ فادّعى أن الزمان يعاديه ويحاربه فيه، فقد أعطاك أنّ ذلك لمثل هذه العلّة وليس إذا ردَّت الريح الرِّداء، فقد وَجب أن يكون ذلك لعلّة الحسد أو لغيرها، لأن ردَّ الرداء شأنُها، فاعرفه، فإن مِنْ شَأن حكم المُحصِّل أن لا ينظر في تلاقي المعاني وتناظُرها إلى جُمَل الأمور، وإلى الإطلاق والعموم، بل ينبغي أن يدقّقَ النظر في ذلك، ويراعَى التناسب من طريق الخصوص والتفاصيل، فأنت في نحو بيت ابن وُهيب تدّعى صفةً غير ثابتة، وهي إذا ثبتت اقتضت مثل العِلّة التي ذكرها، وفي نحو بيت الريح، تذكر صفةً غير ثابتة حاصلةً على الحقيقة، ثم تدّعي لها علة من عند نفسك وضعاً واختراعاً، فافهمه، وهكذا قول المتنبي:
|
مَلامِي النَّوَى في ظُلْمها غايةُ الظُّلْمِ |
|
لعلَّ بها مِثْلَ الَّذِي بِي مِن السُّقـمِ |
|
فَلَوْ لم تَغَرْ لم تَزْوِ عَنِّي لِقـاءَكُـم |
|
ولو لم تُرِدْكُمْ لم تكنْ فِيكُمُ خَصْمِي |
الدعوى في إثبات الخصومة، وجَعْلِ النَّوى كالشيء الذي يعقل ويميّز ويريد ويختار، وحديثُ الغَيرةِ والمشاركةِ في هوى الحبيب، يثبُتُ بثبوت ذلك من غير أن يفتقر مِنك إلى وَضْعٍ واختراع. ومما يلحق بالفنّ الذي بدأتُ به قولُه:
|
بِنَفسِيَ ما يشكوهُ مَن راح طَرْفُهُ |
|
ونَرْجِسُهُ مِمّا دَهَى حُسنَه وَردُ |
|
أراقَتّْ دَمِي عَمْداً مَحاسنُ وجهه |
|
فأضْحَى وفي عَيْنَيه آثارُه تَبْدُو |
لأنه قد أتى لحمرة العين وهي عارض يَعْرِض لها من حيث هي عينٌ بعلّةٍ يعلم أنها مخترعَة موضوعة، فليس ثمَّ إراقة دم، وأصْل هذا قول ابن المعتز:
|
قَالُوا اشتكتْ عَيْنُه فقُلْتُ لَهُـم |
|
مِن كَثْرةِ القَتْل نَالَها الوَصَبُ |
|
حُمْرتُها مِن دِماءِ مَن قتلَـتْ |
|
والدَّمُ في النَّصْل شاهدٌ عَجَبُ |
وبين هذا الجنس وبين نحو الرّيح تحسدني، فرقٌ، وذلك أن لك هناك فِعلاً هو ثابت واجب في الريح، وهو ردُّ الرداء على الوجه، ثم أحببت أن تتطرّف، فادَّعيت لذلك الفعل علّةً من عند نفسك، وأما هاهنا فنظرتَ إلى صفةٍ موجودة، فتأوّلتَ فيها أنها صارت إلى العين من غيرها، وليست هي التي من شأنها أن تكونَ في العين، فليس معك هنا إلا معنىً واحدٌ، وأما هناك فمعك معنيان: أحدُهما موجودٌ معلومٌ، والآخرُ مُدَّعًى موهومٌ فاعرفه. وممّا يشبه هذا الفَنَّ الذي هو تأوُّلٌ في الصفة فقط، من غير أن يكون معلولٌ وعلّةٌ، ما تراه من تأوُّلهم في الأمراض والحمَّيَات أنها ليست بأمراض، ولكنها فِطَنٌ ثاقبة وأذهانٌ متوقِّدة وعَزَمات، كقوله:
|
وحُوشِيتَ أن تَضْرَى بجسمك عِلَّةٌ |
|
ألاَ إنَّها تلك العُزُوم الثَّـواقـبُ |
وقال ابن بابك:
|
فترتَ وما وجدتَ أبا العلاءِ |
|
سِوَى فَرْط التوقُّد والذَّكاءِ |
ولكشاجم، يقوله في علي بن سليمان الأخفش:
|
ولقد أخطـأَ قـومٌ زعـمـوا |
|
أنها من فَضْل بَرْدٍ في العَصَبْ |
|
هُو ذَاكَ الذِّهـن أذكـى نَـارَه |
|
وَالمِزَاجُ المُفْرِطُ الحَرِّ التهبْ |
ولا يكون قول المتنبي:
|
وَمَنازلُ الحُمَّى الجُسومُ فقلْ لنا |
|
مَا عُذْرُها في تَرْكها خَيراتِها |
|
أعجبتَها شَرَفاً فَطَال وُقُوفُهـا |
|
لتأَمُّلِ الأعضاءِ لاَ لأَذَاتِـهـا |
من هذا في شيء، بأكثر من أن كلا القولين في ذكر الحُمَّى، وفي تطييب النفس عنها، فهو اشتراك في الغَرض والجنس، فأما في عمود المعنى وصورته الخاصة فلاَ، لأن المتنبي لم ينكر أنه ما يجده الممدوح حُمَّى كما أنكره الآخر، ولكنّه كأنه سأل نفسه كيف اجترأت الحمَّى على الممدوح، مع جلالته وهيبته، أم كيف جَاز أن يقصد شيءٌ إلى أذاه مع كَرَمه ونُبله، وأن المحبّة من النفوس مقصورة عليه? فتحمَّلَ لذلك جواباً، ووضع للحُمَّى فيما فعلته من الأذى عُذْراً، وهو تصريحُ ما اقتصر فيه على التعجُّب في قوله:
|
أيَدْري مَـا أَرابَـك مَـن يُريبُ |
|
وَهلْ تَرْقَى إلى الفَلك الخطوبُ |
|
وجسمُك فَوْق هِـمَّةِ كُـلِّ داءٍ |
|
فقُرْبُ أقلِّها مـنـه عـجـيبُ |
إلا أن ذلك الإيهام أحسن من هذا البيان، وذلك التعجُّبُ موقوفاً غيرَ مجاب، أولَى بالإعجاب، وليس كل زيادة تُفلح، وكل استقصاء يَمْلُح. ومن واضح هذا النوع وجيّده قولُ ابن المعتزّ:
|
صدَّت شُرَيْرُ وأزمعت هَجْرِي |
|
وَصَغَت ضَمائرُها إلى الغَدْرِ |
|
قالت كَبِرتَ وشِبتَ قلتُ لهـا |
|
هذا غُبارُ وَقَـائعِ الـدَّهْـرِ |
ألا تراه أنكر أن يكون الذي بدا به شيباً، ورأى الاعتصام بالجَحْد أخصَر طريقاً إلى نَفْي العيب وقطع الخصومة، ولم يسلك الطريقة العامّية فيُثبِتَ المشيب، ثم يمنَع العائب أن يعيب، ويُريَه الخطأ في عَيْبه به، ويُلزِمَه المناقضةَ في مذهبه، كنحو ما مضى، أعني كقول البحتري: وبياضُ البازيّ. وهكذا إذا تأوَّلوا في الشيب أنه ليس بابيضاض الشعر الكائن في مجرى العادة وموضوع الخلْقة، ولكنه نُور العقل والأدبِ قد انتشر، وبان وَجْهه وظهر، كقول الطائي الكبير:
|
ولا يُرَوِّعْك إيماضُ القَتِير به |
|
فَإنَّ ذاك ابتسامُ الرَّأْي والأدبِ |
وينبغي أن تعلمَ أنّ باب التشبيهات قد حظِي من هذه الطريقة بضرب من السِّحْر، لا تأتي الصفة على غَرابته، ولا يبلُغ البيان كُنَه ما ناله من اللُّطف والظَّرف، فإنه قد بلغ حدّاً يرُدُ لمعروفَ في طِباع الغَزِل، ويُلْهى الثَّكْلان من الثُّكْل، ويَنْفُث في عُقَد الوَحشة، وينشُد ما ضلّ عنك من المسَرَّةِ، ويشهد لِلشِّعر بما يُطيل لِسَانه في الفخر، ويُبين جُمْلة ما للبيان من القُدرة والقَدْر، فمن ذلك قول ابن الرومي:
|
خجِلتْ خدودُ الورد من تفضيله |
|
خَجَلاً تورُّدُها علـيه شـاهـدُ |
|
لم يَخْجَلِ الوردُ المورَّدُ لـونُـه |
|
إلاَّ وناحِلهُ الفضـيلةَ عـانـدُ |
|
للنرجس الفضلُ المُبينُ وإن أبَى |
|
آبٍ وحادَ عن الطـريقة حـائدُ |
|
فصْلُ القضـية أنّ هـذا قـائدٌ |
|
زَهَرَ الرياضِ وأَنّ هذا طاردُ |
|
شتَّانَ بين اثنين هـذا مُـوعِـدُ |
|
بتَسلُّبِ الـدُّنـيا وهَـذَا واعـدُ |
|
يَنْهَى النديمَ عن القبيح بلحظِـه |
|
وَعَلَى المُدامةِ والسماعِ مُساعدُ |
|
اطلبْ بِعَفْوك في الملاح سَمِيَّه |
|
أبداً فإنك لا مَـحَـالة واجـدُ |
|
والوَرْدُ إن فكّرتَ فردٌ في اسمه |
|
ما في الملاح له سمِيُّ واحـدُ |
|
هذي النجومُ هي التي رَبَّتْهُمـا |
|
بِحَيا السحابِ كما يُربِّي الوالـدُ |
|
فانظر إلى الأخَوَين مَن أدناهما |
|
شَبَهاً بوالده فذاك الـمـاجـدُ |
|
أين الخدودُ من العيون نَـفَـاسةً |
|
ورِئاسةً لولا القياسُ الفـاسـدُ |
|
وحَارَبَني فيه رَيْبُ الزَّمانِ |
|
كأنَّ الزَّمانَ لهُ عاشـقُ |
إلاَّ أنه لم يضع عِلّة ومعلولاً من طريق النصّ على شيء، بل أثبت محاربةً من الزمان في معنى الحبيب، ثم جعل دليلاً على عِلَّتها جوازَ أن يكون شريكاً له في عشقه، وإذا حقَّقْنا لم يجب لأجل أن جَعَلَ العِشقِ عِلَّة للمحاربة، وجَمَع بين الزمان والريح، في ادعاء العداوةِ لَهُما أن يتناسب البيتان من طريق الخصوص والتفصيل. وذاك أن الكلام في وضع الشاعر للأمر الواجب علّةً غيرَ معقولٍ كونُها علّةً لذلك الأمر، وكونُ العشق علّةً للمعاداة في المحبوب معقولٌ معروف غير بِدْعٍ ولا مُنكَر، فإذا بدأ فادّعى أن الزمان يعاديه ويحاربه فيه، فقد أعطاك أنّ ذلك لمثل هذه العلّة وليس إذا ردَّت الريح الرِّداء، فقد وَجب أن يكون ذلك لعلّة الحسد أو لغيرها، لأن ردَّ الرداء شأنُها، فاعرفه، فإن مِنْ شَأن حكم المُحصِّل أن لا ينظر في تلاقي المعاني وتناظُرها إلى جُمَل الأمور، وإلى الإطلاق والعموم، بل ينبغي أن يدقّقَ النظر في ذلك، ويراعَى التناسب من طريق الخصوص والتفاصيل، فأنت في نحو بيت ابن وُهيب تدّعى صفةً غير ثابتة، وهي إذا ثبتت اقتضت مثل العِلّة التي ذكرها، وفي نحو بيت الريح، تذكر صفةً غير ثابتة حاصلةً على الحقيقة، ثم تدّعي لها علة من عند نفسك وضعاً واختراعاً، فافهمه، وهكذا قول المتنبي:
|
مَلامِي النَّوَى في ظُلْمها غايةُ الظُّلْمِ |
|
لعلَّ بها مِثْلَ الَّذِي بِي مِن السُّقـمِ |
|
فَلَوْ لم تَغَرْ لم تَزْوِ عَنِّي لِقـاءَكُـم |
|
ولو لم تُرِدْكُمْ لم تكنْ فِيكُمُ خَصْمِي |
الدعوى في إثبات الخصومة، وجَعْلِ النَّوى كالشيء الذي يعقل ويميّز ويريد ويختار، وحديثُ الغَيرةِ والمشاركةِ في هوى الحبيب، يثبُتُ بثبوت ذلك من غير أن يفتقر مِنك إلى وَضْعٍ واختراع. ومما يلحق بالفنّ الذي بدأتُ به قولُه:
|
بِنَفسِيَ ما يشكوهُ مَن راح طَرْفُهُ |
|
ونَرْجِسُهُ مِمّا دَهَى حُسنَه وَردُ |
|
أراقَتّْ دَمِي عَمْداً مَحاسنُ وجهه |
|
فأضْحَى وفي عَيْنَيه آثارُه تَبْدُو |
لأنه قد أتى لحمرة العين وهي عارض يَعْرِض لها من حيث هي عينٌ بعلّةٍ يعلم أنها مخترعَة موضوعة، فليس ثمَّ إراقة دم، وأصْل هذا قول ابن المعتز:
|
قَالُوا اشتكتْ عَيْنُه فقُلْتُ لَهُـم |
|
مِن كَثْرةِ القَتْل نَالَها الوَصَبُ |
|
حُمْرتُها مِن دِماءِ مَن قتلَـتْ |
|
والدَّمُ في النَّصْل شاهدٌ عَجَبُ |
وبين هذا الجنس وبين نحو الرّيح تحسدني، فرقٌ، وذلك أن لك هناك فِعلاً هو ثابت واجب في الريح، وهو ردُّ الرداء على الوجه، ثم أحببت أن تتطرّف، فادَّعيت لذلك الفعل علّةً من عند نفسك، وأما هاهنا فنظرتَ إلى صفةٍ موجودة، فتأوّلتَ فيها أنها صارت إلى العين من غيرها، وليست هي التي من شأنها أن تكونَ في العين، فليس معك هنا إلا معنىً واحدٌ، وأما هناك فمعك معنيان: أحدُهما موجودٌ معلومٌ، والآخرُ مُدَّعًى موهومٌ فاعرفه. وممّا يشبه هذا الفَنَّ الذي هو تأوُّلٌ في الصفة فقط، من غير أن يكون معلولٌ وعلّةٌ، ما تراه من تأوُّلهم في الأمراض والحمَّيَات أنها ليست بأمراض، ولكنها فِطَنٌ ثاقبة وأذهانٌ متوقِّدة وعَزَمات، كقوله:
|
وحُوشِيتَ أن تَضْرَى بجسمك عِلَّةٌ |
|
ألاَ إنَّها تلك العُزُوم الثَّـواقـبُ |
وقال ابن بابك:
|
فترتَ وما وجدتَ أبا العلاءِ |
|
سِوَى فَرْط التوقُّد والذَّكاءِ |
ولكشاجم، يقوله في علي بن سليمان الأخفش:
|
ولقد أخطـأَ قـومٌ زعـمـوا |
|
أنها من فَضْل بَرْدٍ في العَصَبْ |
|
هُو ذَاكَ الذِّهـن أذكـى نَـارَه |
|
وَالمِزَاجُ المُفْرِطُ الحَرِّ التهبْ |
ولا يكون قول المتنبي:
|
وَمَنازلُ الحُمَّى الجُسومُ فقلْ لنا |
|
مَا عُذْرُها في تَرْكها خَيراتِها |
|
أعجبتَها شَرَفاً فَطَال وُقُوفُهـا |
|
لتأَمُّلِ الأعضاءِ لاَ لأَذَاتِـهـا |
من هذا في شيء، بأكثر من أن كلا القولين في ذكر الحُمَّى، وفي تطييب النفس عنها، فهو اشتراك في الغَرض والجنس، فأما في عمود المعنى وصورته الخاصة فلاَ، لأن المتنبي لم ينكر أنه ما يجده الممدوح حُمَّى كما أنكره الآخر، ولكنّه كأنه سأل نفسه كيف اجترأت الحمَّى على الممدوح، مع جلالته وهيبته، أم كيف جَاز أن يقصد شيءٌ إلى أذاه مع كَرَمه ونُبله، وأن المحبّة من النفوس مقصورة عليه? فتحمَّلَ لذلك جواباً، ووضع للحُمَّى فيما فعلته من الأذى عُذْراً، وهو تصريحُ ما اقتصر فيه على التعجُّب في قوله:
|
أيَدْري مَـا أَرابَـك مَـن يُريبُ |
|
وَهلْ تَرْقَى إلى الفَلك الخطوبُ |
|
وجسمُك فَوْق هِـمَّةِ كُـلِّ داءٍ |
|
فقُرْبُ أقلِّها مـنـه عـجـيبُ |
إلا أن ذلك الإيهام أحسن من هذا البيان، وذلك التعجُّبُ موقوفاً غيرَ مجاب، أولَى بالإعجاب، وليس كل زيادة تُفلح، وكل استقصاء يَمْلُح. ومن واضح هذا النوع وجيّده قولُ ابن المعتزّ:
|
صدَّت شُرَيْرُ وأزمعت هَجْرِي |
|
وَصَغَت ضَمائرُها إلى الغَدْرِ |
|
قالت كَبِرتَ وشِبتَ قلتُ لهـا |
|
هذا غُبارُ وَقَـائعِ الـدَّهْـرِ |
ألا تراه أنكر أن يكون الذي بدا به شيباً، ورأى الاعتصام بالجَحْد أخصَر طريقاً إلى نَفْي العيب وقطع الخصومة، ولم يسلك الطريقة العامّية فيُثبِتَ المشيب، ثم يمنَع العائب أن يعيب، ويُريَه الخطأ في عَيْبه به، ويُلزِمَه المناقضةَ في مذهبه، كنحو ما مضى، أعني كقول البحتري: وبياضُ البازيّ. وهكذا إذا تأوَّلوا في الشيب أنه ليس بابيضاض الشعر الكائن في مجرى العادة وموضوع الخلْقة، ولكنه نُور العقل والأدبِ قد انتشر، وبان وَجْهه وظهر، كقول الطائي الكبير:
|
ولا يُرَوِّعْك إيماضُ القَتِير به |
|
فَإنَّ ذاك ابتسامُ الرَّأْي والأدبِ |
وينبغي أن تعلمَ أنّ باب التشبيهات قد حظِي من هذه الطريقة بضرب من السِّحْر، لا تأتي الصفة على غَرابته، ولا يبلُغ البيان كُنَه ما ناله من اللُّطف والظَّرف، فإنه قد بلغ حدّاً يرُدُ لمعروفَ في طِباع الغَزِل، ويُلْهى الثَّكْلان من الثُّكْل، ويَنْفُث في عُقَد الوَحشة، وينشُد ما ضلّ عنك من المسَرَّةِ، ويشهد لِلشِّعر بما يُطيل لِسَانه في الفخر، ويُبين جُمْلة ما للبيان من القُدرة والقَدْر، فمن ذلك قول ابن الرومي:
|
خجِلتْ خدودُ الورد من تفضيله |
|
خَجَلاً تورُّدُها علـيه شـاهـدُ |
|
لم يَخْجَلِ الوردُ المورَّدُ لـونُـه |
|
إلاَّ وناحِلهُ الفضـيلةَ عـانـدُ |
|
للنرجس الفضلُ المُبينُ وإن أبَى |
|
آبٍ وحادَ عن الطـريقة حـائدُ |
|
فصْلُ القضـية أنّ هـذا قـائدٌ |
|
زَهَرَ الرياضِ وأَنّ هذا طاردُ |
|
شتَّانَ بين اثنين هـذا مُـوعِـدُ |
|
بتَسلُّبِ الـدُّنـيا وهَـذَا واعـدُ |
|
يَنْهَى النديمَ عن القبيح بلحظِـه |
|
وَعَلَى المُدامةِ والسماعِ مُساعدُ |
|
اطلبْ بِعَفْوك في الملاح سَمِيَّه |
|
أبداً فإنك لا مَـحَـالة واجـدُ |
|
والوَرْدُ إن فكّرتَ فردٌ في اسمه |
|
ما في الملاح له سمِيُّ واحـدُ |
|
هذي النجومُ هي التي رَبَّتْهُمـا |
|
بِحَيا السحابِ كما يُربِّي الوالـدُ |
|
فانظر إلى الأخَوَين مَن أدناهما |
|
شَبَهاً بوالده فذاك الـمـاجـدُ |
|
أين الخدودُ من العيون نَـفَـاسةً |
|
ورِئاسةً لولا القياسُ الفـاسـدُ |
وترتيب الصنعة في هذه القطعة، أنه عمل أوَّلاً على قلب طرفَي التشبيه، كما مضى في فصل التشبيهات، فشبّه حُمرةَ الورد بحمرة الخجل، ثم تناسَى ذلك وخَدعَ عنه نفسه، وحملها على أن تعتقد أنه خَجَلٌ على الحقيقة، ثم لما اطمأنَّ ذلك في قلبه واستحكمت صورته، طَلَبَ لذلك الخجل عِلّةً، فجعل عِلَّته أنْ فُضِّل على النرجس، ووُضِع في منزلةٍ ليس يرى نفسَهُ أهْلاً لها، فصار يتَشوَّر من ذلك، ويتخوّف عيبَ العائب، وغميزةَ المستهزئ، ويجدُ ما يجد مَنْ مُدِح مِدْحةً يَظْهر الكذب فيها ويُفْرِط، حتى تصير كالهُزء بمن قُصِد بها، ثم زادته الفِطْنة الثاقبةُوالطبع المُثْمر في سحر البيان، ما رأيت من وضع حِجاج في شأن النرجس، وجهةِ استحقاقه الفضلَ على الورد، فجاء بحُسنٍ وإحسانٍ لا تكاد تجد مثله إلاّ له. ومما هو خليقٌ أن يوضع في منزلة هذه القطع، ويلحق بها في لطف الصنعة، قول أبي هِلالٍ العسكري:
|
زَعَم البَنَفْسَجُ أنَّـه كـعِـذَارهِ |
|
حُسْناً فسَلُّوا مِن قَفَاه لسـانَـهُ |
|
لَم يَظْلِمُوا في الحكم إذْ مَثَلوا به |
|
فلشَدَّمَا رفع البَنَفْسَجُ شَـانَـهُ |
وقد اتفق للمتأخرين من المحْدَثين في هذا الفن نُكَتٌ ولطائف، وبِدَعٌ وظرائف، لا يُستكثر لها الكثير من الثّناء، ولا يضيق مكانُها من الفَضْل عن سَعَة الإطراء، فمن ذلك قول ابن نباتة في صفة الفرس:
|
وأدهمُ يستمدُّ الـلـيلُ مـنـه |
|
وتَطلُع بين عَينَـيه الـثُّـريَّا |
|
سَرَى خَلْفَ الصَّباحِ يطير مَشْياً |
|
ويَطْوِي خَلْفَه الأفـلاكَ طَـيّاً |
|
فلَمّا خاف وَشْكَ الفَوْتِ مـنـه |
|
تَشَبَّثَ بالقـوائم والـمُـحَـيَّا |
وأحسن من هذا وأحكم صنعةً قولُه في قطعة أخرى:
|
فكأنما لَطَمَ الصباحُ جـبـينَـهُ |
|
فاقتصَّ منه وخَاضَ في أَحشائهِ |
وأول القطعة:
|
د جَاءَنا الطِّرْفُ الذي أهْـدَيْتَـهُ |
|
هَادِيه يَعْقِد أرضَه بـسـمـائهِ |
|
َوِلايةً وَلَّيتَـنـا فـبَـعَـثْـتَـهُ |
|
رُمحاً سَبيبُ العُرفِ عَقْدُ لِوائِه |
|
ختال منه على أَغَرَّ محـجَّـلٍ |
|
ماءُ الدَّياجي قطرةٌ مـن مـائهِ |
|
كأنما لَطَمَ الصَّبـاحُ جـبـينَـهُ |
|
فاقتصَّ منه وخَاضَ في أحشائِه |
|
تمهِّلاً والبرقُ مـن أسـمـائه |
|
مُتبرقعاً والحُسْنُ من أكـفـائِه |
|
مَا كانت النِّيران يَكْمُنُ حَـرُّهـا |
|
لَوْ كان للنِّيران بعـضُ ذَكـائِه |
|
لا تَعْلَقُ الألحاظُ في أَعطـافِـه |
|
إلاَّ إذا كفكفتَ مـن غُـلَـوائهِ |
|
لاَ يُكمِلُ الطرْفُ المحاسنَ كُلَّها |
|
حَتَّى يكونَ الطَّرْفُ من أُسَرائِه |
ومما له في التفضيلِ الفَضْلُ الظاهرُ لحسن الإبداع، مع السلامة من التكلُّف، قوله:
|
وماءٍ عَلى الرَّضْرَاض يَجْري كأنَّهُ |
|
صحائفُ تِبْرٍ قد سُبِكْـنَ جـداولاَ |
|
كأنّ بها من شدة الـجَـرْيِ جِـنَّةً |
|
وقَدْ ألبستهُنَّ الـرِّياحُ سَـلاَسـلاَ |
وإنما ساعده التوفيقُ، من حيث وُطّئ له من قبلُ الطريقُ، فسبق العُرْفُ بتشبيه الحُبُك على صفحات الغُدْران بحلَق الدروع، فتدرَّج من ذلك إلى أن جعلها سلاسل، كما فعل ابن المعتزّ في قوله:
|
وأنهارِ ماءٍ كالسلاسل فُجـرّت |
|
لتُرضِع أولادَ الرياحين والزَهْرِ |
ثم أتمّ الحِذْق بأن جعل للماء صفة تَقْتَضي أن يُسَلْسَل، وقَرُبَ مأخذُ ما حاول عليه، فإن شدة الحركة وفرط سرعتها من صفات الجنون، كما أن التمهُّل فيها والتأنّي من أوصاف العقل، ومن هذا الجنس قولُ ابن المعتزّ في السيف، في أبيات قالها في الموفَّق، وهي:
|
وفَارسٍ أَغْمَدَ فـي جُـنّةٍ |
|
تُقطّع السيفَ إذا ما وَرَدْ |
|
كأنها ماءٌ علـيه جَـرَى |
|
حتى إذا ما غاب فِيهِ جَمَدْ |
|
في كفّهِ عَضْبٌ إذا هـزَّهُ |
|
حسِبتَهُ من خَوْفِه يَرْتَعِـد |
فقد أراد أن يخترع لهزّةِ السيف عِلّةً، فجعلها رِعْدَة تناله من خوف الممدوح وهَيْبَته، ويُشبه أن يكون ابن بابك نظر إلى هذا البيت وعلَّق منه الرعدة في قوله:
|
فإن عَجَمَتْني نيُوبُ الخطـوبِ |
|
وأَوْهَى الزمانُ قُوَى مُنَّتِـي |
|
فَمَا اضطرب السيفُ من خِيفةٍ |
|
ولا أُرعِدَ الرمحُ مـن قِـرَّةِ |
إلا أنه ذهب بها في أسلوب آخر، وقصد إلى أن يقول إنّ كون حركات الرمح في ظاهر حركة المرتعد، لا يوجبُ أن يكون ذلك من آفة وعارض، وكأنه عكس القضيّة فأبَى أن تكون صفة المرتعد في الرمح للعلل التي لمثلها تكون في الحيوان. وأمَّا ابن المعتزّ فحقّق كونها في السيف على حقيقة العلّةِ التي لها تكون في الحيوان فاعرفه. وقد أعاد هذا الارتعادَ على الجملة التي وصفتُ لك، فقال:
|
قالُوا طواهُ حُزنُهُ فـانـحـنَـى |
|
فقلتُ والشـكُّ عـدُوُّ الـيقـين |
|
ما هَيَفُ النَّرجِس مـن صَـبْـوَةٍ |
|
ولا الضَنَى في صُفرة الياسمينْ |
|
ولا ارتعادُ السَّـيفِ مـن قِـرَّةٍ |
|
ولا انعطافُ الرمح من فَرْطِ لينْ |
ومما حقُّه أن يكون طرازاً في هذا النوع قولُ البحتري:
|
يَتَعثَّرْنَ في النُّحور وفي الأَوْ |
|
جُهِ سُكْراً لمَّا شَربْنَ الدمَّاءَ |
جعل فِعلَ الطاعنِ بالرماح تعثُّراً منها، كما جعل ابن المعتزّ تحريكه للسيف وهزَّه له ارتعاداً، ثم طلب للتعثُّر عِلَّة، كما طلب هو للارتعاد فاعرفه. ومن هذا الباب قول عُلبة:
|
وكأن السَّماءَ صَاهَرَت الأَرْ |
|
ضَ فصَار النِّثارُ من كافورِ |
وقول أبي تمام:
|
كأنّ السحاب الغُرّ غَيَّبن تَحْتَها |
|
حَبِيباً فما تَرْقَا لهنّ مَدَامِـعُ |
وقول السريّ يصف الهلال:
|
جاءَك شَهْرُ السُّرُورِ شوّالُ |
|
وغال شَهْر الصِّيامِ مغتالُ |
ثم قال:
|
كأنـه قَـيْدُ فِـضّةٍ حَـرِجٌ |
|
فُضَّ عن الصائمين فاخْتالوا |
كل واحد من هؤلاء قد خدع نفسه عن التشبيه وغالطها، وأَوْهَمَ أن الذي جرى العُرْف بأن يؤخذ منه الشَّبه قد حضر وحصل بحضرتهم على الحقيقة، ولم يقتصر على دعوى حُصوله حتى نصب له عِلَّة، وأقام عليه شاهداً، فأثبت عُلبة زفافاً بين السماء والأرض، وجعل أبو تمام للسحاب حبيباً قد غُيّب في التراب، وادَّعى السريُّ أن الصائمين كانوا في قَيْدٍ، وأنه كان حَرِجاً، فلما فَضَّ عنهم انكسر بنصفين، أو اتسع فصار على شكل الهلال، والفرق بين بيت السريّ وبيتي الطائييَّن، أن تشبيه الثلج بالكافور معتاد عامّيٌّ جارٍ على الألْسُن، وجعلُ القَطْرِ الذي ينزل من السحاب دموعاً، ووَصْفُ السحابِ والسماءِ بأنها تبكي، كذلك، فأمّا تشبيه الهلال بالقَيْدِ فغير معتاد نفسه إلاّ أنَّ نظيرَه معتاد، ومعناه من حيث الصورة موجود، وأعني بالنظير ما مضى من تشبيه الهلال بالسِّوار المنفصم، كما قال:
|
حاكياً نِصفَ سِوارٍ |
|
مِنْ نُضارٍ يتوقَّـدْ |
وكما قال السري نفسه:
|
ولاح لنا الهلال كشطر طَوْقٍ |
|
على لَبَّاتِ زَرقاءِ اللـبـاسِ |
إلا أنه سَاذَجٌ لا تعليل فيه يجب من أجله أن يَكُون سِوَاراً أو طَوْقاً، فاعرفه، ورَأيت بعضهم ذكر بَيْت السريّ الذي هو: "كَأنَّه قَيْد فِضَّة حَرَجٌ" مع أبيات شعر جمعه إليها، أنشدَ قطعةَ ابن الحجاج:
|
يا صَاحِبَ البَيْتِ الَّـذِي |
|
قد مَاتَ ضَيْفاه جمِيعَا |
|
مَالِي أَرى فَلَكَ الرَّغي |
|
فِ لدَيك مُشْتَرِفاً رَفِيعَا |
|
كالبدرِ لا نرجـو إلـى |
|
وَقْت المَسَاءِ له طُلوعَا |
ثم قال إنّه شبَّه الرغيف بالبدر، لعِلَّتين إحداهما الاستدارة، والثانيةُ طلوعه مَساءً، قال وخيرُ التشبيه ما جمع مَعْنيين، كقول ابن الرمي:
|
يا شبيه البدْر في الحُس |
|
نِ وفي بُعد المَـنَـالِ |
|
جُدْ فقد تنفجِرُ الـصَّ |
|
خرةُ بالمـاءِ الـزُّلالِ |
وأنشد أيضاً لإبراهيم بن المهدي:
|
ورحمتَ أطفالاً كأفْراخ القَطَا |
|
وحنينَ وَالِهةٍ كقَوْسِ النَّـازِعِ |
ثم قال ومثله قولُ السَّري: "كأنه قَيْدُ فِضَّةٍ حَرَجٌ" وهو لا يشبه ما ذكره، إلا أنْ يَذهبَ إلى حديثِ أنه أفاد شكلَ الهلال بالقيد المفضوض، ولونَه بالفضة، فأمَّا إن قصد النكتة التي هي موضع الإغراب، فلا يستقيم الجمع بينه وبين ما أنشد، لأن شيئاً من تلك الأبيات لا يتضمَّنُ تعليلاً، وليس فيها أكثر من ضمّ شَبَهٍ إلى شبه، كالحنين والانحناء من القوس، والاستدارة والطلوع مساءً من البَدْر، وليس أحد المعنيين بِعِلّة للآخر، كيف? ولا حاجة بواحد من الشبهين المذكورين إلى تصحيحِ غيره له. ومما هو نظيرٌ لبيت السريّ وعلى طريقة قول ابن المعتزّ:
|
سَقَاني وقد سُلَّ سَيفُ الصبـا |
|
حِ والليلُ من خَوْفه قَدْ هَرَبْ |
لم يقنع هاهنا بالتشبيه الظَّاهر والقولِ المرسَل، كما اقتصر في قوله:
|
حتى بدا الصباحُ من نقابِ |
|
كما بدا المُنْصلُ من قِرابِ |
وقوله:
|
أمّا الظلامُ فحِينَ رَقَّ قَـمِـيصُـهُ |
|
وأَتى بياضُ الصُّبْح كالسَّيف الصَّدي |
ولكنه أحبّ أن يحقّق دعواه أنّ هناك سيفاً مسلولاً، ويجعل نفسه كأنها لا تعلم أن هاهنا تشبيهاً، وأنّ القصد إلى لونِ البياضِ في الشكل المستطيل، فتوصَّلَ إلى ذلك بأَن جعل الظَّلام كالعدوّ المنهزم الذي سُلّ السَّيف في قَفَاه، فهو يهرب مخافَة أن يُضْرب به، ومثل هذا في أن جعل الليلَ يخافُ الصبحَ، لا في الصنعة التي أنا في سياقها، قولُه:
|
سَبقنا إليهَا الصُّبْحَ وهو مُقـنَّـعٌ |
|
كَمِينٌ وقلبُ اللَّيلِ منه على حَذَرْ |
وقد أخذ الخالديُّ بيته الأوّل أخْذاً، فقال:
|
والصُّبحُ قد جُرِّدت صَوارِمُه |
|
والليلُ قد همَّ منه بالهَـربِ |
وهذه قطعة لابن المعتزّ، بيتٌ منها هو المقصود:
|
وانظُر إلى دُنْيَا ربِيعٍ أقـبـلـتْ |
|
مِثْلَ البَغيِّ تبـرَّجـتْ لـزُنـاةِ |
|
جاءَتـك زائرةٌ كـعـــامٍ أوّلٍ |
|
وتَلبَّستْ وتعطَّـرَتْ بـنـبـاتِ |
|
وَإذا تَعرَّى الصُبحُ من كـافـورِهِ |
|
نَطَقتْ صُنوفُ طُيورِها بِلُغـاتِ |
|
والوَرْدُ يضحكُ من نَواظر نَرْجسٍ |
|
قَذِيَت وآذنَ حَيُّهـا بـمَـمَـاتِ |
هذا البيت الأخير هو المراد، وذلك أن الضَحِك في الوَرْد وكلِّ ريحان ونُوْرٍ يَتَفَتَّح، مشهور معروف، وقد علَّله في هذا البيت، وجعل الوَرْد كأنه يعقل ويميّز، فهو يَشْمَت بالنرجس لانقضاء مُدّته وإدبار دَوْلته، وبُدُوِّ أمارات الفناء فيه، وأعاد هذا الضحك من الورد فقال:
|
ضَحِكَ الوَرْدُ في قَفَا المَنْثُورِ |
|
واسْتَرحْنَا من رِعْدَةِ المَقرُورِ |
أراد إقبال الصيف وحَرّ الهواء، ألا تراه قال بعده:
|
وَاستَطَبْنا المَقِيلَ في بَرْد ظِلّ |
|
وَشَمِمْنَا الرَّيحانَ بالكـافـورِ |
|
فالرحيلَ الرحيلَ يا عَسْكرَ الل |
|
ذّاتِ عن كُلِّ رَوْضةٍ وغَدِيرِ |
فهذا من شأنِ الورد الذي عابَه به ابن الرومي في قوله:
|
فَصْل القضية أن هـذا قـائد |
|
زَهَرَ الرياضِ وأن هذا طاردُ |
وقد جعله ابن المعتز لهذا الطَّرْدِ ضاحكاً ضحكَ مَن استولى وظفر وابتَزَّ غيرَه على وِلاية الزَّمان واستبدَّ بها، ومما يشوب الضحِكَ فيه شيءٌ من التَّعليل قوله أيضاً:
|
مَات الهَوى مِنّي وضاع شَبَابـي |
|
وقَضَيْتُ من لَـذَّاتـه آرَابـي |
|
وإذا أردتُ تَصَابياً في مجلـسٍ |
|
فالشَّيْبُ يضحَك بِي مَع الأَحبابِ |
لا شكّ أن لهذا الضحك زيادةَ معنًى ليست للضحك في نحو قول دعبل: "ضَحِكَ المَشِيبُ بِرَأْسِه فبَكَى" وما تلك الزيادة إلا أنه جعل المشيبَ يضحك ضَحِكَ المتعجِّبِ من تعاطي الرجل ما لا يليق به، وتكلُّفه الشيءَ ليس هو من أهله، وفي ذلك ما ذكرتُ من إخفاءِ صُورة التشبيه، وأَخْذِ النفس بتناسيه، وهكذا قوله:
|
لَمَّا رأونا في خَمِـيسٍ يلـتـهـبْ |
|
في شَارِقٍ يَضْحَك مِنْ غَيرِ عجبْ |
|
كَأنَّهُ صَبَّ علـى الأرض ذَهـبْ |
|
وقد بَدَت أسيافُنا مـن الـقُـرُبْ |
|
حَتىَّ تكونَ لِمـنـاياهُـمْ سَـبَـبْ |
|
نرفُلُ في الحَدِيد والأرضُ تجِـبْ |
|
وحَنَّ شَريانٌ ونَبْعٌ فاصطَخبْ |
|
تَتَرَّسُوا مِنَ القتالِ بالهَـرَبْ |
المقصودُ قولُه يضحك من غير عَجَبْ، وذاك أنّ نفيه العلّة إشارةٌ إلى أنه من جنس ما يُعلَّل، وأنّه ضَحِكٌ قَطْعاً وحقيقةً، ألا ترى أنّك لو رحبتَ إلى صريح التشبيه فقلت هيئتُه في تلألؤه كهيئة الضاحك، ثم قلت من غير عجب، قلت قولاً غير مَقْبُولٍ، واعلم أنك إن عددتَ قولَ بعض العرب:
|
ونَثْرَةٍ تهزأُ بالنِّصـالِ |
|
كأنّها من خِلَع الهلالِ |
الهِلال الحيّة هاهنا، واللام للجنس في هذا القبيل، لم يكن لك ذلك.
فصل وهذا
نوع آخر في التعليل
وهو أن يكون للمعنى من المعاني والفعلِ من الأفعال علّةٌ مشهورة من طريق العادات والطباع، ثم يجيءُ الشاعر فيمنع أن تكون لتلك المعروفة، ويضع له عِلَّةً أخرى، مثاله قول المتنبي:
|
مَا بِه قتلُ أعـاديه ولـكـن |
|
يتّقي إخلافَ ما تَرْجُو الذئابُ |
الذي يتعارفه الناس أن الرجل إذا قتل أعاديه فلإرادته هلاكَهم، وأن يدفع مضارَّهم عن نفسه، وليسلَم مُلكه ويصفُوَ من منازَعاتهم، وقد ادَّعى المتنبي كما ترى أن العِلةَ في قتل هذا الممدوح لأعدائه غير ذلك. واعلم أن هذا لا يكون حتى يكون في استئناف هذه العِلّة المدَّعاةِ فائدة شريفة فيما يتصل بالممدوح، أو يكون لها تأثير في الذمّ، كقصد المتنبي هاهنا في أن يبالغ في وصفه بالسَّخاء والجود، وأَنّ طبيعةَ الكرمِ قد غلبت عليه، ومحبَّته أن يُصدِّق رجاء الراجين، وأن يجنِّبهم الخيبة في آمالهم، قد بلغت به هذا الحدَّ، فلما علم أنه إذا غدا للحرب غَدَت الذئاب تتوقّع أن يتسع عليها الرزق، ويُخْصِب لها الوقت من قَتْلَى عداه، كَرِهَ أن يُخْلِفها، وأن يخيِّبَ رجاءهَا ولا يُسعِفُها، وفيه نوع آخر من المدح، وهو أنه يهزم العِدَى ويكسِرهم كسراً لا يطمَعون بعده في المعاوَدة، فيستغني بذلك عن قَتْلَهم وإراقة دمائهم، وأنه ليس ممن يُسْرف في القتل طاعةً للغَيْظ والحَنَق، ولا يعفو إذا قَدَر، وما يُشبه هذه الأوصاف الحَميدة فاعرفه. ومن الغريب في هذا الجنس على تَعَمُّقٍ فيه، قول أبي طالب المأموني في قصيدة يمدح بها بعض الوزراء بِبُخارى:
|
مُغرَمٌ بالثناءِ صَبٌّ بكسـب ال |
|
مَجْدِ يهتزُّ للسَّماح ارتـياحَـا |
|
لا يَذُوق الإغفـاءَ إلاّ رجـاءً |
|
أن يَرَى طيفَ مسْتَمِيحٍ رَوَاحَا |
وكأنه شَرَطَ الرّواح على معنى أن العُفاة والرَّاجين إنّما يَحْضُرونه في صَدْر النهار على عادة السلاطين، فإذا كان الرواح ونحوه من الأوقات التي ليست من أوقاتِ الإذن قَلُّوا، فهو يشتاق إليهم فينام ليأنس برُؤية طيفهم، والإفراط في التعمّق ربما أخلَّ بالمعنى من حيث يُرَاد تأكيدُه به، ألا تَرى أن هذا الكلام قد يُوهم أنه يحتجّ له أنه ممن لا يرغب كل واحد في أخْذِ عطائه، وأنه ليس في طبقة من قيل فيه:
|
عَطاؤُك زَينٌ لامرئٍ إن أَصبتَه |
|
بخير وما كُلّ العَطـاءِ يَزِينُ |
وممّا يدفع عنه الاعتراض ويُوجب قلّةَ الاحتفال به، أن الشاعر يُهِمُّه أبداً إثبات ممدوحه جواداً أو توّاقاً إلى السُّؤَّال فرِحاً بهم، وأن يُبَرِّئه من عبوس البخيل وقطوب المتكلِّف في البذل، الذي يقاتل نفسه عن مالِه حتى يُقال جوادٌ، ومَنْ يهوى الثَّناء والثّراء معاً، ولا يتمكَّن في نفسه معنى قولِ أبي تمام:
|
وَلَمْ يجتمع شَرقٌ وغربٌ لقـاصـدٍ |
|
ولا المجدُ في كفِّ امرئٍ والدراهمُ |
فهو يُسرع إلى استماع المدائح، ويُبطئ عن صِلة المادح، نعم، فإذا سُلِّم للشاعر هذا الغرض، لم يفكر في خَطَرات الظنون. وقد يجوز شيءٌ من الوَهْم الذي ذكرتُه على قولِ المتنبي:
|
يُعطي المُبشِّرَ بالقُصَّاد قَبْلَهُم |
|
كمن يُبشِّره بالماء عطشانَا |
وهذا شيءٌ عَرَضِ، ولاستقصائه موضعٌ آخرُ، إن وفَّق اللّه. وأصل بيت الطيف المستميح، من نحو قوله:
|
وَإنّي لأسْتَغْشِي وما بِيَ نَعْسةٌ |
|
لعلَ خيالاً منكِ يَلْقَى خيالـيَا |
وهذا الأصل غير بعيد أن يكون أيضاً من باب ما استُؤنف له علّةٌ غير معروفة، إلاّ أنه لا يبلغ في القوة ذلك المبلغ في الغرابة والبعد من العادة، وذلك أنه قد يُتصوَّر أن يُريد المُغرَمُ المتيَّم، إذا بَعُدَ عهده بحبيبه، أن يراه في المنام، وإذا أراد ذلك جاز أن يريد النوم له خاصَّةً فاعرفه. ومما يلحق بهذا الفصْل قوله:
|
رَحَل العزاءُ برحْلَتي فكأنني |
|
أتبعتُه الأَنفاسَ للتـشـييعِ |
وذلك أنه علّل تصعُّد الأَنفاس من صدره بهذه العلة الغريبة، وترك ما هو المعلوم المشهور من السبب والعلة فيه، وهو التحسّر والتأسّف، والمعنى: رحل عنِّي العزاء بارتحالي عنكم، أي: عنده ومعه أو به وبسببه، فكأنه لما كان محلّ الصبر الصَّدْر، وكانت الأنفاس تتصعّد منه أيضاً، صار العزاءُ وتنفُّس الصَّعَداء كأنهما نزيلان ورفيقان، فلما رحل ذاك، كان حقّ هذا أن يشيّعه قضاءً لحق الصُّحبة. ومما يلاحِظُ هذا النوع، يجري في مسلكه ويَنْتظم في سِلْكه، قولُ ابن المعتز:
|
عاقبتُ عَيْني بالدَّمع والسَّهَـر |
|
إذ غار قلبي عَلَيك من بَصَري |
|
وَاحتملتْ ذاك وهـي رَابـحةٌ |
|
فيكَ وفازت بلذَّة الـنّـظـرِ |
وذاك أن العادة في دمع العين وسَهرها أن يكون السببَ فيه إعراضُ الحبيب، أو اعتراض الرقيب، ونحو ذلك من الأسباب المُوجِبة للاكتئاب، وقد ترك ذلك كله كما تَرَى، وادّعى أن العلة ما ذكره من غَيْرةِ القلب منها على الحبيب وإيثارِه أن يتفرَّد برؤيته، وأنه بطاعة القلب وامتثال رَسْمه، رامَ للعين عقوبةً، فجعل ذاك أن أبكاها، ومَنَعها النوم وحماها، وله أيضاً في عقوبة العين بالدَّمع والسهر، من قصيدة أوّلها:
|
قُلْ لأَحلَى العباد شِكـلاً وقـدَّا |
|
أَبجِدٍّ ذَا الهجرُأمْ لـيس جِـدَّا |
|
ما بِذَا كانت المُنَى حدَّثَتْـنـي |
|
لَهْفَ نفسي أَراك قد خُنتَ ودَّا |
|
ما تَرَى في مُتَيَّمٍ بـكَ صَـبٍّ |
|
خاضِعٍ لا يرى من الذُلِّ بُـدَّا |
|
إن زَنَتْ عينُه بغيرك فاضربْ |
|
ها بطُول السُهاد والدَّمْع حَدَّا |
قد جعل البكاءَ والسهاد عقوبةً على ذنبِ أَثبته للعين، كما فعل في البيت الأول، إلا أنّ صورة الذنب هاهنا غير صورته هناك، فالذنب هاهنا نَظَرُها إلى غير الحبيب، واستجازتُها من ذلك ما هو محرَّم محظور والذنب هناك نظَرُها إلى الحبيب نفسه، ومزاحمتها القلب في رؤيته، وغَيْرةُ القلب من العين سببُ العقوبة هناك، فأمّا هاهنا فالغيرة كائنة بين الحبيب وبين شخصٍ آخر فاعرفه. ولا شُبْهة في قصور البيت الثاني عن الأول، وأنّ للأوّل عليه فضلاً كبيراً، وذلك بأن جعل بعضَه يغار من بعض، وجعل الخصومة في الحبيب بين عينيه وقلبه، وهو تمام الظَّرْف واللطف، فأمّا الغيرة في البيت الآخر، فعلى ما يكون أبداً، هذا ولفظ زَنَتْ، وإن كان ما يتلوها من أحكام الصنعة يُحَسّنها، وورودُها في الخبر العينُ تزني، ويؤنِس بها، فليست تَدَعُ ما هو حكمها من إدخال نُفْرةٍ على النفس. وإن أردت أن ترى هذا المعنى بهذه الصنعة في أعجب صورة وأظرفها، فانظر إلى قول القائل:
|
أَتتني تُؤَنِّبني بـالـبـكـا |
|
فأهلاً بهَا وبتأنِـيبـهَـا |
|
تقولُ وفي قولها حِشْـمةٌ |
|
أتبكي بعَيْنٍ تراني بـهـا |
|
فقلت إذا استحسنتْ غيرَكم |
|
أمرتُ الدُّموع بتأديبـهـا |
أعطاك بلفظة التأديب، حُسْنَ أدب اللبيب، في صيانة اللَّفظ عما يُحرج إلى الاعتذار، ويؤدّي إلى النِّفار، إلا أن الأُستاذية بعدُ ظاهرةٌ في بيت ابن المعتز، وليس كل فضيلة تبدُو مع البديهة، بل بعَقِب النَّظرِ والرويَّة، وبأن يفكَّر في أول الحديث وآخره، وأنت تعلم أنه لا يكون أبلغ في الذي أراد من تعظيم شأن الذنب، من ذكر الحدّ، وأنّ ذلك لا يتمّ له إلاّ بلفظة زنت، ومن هذه الجهة يلحَقُ الضَّيْمُ كثيراً من شأنُه وطريقُه طريقُ أبي تمام، ولم يكن من المطبوعين، وموضعُ البَسْط في ذلك غير هذا فَغَرَضي الآن أن أُرِيَك أنواعاً من التخييل، وأضَعَ شِبْهَ القوانين ليُستعان بها على ما يُراد بعدُ من التفصيل والتبيين.
 الاكثر قراءة في البيان
الاكثر قراءة في البيان
 اخر الاخبار
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية















 قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة "المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة (نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)