بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى، والصلاة على عباده الذين اصطفى محمد وآله المنتجبين..
أما بعد..
هذا بحث تقدمت به إلى مجلة العميد التي تعنى في بحوثها عن آثار أهل البيت «عليهم السلام» وقد فاز هذا البحث في المسابقة وسيتم طرحه في مؤتمر عن الإمام الحسين «عليه السلام» في 23 ـ 24 آب 2016 م. في المؤتمر المزمع إقامته في مدينة كربلاء المقدسة، في العتبة العباسية المقدسة.. فإليكم نص البحث، راجياً من الله أن ينال إعجابكم ، ومتمنياً من القارئ الكريم أن يرفدني بملاحظاته الكريمة.. مع الشكر الجزيل مسبقاً لمن تشجم قرائته..
تقديم:
حين خلق الله سبحانه الأرض، وبرأ النسمات، وأقام السماوات، ودحا الأرض، وخلق الإنسان وجعله خليفته فيها، وسبب له الأسباب والمقومات الأساسية التي يحتاجها لكي يحيا فيها، ويمشي في مناكبها، وأراد له الكمال في كل الصعد النفسية، والتربوية، والأخلاقية، والحياتية، والصحية، والجسدية..الخ
فما كان منه عز وجل إلا أن أرسل للبشرية على مر تاريخها، الهداة المهديين، والرسل المختارين، وختم بأعظم الأنبياء والمرسلين محمد «صلى الله عليه وآله»، وجعل من يخلفه في هذه المهمة من الأوصياء المنتجبين، اثنا عشر إماماً، أو خليفة «كلهم من قريش»(1 ).
وإن النظر والبحث في تاريخ وسيرة النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» وأهل بيته الأطهار «عليهم السلام» لا يقاس به أي تاريخ آخر وذلك يعود إلى «حساسيته وأهميته وتأثيراته على مختلف مناحي الحياة الإنسانية أي تاريخ لأي شخص، أو أية فئة مرت في أي مجال في تاريخ البشر العام قديِمه، وحديِثه.
لأنه يمس جوهر الحياة الإنسانية في الصميم، ولأن نجاح البشر، وسعادتهم في حاضرهم ومستقبلهم، ومصيرهم في الدنيا والآخرة مرهون بمدى استفادتهم، وطبيعة تفاعلهم مع هذا التاريخ ..
وذلك لأن نبينا الأكرم «صلى الله عليه وآله» هو خاتم الأنبياء ووارثهم [وأوصيائه هم آخر الأوصياء]، والمسؤول عن استثمار كل جهودهم وتضحياتهم، وتحويلها إلى واقع عملي فاعلٍ، يبعث الحياة والحركة في كل فكرِ، ومشاعرِ، وعواطفِ الأمة. ويسهم في تكوين خصائصها الإنسانية، ويثير فيها روح الإيمان، ويجسد في واقعها القيم الأخلاقية، ويرسم كل سماتها الحية، والفاعلة في مختلف جوانب شخصيتها، ويثير الحركة والحياة والطموح في أفرادها وجماعاتها وسائر مكوناتها، وينسج علاقاتها بكل ما ومن حولها، ويحدد موقعها وأهدافها، ومسارها، ومصيرها.
ليكون ذلك وفق النهج الإسلامي القويم، وبوهج إيماني صادق، والتزام حازم وصارم، بما يفرضه هذا المسار، مع وضوح في الرؤية، وسلامة في النظرة، ووضع للأمور في نصابها الصحيح، والتعامل معها بواقعية وصدق وإخلاص»( 2).
وبعد هذا كله، ففي النظر في نهضة الإمام الحسين «عليه السلام» دور لا يمكن لأحد أن ينكره، أو أن يتغاضى عنه فيما يرتبط في تأثير تلك النهضة على المجتمع الإسلامي، وما أرسته من مقومات اعتبرت أساسية في انتصار القيم.
وانطلاقاً من هنا، لا بد لأي باحث كان أراد الخوض في غمار البحث عن النصر القيمي وقبل تبيان ما هي المقومات التي ساعدت على انتصار هذه القيم، هذا أولاً. عليه تحديد هذه القيم التي يركن لها البشر.
ثانياً: إظهار المفاصل الأساسية والمقومات الموجودة في تلك النهضة والتي ساهمت في انتصار هذه القيم.
فلذلك، سوف ينقسم البحث الذي بين أيدي القارئ الكريم إلى قسمين:
الأول: القيم وتعريفها.
الثاني: مقومات انتصارها.
فإلى ما يلي من مطالب، متوكلين على المولى عز وجل، ومصلين على النبي وآله..
القيم وتعريفها:
تُعرف لغةً بأنها جمعٌ لكلمة قيمة، وقيل: «قوام كل شيء: ما استقام به»( ). وقيمة الشيء أي أنه ذو المقدار، أو الثمن.
وتُعرف اصطلاحاً: بأنها مجموعة الصفات الأخلاقية، التي يتميّز فيها البشر، وتقوم الحياة الاجتماعية عليها، ويتمّ التعبير عنها باستخدام الأقوال والأفعال، وتُعرف أيضاً بأنّها مجموعة من الأخلاق الفاضلة التي اعتمدت على التربية في توجيه السلوك البشري للقيام بكل عمل، أو قول يدلّ على الخير.
ولكن السؤال الذي يمكن أن يطرح من هو القيم على كل تلك الأمور، وما هو الحاكم عليها والمرجع الذي يمكن العودة إليه في تحديد القيم الإنسانية؟!
ونجيب:
أولاً: لا يمكن لأي مخلوق كان الادعاء أن القيم التي يسير عليها، والتي تحكم سيرته هي الأفضل، وذلك لأن الناس في مبادئهم مختلفون، وفي أفكارهم يتبدلون، وفي أحكامهم يتلونون، وعقائدهم غير مستوون.. فما يراه أحدهم أنه حق وسليم قد يكون في نظر الآخرين باطل وسقيم.
من هنا فلا بد للعودة إلى نقطة مشتركة يقبلها الجميع، ومساحة التقاء يتفق عليها السامي والوضيع..
ثانياً: إن القيم الإنسانية نسبت للإنسان لأنه المخلوق العاقل الذي منحه الله ميزة الاختيار، وهو في هذه الدنيا في موقع الاختبار، فلا بد للإنسانية جمعاء بما أن القيم منسوبة لهم جميعاً أن يقفوا عند حدود تكون مقبولة لديهم دون استثناء.
ثالثاً: الإنسان بما هو إنسان فإنه يؤثر ويتأثر بشتى العوامل والأفكار، ولربما يتقلب في فهمه للأمور، وإن خلق الإنسان كان من وراءه هو الخلافة في الأرض، والتعرف على غيره، وأن يعمل لما فيه خير نفسه والآخرين على حد سواء، فمن عمل على تقويم نفسه أولاً، لا بد أن يؤثر في غيره ويشدهم إلى أعماله لو كانت صالحة، وكذلك المفسد فإنه يؤثر في من حوله سلباً وإيجاباً..
الدين القيم:
إذن وجب البحث عن تلك القيم الحاكمة التي فيها قوام الإنسان وخيره وصالحه، في هذه الدنيا، وما لها انعكاس على مصيره في الآخرة، ويوم الحساب..
ولأن الله عز وجل ما كان ليترك الناس يضربون في الأرض ضرب عشواء، فبعد أن منحهم العقل ليعقلوا به ويتفكروا، وأعطاهم الإرادة ليكونوا مختارين، أرسل لهم الأنبياء والمرسلين، والأوصياء المعصومين..
فكان وظيفة هؤلاء أن يعرفوا الناس على أفضل، وأسمى، وأرقى القيم الإنسانية، بما أنهم هم يجتمعون مع باقي البشر بإنساتيهم، إلا أنهم ميزوا عنهم بأنهم أفضل الناس خليقة، وأرقى البشر خلقاً، وهم متصلون بالله من خلال الوحي الإلهي عليهم..
وحيث أن لكل الأديان خاتمة، ولجميع الأنبياء صفوة، وفي أوصيائهم الفضلى والقدوة، كان الدين الخاتم هو الحاكم على هذه القيم الإنسانية، وفيه تمامها وكمالها..
وهذا يناسب أن يكون المراد بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾(3 ). هو الدين.
وهذه الآية ليست في صدد مدح الخصال الأخلاقية لرسول الله «صلى الله عليه وآله» وحسب، ولست في مقام إظهار حسن خلقه فقط، وقد روي عن الإمام أبي جعفر «عليه السلام» في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾( 4).
حيث قال: هو الإسلام. وروي أيضاً، أن الخلق العظيم: الدين العظيم(5 ).
وفي رواية أخرى عن أبي جعفر الباقر «عليه السلام» في تفسير الآية قال: أي على دين عظيم(6 ).
وما جاء عن النبي «صلى الله عليه وآله»، من أنه قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»( 7).
فذلك مع ملاحظة حصر ما جاء به «صلى الله عليه وآله» بذلك، بواسطة كلمة إنما.
ويضاف إلى ذلك: أن ما جاء به الأنبياء السابقون هو ذلك نفسه أيضاً..
ويؤيد ما سبق الذي روي عن طريق أهل البيت عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» أنه قال: «عليكم بمكارم الأخلاق فإن ربي بعثني بها.. الخ»( 8).
وخلاصة الموضوع: أن الدين الخاتم، هو أعظم القيم وأدلها إلى ما فيه خير الإنسان، والبشرية جمعاء، وإن الميل نحو التدين لهو «صاحب الدور الأساسي في حل المشكلة الاجتماعية، عن طريق تجنيد الدافع الذاتي لحساب المصلحة العامة.
وبهذا نعرف أن الدين حاجة فطرية للانسانية، لأن الفطرة ما دامت هي أساس الدوافع الذاتية التي نبعت منها المشكلة فلابد أن تكون قد جهزت بإمكانات لحل المشكلة أيضاً، لئلا يشذ الانسان عن سائر الكائنات التي زودت فطرتها جميعاً بالإمكانات التي تسوق كل كائن إلى كماله الخاص. وليست تلك الامكانات التي تملكها الفكرة الانسانية لحل المشكلة إلا غريزة التدين والاستعداد الطبيعي لربط الحياة بالدين وصوغها في إطاره العام.
فللفطرة الانسانية إذن جانبان: فهي من ناحية تملي على الانسان دوافعه الذاتية. التي تنبع منها المشكلة الاجتماعية الكبرى في حياة الانسان (مشكلة التناقض بين تلك الدوافع والمصالح الحقيقية العامة للمجتمع الانساني).
وهي من ناحية أخرى تزود الانسان بإمكانية حل المشكلة عن طريق الميل الطبيعي إلى التدين، وتحكيم الدين في الحياة بالشكل الذي يوفق بين المصالح العامة والدوافع الذاتية. وبهذا أتمت الفطرة وظيفتها في هداية الانسان إلى كماله. فلو بقت تثير المشكلة ولا تموت الطبيعة الانسانية بحلها، لكان معنى هذا أن الكائن الانساني يبقى قيد المشكلة، عاجزاً عن حلها، مسوقاً بحكم فطرته إلى شرورها ومضاعفاتها وهذا ما قرره الإسلام بكل وضوح في قوله تعالى:
﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾( 9).
فإن هذه الآية الكريمة تقرر:
أولاً: إن الدين من شؤون الفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها جميعاً، ولا تبديل لخلق الله.
وثانياً: إن هذا الدين الذي فطرت الإنسانية عليه ليس هو إلا الدين الحنيف، أي دين التوحيد الخالص، لأن دين التوحيد هو وحده الذي يمكن أن يؤدي وظيفة الدين الكبر، ويوجد البشرية على مقياس عملي وتنظيم اجتماعي، تحفظ فيه المصالح الاجتماعية.
وأما أديان الشرك أو الأرباب المتفرقة على حد تعبير القرآن، فهي في الحقيقة نتيجة للمشكلة فلا يمكن أن تكون علاجاً لها، لأنها كما قال يوسف لصاحبي السجن ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾(10 ).
يعني بذلك أنها وليدة الدوافع الذاتية، التي أملت على الناس أديان الشرك طبقاً لمصالحهم الشخصيّة المختلفة، لتصرّف بذلك ميلهم الطبيعي إلى الدين الحنيف تصريحاً غير طبيعي، وتحول بينهم وبين الاستجابة الصحيحة لميلهم الديني الأصيل.
وثالثاً: إن الدين الحنيف الذي فطرت الانسانية عليه يتميز بكونه ديناً قيماً على الحياة ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّم﴾( )، قادراً على التحكم فيها وصياغتها في إطاره العام. وأما الدين الذي لا يتولى إمامة الحياة وتوجيهها، فهو لا يستطيع أن يستجيب استجابة كاملة للحاجة الفطرية في الانسان، إلا الدين، ولا يمكنه أن يعالج المشكلة الأساسية في حياة الإنسان»(11 ).
الحسين «عليه السلام» إمام القيم:
بعد أن وصلنا إلى النتيجة التالية، وهي:
أولاً: الدين الخاتم، وهو الإسلام، دين الله العظيم.
ثانياً: إن القائم على هذا الدين هو النبي الأعظم «صلى الله عليه وآله»، لأنه صاحب الرسالة الخاتمة.
ثالثاً: إن الأوصياء الأثنا عشر «عليهم السلام» هم القائمون على هذا الدين من بعد النبي «صلى الله عليه وآله».
رابعاً: ووظيفة النبي «صلى الله عليه وآله» والأئمة «عليهم السلام» هو وضع الأطر والقيم التي يجب على الناس انتهاجها في حياتهم ليصلوا إلى كمال أنفسهم.
خامساً: إن منهجة القيم في بوتقة، أو دستور يمكن أخذه من المعصوم، وعمل فيه في كل زمان ومكان، ذلك لأن هذا النهج هو النهج الخاتم الصالح لكل الأزمنة من بعده.
سادساً: إن تلك القيم يمكن أخذها من المعصوم في حال السلم والحرب، في حال القعود أو القيام.
وبما أن الإمام الحسين «عليه السلام» هو أحد الأئمة المعصوين «عليهم السلام»، الذي يجب أن نقتدي بهم وذلك من خلال الدور الذي أعطي لهم من قبل رسول الله «صلى الله عليه وآله»، ولأن نهضة الإمام الحسين «عليه السلام» كان علامة فارقة في تاريخ الأمة، بكل ما فيها، فلا بد أن هذه النهضة قد خطت ووضعت نهجاً للقيم الإنسانية الصالحة لكل البشر أن يسيروا عليها، حيث أن هذا هو النصر المبين، بأن تترك ما هو مؤثراً بشكل إيجابي، ويحفر في ذاكرة الناس ذلك النهج القويم ولو تبع ذلك التضحيات الجسام، وكان نتيجة هذا النهج فقد العزيز والغالي، بل بذل نفسه الشريفة من أجل إعلاء ما يراه أنه حق.. وهذا ما يسمى باختصار: «النصر القيمي»..
مكانة الإمام الحسين «عليه السلام» من دين الله:
ولا بد لنا، وقبل الانتقال إلى المقومات التي جعلت القيم الإنسانية التي اسس لها الإمام الحسين «عليه السلام» تنتصر، وتبقى ما دام هذا الدنيا موجودة من خلال نهضته المباركة، أن نتكلم بإيجاز عن موقعية الإمام الحسين «عليه السلام» من دين الله العظيم، الذي جعله الله خاتم الرسالات بأكملها.
إن مقام الإمامة للإمام الحسين الشهيد «عليه السلام» ثابت وواضح ولا يمكن التغاضي عنه أو الاعتراض عليه. فقد جاء في جملة من الروايات والمصادر أدلة وبراهين لا تعد ولا تحصى، ولسنا هنا بصدد سرد جميع تلك الأدلة والوقوف عليها، لا شك أن مقام الإمامة هو المهم.
وهنا يأتي السؤال التالي: ما هو دور الإمام الحسين «عليه السلام» في ذالكم المشروع الإلهي؟!
ونقول:
إن التفكير السليم يقتضي أن تكون الإمامة هي المشروع الإلهي وفيما تكون الخلافة جزء من منصب الإمامة، حيث أنها المشروع الإلهي الأساس والمهم. وكما وإن الإمامة لا تبطل، ولا ينتهي تأثيرها، ولا تنقضي أهدافها باغتصاب بعض صلاحياتها من صاحبها الشرعي، لذلك «فإن الإمامة ليست هي الخلافة والسلطة، بل السلطة بعض شؤون الإمام «عليه السلام». ومن شؤون الإمام الحكم بين الناس بالحق والعدل.. ومن شؤونه أيضاً مرجعيته الشرعية والفكرية في مختلف العلوم والفنون، والحكمة والأدب والمعارف، واكتناه الأسرار والغيوب التي أذن الله لخلَّص أوليائه وأصفيائه بالوقوف عليها.. ومن أجل القيام بنفس المهام التي كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» يقوم بها في مختلف الأحوال والمجالات. وللإمام خصائص النبي وحالاته باستثناء الوحي، وكما للإمام مقام الشاهدية، وتعرض على الإمام أعمال الخلائق. ومن شروط تقبل الأعمال الاعتقاد بالإمامة، وبه تنال الجنة، وبه النجاة من النار، وقد ورد أنه لا يدخل الجنة إلا من كان معه جواز من علي «عليه السلام»( 12).
وضياع مقام الإمامة كما صرحت به آية: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ..﴾ يوازي ضياع الرسالة كلها، بل كل شيء في هذا الدين يبقى ناقصاً بدونها، وغير ذي فائدة أو أثر، فهي تقول: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ﴾..»(13 ).
وعلى هذا فإن العقل والفطرة السليمة، والدليل العقلي لازم لوجود الحجة، والمعصوم، والإمام المختار من الله عز وجل ومن رسوله «صلى الله عليه وآله»، من هنا فإن الدليل العقلي والمنطقي يُخبر بالتالي:
من الثابت أن الله تعالى قد خلق هذه الخلائق لغاية معينة؟!
وذلك هو مقتضى الحكمة وإلا لكان لخلقه هذا عبثاً – والعياذ بالله – وتنزه الله عن هذا تنزيها. وقد قام سبحانه بخلق الإنسان في أطوار من التدرج، وجعل لهذا المخلوق – أي الإنسان – قابلية التكامل، وأعطاه هبة العقل الذي ميزه به عن سائر المخلوقات لكي يستطيع بواستطه أن يتكامل، غير أن العقل لا يستطيع وحيداً أن يصل إلى معرفة الحقائق بشكل دائم، فكان لا بد لهذا العقل من مرشدٍ إلهي يساعده على التكامل، ويوصله إلى الدرجة التي بمقدوره أن يصل إليها. وبالتالي لا يمكن أن يبلغها من دون واسطة، وهذه الواسطة هي: الرسول ومن بعده الوصي الإمام..
لذلك، وجب أن لا تخلو الأرض من هذا المكمّل، لئلا يضل الإنسان عن الطريق في بلوغه الغاية التي خلق لأجلها، وهذا الضلال يؤدي إلى حصول الفساد في الأرض، وشيوع الاضطراب والتنازع، والتصارع والتخاصم، وينجم عن ذلك الكوارث التي يهلك فيها الخلق، وهذا هو مصداق قوله: «لساخت الأرض بأهلها»(14 ). وعندها نتساءل عن الغاية في هذا الخلق ترى هل هو عبثي؟!
والمعلوم لدى الجميع بأن: الله حكيم ليس في غاياته أي عبث.
ولذلك كله: فالإمام الحسين «عليه السلام» هو إمام الأمة، من هديه نستنير وبضوء إرشاداته نهتدي إلى سواء السبيل، وبكلماته الشافية نعرف الحق من الباطل، والصالح من الطالح، ومن خلال نهضته الشريفة نهتدي إلى سواء السبيل..
والإمام يظل إماماً واجب الإتباع والاقتداء به في حال نهضته إذا قام، أو قعد لمصلحة الدين قد أرتأها، وهذا ما يختصر حديث النبي «صلى الله عليه وآله» في حق الحسن والحسين حين قال: «الحسن والحسين إماما قاما أو قعدا»(15 ).
وفي نص آخر: «الحسن والحسن إماما أمتي بعد أبيهما»(16 ).
النهضة الحسينية المباركة:
حين يريد أحدنا أن يتحدث عن حركة الإمام الحسين «عليه السلام»، ونهوضه ضد الحاكم الظالم لربما يحصر فترة تلك النهضة من حين خروجه من المدينة المنورة، ومن ثم إلى مكة المكرمة، متوجهاً بعد ذلك إلى العراق إلى أن انتهى الأمر في العاشر من المحرم، باستشهاده في أرض كربلاء المقدسة..
ولعل البعض يطلق على قيام الإمام الحسين «عليه السلام» ضد الظلمة، ومن باب التسامح «الثورة الحسينية»، ولكن هذا يحتاج من الباحث إلى تدقيق أكبر، ونظر في مفاهيم الحركة الحسينية، ولا بد لمن أراد التدقيق بهذه الأمور، لكي نصل لنتيجة لا يكون فيها اجحافاً بحق الإمام الحسين «عليه السلام» وحركته المباركة..
إذن ومن هذا المنطلق تطرح بعض التساؤلات حول ما قام به الإمام الحسين «عليه السلام»، ويمكن حصر هذه التساؤلات فيما يلي:
ماذا تسمى حركة الإمام الحسين «عليه السلام»، هل هي نهضة، ثورة، أو خروج؟!
متى بدأت حركة الإمام الحسين «عليه السلام» ونهضته المباركة؟!
ونجيب:
بالنسبة للسؤال الأول:
أولاً: لا يمكن أن نطلق على حركة الإمام الحسين أنها خروج، وذلك يعود لعدة أمور، منها:
أ: الخروج يطلق على من خرج على إمام زمانه، الشرعي، المبايع له بالسمع والطاعة.
ب: إن إطلاق هذه التسمية على حركة الإمام الحسين «عليه السلام» كان من قبل المعسكر الأموي حيث ادعى ابن خلدون، وابن العربي بأن الإمام الحسين «عليه السلام»: «إن الحسين قتل بسيف جده»( 17).
ج: وفي هذه الدعوى تبرئة ليزيد «لعنه الله» من دم الإمام الحسين «عليه السلام» حيث قالوا أن خروجه لم يكن مصلحة للدين ولا للدنيا، وقالوا أن يزيداً لم يأمر بقتله، ومن هؤلاء:
ابن حجر الهيثمي(18 )، ومنهم محمد كرد علي، وتقي الدين ابن الصلاح، والغزالي، وابن العربي، وابن تيمية وأمثالهم(19 ). حيث اعتبر هؤلاء: أن من يخرج على إمام زمانه فقد اسقط ذمة الله من رقبته وأصبح «خارجي»، وبذلك تسقط حرمة دمه وماله، وأهله. وهذا كله تبرير ساقط غير حصيف، فقط ليقولوا أن خروج الإمام الحسين «عليه السلام» لم يكن له وازع ديني أو غيره..
ومن هنا، لا يصح ولا يجوز لأي أحد أن يقول أن حركة الإمام الحسين «عليه السلام» كانت خروجاً. وإلا صرنا في النطاق الذي أراده هؤلاء الحاقدين، الناصبي العداء لأهل بيت النبوة «عليهم السلام».
وهذا يفتح المجال لنقول: هل كان يزيد «لعنه الله» إماماً حقاً واجب الطاعة؟!
والجواب: بالطبع كلا، لأن في ذلك خلاف لما أقره النبي «صلى الله عليه وآله» من إمامة الحسنين «عليهما السلام» في كثير من النصوص العامة والخاصة..
ويزيد «لعنه الله» هو من أمر بقتل الإمام الحسين «عليه السلام»، بعد هلاك أبيه، وقبل أن يبايعه الناس، خصوصاً في العراق والحجاز واليمن، وقد دسوا الرجال لكي يغتالوه في أقدس مكان، وفي أشرف وأفضل الأيام، ولو كان معلقاً بأستار الكعبة، أو بضرب عنقه كما جاء في نص رسالته إلى عامله على المدينة حيث أنه أمره: «أن يأخذ البيعة من هؤلاء الأربعة [ويقصد بهم] (الحسين «عليه السلام»، وابن الزبير، وابن عمر، وابن أبي بكر) أخذاً ضيقاً، ليست فيه رخصة، فمن تأبى عليك فاضرب عنقه، وابعث إلي برأسه»( 20).
والإمام الحسين «عليه السلام» وغيره من الذين يعتبرون بأنهم كبار الصحابة لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، وهم – كما يعتقدون - أهل الحل والعقد قد رفضوا خلافته عليهم بالقوة، وهو المعروف بفسقه وجوره( 21).
ويكفي ما قاله النبي «صلى الله عليه وآله» في حق يزيد ونقله ابن عباس عنه «صلى الله عليه وآله»، وهو قوله: «ما لي وليزيد، لا بارك الله في يزيد فإنه يقتل ولدي، وولد ابنتي الحسين.. الخ»( 22).
فهذا الحاكم لا تصح بيعته بأي شكل من الأشكال، ولا يُصالح ولا يُسالم معه، فهو معتد آثم، كان يتربص الدوائر بالإمام الحسين «عليه السلام»، ويبذل قصارى جهده لكي يوقع به «عليه السلام»..
ثانياً: ولا يمكن القبول أن حركة الإمام الحسين «عليه السلام» كانت ثورة بمعنى الصحيح للكلمة، وذلك يعود إلى عدة نقاط أهمها:
أ – إن طلب الإصلاح في أمة النبي «صلى الله عليه وآله» لا يمكن أن يكون «ثورة» حيث أن كلمة ثورة لا تليق بالإمام الحسين «عليه السلام»، وذلك لأنه لا ارتباط ديني من قريب وبعيد بين الثورة وما قام به الإمام «عليه السلام».
ب – وقد ارتأى لفيف من علمائنا الأعلام أن حركة الإمام الحسين «عليه السلام» هي «محض جهاد في سبيل الله، بالمفهوم الديني الدقيق، ولا يصح وصفها بالثورة، بل يكون إطلاق وصف الثورة عليها إهانة للإمام الحسين «عليه السلام» لا يجوز أن ترتكب في حق هذا الإمام العظيم»(23 ).
وقد صحب الإمام الحسين «عليه السلام» في مسيره نحو العراق أهله، وعياله، وقلة قليلة من الأصحاب الذين رافقوه واستشهدوا معه في كربلاء، فهو لم يجهز عسكراً، ولم يجيش الجيوش، وكل هدفه كان أن يقوم بحركة إصلاحية جهادية فيها لله رضا ولرسوله، مضحياً بنفسه الشريفة، ولكي تتجلى حقائق الدين الحنيف، ويعمل على إظهار المعالم التي درست منه، ويقوم بترسيخ دعائم الإسلام المحمدي الأصيل في وجدان هذه الأمة وضميرها، ويكشف زيف ادعاء الظالمين ويسقط تلك الأقنعة الخداعة التي لبسها أولئك، ويضحد الباطل، ويفضح أمور الظالمين ومن يحمونه ويدعون إليه.
ج – وهناك فوارق جمة وشتى وعديدة فيما بين: «الثورة» و «الجهاد»، حيث أن «الجهاد مفهوم ديني خالص، فمن الطبيعي أن نتحدث عنه بما له من خلال نظرة الدين والإسلام له. ووفق ما له من نصوص وأحكام. ولا نتحدث عنه بمفهومه اللغوي الصرف الذي هو مجرد بذل الجهد.
ومن الجهة الأخرى، فإنه ليس للثورة مفهوم ديني يمكن الحديث عنه، أو التلويح به.
وهذا ما يميز الجهاد عن الثورة، وهو أمر مهم جداً. لأنه يكرس مجموعة من الفوارق بين الجهاد والثورة»( ). ومن تلك الفوارق التي أذكر بعضها بإيجاز:
1: الجهاد هو من صلب المفهوم الديني، أما الثورة فليست كذلك.
2: إن الجهاد لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان صادراً بقصد التقرب من الله، ومن مسلم عاقل بالغ، أما الثورة قد لا تكون مشتملة على تلك الشروط، بحيث يسقط شرطاً من هذه الشروط المطلوبة في الجهاد.
3: إن الجهاد يشترط بالهدف من وراءه أن يكون عملاً محبوباً لله عز وجل مرضياً له، وهذا الشرط قد يكون ساقطاً في مبادئ الثورات.
4: إن الجهاد يتطلب معنى القتال في سبيل الله وتضحية في سبيل إعلاء كلمته، والذود عن حياض الإسلام، وفي الثورات قد نجد خلاف ذلك فقد يكتفى بالاعتصامات والاحتجاجات والعصيان المدني فقط.
5: إن الجهاد في سبيل الله يجب العودة فيه إلى صاحب قرار معصوم، مؤيد من الله سبحانه، عالماً بأحكام الشرع، وفي الثورات قد يكون سببها هو الهيجان، والغضب، والتحرك العشوائي..
6: الجهاد لا بد فيه من تأمل وتدبر وتفكر في شؤون البلاد والعباد، ومصيرها، وما سيؤول إليه حالها، ولكن هذا غير متوفر في الحركات الثورية بسبب الاندفاع والهياج الشعبي..
وهناك العديد العديد من الفورقات والتباين فيما بين «الجهاد» و «الثورة»، ومن أراد التوسع في ذلك فليراجع كتاب: سيرة الإمام الحسين «عليه السلام» في الحديث والسيرة، لمؤلفه السيد المحقق جعفر مرتضى العاملي «حفظه الله» في ج15 من ص14 إلى ص21، المبحث: (الحسين «عليه السلام» مجاهد أم ثائر؟!).
ثالثاً: ونصل بعد هذا كله إلى النتيجة التالية، أن حركة الإمام الحسين «عليه السلام» الإصلاحية، الجهادية، هي نهضة مباركة، وذلك يعود إلى الأسباب التالية:
أ: النهضة: هي الحركة التي تعقب السكون، وهي حركة تبدو متسمة بالسرعة والمفاجأة، وهي ليست بعيدةً عن المعنى الاصطلاحي الشائع أي «البَراحُ من الموضع والقيامُ عنه، ونهَضَ، يَنْهَضُ، نَهْضاً، ونُهوضاً، وانْتَهَضَ، أَي: قامَ»( 24).
وقيل النهضة ما كانت مشتملة على القوة والعزيمة والمقاومة، وهي متممة لمعنى الحركة المفاجئة السريعة، لأن أي حركة تحتاج إلى قوة وعزيمة وجلد. حيث قالوا: «ناهَضْتُه: أَي قاوَمْتُه»(25). وقالوا: «النَّهْضةُ: الطَّاقةُ والقوَّةُ»( 26).
وانطلاقاً من هذه التعريفات الاصطلاحية واللغوية، تكون النهضة للقيام بأي عمل يسبقه سكون عن الحركة، ولا بد من أن تكون مشتملة على قوة الموقف، وعزيمة الإرادة، ومقاومة الضلال بشتى أشكالها وأنواعه، ويمكن أن يكون النهوض قولياً، وفعلياً.
ب: النهضة الحسينية لا يمكن حصرها بواقعة كربلاء فقط، فهي ممتدة ومتواصلة من بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى «عليه السلام»، إلى أن وصلت السلطة ليزيد «لعنه الله»، إلا أنها كانت نهضة قولية في زمن معاوية، وذلك التزاماً من الإمام الحسين «عليه السلام» ببنود المعاهدة التي تمت بين معاوية «لعنه الله» والإمام الحسن «عليه السلام».
ج: وهذا يعني أن النهضة الحسينية المباركة أخذت المنحى التصاعدي، بأن بدأت بالتصدي للمعتدي بإظهار ظلمه وعدوانه لسانياً، وقولياً من باب إلقاء الحجة، ومن ثم حينما تصاعد التعدي عليه من قبل السلطة الأموية كان مدافعاً عن نفسه وعن حقه، فهو لم يبتدأ بقتال، بل هم من أرادوا قتله بداية، فهو لم يعترف بسلطة يزيد «لعنه الله» لأن ذلك خلاف المعاهدة، بأن تتنقل الخلافة للإمام الحسين «عليه السلام» من بعد معاوية في حال لم يكن الإمام الحسن «عليه السلام» موجوداً على قيد الحياة.
وخلاصة فالنهضة الحسينية من بدايتها وحتى استشهاد الإمام الحسين «عليه السلام» كانت في مقابل كشف الظالمين على حقيقتهم وبلورة الأمور لكي تفهم الأمة ماذا ضيعت.
وبالنسبة للسؤال الثاني، نقول:
إن النهضة الحسينية المباركة وكما أسلفنا آنفاً ليست مختصة من وقت أن ترك الإمام الحسين «عليه السلام» مدينة جده «صلى الله عليه وآله»، بل من حين شهادة الإمام الحسن «عليه السلام»، وسيظهر ذلك من خلال الآتي في هذا البحث إن شاء الله.
مقومات النصر:
حسب ما وصلنا إليه فإن نهضة الإمام الحسين «عليه السلام» كانت منذ بدئه بالتصدي للسلطة الأموية المتمثلة بمعاوية بن أبي سفيان والتي انتقلت بعد هلاكه إلى يزيد «لعنه الله»، ومن بين المقومات التي أسست للنصر القيمي:
المحور الأول: إسباغ الحجة، وإثبات الدليل:
هو التصدي لهذه السلطة قولياً، إسباغاً بالحجة عليهم، فكان نفس خروجه هو لطلب الإصلاح في الأمة، بهدف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والخروج جاء محصلة لتزايد المظلومية عليه، وسعيهم الحثيث لقتله «عليه السلام». فأراد أن يصل لقمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حركة إصلاحية يكون دمه الشريف فداء لذلك الهدف السامي.
فالنصر لا بالسيف فقط بل بقوة الدليل الذي يظل محفوراً في ضمير الأمة بإظهار ضعف منطقه، وهشاشة دليله، وهذا ديدن الأنبياء والأوصياء..
روي عن موسى بن عقبة أنه قال: قيل لمعاوية: إن الناس قد رموا أبصارهم إلى الحسين «عليه السلام»، فلو قد أمرته يصعد المنبر ويخطب، فإن فيه حصراً، أو في لسانه كلالة.
فقال لهم معاوية: قد ظننا ذلك بالحسن، فلم يزل حتى عظم في أعين الناس وفضحنا.
فلم يزالوا به حتى قال للحسين: يا أبا عبد الله لو صعدت المنبر فخطبت.
فصعد الحسين «عليه السلام» على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي «صلى الله عليه وآله»، فسمع رجلاً يقول: من هذا الذي يخطب؟!
فقال الحسين «عليه السلام»:
نحن حزب الله الغالبون، وعترة رسول الله «صلى الله عليه وآله» الأقربون، وأهل بيته الطيبون، وأحد الثقلين (الذين) اللذين جعلنا رسول الله «صلى الله عليه وآله» ثاني كتاب الله تبارك وتعالى، الذي فيه تفصيل كل شيء، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والمعول علينا في تفسيره، لا يبطئنا [نتظنّى] تأويله، بل نتبع حقائقه.
فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة، أن كانت بطاعة الله ورسوله مقرونة، قال الله عز وجل: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ﴾( 27).
وقال: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَ قَلِيلاً﴾( 28).
وأحذركم الإصغاء إلى هتوف الشيطان بكم، فإنه لكم عدو مبين، فتكونوا كأوليائه الذين قال لهم: ﴿لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ﴾(29 ). فتلقون للسيوف ضرباً وللرماح ورداً، وللعمد حطماً، وللسهام غرضاً. ثم لا يقبل من نفس إيمانها ﴿لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً﴾(30 ).
قال معاوية: حسبك يا أبا عبد الله قد بلغت( 31).
وفي هذه الخطبة إشارات مهمة، منها:
أولاً: الظاهر من نص الرواية أن السلطة وأتباعها يقومون بتقصي أحوال من هم حولهم، وخاصة من يرونهم أنهم مناوئين لهم، بل قل أنهم يخافون منهم، لأنهم يعلمون علم اليقين أنهم الأحق بما تحت إيديهم.
ثانياً: تحاول هذه الطبقة من الناس أن تنصب الأفخاخ للأئمة «عليهم السلام» بشتى الوسائل، فحين يوسوسون لمعاوية بأن يطلب من الإمام الحسين «عليه السلام» ظناً منهم أنه سوف يرهبه الوقوف على المنبر، ويتهيب من هذا الموقف، ولكن معاوية يعلم عكس ذلك، وقد خبره من خلال تجربة سابقة مع الإمام الحسن المجتبى «عليه السلام»، ومع ذلك يحاول مرة ثانية مع الإمام الحسين «عليه السلام».
ثالثاً: حين صعد الإمام الحسين «عليه السلام» إلى المنبر، سمع أحدهم يقول: « من هذا الذي يخطب؟!»، فهل قال هذا جهلاً بشخص الإمام الحسين «عليه السلام»، أم استهزائاً منه فقط، وقد حاول الجبابرة من المتسلطين على الناس فعل مثل هذه الأفعال مع جميع الأئمة «عليهم السلام» وتعج كتب الأحاديث بمثل هذه المواقف، ومنها قصيدة الفرزدق بالإمام زين العابدين «عليه السلام» حين قال هشام بن عبد الملك: «من هذا؟!»، فكانت تلك القصيدة الرائعة المفعمة بمعاني الولاء والحب.
رابعاً: إن رد الإمام الحسين «عليه السلام» حين قال: «نحن حزب الله»، إشارة منه إلى أن من يعاديهم، ويتربص بهم ويحاول المحاولة تلو الأخرى لقتلهم، ويبذل الغالي والرخيص في سبيل ذلك هم حزب الشيطان.
خامساً: عترة الرسول هم الذين أوصى بهم النبي «صلى الله عليه وآله» لأنهم هم الأقربون، حيث أنهم الأعلم والأدرى بما جاء به، فلا يمكن لأحد أن يدعي بأنه أقرب منهم لهذا الدين وأعلم به غيرهم.
سادساً: هم عدل القرآن، وأحد الثقلين الذين أوصى الأمة بأن تتمسك بهم، فمن كان عدل القرآن كان تفصيل كل ما فيه لديه.
سابعاً: وهم أهل بيته الطيبون إشارة منه إلى طهارة نفوسهم، وبعدهم عن الخبائث، بحيث لا يمكن للخبيث أن يكون مع الطيب، بل هم المطهرون من كل رجس.
ثامناً: وأشار إلى أن طاعته واجبة مفروضة على كل الأمة وهي حق له، فكيف بمن يتربص به الدوائر يريد قتله والخلاص منه. وقد احتج عليهم بآية الطاعة..
تاسعاً: «حسبك يا أبا عبد الله قد بلغت»، قول معاوية هنا يدل أنه لا يستطيع أن يتحمل قول الحقيقة، ولم يستطيع التعامل مع الدليل، ولا مع حجة الإمام الحسين «عليه السلام» التي ساقها، وهذا هو أول مقومات النصر على العدو. بفضحه وفضح أساريره لا بالتهجم والسب والشتم، بل بإظهار الحق وأهله له..
وأخيراً، فإن كل تلك المعاني والإشارات تدل بما لا يدانيه الظن أو الريب والشك، أن من يملك الحجة يمكن أن يخرس الباطل، ومن معه الدليل هو في موقع القوة، وهذا من مقومات النصر للقيم السامية، وذلك قيل: «نحن أبناء الدليل نميل معه كيفما يميل». ولأن الدليل بوضحه يكون كالشمس في رائعة النهار، لا يمكن لأحد أن ينفي وجودها، فالنصر يبدأ بأن تنصر الحق بالدليل القوي، الذي لا يمكن لأحد أن ينفيه أو يشكك به.
المحور الثاني: الهجرة:
إن خطوات النبي «صلى الله عليه وآله» خلال عمله الرسالي هي التي أنجحت مهمته، وأظهرت دين الله على الجميع ولو كره المشركون، والمنافقون، والمبغضون..
فإنه «صلى الله عليه وآله» بخطواته الحكيمة، وسياساته الرشيدة أستطاع أن يقوم بنشر الهداية، وإيصال الكلمة الحق..
بداية، بلغ ذوي قرابته وأهله، ومن ثم قومه، وحين حاربوه على مدى ثلاثة عشر سنة، ترك مكة مهاجراً لله، وقد أجمع القوم على قتله، ظناً منهم أنهم سيفلحون في ذلك ولكن: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾( ).
وقد اجتمعت قريش في دار الندوة، واتفقوا على أن يقتلوا رسول الله «صلى الله عليه وآله»، فاختاروا عشرة أو خمسة عشر رجلاً، من كل قبيلة من قريش ـ وكانوا عشر أو خمس عشرة قبيلة أو أكثر ـ ليبِّيتوا النبي «صلى الله عليه وآله» بضربة واحدة من سيوفهم.
فأخبر الله تعالى نبيه بمكرهم، فأخبر «صلى الله عليه وآله» علياً «عليه السلام» بمكر قريش، وأمره أن يتغشى ببرده الحضرمي، وينام في فراشه.
فقال علي «عليه السلام»: أوتسلم بمبيتي هناك يا نبي الله؟!
قال: نعم.
فتبسم علي «عليه السلام» ضاحكاً، وأهوى إلى الأرض ساجداً شكراً لله.
فنام على فراشه، واشتمل ببرده الحضرمي، وخرج النبي «صلى الله عليه وآله» في فحمة العشاء، والرصد قد أطافوا بداره ينتظرون، وهو يقرأ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ﴾(32 ). وذهب «صلى الله عليه وآله» إلى الغار(33 ).
ونلاحظ ما يلي من هذه الرواية:
أولاً: إن القوم من المشركين قد عزموا أمرهم على اغتيال النبي «صلى الله عليه وآله»، وبذلك ينتهوا منه ومن دعوته.
ثانياً: إن خروج النبي «صلى الله عليه وآله» هو أمر لا بد منه، وهجرته إلى المدينة أيضاً، فلو بقي لما كان لمقومات ظهور الدين أن تتم.
ثالثاً: إن جميع أفعال النبي «صلى الله عليه وآله» إنما هي من أمر إلهي، لما فيه مصلحة الدين ومصلحته «صلى الله عليه وآله».
رابعاً: كان لا بد للهجرة أن تتم وبذلك لكي يقوم النبي «صلى الله عليه وآله» بترتيباته، وتنظيم أموره بعد أن فقد المعين والناصر بوفاة عمه أبي طالب «عليه السلام» وزوجته أم المؤمنين خديجة «رضوان الله عليها».
خامساً: إن خروج النبي «صلى الله عليه وآله» من بين المجتمعين حول بيته كان بصورة طبيعية لا إعجازية. واستفاد من الوسائل نفسها التي تكون من خيارات جميع الناس، فالجميع يستفيد من حلكة الظلام في الليل ليتستر له ويختفي عن أنظار المناوئين له، كما وأنه يحاول الاستفادة من هبوب الريح في تلك الظلمة، لينثر على أعدائه تراباً يدخل في عيونهم، ويربكهم، حتى يظنوا أنه الريح هي التي أثارت ذلك التراب.
سادساً: كما أن الجميع يتلو تلك الآية المباركة ليصرف أنظار الأعداء عنه. وما قام به «صلى الله عليه وآله» لم يزد بالإستفادة منه مما هو ميسور لجميع الناس. لأن جميع الناس أيضاً يحاولون أن يوهموا عدوهم بوجودهم في مكان، ولو بإضاءة المصباح، أو إبقاء أناس فيه، يظن العدو الراصد، أنهم هم بغيته، وهذا هو الهدف من اضطجاع الإمام علي «عليه السلام» في فراش النبي «صلى الله عليه وآله» من هذا.
وقد شابه الإمام الحسين «عليه السلام» في هجرته من المدينة النبي «صلى الله عليه وآله» من عدة جهات، فإنه «عليه السلام» خرج لما هو أهم من البقاء، وذلك بذهابه إلى مكة ومن ثم إلى العراق لكي يستشهد هناك وتكون هجرته هذه إعادة لإحياء الدين المحمدي، وإعادة الروح إليه بعدما حاول بني أميه طمسه، وتغيير معالمه.. حتى أن الإمام الحسين «عليه السلام» قد استعمل نفس الطريقة في هجرته من مكة وقد خرج في جوف الليل.
يروي ابن أعثم: إن الإمام الحسين «عليه السلام» خرج في جوف الليل(34 ).
وصرح ابن طاووس: بأن ارتحاله «عليه السلام» كان في وقت السحر( 35).
وقيل أيضاً: «أنه «عليه السلام» خرج من المدينة وهو يقرأ قوله تعالى: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾( 36)»(37 ).
وما يمكن قوله هنا، هو التالي:
أولاً: إن ترك الإمام الحسين «عليه السلام» للمدينة المنورة قد شابه به خروج النبي «صلى الله عليه وآله» من مكة المكرمة، وكان ذلك ليلاً حسب الروايات المنقولة. وذلك حفاظاً على نفسهما الشريفتان من القتل، وتضييع أهداف الأعداء.
ثانياً: إن استخدام الإمام الحسين والنبي «صلى الله عليه وآله» للآيات الكريمة لا يخرج عن الاستعانة بالله سبحانه في كل الأحوال وعلى جميع الأصعدة.
ثالثاً: إن الإمام الحسين «عليه السلام» قد ترك المدينة لإنجاح أهداف نهضته الشريفة، ومن مقومات انتصار الحق على الباطل، بحيث ينفذ الخطة الإلهية حتى النهاية.
رابعاً: لا يخفى على أحد: أن الإمام الحسين «عليه السلام» لم يكن خائفاً من القتل، وإنما كان يريد إفشال ما يريده قاتلوه من تضييع دمه هدراً قبل أن يفعل ما عليه فعله، مع علمه بأنهم مصرون على قتله، كما دل عليه قوله لأخيه ابن الحنفية: «والله يا أخي، لو كنت في حجر هامة من هوام الأرض لاستخرجوني منه حتى يقتلوني»( 38).
خامساً: الذهاب لمكة المكرمة لكي يلقى الحجيج في موسم الحج كان أيضاً من الأهداف التي أرادها الإمام الحسين «عليه السلام»، وهو في بيان حقه في نهضته المباركة.
وأخيراً نقول: إن هجرة النبي «صلى الله عليه وآله» كانت في صالح الدعوة، وهجرة الإمام «عليه السلام» كانت في صالح النهضة وإحياء الدين.
المحور الثالث: الدعوة إلى الله:
حسب ما ينقل التاريخ أن إقامة الإمام الحسين «عليه السلام» في مكة كانت أكثر من أربعة أشهر، ثم توجه إلى العراق في العشر الأولى من ذي الحجة..
وفي هذه الفترة الزمنية، قام بالدعوة إلى الله بما هو يناسب، والتأكيد على مشروعية نهضته ضد الظلم، فمن الأمور التي نشط بها «عليه السلام»، التالي:
أولاً: لقاؤه بالوافدين والحجيج إلى مكة، فكانوا يجتمعون حوله حلقاً حلقاً، ويتبادل وإياهم أطراف الحديث بما يهمهم من الشؤون.
ثانياً: كان يجتمع بالشخصيات البارزة آنذاك، ويتحاور معهم في شتى الأمور.
ثالثاً: قام بإرسال الرسائل إلى أهل البصرة، وأهل الكوفة..
رابعاً: تلقى رسائل أهل الكوفة وأجابهم عليها، حتى أنه أوفد ابن عمه وثقته مسلم بن عقيل إليهم كي يستطلع أحوال أهلها.
خامساً: ألقى الخطب في مكة ومنها ما فيه عبر للتاريخ ولأصل الدعوة إلى الله..
سادساً: كان يصلي في الناس جماعة..
سابعاً: حين عرف البعض عزمه الذهاب إلى الكوفة كتب إليه البعض ظناً منه إنه في مقام النصيحة له.
ثامناً: بعد تزايد الناصحين له بترك الذهاب إلى الكوفة خطب خطبته الشريفة التي رسم فيها الخطوط العريضة لقيامه، والهدف من نهضته المباركة.
تاسعاً: نقلوا: أنه بعد «مسير طويل، دام عدة أيام لاحت للإمام ومن معه من بعيد جبال مكة، فجعل يتلو هذه الآية: ﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾(39 )»(40 ).
وبقراءته لهذه الآية الشريفة يشير إلى ما يلي:
أ: يخبر أنه يقدم على مرحلة جديدة يحتاج فيها إلى هدايات الله، ودلالاته وألطافه.
ب: ويشير «عليه السلام» بقراءته لهذه الآية أيضاً على: أن مكة هي البداية لمسيرته الشريفة، وليست نهاية.
ج: ويشير كذلك: أن في تلك مسيرة خفايا، ومفاجآت كبرى، وحوادث لم يسبق أن مرت في التاريخ مشابه لها أو من مثيل.
د: ومن الدلالات أيضاً: «أن موسى «عليه السلام» بعد أن قتل القبطي، وطلبه أعداؤه خرج إلى جهة مدين ولم يكن قد ذهب إليها من قبل ولا عرف طريقها.
كما أنه لم يكن يعرف فيها أحداً من الناس، ولا كان له فيها بحسب علمه معين ولا ناصر. وإنما توجه إليها لأنها كانت لا تخضع لسلطان فرعون .. وكان «عليه السلام» يطلب الخروج إلى بلد له هذه الصفة. لأنه يريد أن يسلك طريق النجاة من الظالمين.
وهذه كانت حال كربلاء، فهي بمثابة سبيل نجاته باستشهاده «عليه السلام»..الخ»( 41).
عاشراً: خطبة المسار:
فقد روي: «أنَّهُ «صلوات الله عليه» لَمّا عَزَمَ عَلَى الخُروجِ إلَى العِراقِ قامَ خَطيباً، فَقالَ: الحَمدُ للهِ، ما شاءَ اللهُ ولا قُوَّةَ إلّا بِاللهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلى رَسولِهِ وسَلَّمَ.
خُطَّ المَوتُ عَلى وُلدِ آدَمَ، مَخَطَّ القِلادَةِ عَلى جيدِ الفَتاةِ.
وما أولَهَني إلى أسلافِي اشتِياقَ يَعقوبَ إلى يوسُفَ.
وخيرَ لي مَصرَعٌ أنَا لاقيهِ.
كَأَنّي بِأَوصالي تُقَطِّعُها ذِئابُ [عسلان] الفَلَواتِ بَينَ النَّواويسِ وكَربَلاءَ، فَيَملَأنَ مِنّي أكراشاً جوفاً، وأجرِبَةً سُغباً. لا مَحيصَ عَن يَومٍ خُطَّ بِالقَلَمِ.
[زاد في عدد من المصادر قوله: رِضَى اللهِ رِضانا أهلَ البَيتِ، نَصبِرُ عَلى بَلائِهِ، ويُوَفّينا أُجورَ الصّابِرينَ.
لَن تَشُذَّ عَن رَسولِ اللهِ «صلى الله عليه وآله» لُحمَتُهُ، بَل هِيَ مَجموعَةٌ لَهُ في حَظيرَةِ القُدسِ، تَقَرُّ بِهِم عَينُهُ، ويُنجَزُ بِهِم وَعدُهُ].
مَن كانَ باذِلاً فينا مُهجَتَهُ، ومُوَطِّناً عَلى لِقاءِ اللهِ نَفسَهُ، فَليَرحَل مَعَنا؛ فَإِنّي راحِلٌ مُصبِحاً إن شاءَ اللهُ»( 43).
وما يمكن الاستدلال به من هذه الخطبة الشريفة، ما يلي:
أ: إن إخبار الناس عن خبر استشهاده «عليه السلام» يستند إلى علم الله بعصيان الناس ما يأمرهم الله به، ولا يقتضي الجبر الإلهي لهم، ومنعهم عن القيام بواجبهم العقلي والشرعي. فلو اجتمع له المناصرين كان من الممكن أن تتغير الأحوال..
ب: إن قانون البداء يبقى هو الحاكم، فلا يمكن لأي كان تجاهله وصرف النظر عنه .. ولاسيما فيما يرتبط بحدوث الإستشهاد للحسين «عليه السلام» في خصوص هذا المسير.
ج: إن الإمام الحسين «عليه السلام» يشير إلى أن الموت ليس بحد ذاته سيء في، وليس فيه خسارة لبني البشر، بل قد يكون سبيل إلى الارتقاء في سلم الدرجات الآخروية، وباعث للبهجة، ودرب أنس للذين يعلمون ويتدبرون، ويتأملون ويتفكرون.
فكما أن العقد الذي يزين به جيد الفتاة مما يزيد في بهرجتها، ورونقها ويضفي عليها جمالاً، ويجعل الأنظار مشدودة إليها، ويزد من الرغبة فيها، وتنشد النفوس لها. فالموت هو كذلك بالنسبة للإمام «عليه السلام»، فإنه يضيف على حياة الإنسان المؤمن الموقن البهجة والرونق والجمال، ويزيد من طموحه، ويدفعه إلى الاستبسال لاتمام العمل، وعلى أكمل وجه، ويتسابق والمؤمنين أخوته لكسب الخيرات، ويتنافس وإياهم ليعلو في الدرجات، وإكمال المهمات، وقال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾( 44).
إن بيان الإمام الحسين «عليه السلام» لمعنى الموت وحتميته بأروع الصور والتشابيه البلاغية فهو مثل «زينة الحياة، يزيدها جمالاً، وبهاءً ورونقاً، ويعطيها المزيد من البهجة واللذة، تماماً كما هو الحال بالنسبة للقلادة إذا كانت على جيد الفتاة، فإنها تكون زينة لها، تشدُّ الأنظار إليها، وتزيد من تعلق القلوب بها.
ويستوقفنا هنا التعبير بكلمة: «جيد» التي توحي بالجودة، وهو تعبير مريح للنفس، مثير للكثير من المعاني اللذيذة في أعماقها.
كما ويلفت نظرنا أيضاً اختيار خصوص الزينة التي في هذا الموقع الحساس من جسد المرأة، بما يثيره من إيحاءات تنبعث من صميم الإغراء الأنثوي، وفي النقطة المركزية والأساس فيه.
ثم إنه «عليه السلام» يختار التعبير بكلمة «الفتاة» بدلاً من كلمة «المرأة» ونحوها. لأن الفتاة وليس سواها، هي التي تمثل القمة في الحيوية، والطموح، والجمال، وما إلى ذلك.
فهذا موقع الموت، وهذه هي حساسيته، وبذلك تظهر أهميته»( 45).
من هنا، فإن شهادته «عليه السلام» بما هي موت، ليست موتاً بحقيقتها بل هي حياة له في الدنيا والآخرة، حياة له بتجدد ذكراه الشريفة، فكلما ذكر إسم الإمام الحسين «عليه السلام» فهمنا معنى التضحية بأكمل صورها، والدعوة بأبهى طلتها، وفهمنا الحق بأوضح نهج ومنهاج..
فشهادته إحياء لما حاول الآخرين طمسه، وإعادة لنهج الرسالي القويم، وسيراً على خطى النبي «صلى الله عليه وآله»..
المحور الرابع: مرضاة الله:
قالوا: أقبَلَ الحُرُّ بنُ يَزيدَ حَتّى نَزَلَ حِذاءَ( 46) الحُسَينِ «عليه السلام» في ألفِ فارِسٍ، ثُمَّ كَتَبَ إلى عُبَيدِ اللهِ بنِ زِيادٍ يُخبِرُهُ أنَّ الحُسَينَ نَزَلَ بِأَرضِ كَربَلاءَ.
قالَ: فَكَتَبَ عُبَيدُ اللهِ بنُ زِيادٍ إلَى الحُسَينِ «عليه السلام»:
أمّا بَعدُ يا حُسَينُ، فَقَد بَلَغَني نُزولُكَ بِكَربَلاءَ، وقَد كَتَبَ إلَيَّ أميرُ المُؤمِنينَ يَزيدُ بنُ مُعاوِيَةَ أن لا أتَوَسَّدَ الوَثيرَ، ولا أشبَعَ مِنَ الخُبزِ [الخمير] أو أُلحِقَكَ بَاللَّطيفِ الخَبيرِ، أو تَرجِعَ إلى حُكمي وحُكمِ يَزيدَ بنِ مُعاوِيَةَ، وَالسَّلامُ.
فَلَمّا وَرَدَ الكِتابُ قَرَأَهُ الحُسَينُ «عليه السلام»، ثُمَّ رَمى بِهِ، ثُمَّ قالَ: لا أفلَحَ قَومٌ آثَروا مَرضاةَ أنفُسِهِم عَلى مَرضاةِ الخالِقِ.
فَقالَ لَهُ الرَّسولُ: أبا عَبدِ اللهِ، جَوابُ الكِتابِ؟
قالَ: ما لَهُ عِندي جَوابٌ؛ لِأَنَّهُ قَد حَقَّت عَلَيهِ كَلِمَةُ العَذابِ.
فَقالَ الرَّسولُ لِابنِ زِيادٍ ذلِكَ، فَغَضِبَ مِن ذلِكَ أشَدَّ الغَضَبِ( 47).
وفي هذه الرواية ما يدلنا على الآتي:
أولاً: إن الإمام الحسين «عليه السلام» حين ألقى رسالة عبيد الله بن زياد، أوصل بفعل عملي رفضه لمضمون الرسالة، ليفهم الرسول أنها مرفوضة عنده نصاً ومضموناً.
ثانياً: إن الإمام الحسين «عليه السلام» لا يمكن له بموقعيته في الأمة، وبما أنه الإمام المعصوم أن ينزل على حكم هؤلاء القوم الضالين، الظلمة، فإن إلقاءه للكتاب يدل على أنه لا يرضى بالنزول على حكمهم، والتنازل عن الذي فيه مرضاة الله ليرضيهم.
ثالثاً: إنه «عليه السلام» أشار إلى أن هؤلاء الظلمة ركنوا إلى أنفسهم، والسلطة قد أعمت قلوبهم، وحب التسلط حتى الإمام المفترض الطاعة صار هدفهم، لأن حب الدنيا استحوذت عليهم، وغرتهم، وجعلت منهم، عبيداً لها، لا يأتمرون بحكم الله ووليه..
رابعاً: إن مرضاة الله عز وجل هي من أسمى الأهداف عند الإمام الحسين «عليه السلام»، لو في ذلك ذاهب نفسه الشريفة، فهو لا يهاب أي شيء في سبيل مرضاته تعالى. وذلك ما جعل الإمام الحسين «عليه السلام» منتصراً عليهم. فمن كان مع الله، كان الله معه مؤيداً ومسدداً..
خامساً: إن مرضاة الله سبحانه التي سعى لها الإمام الحسين «عليه السلام» هي إحدى مقومات النصر للقيم الإلهية، والدينية.. فـ «لا أفلَحَ قَومٌ آثَروا مَرضاةَ أنفُسِهِم عَلى مَرضاةِ الخالِقِ».
سادساً: إن العذاب محق لمثل هؤلاء، لأنهم يسعون لمرضاة أنفسهم على حساب ولي الله، وأقدس، وأطهر إنسان على وجه الأرض.. فلعنهم الله لعنة الأولين والآخرين.
سابعاً: إن غضب ابن زياد لم يكن لله وهذا واضح، بل غضبه كان حمية لنفسه، لأن جاء من يفضحه على حقيقته، ويخبر عن سرائره الدنيئة.. وهذا ما جعلهم يقدمون على ما أقدموا عليه من جريمة نكراء..
المحور الخامس: التعلق بالله:
لما كان الدعاء هو أحد الوسائل والوسائط في التقرب من الله عز وجل، وصورة من صور التعلق بالذات الإلهية المقدسة، والإمام الحسين «عليه السلام» هو من أفضل الخلق تقرباً وتعلقاً به عز وجل، ويتجلى ذلك في أدعيته يوم عاشوراء، وفي لحظات الأخيرة من عمره الشريف، ولسانه يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى..
روي عن علي بن الحسين زين العابدين «عليه السلام» قال: لَمّا صَبَّحَتِ الخَيلُ الحُسَينَ «عليه السلام»، رَفَعَ يَدَيهِ وقالَ: «اللّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتي في كُلِّ كَرْبٍ، وَرَجائِي في كُلِّ شِدَّة، وَأَنْتَ لي في كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بي ثِقَةٌ وَعُدَّة. كَمْ مِن هَمٍ يَضْعُفُ مِنهُ الفُؤاد، وَتَقِلُّ فِيهِ الحِيلَةَ، وَيَخْذُلُ فِيهِ الصَّديق، وَيَشمَتُ فِيهِ العَدوُّ، أَنْزَلتُهُ بِك، وَشَكَوتُهُ إِلَيْك، رَغبَةً مِنّي إِلَيْك عَمَّنْ سِواكَ، فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفتَهُ، وَأَنْتَ وَليُّ كُلِّ نِعْمَةٍ، وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ، وَمُنْتَهىٍّ كُلِّ رَغبَة»( 48).
وروي عنه أيضاً أنه دعا بهذا الدعاء الأخير يوم الكوثر( 49): «اللّهُمَّ أَنْتَ مُتَعالِي المَكانِ، عَظِيمُ الجَبَروتِ، شَدِيدُ المِحال، غَنِيُّ عَنِ الخَلائِقِ، عَرِيضُ الكِبْرِياءِ، قادِرٌ عَلى ما تَشاءُ، قَرِيبُ الرَّحْمَةِ، صادِقُ الوَعْدِ، سابِغُ النِّعْمَةِ، حَسَنُ البَلاِء، قَرِيبٌ إِذا دُعِيتَ، مُحيطٌ بِما خَلَقْتَ، قابِلُ التَّوْبَةِ لِمَنْ تابَ إِلَيْكَ.
قادِرٌ عَلى ما أَرَدْتَ، وَمُدْرِكٌ ما طَلَبْتَ، وَشَكُورٌ إِذا شُكِرْتَ، وَذَكُورٌ إِذا ذُكِرْتَ؛ أَدْعُوكَ مُحْتاجاً، وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فَقِيراً، وَأَفْزَعُ إِلَيْكَ خائِفاً، وَأَبْكِي إِلَيْكَ مَكْرُوباً، وَأَسْتَعِينُ بِكَ ضَعِيفاً، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ كافِياً، اُحْكُمْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا، فَإِنَّهُمْ غَرُّونا، وَخَدَعُونا، وَخَذَلُونا، وَغَدَرُوا بِنا، وَقَتَلُونا. وَنَحْنُ عِتْرَةُ نَبِيِّكَ، وَوَلَدُ حَبِيبِكَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله، الَّذِي اصْطَفَيْتَهُ بِالرِّسالَةِ، وَائْتَمَنْتَهُ عَلى وَحْيِكَ، فَاجْعَلْ لَنا مِنْ أَمْرِنا فَرَجاً، وَمَخْرَجاً، بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمِينَ»( 50).
وهذه الأدعية الشريفة تبين لنا مرتكزات نهج أهل الإيمان السليم، منها:
أولاً: أن هناك نوعان من البشر، أهل الباطل وأهل الحق، فأما أهل الباطل فكل اهتمامهم هو العمل على تقوية الأمور الذاتية والمادية في جانبهم، بحيث يعتمدون على القدرات العسكرية، وما يشتمل عليه من سلاح وعتاد، ويرتكز في أنفسهم أنه كلما زادت قوتهم المادية هذه كلما كان الأمل بالنصر أكبر وفرصه أكثر.
أما أهل الحق، وعلى قلة عددهم، وكثرة الأعداء من حولهم، وتضييق الخناق عليهم، فإن اهتمامهم مختلف تمام الاختلاف عن أهل الباطل، فتراهم قد سلموا جميع أمورهم وأحوالهم، وشؤونهم في حال الضيق أو الفرج، للتدبير الإلهي الذي وضعه في تسيير أحوال الكون، وهذا التسليم لهذه السنن الكونية، والأهداف التي وضعها، ما هو إلا طمعاً في مرضاته سبحانه وتعالى. وكل هموم هذه الثلة من أهل الحق هو تحقيق الأهداف الإلهية بكل توابعها..
ثانياً: إن أهل الباطل بما حصل لهم من قدرات مادية جعلتهم يتجبرون، وييطشون ويظلمون، حتى اختصروا كل معاني القوة التي اغرتهم وجعلت منهم أداة طيعة بيد سلطان متجبر، عنده نفس فرعونية، فسخر كل تلك القوة من أجل ذاته وأهوائه، فبئس مثل القوم.
أما أهل الحق، فإن نظرتهم إلى ما سخره الله لهم في هذا الوجود هي نظرة رحبة، فإنهم من خلال هذا الفهم الحقيقي لأصل وجودهم يضعون كل شيء في موضعه الحقيقي، بما يتوافق مع السنن الإلهية، والهداية الربانية. ومع ذلك فإنهم لا يؤولون جهداً، ولا يتركون فرصة على الصعيد الشخصي إلا واستثمروه، وحرصوا عليه، وأعطوه دوره الكامل، واعترفوا بقيمته الحقيقية، وحيويته الفاعلة.
وانطلاقاً من هذه المرتكزات، إثباتاً وتأكيداً على هذه الحقائق: كان دعاء الإمام الحسين «عليه السلام» في هذه اللحظات العصيبة، وهذا التوقيت بالذات..
ثالثاً: لقد أظهرت هذه الأدعية ثقة مطلقة، وتوكل كلي على الله، وخاصة في الشدائد والبلايا، بل أظهرت أيضاً إيمان يقيني بأن الله وحده هو الذي يكشف الكرب، ويزيح الهم..
رابعاً: إن الإمام الحسين «عليه السلام» توجه إلى الله وحده دون غيره حاصراً رجاء به، مع الأمل به أنه هو القادر على كل شيء، في هذه الشدة وفي كل شدة..
خامساً: الإنسان المؤمن الكامل لا يجد في نفسه حول ولا قوة من دون الله، فهو لا يعول على قدرته الذاتية، بما لديه من قوى كالتفكير، والعدة، والقوة الجسدية، وهو لا يعتد بها مثل باقي الناس، بل المعول عليه هو الله القادر..
سادساً: يؤكد الإمام الحسين «عليه السلام» في دعاؤه على قرابته من النبي «صلى الله عليه وآله»، ومكانته من هذا الدين، ويشكو لله كيف أن أمته ضيعت حقوقه، لا بل اعتدت عليه ظلماً وعدواناً وقتلته مظلوماً..
سابعاً: لا يرى الإمام الحسين «عليه السلام» مخرجاً له إلا برحمة من الله عز وجل، مسلماً أمره له على كل الأحوال، متعلقاً بجنابه..
هذا هو حال العارف بالله، المتعلق به فهو لا يرى لنفسه وجوداً حقيقياً إلا بوجوده في الله، وهو ذائب فيه، بكل حركة من حركاته، وبكل سكنة من سكانته.. وهذه تعتبر من أعلى القيم التي تجعله منتصر..
المحور السادس: وارث الأنبياء:
من كان مقومات نصره القيم التي سار عليها أنبياء الله فيما سبق، وحاول بكل وجوده أن يطبقها، وبشهادته أن يحيها من جديد، فلا بد أن يكون مستحقاً لأن يكون وارثاً لهذا الخط الرسالي، وهذا هو النصر بعينه، فالنصر لا يكون فقط بالانتصار في معركة أو حرب ما، بل النصر الحقيقي هو أن يظل ذكر صاحب النصر مخلداً، وبنظرة سريعة أين هو ذكر يزيد بن معاوية، وعبيد الله بن زياد، وعمر بن سعد، وشمر بن ذي الجوشن، وغيرهم من الطواغيت..
وانظر في ذلك الخط الرسالي والقيم الإلهية الخالصة لله عز وجل، والتي مثلها الإمام الحسين «عليه السلام» من خلال نهضته الشريفة حتى استحق بذلك أني يكون «وارث الأنبياء».
فأصبح الإمام الحسين «عليه السلام» وارث لآدم أبي البشر «عليه السلام» من حيث كونه صفوة الله،
ثم ورث نبي الله نوح «عليه السلام» بما اختصه من النبوة والارتباط المباشر بالله عز وجل، وكما أنه تلقى المعارف منه سبحانه.
وهو وراث إبراهيم «عليه السلام» بخصوصية الخلة والقرب من الله سبحانه، ووارث إسماعيل «عليه السلام» بكونه ذبيح الله، وموسى «عليه السلام» من حيث هو كليم الله، ومن ثم عيسى «عليه السلام» من حيث كونه روح الله، ويرث خاتم الأنبياء والرسل محمداً «صلى الله عليه وآله» من باب كونه حبيب الله، فالإمام الحسين «عليه السلام» قد ورث جميع الأنبياء «عليهم السلام» بخصوصياتهم هذه كلها والتي كانت أبرز ميزاتهم، وصفاتهم، وأظهر ما فيهم وأتمها..
فكل من تمسك بهذا النهج الحسيني، ومشى على خطاه الخالدة، فإنه في الركب النبوي الرسالي، الذي يحبه الله ورسوله، وبالتالي فإن الانتصار لهذه القيم، لهو النصر الحقيقي والتام، الذي لا يشوبه أي نقص أو اختلال، بل هو نصر كامل، مظفر، كما هو حال الانتصار النهضة الحسينية المباركة..
وبالتالي فإن هذا مختصر في مقولة أمير المؤمنين «عليه السلام» حيث قال: «فَالمَوْتُ في حَيَاتِكُمْ مَقْهُورِينَ، وَالْحَيَاةُ في مَوْتِكُمْ قَاهِرِينَ»(51 ).
فإن القهر والذلة، هو الموت بعينه، وإن كان حياً يرزق في صورة الأحياء، فقد قال تعالى: ﴿أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وما يَشْعُرُونَ﴾( 52). والحياة الخالدة في الموت قاهرين لأعداء الله، ومظهرين الحق زاهقين للباطل، فتلك هي الحياة الطبيعيّة في الموت، مع القهر لأعداء الله. كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾( 53).
وقوله عز وجل: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾( 54).
فإن الغاية «الَّتي عساهم يفرّون من القتال خوفاً منها وهي الموت موجودة في الغاية الَّتي عساهم يطلبونها من ترك القتال، وهي الحياة البدنيّة حال كونهم مقهورين. وتجوّز بلفظ الموت في الشدائد والأهواء الَّتي تلحقهم من عدوّهم لو قهرهم وهى عند العاقل أشدّ بكثير من موت البدن وأقوى مقاساة فإنّ المذلَّة وسقوط المنزلة والهضم والاستنقاص عند ذي اللبّ موتات متعاقبة، ويحتمل أن يكون مجازاً في ترك عبادة اللَّه بالجهاد. فإنّه موت للنفس وعدم لحياتها برضوان اللَّه، وكذلك جذبه لهم أنّ الغاية الَّتي تفرّون إليها بترك القتال وهى الحياة موجودة في الغاية الَّتي تفرّون منها، وهي الموت البدنيّ، حال كونهم قاهرين. أمّا في الدنيا فمن وجهين: أحدهما الذكر الباقي الجميل الَّذي لا يموت ولا يفنى.
الثاني: أنّ طيب حياتهم الدنيا، إنّما يكون بنظام أحوالهم بوجود الإمام العادل وبقاء الشريعة كما هي، وذلك إنّما يكون بإلقاء أنفسهم في غمرات الحرب محافظة على الدين وموت بعضهم فيها. ولفظ الموت مهمل تصدق نسبته إلى الكلّ وإن وجد في البعض، وأمّا في الآخرة فالبقاء الأبدي بالمحافظة على وظائف اللَّه والحياة التامّة في جنّات عدن»( 55).
وسيظل النهج الحسيني من خلال النهضة المباركة محفوظاً، صادعاً، متكرراً، في كل مرة يتصدى فيها أهل الحق لأهل الباطل..
وسيظل نداء الإمام الحسين «عليه السلام» خالداً إلى يوم القيامة، مختصراً كل معاني النصر القيمي، في قوله «عليه السلام»: «ألا وإنَّ الدَّعِيَّ ابنَ الدَّعِيِّ قَد رَكَزَ بَينَ اثنَتَينِ، بَينَ السَّلَّةِ وَالذِّلَّةِ، وهَيهاتَ مِنّا الذِّلَّةُ، يَأبَى اللهُ لَنا ذلِكَ ورَسولُهُ وَالمُؤمِنونَ، وحُجورٌ طابَت، وحُجورٌ طَهُرَت، وأُنوفٌ حَمِيَّةٌ، ونُفوسٌ أبِيَّةٌ، مِن أن تُؤثَرَ طاعَةُ اللِّئامِ عَلى مَصارِعِ الكِرامِ»( 56).
الخلاصة والخاتمة:
هذا البحث المقتضب الذي بين يدي القارئ الكريم، لم يقف على كل تلك المقومات للنصر القيمي، ولا أدعي أنني أستطيع أن أحصيها جميعها أو جلها، فإن مواقف الإمام الحسين «عليه السلام» وأقواله وأفعاله ومواقفه ضمن هذه النهضة المباركة هي كثيرة، وكثيرة جداً تحتاج من الباحث المتأمل، وذو الرأي الحصيف، إلى مطولات، ونحن في موضع الاختصار، والوقوف على أهمها لا يمكن أخذ بها، وتبيانها بما تتيح لنا الفرصة لذلك، ولا يمكن الادعاء أننا أحصيناها كلها وبشكل كامل وتام..
وأقول: إن مثل هذه الأبحاث وغيرها، هي السبيل لتقصي أحوال النهضة الحسينية تحتاج لمجهود كبير، واجتماع أهل العلم لكي يتبينوا الأسس والأهداف لتلك النهضة المباركة، وإن تظافر الجهود ما يمكن التعويل عليه في مثل هذا النوع من الأبحاث.
إن الهدف من هذا البحث:
أولاً: هو وضع لبنة، أو حجر أساس يبنى عليه ويؤسس من خلال انطلاقة لأبحاث أخرى، ومحاور عديدة كانت أيضاً من صلب المقومات للنصر القيمي.
ثانياً: إضافة شيء جديد في طرق البحث العلمي الديني، التي تساعد على إظهار القيم الدينية التي حارب من أجلها الأئمة المعصومين «عليهم السلام»، والمتمثلة هنا بالنهضة الحسينية المباركة.
ثالثاً: إظهار النهج الحسيني في استنهاض الأمة من كبوتها، وإيقاظها من غفوتها، الذي يصلح لجميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، وذلك أن هذا النهج لم يكن مقتصراً فقط على زمانه، وليس هو بالحالة الخاصة التي تقتصر على من عاصروه فقط. بل هذا النهج الإمامي هو نهج خالد، قد خلده الإمام الحسين «عليه السلام» بدمه، وهو حي بذكره.
رابعاً: مقارنة النهج الحسيني الرامي لإنقاذ الأمة وإسعادها، وإظهار أهدافه، وشعاراته، ورموزه، وبين نهج أعدائه من أهل الباطل ومن لف لفهم، والذي يمكن أن يقال عنه أنه: نهج عدوان وإجرام، وإذلال للعباد، وإفساد في البلاد، وشعاراتهم وأهدافهم كانت شعارات فساد وإفساد، ورموزهم وشخصياتهم كانوا أشر وأحط الناس.
خامساً: إبراز مثل هذه المقومات التي تساعد في تغيير أحوال الأمة، ويساعد في نهضتها من جديد.
وأخيراً، لا يسعني إلا بالتقدم بخالص الشكر والامتنان «مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات في العتبة العباسية المقدسة» وكل المؤسسات والمراكز المتخصصة في نشر علوم أهل البيت «عليهم السلام»، واقتفاء اثارهم الشريفة، والذين كانوا السبب المباشر ومن خلال «مؤتمر الإمام الحسين (عليه السلام)» لكي اتشجع لكتابة هذا البحث المتواضع..
وأرجو من الله عز وجل أن يتقبل هذا القليل مني في حق المولى الإمام الحسين «عليه السلام»، وأتقدم من القارئ الكريم بجزيل الشكر والامتنان لقراءة ما خطته يدي، راجياً منه التفضل عليّ بالنصيحة، والتجاوز عن الأخطاء التي سهوت عنها..
أخوكم الفقير إلى الله، عبد الله وعبدهم..
السيد يوسف شفيق البيومي/ الرضوي.
حرر في: لبنان – صيدا: ليلة 15 شعبان 1437 هـ. ق.
ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف.
الموافق له: 21 آيار 2016 م.
_____________________________________________
(1 ) راجع: كشف الغطاء (ط.ق) ج1 ص7 والسنة في الشريعة الإسلامية لمحمد تقي الحكيم ص63 والأمالي للصدوق ص387 و 469 والخصال ص470 و 471 و 472 وإكمال الدين ص68 و 272 و 273 وكفاية الأثر ص51 و 76 و 77 و 78 وشرح أصول الكافي ج2 ص240 وج5 ص230 وج7 ص374 وكتاب الغيبة للنعماني ص104 و 105 و 120 و 121 و 122 و 123 و 124 والغيبة للطوسي ص128 و 129 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص248 و 249 و 254 والعمدة لابن البطريق ص416 و 417 و 418 و 420 و 421 والطرائف لابن طاووس ص170 وبحار الأنوار ج36 ص231 و 234 و 235 و 236 و 237 و 266 و 267 و 269 و 298 و 362 و 363 و 364 و 365 وكتاب الأربعين للماحوزي ص381 و 386 وسفينة النجاة للسرابي التنكابني ص385 والإكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي ص193 والملاحم والفتن لابن طاووس ص345 والمسلك في أصول الدين للمحقق الحلي ص274 وتقريب المعارف لأبي الصلاح الحلبي ص418 وإعلام الورى ج2 ص159 و 162 وكشف الغمة ج1 ص57 و 58 ومسند أحمد ج5 ص87 و 88 و 90 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 106 و 107 و 108 وصحيح البخاري (ط دار الفكر) ج8 ص127 وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج6 ص3 و 4 وسنن أبي داود ج2 ص309 وسنن الترمذي ج3 ص340 والمستدرك للحاكم ج3 ص617 و 618 وشرح مسلم للنووي ج12 ص201 ومجمع الزوائد ج5 ص190 وفتح الباري ج13 ص181 وعمدة القاري ج24 ص281 ومسند أبي داود الطيالسي ص105 و 180 ومسند ابن أبي الجعد ص390 والآحاد والمثاني ج3 ص126 و 127 وكتاب السنة لابن أبي عاصم ص518 وصحيح ابن حبان ج15 ص43 و 44 و 46 والمعجم الأوسط ج3 ص201 وج6 ص209 والمعجم الكبير ج2 ص195 و196 و 197 و 214 و 218 و 223 و 226 و 232 و 241 و 249 و 253 و 254 و 255 وج22 ص120 والرواة عن سعيد بن منصور لأبي نعيم الأصبهاني ص44 والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص95 والكامل لابن عدي ج2 ص386 وطبقات المحدثين بأصبهان ج2 ص90 وتاريخ بغداد ج2 ص124 وج14 ص354 وتاريخ مدينة دمشق ج5 ص191 وسير أعلام النبلاء ج8 ص184 وج14 ص444 وذكر أخبار إصبهان ج2 ص176 والبداية والنهاية ج1 ص177 وج6 ص278 و 279 وإمتاع الأسماع للمقريزي ج12 ص302 و 203 وينابيع المودة ج3 ص289.
( 2) مختصر مفيد للسيد جعفر مرتضى العاملي (أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة)، المركز الإسلامي للدراسات، ط1، لبنان، بيروت، 2014م، ج17 ص75.
( 3) كتاب العين للفراهيدي ج5 ص233.
( 4) الآية 4 من سورة القلم.
( 5) الآية 4 من سورة القلم.
( 6) معاني الأخبار للصدوق ص188 وبحار الأنوار للمجلسي ج68 ص382 وتفسير نور الثقلين للحويزي ج5 ص391 وتفسير كنز الدقائق للقمي المشهدي ج13 ص377.
( 7) بحار الأنوار للمجلسي ج16 ص210 وج68 ص382 وميزان الحكمة للريشهري ج1 ص800 وتفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي ج2 ص382 والتبيان في تفسير القرآن للطوسي ج10 ص75 وتفسير مجمع البيان للطبرسي ج10 ص86 والمنتخب في تفسير القرآن لابن ادريس الحلي ج2 ص345 وج3 ص303 وروض الجنان لأبي الفتوح الرازي (فارسي) ج19 ص346 والتفسير الأصفى للفيض الكاشاني ج2 ص1335 وج5 ص208 والبرهان في تفسير القرآن للسيد البحراني ج5 ص455 وتفسير نور الثقلين للحويزي ج5 ص392 وتفسير الميزان للطباطبائي ج19 ص377 وجامع البيان لابن جرير الطبري ج29 ص24 وتفسير السمعاني ج6 ص18 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج18 ص227 والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم الجوزية ص135 والدر المنثور للسيوطي ج6 ص251.
( 8) مسند الرضا «عليه السلام» لابن سليمان الغازي ص131 ومكارم الأخلاق للطبرسي ص8 وبحار الأنوار للمجلسي ج16 ص210 وج68 ص382 ومواقف الشيعة للميجاني ج3 ص452 وميزان الحكمة للريشهري ج1 ص804 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص192 ومكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص6 ومسند الشهاب للقضاعي ج2 ص192 والاستذكار لابن عبد البر ج8 ص576 وج16 ص254 وكشف الخفاء للعجلوني ج1 ص211 وتفسير جوامع الجامع للطبرسي ج3 ص611 وتفسير مجمع البيان للطبرسي ج10 ص86 وزبدة التفاسير لفتح الله الكاشاني ج7 ص140 وتفسير نور الثقلين للحويزي ج5 ص392 وتفسير كنز الدقائق للقمي المشهدي ج13 ص377 والتفسير الكاشف للشيخ مغنية ج1 ص39 وج5 ص33 وج7 ص553 وتفسير الأمثل للشيرازي ج18 ص529 وأضواء البيان للشنقيطي ج8 ص248 وأعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي ج1 ص301، وغيره الكثير من المصادر.
( 9) وسائل الشيعة للحر العاملي (ط آل البيت) ج12 ص174 و(ط الإسلامية) ج8 ص521 والآمالي للطوسي ص478 وبحار الأنوار للمجلسي ج11 ص156 وج66 ص370 و375 وج 68ص420 وج89 ص197 ومستدرك الوسائل ج11 ص191 ومستدرك سفينة البحار ج3 ص174 وج9 ص103 وراجع أيضاً: الأمالي للصدوق ص441.
( 10) الآية 30 من سورة الروم.
( 11) الآية 40 من سورة يوسف.
( 12) الآية 36 من سورة التوبة.
( 13) اقتصادنا للسيد محمد باقر الصدر «قدس سره» (تحقيق المكتب الإعلامي الإسلامي)، مؤسسة بوستان، ط2، إيران، خراسان، 1425 هـ. ق، ص313.
( 14) راجع: الأمالي للطوسي ص290 ومناقب آل أبي طالب ج2 ص7 والتحصين لابن طاووس ص558 و 559 والطرائف لابن طاووس ص82 والمحتضر للحلي ص170 وبحار الأنوار ج8 ص68 وج39 ص196 و 202 و 234 وكشف الغمة ج2 ص24 ونهج الإيمان ص506 ومستدرك سفينة البحار ج6 ص264 وذكر أخبار أصبهان ج1 ص342 وبشارة المصطفى ص227 و 309 ونور الثقلين (تفسير) ج4 ص401 وينابيع المودة ج1 ص338 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج7 ص119 عن جملة من المصادر.
( 15) راجع: تفسير سورة الانشراح، للمحقق السيد جعفر مرتضى العاملي ص79 وسيرة الإمام الحسين «عليه السلام» في الحديث والسيرة للمحقق السيد جعفر مرتضى العاملي ج4 ص57.
( 16) راجع: نهج البلاغة (بشرح عبده) ج4 ص37 رقم الحديث 147 والإرشاد ج1 ص228 والخصال ص187 والأمالي للصدوق ص253 والأمالي للطوسي ص21 وكمال الدين ص139 و 207 و 291 و 292 و 293 و 294 والأمالي للمفيد ص250 وبصائر الدرجات ص506 ورسائل في الغيبة للمفيد ج2 ص12 والإحتجاج للطبرسي ج2 ص48 و 49 وج1 ص3 ومناقب آل أبي طالب ج1 ص211 وبحار الأنوار ج23 ص6 و 48 و 49 وج52 ص92 ونهج السعادة ج1 ص495 وج8 ص21 وعيون الحكم والمواعظ ص541 ودستور معالم الحكم لابن سلامة ص84 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج10 ص263 وتاريخ مدينة دمشق ج50 ص255 وتاريخ اليعقوبي ج2 ص206 والمعيار والموازنة ص81 ونزهة الناظر للحلواني ص57 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج18 ص347 وإعلام الورى ج2 ص228 وينابيع المودة ج1 ص75 وج3 ص360 ومستدرك سفينة البحار ج2 ص205 والغيبة للنعماني ص32 و 136 وتفسير القمي ج1 ص359 وتفسير نور الثقلين ج2 ص484.
( 17) راجع: الكافي ج1 ص288 ومكاتيب الرسول ج1 ص561 وغنية النزوع ص323 وجامع الخلاف والوفاق ص368 و 404 وتذكرة الفقهاء ج5 ص435 و (ط قديمة) ج1 ص254 وج2 ص437 ومختلف الشيعة ج3 ص333 وج6 ص308 و 330 ومجمع البيان (ط مؤسسة الأعلمي) ج2 ص311 وج8 ص165 وتفسير جوامع الجامع ج3 ص70 و 857 وتلخيص الشافي ج4 ص170 ونور الثقلين ج3 ص290 وج4 ص284 والميزان ج4 ص312 والإرشاد للمفيد ج2 ص30 والمسائل الجارودية للمفيد ص35 والمستجاد من الإرشاد للعلامة (المجموعة) ص157 والصراط المستقيم ج2 ص118 وج3 ص130 والمحتضر لابن سليمان الحلي ص179 والتعجب للكراجكي ص129 والفصول المختارة للمرتضى ص303 وروضة الواعظين ص156 وكفاية الأثر ص38 و 117 والفرق بين الفرق ص25 ودعائم الإسلام ج1 ص37 ومناقب آل أبي طالب ج3 ص143 و 163 والفضائل لابن شاذان ص118 والطرائف لابن طاووس 196 وعوالي اللآلي ج3 ص130 وج4 ص93 ومدينة المعاجز ج2 ص391 وج3 ص290 وبحار الأنوار ج16 ص307 وج21 ص279 وج35 ص266 وج36 ص289 و 325 وج73 ص7 وج37 ص298 و 291 وج44 ص2 و 16 وإعلام الورى ج1 ص407 و 421 وكشف الغمة ج2 ص156 وج2 ص225 و 245 والفصول المهمة لابن الصباغ ج2 ص717 و 732 وفضائل أمير المؤمنين «عليه السلام» لابن عقدة ص168 ونزهة المجالس ج2 ص184 وفي السراج الوهاج للشبراوي الشافعي أنه «صلى الله عليه وآله» قال لهما: أنتما الإمامان، ولأمكما الشفاعة، وغاية المرام ج2 ص243 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج7 ص482 وج19 ص216 و 217 عن أهل البيت لتوفيق علم (ط مطبعة السعادة القاهرة) ص195 وعن الرسالة في نصيحة العامة لابن كرامة البيهقي (النسخة المصورة في مكتبة أمبروزيانا في إيطاليا) ص18 و 67 وينابيع المودة ص445.
( 18) راجع: كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق ص260 وبحار الأنوار للمجلسي ج36 ص254 ومسند الإمام الرضا «عليه السلام» للعطاردي ج1 ص220 والبرهان في تفسير القرآن للسيد البحراني ج4 ص195 وأهل البيت في الكتاب والسنة للريشهري ص 464 والقرآن وفضائل أهل البيت «عليهم السلام» للأنديمكشي ص376 وغاية المرام وحجة الخصام للسيد البحراني ج2 ص158 وج7 ص127 وإلزام الناصب لليزدي الحائري ج1 ص76 وشرح إحقاق الحق للمرعشي ج13 ص67 وفرائد السمطين للحمويني ج1 ص55.
( 19) الضوء اللامع (دار الجيل) ج4 ص147 وفيض القدير بشرح الجامع الصغير ج1 ص265 وج5 ص213 ولكنهم قالوا: إن ذلك لم يوجد في تاريخ ابن خلدون، والحق أنها كانت في النسخة الأولى لذلك الكتاب، ثم حذفها منه في النسخة الثانية.
( 20) راجع: الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي (ط دار الفكر) ص193.
( 21) راجع: رسالة ابن تيمية: سؤال في يزيد بن معاوية (لعنه الله) ص14 و15 و17، والعواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (مكتبة دار التراث، مصر) ص232 و233 وإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي ج3 ص125 والإتحاف بحب الأشراف لعبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي ص67 و 68 والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لإبن حجر الهيتمي (مؤسسة الرسالة، بيروت) ص221 وخطط الشام لمحمد بن عبد الرزاق بن محمَّد، كُرْد عَلي (مكتبة النوري، دمشق) ج1 ص145 وقيد الشريد من أخبار يزيد لابن طولون (دار الصحوة للنشر) ص57 و 59.
( 22) راجع: مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج4 ص88 و (ط المكتبة الحيدرية) ج3 ص240 وبحار الأنوار للمجلسي ج44 ص325، الإمام الحسين «عليه السلام» لعبد الله العلايلي ج17 ص174 و 175 والفتوح لابن أعثم ج5 ص10 وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي (ط النجف) ص235.
( 23) راجع: مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم من ص6 حتى ص16.
( 24) مثير الأحزان لابن نما ص12 وبحار الأنوار للمجلسي ج44 ص266، الإمام الحسين «عليه السلام» لعبد الله العلايلي ج17 ص137 والدر النظيم لليافعي ص540 والمجالس الفاخرة للسيد شرف الدين ص257.
( 25) سيرة الإمام الحسين «عليه السلام» في الحديث والسيرة للسيد جعفر مرتضى العاملي (منشورات المركز الإسلامي للدرسات) ج15 ص14.
( 26) سيرة الإمام الحسين «عليه السلام» في الحديث والسيرة للسيد جعفر مرتضى العاملي (منشورات المركز الإسلامي للدرسات) ج15 ص16.
( 27) لسان العرب لابن منظور ج7 ص245.
( 28) المصدر السابق.
( 29) المصدر السابق.
( 30) الآية 59 من سورة النساء.
( 31) الآية 83 من سورة النساء.
( 32) الآية 48 من سورة الأنفال.
( 33) الآية 158 من سورة الأنعام.
( 34) الإحتجاج للطبرسي ج2 ص23 وبحار الأنوار ج44 ص205 والعوالم ج17 ص83 و 84 وراجع: وسائل الشيعة (آل البيت) ج27 ص195 و (الإسلامية) ج18 ص144 ومناقب آل أبي طالب ج4 ص67 و (ط المكتبة الحيدرية) ج3 ص223.
( 35) الآية 30 من سورة الأنفال.
( 36) الآية 9 من سورة يس.
( 37) راجع ما تقدم في المصادر التالية: المناقب للخوارزمي الحنفي ص73 والمستدرك للحاكم ج3 ص133 وتلخيصه للذهبي بهامشه وصححاه، ومسند أحمد ج1 ص321 وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص34 وشواهد التنزيل ج1 ص99 و 100 و 101 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص100 والبرهان ج1 ص207 والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي ص30 وخصائص أمير المؤمنين للنسائي (ط النجف) ص63 والسيرة الحلبية ج2 ص35 ومجمع الزوائد ج9 ص120 عن أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير واحد وهو ثقة، وعن الطبراني في الكبير والأوسط، وبحار الأنوار ج19 ص60 و 78 و 93 عن الطبري وأحمد، والعياشي، وكفاية الطالب، وفضائل الخمسة ج1 ص231 وذخائر العقبى ص87 وكفاية الطالب ص242. وقال: إن ابن عساكر ذكره في الأربعين الطوال، وترجمة الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام»، من تاريخ ابن عساكر (تحقيق المحمودي) ج1 ص186 و 190 ونقله المحمودي في هامشه عن: الفضائل لأحمد بن حنبل، حديث291 وعن غاية المرام ص66 عن الطبراني ج3 في الورق 168/ب وفي هامش كفاية الطالب عن: الرياض النضرة ج2 ص203. وأما الفقرات الأخرى فهي موجودة في مختلف كتب الحديث والتاريخ. وراجع: حلية الأبرار ج1 ص144 والميزان ج9 ص81 وأعيان الشيعة ج1 ص237 و 376 والأمالي للطوسي ص466 ومستدرك الوسائل ج5 ص155 و 465 وجامع أحاديث الشيعة ج5 ص475 وكشف الغمة ج2 ص30.
( 38) الإرشاد للمفيد (ط دار المفيد سنة 1414هـ) ج2 ص34 وروضة الواعظين ص189 و (منشورات الشريف الرضي) ص171 وإعلام الورى ج1 ص435 وبحار الأنوار ج44 ص326 و 330 والعوالم، الإمام الحسين ج17 ص176 و 179 ونهاية الأرب ج20 ص380 وتاريخ الأمم والملوك ج5 ص340 و (ط الأعلمي) ج4 ص252 والكامل في التاريخ ج4 ص16 و 17 وجمهرة خطب العرب ج2 ص34 وراجع: الأخبار الطوال ص228 وتذكرة الخواص ج2 ص132 والبداية والنهاية ج8 ص147 و (ط دار إحياء التراث) ج8 ص158 ومصادر كثيرة أخرى.
( 39) الملهوف ص39 و 40 وبحار الأنوار ج44 ص364 والعوالم، الإمام الحسين ج17 ص214 ولواعج الأشجان ص72 وأعيان الشيعة ج1 ص593 وعن معالي السبطين ج1 ص251.
( 40) الآية 21 من سورة القصص.
( 41) الإرشاد للمفيد ص223 و (ط دار المفيد سنة 1414هـ) ص35 وبحار الأنوار ج44 ص332 ج17 ص181 وتفسير كنز الدقائق ج10 ص53.
( 42) بحار الأنوار ج45 ص99 والعوالم، الإمام الحسين ج17 ص323 وينابيع المودة ج3 ص60 وراجع: الكامل في التاريخ ج4 ص38 وتاريخ الأمم والملوك (ط الأعلمي) ج4 ص289 والفتوح لابن أعثم ج5 ص67 وراجع: مدينة المعاجز ج3 ص485 ولواعج الأشجان ص72 و 256 وأعيان الشيعة ج1 ص593 و 620 ونهاية الأرب ج20 ص407 والمجالس الفاخرة للسيد شرف الدين ص106.
( 43) الآية 22 من سورة القصص.
( 44) الفتوح لابن أعثم ج5 ص23 ومقتل الحسين للخوارزمي ج1 ص190 وبحار الأنوار ج44 ص332، الإمام الحسين ج17 ص181 ولواعج الأشجان ص32 وتاريخ الأمم والملوك ج5 ص434 و (ط الأعلمي) ج4 ص254 والكامل في التاريخ ج4 ص17 والإرشاد (ط دار المفيد) ج2 ص35 وروضة المواعظين ص190 و (منشورات الشريف الرضي) ص172 وإعلام الورى ج1 ص435 والأغاني ج18 ص447 وأعيان الشيعة ج1 ص588 وتفسير كنز الدقائق ج10 ص53. .
( 45) سيرة الإمام الحسين «عليه السلام» في الحديث والتاريخ للسيد جعفر مرتضى العاملي ج12 ص1.
( 46) راجع: المسائل العكبرية للمفيد ج6 ص69 وبحار الأنوار ج44 ص366، الإمام الحسين ج17 ص216 والملهوف ص126 و(نشر أنوار الهدى) ص38 ومثير الأحزان ص41 و (ط المكتبة الحيدرية) ص29 وكشف الغمة ج2 ص239. وراجع: الحدائق الوردية ج1 ص114 وتيسيير الوصول ص199 ونزهة الناظر ص86 ومقتل الحسين للخوارزمي ح1 ص5 ولواعج الأشجان ص70 وإبصار العين ص27 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج11 ص599.
(47 ) الآية 64 من سورة العنكبوت.
( 48) مقالات ودراسات للسيد جعفر مرتضى العاملي (منشورات المركز الإسلامي للدراسات) ط1، لبنان، بيروت، 2009م، ص12.
( 49) حذاء: أي سار سريعاً حتى أدركه، وقيل: سَرِيعُ الإِدْراكِ.
( 50) الفتوح لابن أعثم ج5 ص84 ومقتل الحسين ج1 ص239 ومطالب السؤول ص75 و (تحقيق ماجد العطية) ص400 ومناقب آل أبي طالب ج4 ص98 و (ط المكتبة الحيدرية) ج3 ص248 وموسوعة الإمام الحسين ج4 ص34 عنهم، وعن كشف الغمة ج2 ص259 و (ط دار الأضواء) ج2 ص257 وبحار الأنوار ج44 ص383 وراجع: أعيان الشيعة ج1 ص598.
( 51) الإرشاد ج2 ص96 وبحار الأنوار ج45 ص4 وتاريخ الأمم والمولك ج5 ص423 و (ط الأعلمي) ج4 ص321 وتاريخ مدينة دمشق ج14 ص217 وترجمة الإمام الحسين لابن عساكر ص313 ونهاية الأرب ج20 ص439 والوافي بالوفيات ج12 ص265 والطبقات الكبرى (الطبقة الخامسة من الصحابة) ج1 ص468 وترجمة الإمام الحسين من طبقات ابن سعد ص71 والكامل في التاريخ ج4 ص60 وراجع: سير أعلام النبلاء ج3 ص301 ونظم درر السمطين ص216 ومقتل الحسين لأبي مخنف ص115 وإبصار العين ص32 وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج11 ص613 وج12 ص293 وج19 ص415 وج27 ص209.
( 52) يوم كوثر، مبنية للمجهول: أي صار مغلوباً بكثرة العدو.
( 53) مصباح المجتهد للطوسي ص827 والمزار للمشهدي ص399 وإقبال الأعمال لابن طاووس ج3 ص304 والمصباح للكفعمي ص544 وبحار الأنوار للمجلسي ج98 ص348 وموسوعة مكاتيب الأئمة «عليهم السلام» لنجف آبادي ج2 ص218 والبلد الأمين والدرع الحصين للكفعمي ص186.
( 54) نهج البلاغة (خطب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام») تحقيق صالح، ص89.
( 55) الآية 21 من سورة النحل.
( 56) الآية 169 من سورة آل عمران.
( 57) الآية 154 من سورة البقرة.
( 58) شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني (منشورات مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي) ط1، 1362 هـ. ش، قم المقدسة، إيران، ج2 ص136.
( 59) الملهوف ص155 و (نشر أنوار الهدى) ص58 والإحتجاج ج2 ص97 ح167 و (ط دار النعمان) ج2 ص24 وتحف العقول ص240 ومثير الأحزان ص54 و (ط المكتبة الحيدرية) ص39 كلها نحوه، وراجع: إثبات الوصية ص177 وبحار الأنوار ج45 ص83 و 10، الإمام الحسين ج17 ص252 ولواعج الأشجان ص129 وأعيان الشيعة ج1 ص602 وإبصار العين ص34 وموسوعة الإمام الحسين ج4 ص114 – 116 عن تلك المصادر.

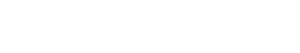

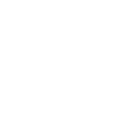


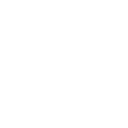
















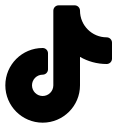





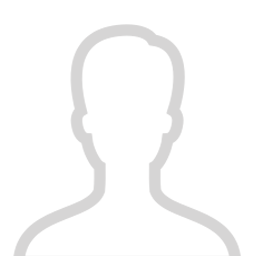


.png) د.فاضل حسن شريف
د.فاضل حسن شريف .png) منذ 3 ايام
منذ 3 ايام 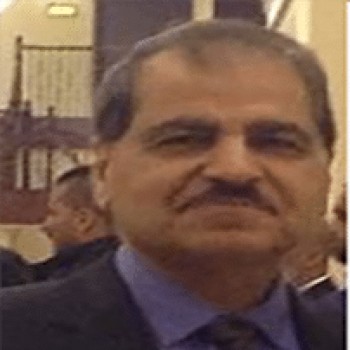











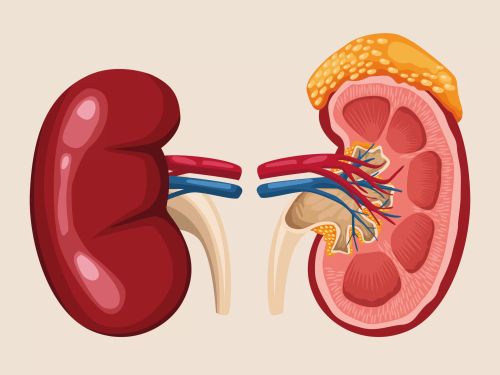
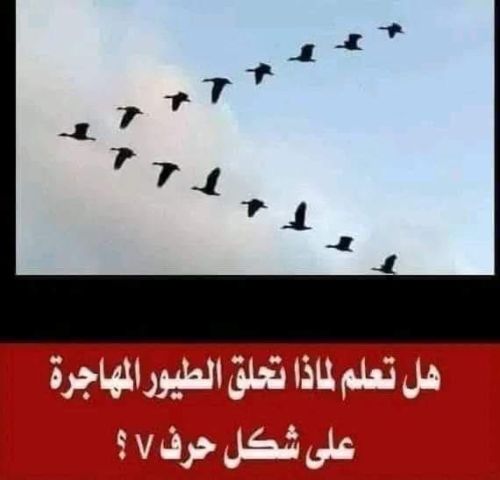
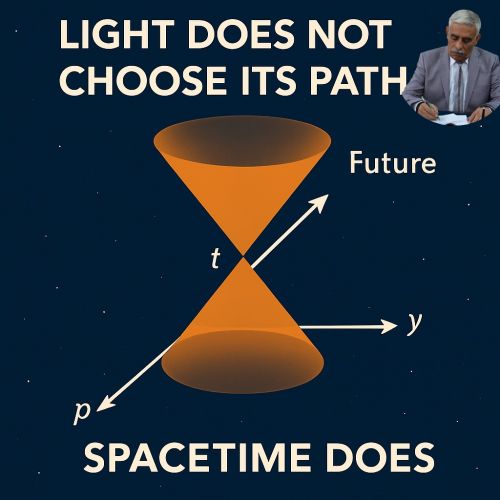



 حسين مني وأنا من حسين
حسين مني وأنا من حسين زيارة الأربعين والإبداع في نصرة الإمام الحسين (عليه السلام)
زيارة الأربعين والإبداع في نصرة الإمام الحسين (عليه السلام)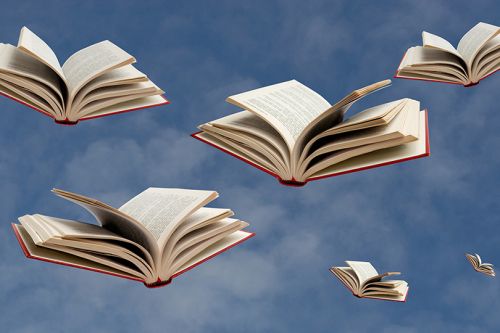 العنوان سرّ الكتاب
العنوان سرّ الكتاب EN
EN