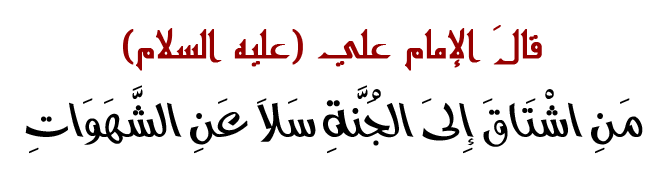
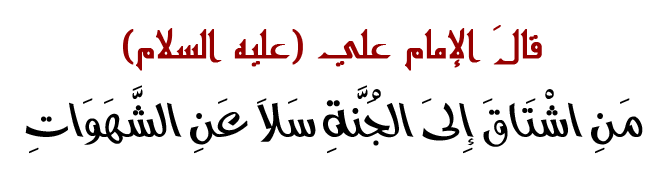
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-9-2020
التاريخ: 26-03-2015
التاريخ: 26-03-2015
التاريخ: 2-2-2020
|
فصل في الفرق بين الاستعارة والتمثيل
اعلم أن من المقاصد التي تقع العناية بها أن نُبيّن حالَ الاستعارةِ مع التمثيل، أهي هو على الإطلاق حتى لا فرق بين العبارتين، أم حدُّها غيرُ حدِّه إلا أنها تتضمّنه وتَتَّصل به? فيجب أن نُفرِد جملةً من القول في حالها مَع التَّمثيل، قد مضى في الاستعارة أن حدّها يكون للّفظ اللُّغوي أصلٌ، ثم يُنقَل عن ذلك الأصل على الشرط المتقدم، وهذا الحدّ لا يجيء في الذي تقدَّم في معنى التمثيل، من أنه الأصل في كونه مَثَلاً وتمثيلاً، وهو التشبيه المنتزَع من مجموع أمور، والذي لا يُحصّله لك إلا جملةٌ من الكلام أو أكثر، لأنك قد تجد الألفاظَ في الجمل التي يُعقَد منها جاريةً على أصولها وحقائقها في اللغة، وإذا كان الأمر كذلك، بانَ أَنَّ الاستعارة يجب أن تُقيد حكماً زائداً على المراد بالتمثيل، إذ لو كان مرادُنا بالاستعارة هو المراد بالتمثيل، لوَجب أن يصحّ إطلاقُها في كل شيء يقال فيه إنه تمثيلٌ ومَثَل، والقول فيها أنّها دِلالة على حكمٍ يثبت للّفظ، وهو نقلُه عن الأصل اللغويّ وإجراؤه على ما لم يوضع له، ثم إن هذا النقل يكون في الغالب من أجل شَبَهٍ بين ما نُقِلَ إليه وما نُقِلَ عنه، وبيان ذلك ما مضى من أنك تقول: رأيت أسداً، تريد رجلاً شبيهاً به في الشجاعة وظبيةً تريد امرأة شبيهة بالظبية، فالتشبيه ليس هو الاستعارة ولكن الاستعارة كانت من أجل التشبيه، وهو كالغرض فيها، وكالعلّة والسبب في فِعْلها. فإن قلت كيف تكون الاستعارة من أجل التشبيه، والتشبيه يكون ولا استعارةَ؛ وذلك إذا جئتَ بحرفه الظاهر فقلت زيد الأسد. فالجواب أن الأمر كما قلتَ، ولكنّ التشبيه يحصُل بالاستعارة على وجه خاصٍّ وهو المبالغة، فقولي: من أجل التشبيه، أردتُ به من أجل التشبيه على هذا الشرط، وكما أن التشبيه الكائنَ على وجه المبالغة غَرَضٌ فيه وعِلَّة، كذلك الاختصار والإيجاز غَرَضٌ من أغراضها، ألا ترى أنك تُفيد بالاسمِ الواحدِ الموصوفَ والصفةَ والتشبيهَ والمبالغةَ، لأنك تُفيد بقولك رأيت أسداً، أنك رأيت شجاعاً شبيهاً بالأسد، وأنّ شَبَهه به في الشجاعة على أتمّ ما يكون وأبلغِه، حتى إنه لا ينقص عن الأسد فيها، وإذا ثبت ذلك، فكما لا يصحّ أن يقال إن الاستعارة هي الاختصار والإيجاز على الحقيقة، وأنّ حقيقتها وحقيقتهما واحدة، ولكن يقال إن الاختصار والإيجاز يحصلان بها، أو هما غرضان فيها، ومن جملة ما دعا إلى فِعْلِها، كذلك حكمُ التشبيه معها، فإذا ثبت أنها ليست التشبيهَ على الحقيقة، كذلك لا تكون التمثيل على الحقيقة، لأن التمثيلَ تشبيهٌ إلا أنه تشبيهٌ خاصٌّ، فكلُّ تمثيلٍ تشبيهٌ، وليس كلُّ تشبيهٍ تمثيلاً. وإذا قد تقرَّرتْ هذه الجملة، فإذا كان الشَبَه بين المستعار منه والمستعار له من المحسوس والغرائزِ والطِّباع وما يجري مجرَاها من الأوصاف المعروفة، كان حقّها أن يقال إنها تتضمّن التشبيه، ولا يقال إنّ فيها تمثيلاً وضَرْبَ مَثَل، وإذا كان الشَّبَه عقلياً جاز إطلاق التمثيل فيها، وأَن يقال ضُرِبَ الاسمُ مَثَلاً لكذا، كقولنا ضُرب النور مثلاً للقرآن، والحياةُ مَثَلاً للعلم. فقد حصلنا من هذه الجملة على أن المستعير يَعْمِد إلى نقل اللفظ عن أصله في اللغة إلى غيره، ويجوز به مكانَه الأصليَّ إلى مكان آخر، لأجل الأغراض التي ذكرنا من التشبيه والمبالغة والاختصار، والضَّارب للمثل لا يفعل ذلك ولا يقصِده، ولكنه يقصِد إلى تقرير الشَّبه بين الشيئين من الوجه الذي مضى، ثم إنْ وقع في أَثناء ما يُعْقَد به المثلُ من الجملة والجملتين والثلاث لفظةٌ منقولةٌ عن أصلها في اللغة، فذاك شيءٌ لم يعتمده من جهة المَثَلُ الذي هو ضاربه، وهكذا كان متعاطٍ لتشبيهٍ صريحٍ، لا يكون نَقْل اللفظ من شأنه ولا مِن مُقتضى غرضه، فإذا قلت: زيد كالأسد، وهذا الخبر كالشمس في الشهرة، وله رأيٌ كالسَّيف في المضاء، لم يكن منك نقلٌ للفظِ عن موضوعه، ولو كان الأمر على خلاف ذلك، لوجب أن لا يكون في الدنيا تشبيه إلا وهو مجاز، وهذا مُحالٌ، لأن التشبيه معنًى من المعاني وله حروف وأسماءٌ تدلّ عليه، فإذا صُرّح بذلك ما هو موضوع للدلالة عليه، كان الكلام حقيقةً كالحكم في سائر المعاني فاعرفه. واعلم أن اللفظة المستعارة لا تخلو من أن تكون اسماً أو فعلاً، فإذا كانت اسماً كان اسمَ جنس أو صفةً، فإذا كاناسمَ جنسٍ فإنك تراه في أكثر الأحوال التي تُنقَل فيها محتملاً مُتَكَفِّئاً بين أن يكون للأصل، وبين أن يكون للفرع الذي من شأنه أن يُنقَل إليه، فإذا قلتَ: رأيت أسداً، صَلَحَ هذا الكلام لأن تريد به أنك رأيتَ واحداً من جنس السَّبُعِ المعلوم، وجاز أن تريد أنك رأيتَ شجاعاً باسلاً شديد الجُرأة، وإنما يَفْصِل لك أحدَ الغَرَضين من الآخر شاهدُ الحال، وما يتَّصل به من الكلام من قبل وبعد. وإن كان فعلاً أو صفةً، كان فيهما هذا الاحتمال في بعض الأحوال، وذلك إذا أسندتَ الفعلَ وأجريتَ الصفة على اسم مُبهَم يقعُ على ما يكون أصلاً في تلك الصفة وذاك الفعل، وما يكون فرعاً فيهما، نحو أن تقول: أنار لي شيءٌ وهذا شيءٌ مُنِير، فهذا الكلام يحتمل أن يكون أنار ومُنِير فيه واقعَين على الحقيقة، بأن تعني بالشيء بعضَ الأجسام ذوات النور وأن يكونَا واقعَين على المجاز، بأن تريد بالشيء نوعاً من العلم والرأي وما أشبه ذلك من المعاني التي لا يَصِحُّ وجود النور فيها حقيقةً، وإنما توصف به على سبيل التشبيه. وفي الفعل والصفة شيء آخرُ، وهو أنك كأنك تدَّعي معنى اللَّفظ المستعار للمستعار له، فإذا قلتَ: قد أنارت حُجَّتُه، وهذه حجَّةٌ منيرة، فقد ادّعيتَ للحُجَّة النور، ولذلك تجيء فتُضيفه إليك، كما تضاف المعاني التي يُشتقّ منها الفعلُ والصفةُ إلى الفاعل والموصوف فتقول: نُورُ هذه الحجّة جَلاَ بَصَرِي، وشرح صَدْرِي، كما تقول: ظهر نُورُ الشمس، والمثل لا يوجب شيئاً من هذه الأحكام، فلا هو يقتضي تردُّدَ اللفظ بين احتمال شيئينِ ولا أن يُدَّعى معناه للشيء، ولكنه يدَعُ اللفظَ مستقرّاً على أصله. وإذ قد ثبت هذا الأصل، فاعلم أن هاهنا أصلاً آخر يُبنَى عليه، وهو أن الاستعارة وإن كانت تعتمد التشبيه والتمثيلَ وكان التشبيهُ يقتضي شيئين مشبَّهاً ومشبَّهاً به، وكذلك التمثيل، لأنه كما عرفت تشبيهٌ إلا أنه عقليٌّ فإن الاستعارة من شأنها أن تُسقِطَ ذكرَ المشبَّه من البَيْنِ وتطرحه، وتدَّعَي له الاسمَ الموضوعَ للمشبَّه به، كما مضى من قولك: رأيت أسداً، تريد رجلاً شجاعاً ووردتُ بحراً زاخراً، تريد رجلاً كثير الجُود فائضَ الكفّ وأبديتُ نوراً، تريد علماً وما شاكل ذلك، فاسم الَّذِي هو المشبَّه غير مذكورٍ بوجه من الوجوه كما ترى، وقد نقلتَ الحديثَ إلى اسم المشبَّه به، لقَصْدك أن تبالغ، فتضع اللَّفظ بحيث يُخيّل أنَّ معك نَفْس الأسد والبحر والنور، كي تُقوِّي أمر المشابهة وتشدّده، ويكون لها هذا الصنيع حيث يقع الاسم المستعار فاعلاً أو مفعولاً أو مجروراً بحرف الجرّ أو مضافاً إليه، فالفاعل كقولك: بدا لي أسدٌ وانبرى لي لَيْثٌ وبدا نُورٌ وظهرت شمسٌ ساطعة وفاض لي بالمواهبِ بحرٌ، كقوله:َ جنسٍ فإنك تراه في أكثر الأحوال التي تُنقَل فيها محتملاً مُتَكَفِّئاً بين أن يكون للأصل، وبين أن يكون للفرع الذي من شأنه أن يُنقَل إليه، فإذا قلتَ: رأيت أسداً، صَلَحَ هذا الكلام لأن تريد به أنك رأيتَ واحداً من جنس السَّبُعِ المعلوم، وجاز أن تريد أنك رأيتَ شجاعاً باسلاً شديد الجُرأة، وإنما يَفْصِل لك أحدَ الغَرَضين من الآخر شاهدُ الحال، وما يتَّصل به من الكلام من قبل وبعد. وإن كان فعلاً أو صفةً، كان فيهما هذا الاحتمال في بعض الأحوال، وذلك إذا أسندتَ الفعلَ وأجريتَ الصفة على اسم مُبهَم يقعُ على ما يكون أصلاً في تلك الصفة وذاك الفعل، وما يكون فرعاً فيهما، نحو أن تقول: أنار لي شيءٌ وهذا شيءٌ مُنِير، فهذا الكلام يحتمل أن يكون أنار ومُنِير فيه واقعَين على الحقيقة، بأن تعني بالشيء بعضَ الأجسام ذوات النور وأن يكونَا واقعَين على المجاز، بأن تريد بالشيء نوعاً من العلم والرأي وما أشبه ذلك من المعاني التي لا يَصِحُّ وجود النور فيها حقيقةً، وإنما توصف به على سبيل التشبيه. وفي الفعل والصفة شيء آخرُ، وهو أنك كأنك تدَّعي معنى اللَّفظ المستعار للمستعار له، فإذا قلتَ: قد أنارت حُجَّتُه، وهذه حجَّةٌ منيرة، فقد ادّعيتَ للحُجَّة النور، ولذلك تجيء فتُضيفه إليك، كما تضاف المعاني التي يُشتقّ منها الفعلُ والصفةُ إلى الفاعل والموصوف فتقول: نُورُ هذه الحجّة جَلاَ بَصَرِي، وشرح صَدْرِي، كما تقول: ظهر نُورُ الشمس، والمثل لا يوجب شيئاً من هذه الأحكام، فلا هو يقتضي تردُّدَ اللفظ بين احتمال شيئينِ ولا أن يُدَّعى معناه للشيء، ولكنه يدَعُ اللفظَ مستقرّاً على أصله. وإذ قد ثبت هذا الأصل، فاعلم أن هاهنا أصلاً آخر يُبنَى عليه، وهو أن الاستعارة وإن كانت تعتمد التشبيه والتمثيلَ وكان التشبيهُ يقتضي شيئين مشبَّهاً ومشبَّهاً به، وكذلك التمثيل، لأنه كما عرفت تشبيهٌ إلا أنه عقليٌّ فإن الاستعارة من شأنها أن تُسقِطَ ذكرَ المشبَّه من البَيْنِ وتطرحه، وتدَّعَي له الاسمَ الموضوعَ للمشبَّه به، كما مضى من قولك: رأيت أسداً، تريد رجلاً شجاعاً ووردتُ بحراً زاخراً، تريد رجلاً كثير الجُود فائضَ الكفّ وأبديتُ نوراً، تريد علماً وما شاكل ذلك، فاسم الَّذِي هو المشبَّه غير مذكورٍ بوجه من الوجوه كما ترى، وقد نقلتَ الحديثَ إلى اسم المشبَّه به، لقَصْدك أن تبالغ، فتضع اللَّفظ بحيث يُخيّل أنَّ معك نَفْس الأسد والبحر والنور، كي تُقوِّي أمر المشابهة وتشدّده، ويكون لها هذا الصنيع حيث يقع الاسم المستعار فاعلاً أو مفعولاً أو مجروراً بحرف الجرّ أو مضافاً إليه، فالفاعل كقولك: بدا لي أسدٌ وانبرى لي لَيْثٌ وبدا نُورٌ وظهرت شمسٌ ساطعة وفاض لي بالمواهبِ بحرٌ، كقوله:
|
وَفِي الجِيرة الغَادِين من بَطن وَجْرةٍ |
|
غزالٌ كَحِيلُ المُقلـتَـيْن رَبِـيبُ |
والمفعولُ كما ذكرت من قولك: رأيت أسداً، والمجرور نحو قولك لا عَارَ إن فَرّ من أَسدٍ يَزْأَر، والمضاف إليه كقوله:
|
يَا ابن الكواكب من أَئِمّة هاشمٍ |
|
والرُجَّحِ الأَحسابِ والأَحْـلامِ |
وإذا جاوزتَ هذه الأحوال، كان اسم المشبَّه مذكوراً وكان مبتدأ، واسمُ المشبَّه به واقعاً في موضع الخبر، كقولك: زيد أسد، أو على هذا الحد، وهل يستحقّ الاسم في هذه الحالة أن يوصف بالاستعارة أم لا:? فيه شبهة وكلامٌ سيأتيك إن شاء اللَّه تعالى. وإذ قد عرفت هذه الجملةَ، فينبغي أن تعلم أنه ليس كل شيء يجيء مشبَّهاً به بكافٍ أو بإضافة مِثْلَ إليه، يجوز أن تسلّط عليه الاستعارة، وتُنفِذ حكمَها فيه، حتى تنقله عن صاحبه وتدّعيه للمشبَّه على حدّْ قولك: أبديتُ نوراً تريد علماً، وسللتُ سيفاً صارماً، تريد رأياً نافذاً وإنما يجوز ذلك إذا كان الشَّبه بين الشيئين مما يقرُب مأخذه وَيَسْهُل متناوَلُه، ويكونُ في الحالِ دليلٌ عليه، وفي العُرف شاهدٌ له، حتى يُمكن المخاطَبَ إذا أطلقت له الاسم أن يعرف الغَرَضَ ويعلم ما أردت، فكل شيء كان من الضَّرب الأول الذي ذكرتُ أنك تكتفي فيه بإطلاق الاسم داخلاً عليه حرف التشبيه نحو قولهم هو كالأسد، فإنك إذا أدخلت عليه حكم الاستعارة وجدت في دليل الحال، وفي العرف ما يُبيِّن غرضك، إذ يُعْلَم إذا قلت رأيت أسداً، وأنت تريد الممدوح، أنّك قصدت وصفَه بالشجاعة وإذا قلت طلعت شمسٌ، أنت تريد امرأة، عُلِم أنك تريد وَصْفها بالحسن، وإن أردت الممدوح عُلِم أنك تقصِد وصفَه بالنَّباهة والشرف. فأما إذا كان من الضرب الثاني الذي لا سبيل إلى معرفة المقصود من الشبه فيه إلا بعد ذكر الجمل التي يعقد بها التمثيل، فإن الاستعارة لا تدخله، لأن وجه الشبه إذا كان غامضاً لم يَجُز أن تقتسر الاسم وتَغْصِب عليه موضعه، وتنقله إلى غير ما هو أهله من غير أن يكون معك شاهدٌ يُنبئُ عن الشَبه. فلو حاولتَ في قوله: "فإنَّك كالليلِ الَّذِي هو مُدْرِكِي" أن تُعامل الليلَ معاملةَ الأسد في قولك: رأيت أسداً، أعني أن تُسقط ذكر الممدوح من البَيْن، لم تجد له مذهباً في الكلام، ولا صادفت طريقةً تُوَصِّلك إليه، لأنك لا تخلُو من أحد أمرين إمّا أن تحذفَ الصفةَ وتقتصر على ذكر الليل مجرّداً فتقول إن فررتُ أظلّني اللَّيل، وهذا محال، لأنه ليس في الليل دليل على النكتة التي قصدها من أنه لا يفوتُه وإن أبعد في الهرب، وصار إلى أقصى الأرض، لسعة مُلكه وطول يده، وأَنّ له في جميع الآفاق عاملاً وصاحبَ جيش ومُطيعاً لأوامره يردُّ الهارب عليه ويسوقه إليه وغايةُ ما يتأتَّى في ذلك أن يريد أنه إن هرب عنه أظلمت عليه الدنيا، وتحيَّر ولم يهتدِ، فصار كمن يحصُل في ظُلمة الليل، وهذا شيء خارج عن الغَرَض، وكلامنا على أن تستعير الاسم ليؤدَّى به التشبيه الذي قُصِد في البيت ولم أُرِد أنه لا تُمكن استعارته على معنًى ما، ولا يَصْلُح في غرض من الأغراض. وإن لم تحذف الصفة، وجدت طريق الاستعارة فيه يؤدِّي إلى تعسّف، إذ لو قلت إن فررتُ منك وجدتُ ليلاً يُدْركني، وإن ظننتُ أنّ المنتأَى واسعٌ والمهرَبَ بعيدٌ قلتَ ما لا تقبله الطِّباع، وسلكتَ طريقةً مجهولةً، لأن العُرف لم يَجْرِ بأن يُجعل الممدوحُ ليلاً هكذا، فأمّا قولهم إن التشبيه بالليل يتضمّن الدِّلالة على سُخطه، فإنه لا يُفسح في أن يجرى اسم الليل على الممدوح جَرْيَ الأسدِ والشمس ونحوهما، وإنما تصلُح استعارة الليل لمن يُقصَد وصفُه بالسَّواد والظلمة، كما قال ابن طباطبا: "بَعثْتَ معي قِطْعاً من الليل مُظلمَا" يعني زِنْجيّاً قد أنفذه المخاطَبُ معه حين انصرف عنه إلى منزله، هذا وربّما - بل كلما - وجدتَ ما إن رُمْتَ فيه طريقةَ الاستعارة، لم تجد فيه هذا القدر من التُّمحل والتكلُّف أيضاً،و وهو كقولِ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "الناسُ كإبلٍ مئة لا تجدُ فيها راحلة"، قُل الآن من أيّ جهة تصِلُ إلى الاستعارة ههنا، وبأيّ ذريعة تَتذرَّع إليها? هل تقدر أن تقول: رأيت إبلاً مئة لا تجد فيها راحلة في معنى: رأيت ناساً أو الإبل المئة التي لا تجد فيها راحلةً، تريد الناس، كما قلت: رأيت أسداً على معنى رجلاً كالأسد أو الأسد، على معنى الذي هو كالأسدُ? وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم:" مَثَلُ المُؤمِن كمثل النَّخلة أو مثل الخامة"، لا تستطيع أن تتعاطى الاستعارة في شيء منه فتقولَ: رأيت نَخلة أو خامةً على معنى رأيت مؤمناً، إنَّ من رام مثل هذا كان كما قال صاحب الكتاب: مُلْغِزاً تاركاً لكلام الناس الذي يَسْبِق إلى أفئدتهم، وقد قدّمتُ طرفاً من هذا الفصل فيما مضى، ولكنني أعدته هاهنا لاتصاله بما أريد ذكره. فقد ظهر أنه ليس كل شيء يجيء فيه التشبيه الصريح بذكر الكاف ونحوها، يستقيم نَقْلُ الكلام فيه إلى طريقة الاستعارة، وإسقاطِ ذكر المشبَّه جملةً، والاقتصار على المشبَّه به، وبقي أن نتعرّف الحكمَ في الحالة الأخرى، وهي التي يكون كل واحدٍ من المشبَّه والمشبَّه به مذكوراً فيه، نحو زيدٌ أسدٌ ووجدته أسداً، هل تُساوِقُ صريحَ التشبيه حتى يجوز في كل شيئين قُصِدَ تشبيهُ أحدهما بالآخر أن تحذف الكافَ ونحوها من الثاني، وتجعله خبراً عن الأول أو بمنزلة الخبر? والقولُ في ذلك أن التشبيه إذا كان صريحاً بالكاف، ومثل، كان الأعرفُ الأشهر في المشبَّه به أن يكون معرفةً، كقولك: هو كالأسد وهو كالشمس وهو كالبحر وكليث العرين وكالصبح وكالنجم وما شاكل ذلك، ولا يكاد يجيء نكرةً مجيئاً يُرتضَى نحو هو كأسد وكبحر وكغَيْث، إلا أن يُخَصَّص بصفة نحو كبحرٍ زاخر، فإذا جعلت الاسمَ المجرور بالكاف مُعْرَباً بالإعراب الذي يستحقّه الخبر من الرفع أو النصب، كان كلا الأمرين - التعريف والتنكيرِ - فيه حسناً جميلاً، تقول: زيدٌ الأسد والشمس والبحرُ وزيد أسدٌ وشمس وبدر وبحر. وإذْ قد عرفت هذا فارجع إلى نحو "فإنك كالليل الذي هو مدركي"ْبِق إلى أفئدتهم، وقد قدّمتُ طرفاً من هذا الفصل فيما مضى، ولكنني أعدته هاهنا لاتصاله بما أريد ذكره. فقد ظهر أنه ليس كل شيء يجيء فيه التشبيه الصريح بذكر الكاف ونحوها، يستقيم نَقْلُ الكلام فيه إلى طريقة الاستعارة، وإسقاطِ ذكر المشبَّه جملةً، والاقتصار على المشبَّه به، وبقي أن نتعرّف الحكمَ في الحالة الأخرى، وهي التي يكون كل واحدٍ من المشبَّه والمشبَّه به مذكوراً فيه، نحو زيدٌ أسدٌ ووجدته أسداً، هل تُساوِقُ صريحَ التشبيه حتى يجوز في كل شيئين قُصِدَ تشبيهُ أحدهما بالآخر أن تحذف الكافَ ونحوها من الثاني، وتجعله خبراً عن الأول أو بمنزلة الخبر? والقولُ في ذلك أن التشبيه إذا كان صريحاً بالكاف، ومثل، كان الأعرفُ الأشهر في المشبَّه به أن يكون معرفةً، كقولك: هو كالأسد وهو كالشمس وهو كالبحر وكليث العرين وكالصبح وكالنجم وما شاكل ذلك، ولا يكاد يجيء نكرةً مجيئاً يُرتضَى نحو هو كأسد وكبحر وكغَيْث، إلا أن يُخَصَّص بصفة نحو كبحرٍ زاخر، فإذا جعلت الاسمَ المجرور بالكاف مُعْرَباً بالإعراب الذي يستحقّه الخبر من الرفع أو النصب، كان كلا الأمرين - التعريف والتنكيرِ - فيه حسناً جميلاً، تقول: زيدٌ الأسد والشمس والبحرُ وزيد أسدٌ وشمس وبدر وبحر. وإذْ قد عرفت هذا فارجع إلى نحو "فإنك كالليل الذي هو مدركي"
واعلم أنه قد يجوز فيه أن تحذف الكاف وتجعل المجرور كان به، خبراً، فتقول: فإنك الليل الذي هو مدركي، أو أنت الليل الذي هو مدركي، وتقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ المؤمن مَثَل الخامة من الزرع"، المؤمن الخامة من الزرع، وفي قوله عليه السلام: الناس كإبلٍ مئة)3(: الناس إبل مئة، ويكون تقديره على أنك قدّرت مضافاً محذوفاً على حدّ: "وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ" "يوسف: 82"، تجعل الأصل: فإنك مثلُ الليل ثم تحذف مِثْلاً، والنكتةُ في الفرق بين هذا الضرب الذي لا بُدّ للمجرور بالكاف ونحوِها من وَصْفه بجملة من الكلام أو نحوها، وبين الضرب الأول الذي هو نحو زيد كالأسد أنك إذا حذفتَ الكاف هناك فقلت: زيدٌ الأسد، فالقصد أن تبالغ في التشبيه فتجعل المذكورَ كأنه الأسد، وتشير إلى مثل ما يَحصُلُ لك من المعنى إذا حذفت ذكر المشبَّه أصلاً فقلت: رأيت أسداً أو الأسَد، فأمّا في نحو فإنك كالليل الذي هو مدركي، فلا يجوز أن تقصِد جعلَ الممدوحِ الليلَ، ولكنك تنوي أنك أردت أن تقول فإنك مِثل الليل، ثم حذفت المضاف من اللفظ، وأبْقَيت المعنى على حاله إذا لم تحذف، وأمَّا هناك، فإنه وإن كان يقال أيضاً إن الأصل زيد مثل أسد ثم تحذف فليس الحذفُ فيه على هذا الحدّ، بل على أنه جُعل كأَنْ لم يكن لقصد المبالغة، ألا تراهم يقولون: جعله الأسد? وبعيدٌ أن تقول جعله الليل، لأن القصد لم يقع إلى وصف في الليل كالظلمة ونحوها، وإنّما قُصد الحكمُ الذي له، من تعميمه الآفاق، وامتناعِ أن يصير الإنسان إلى مكان لا يُدركه الليلُ فيه. وإن أردت أن تزداد علماً بأن الأمر كذلك أعني أن هاهنا ما يصلح فيه التشبيه الظاهر ولا تصلح فيه المبُالغة وجَعلُ الأولِ الثاني فاعمد إلى ما تجد الاسم الذي افتُتح به المَثَل فيه غيرَ محتمل لضربٍ من التشبيه إذا أُفردِ وقُطع عن الكلام بعده، كقوله تعالى: "إنَّمَا مَثَلُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ" "يونس: 34"، لو قلت إنما الحياة الدنيا ماءٌ أنزلناه من السماء أو الماء ينزل من السماء فتخضّر منه الأرض، لم يكن للكلام وجهٌ غيرُ أن تقدّر حذف مِثْل نحو إنما الحياة الدنيا مِثْلُ ماء ينزل من السماء فيكون كيت وكيت، إذ لا يُتصوَّر بين الحياة الدنيا والماء شَبَهٌ يصحُّ قصدُه وقد أُفْرِد، كما قد يُتخيَّل في البيت أنه قصد تشبيه الممدوح بالليل في السُّخط. وهذا موضعٌ في الجملة مُشْكِلٌ، ولا يمكن القطع فيه بحكم على التفصيل، ولكن لا سبيل إلى جَحْد أنك تجد الاسم في الكثير وقد وُضِع موضعاً في التشبيه بالكاف، لو حاولتَ أن تُخرجه في ذلك الموضع بعينه إلى حدّ الاستعارة والمبالغة، وجَعْلِ هذا ذاك، لم يَنْقَدْ لك، كالنكرة التي هي ماء في الآية وفي الآي الأُخَر نحو قوله تعالى: "أَو كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ" "البقرة: 19"، ولو قلت هم صيّبٌ، ولا تُضمر مِثلاً ألبتَّة، على حدّ هو أسد لم يجز، لأنه لا معنى لجعلهم صيِّباً في هذا الموضع، وإن كان لا يمتنعُ أن يقعَ صيِّب في موضع آخر ليس من هذا الغَرَض في شيء استعارةً ومبالغةً، كقولك: فاضَ صَيِّبٌ منه، تريد جوده، وهو صَيِّب يَفيض، تريد مندفق في الجود، فلسنا نقول إن هاهنا اسمَ جنسٍ واسماً صفةً لا يصلح للاستعارة في حال من الأحوال، وهذا شِعب من القولِ يحتاج إلى كلام أكثر من هذا ويدخل فيه مسائل، ولكن استقصاءه يقطع عن الغرض. فإن قلت فلا بدّ من أصلٍ يُرجع إليه في الفرق بين ما يحسُن أن يُصرَف وَجْهُه إلى الاستعارة والمبالغة، وما لا يحسن ذلك فيه، ولا يُجيبك المعنى إليه، بل يصدُّ بوجهه عنك متى أردته عليه . فالجواب إنه لا يمكن أن يقال فيه قولٌ قاطع، ولكن هاهنا نكتة يجب الاعتماد عليها والنظر إليها، وهي أن الشَّبه إذا كان وصفاً معروفاً في الشيء قد جرى العُرف بأن يُشبَّه من أجله به، وتُعُورف كونه أصلاً فيه يقاسُ عليه كالنور والحُسن في الشمس، أو الاشتهار والظهور، وأنّها لا تَخْفَى فيها أيضاً وكالطيب في المسك، والحلاوة في العسل، والمرارة في الصاب، والشجاعة في الأسد، والفيض في البحر والغيث، والمَضاء والقَطْع والحِدَّة في السيف، والنفاذِ في السِّنان، وسرعة المرور في السَّهم، وسرعة الحركةِ في شعلةِ النار، وما شاكل ذلك من الأوصاف التي لكل وَصْف منها جنسٌ هو أصل فيه، ومُقدَّم في معانيه فاستعارةُ الاسم للشيء على معنى ذلك الشَّبه تجيء سهلةً مُنْقادة، وتقع مألوفةً معتادة، وذلك أنّ هذه الأوصافَ من هذه الأسماء قد تعورف كونها أصولاً فيها، وأنها أخصُّ ما توجد فيه بها، فكل أحد يعلم أن أخصَّ المنيرات بالنور الشمسُ، فإذا أُطلقَتْ ودلَّت الحال على التشبيه، لم يخفَ المرادُ، ولو أنك أردت من الشمس الاستدارة، لم يَجُزْ أن تدلّ عليه بالاستعارة، ولكن إن أردتها من الفَلَك جاز، فإن قصدتها من الكُرة كان أبْين، لأن الاستدارة من الكُرة أشهر وصفٍ فيها، ومتى صَلَحت الاستعارةُ في شيء، فالمبالغة فيه أصلح، وطريقها أوضح، ولسان الحال فيها أفصح، أعني أنك إذا قُلتَ: "يا ابن الكواكبِ من أئمّة هاشمِ" وَ: "يا ابنَ الليوثِ الغُر" فأجريت الاسمَ على المشبَّة إجراءَه على أصله الذي وُضع له وادّعيتَه له، كان قولك: هم الكواكب و هم الليوث أو هم كواكب وليوث، أحْرَى أن تقوله، وأَخفَّ مَؤُونةً على السامع في وقوعِ العلم له به. واعلم أن المعنى في المبالغة وتفسيرنا لها بقولنا جَعَلَ هذا ذاك، وجعله الأسد وادّعى أنه الأسد حقيقةً، أنّ المشبِّه الشيءَ بالشيء من شأنه أن ينظرَ إلى الوصف الذي به يجمع بين الشيئين، وينفيَ عن نفسه الفكرفيما سواه جملةً، فإذا شبَّه بالأسد، ألقى صورة الشجاعة بين عينيه، ألقى ما عداها فلم ينظر إليه، فإنْ هو قال زيد كالأسد، كان قد أثبت له حظّاً ظاهراً في الشجاعة، ولم يخرج عن الاقتصاد، وإذا قال هو الأسد، تناهَى في الدعوى، إمّا قريباً من المحقِّ لفرط بسالة الرجل، وإما متجوِّزاً في القول، فجعله بحيث لا تنقص شجاعته عن شجاعة الأسد ولا يَعْدَمُ منها شيئاً، وإذا كان بحكم التشبيه،وبأنه مقصودُه من ذكر الأسد في حكم مَن يعتقدُ أنّ الاسمَ لم يوضع على ذلك السَّبعُ إلا للشجاعة التي فيه، وأنّ ما عداها من صورته وسائر صفاته عِيالٌ عليها وتَبَعٌ لها في استحقاقه هذا الاسمَ، ثم أثبتَ لهذا الذي يشبِّهه به تلك الشجاعةَ بعينها حتى لا اختلافَ ولا تفاوتَ، فقد جعلَهُ الأسدَ لا محالة، لأن قولنا هو هو على معنيين أحدهما أن يكون للشيء اسمان يعرفه المخاطَبُ بأحدهما دون الآخر، فإذا ذُكر باسمه الآخر توهَّم أن معك شيئين، فإذا قلت: زيد هو أبو عبد اللَه، عرّفته أن هذا الذي تذكر الآن بزيد هو الذي عَرَفه بأبي عبد اللَّه، من الأوصاف التي لكل وَصْف منها جنسٌ هو أصل فيه، ومُقدَّم في معانيه فاستعارةُ الاسم للشيء على معنى ذلك الشَّبه تجيء سهلةً مُنْقادة، وتقع مألوفةً معتادة، وذلك أنّ هذه الأوصافَ من هذه الأسماء قد تعورف كونها أصولاً فيها، وأنها أخصُّ ما توجد فيه بها، فكل أحد يعلم أن أخصَّ المنيرات بالنور الشمسُ، فإذا أُطلقَتْ ودلَّت الحال على التشبيه، لم يخفَ المرادُ، ولو أنك أردت من الشمس الاستدارة، لم يَجُزْ أن تدلّ عليه بالاستعارة، ولكن إن أردتها من الفَلَك جاز، فإن قصدتها من الكُرة كان أبْين، لأن الاستدارة من الكُرة أشهر وصفٍ فيها، ومتى صَلَحت الاستعارةُ في شيء، فالمبالغة فيه أصلح، وطريقها أوضح، ولسان الحال فيها أفصح، أعني أنك إذا قُلتَ: "يا ابن الكواكبِ من أئمّة هاشمِ" وَ: "يا ابنَ الليوثِ الغُر" فأجريت الاسمَ على المشبَّة إجراءَه على أصله الذي وُضع له وادّعيتَه له، كان قولك: هم الكواكب و هم الليوث أو هم كواكب وليوث، أحْرَى أن تقوله، وأَخفَّ مَؤُونةً على السامع في وقوعِ العلم له به. واعلم أن المعنى في المبالغة وتفسيرنا لها بقولنا جَعَلَ هذا ذاك، وجعله الأسد وادّعى أنه الأسد حقيقةً، أنّ المشبِّه الشيءَ بالشيء من شأنه أن ينظرَ إلى الوصف الذي به يجمع بين الشيئين، وينفيَ عن نفسه الفكرفيما سواه جملةً، فإذا شبَّه بالأسد، ألقى صورة الشجاعة بين عينيه، ألقى ما عداها فلم ينظر إليه، فإنْ هو قال زيد كالأسد، كان قد أثبت له حظّاً ظاهراً في الشجاعة، ولم يخرج عن الاقتصاد، وإذا قال هو الأسد، تناهَى في الدعوى، إمّا قريباً من المحقِّ لفرط بسالة الرجل، وإما متجوِّزاً في القول، فجعله بحيث لا تنقص شجاعته عن شجاعة الأسد ولا يَعْدَمُ منها شيئاً، وإذا كان بحكم التشبيه،وبأنه مقصودُه من ذكر الأسد في حكم مَن يعتقدُ أنّ الاسمَ لم يوضع على ذلك السَّبعُ إلا للشجاعة التي فيه، وأنّ ما عداها من صورته وسائر صفاته عِيالٌ عليها وتَبَعٌ لها في استحقاقه هذا الاسمَ، ثم أثبتَ لهذا الذي يشبِّهه به تلك الشجاعةَ بعينها حتى لا اختلافَ ولا تفاوتَ، فقد جعلَهُ الأسدَ لا محالة، لأن قولنا هو هو على معنيين أحدهما أن يكون للشيء اسمان يعرفه المخاطَبُ بأحدهما دون الآخر، فإذا ذُكر باسمه الآخر توهَّم أن معك شيئين، فإذا قلت: زيد هو أبو عبد اللَه، عرّفته أن هذا الذي تذكر الآن بزيد هو الذي عَرَفه بأبي عبد اللَّه، والثاني أن يراد تحققُ التشابُه بين الشيئين، وتكميلُه لهما، ونَفْيُ الاختلاف والتفاوت عنهما، فيقال: هو هو، أي لا يمكن الفرقُ بينهما، لأن الفرق يقع إذا اخْتُصَّ أحدهما بصفةٍِ لا تكون في الآخر، هذا المعنى الثاني فرعٌ على الأوّل، وذلك أن المتشابهين التشابُهَ التامَّ، لمَّا كان يُحسَبُ أحدهما الآخر، ويَتوهَم الرائي لهما في حالين أنه رأى شيئاً واحداً، صاروا إذا حققوا التشابُه بين الشيئين يقولون هو هو، والمشبّه إذا وقف وَهْمَه كما عرَّفتُك على الشجاعة دون سائر الأمور، ثم لم يُثبت بين شجاعة صاحبه وشجاعة الأسد فرقاً، فقد صار إلى معنى قولنا: هو هو بلا شبهة. وإذا تقررت هذه الجملة فقوله "فإنك كالليل الذي هو مدركي" إن حاولت فيه طريقة المبالغة فقلت: فإنك الليل الذي هو مدركي، لزمك لا محالة أن تعْمِد إلى صفةٍ من أجلها تجعله الليل، كالشجاعة التي من أجلها جعلت الرجلَ الأسدَ، فإن قلت تلك الصفةُ الظُّلمةُ، وإنّه قصد شدّةَ سخطِه، وراعى حال المسخوط عليه، وتوهّم أن الدنيا تُظلم في عينيه حسَب الحال في المُسْتَوْحِش الشديد الوَحْشَة، كما قال "أَعيدوا صَباحِي فَهْوَ عند الكواعبِ" قيل لك هذا التقدير، إن استجزناه وعملنا عليه، فإنا نحتمله، والكلامُ على ظاهره، وحرف التشبيه مذكورٌ داخلٌ على الليل كما تراه في البيت، فأمّا وأنت تريد المبالغة، فلا يجيء لك ذلك، لأن الصفات المذكورة لا يُواجَه بها الممدوحون، ولا تُسْتعار الأسماء الدالّة عليها لهم إلا بعد أن يُتدارك وتُقرَن إليها أضدادها من الأوصاف المحبوبة، كقوله "أنت الصَّاب والعَسَلُ" ولا تقول وأنت مادح أنت الصابُ وتسكت، وحتى إن الحاذقَ لا يرضى بهذا الاحتراز وحده حتى يزيد ويحتال في دفع ما يَغْشَى النفسَ من الكراهة بإطلاق الصفة التي ليست من الصفات المحبوبة، فيصل بالكلام ما يخرُج به إلى نوع من المدح، كقول المتنبي:
|
حَسَنٌ في وُجوهِ أعدائهِ أقْ |
|
بَحُ من ضَيْفه رَأَته السَّوَامُ |
بدأ فجعله حسناً على الإطلاق، ثم أراد أن يجعله قبيحاً في عيون أعدائه، على العادة في مدح الرجل بأن عدوَّه يكرهه، فلم يُقنعه ما سبق من تمهيده وتقدّم من احترازه في تلاقي ما يجنيه إطلاق صفة القُبح، حتى وصل به هذه الزيادةَ من المدح، وهي كراهةُ سَوامِهِ لرؤية أضيافه، وحتى حصل ذكرُ القبح مغموراً بين حُسنين، فصار كما يقول المنجّمون: يقع النَّحس مضغوطاً بين سَعْدين، فيبطل فعله وينمحق أثره. وقد عرفتَ ما جَناه التهاوُنُ بهذا النحو من الاحتراز على أبي تمّام، حتى صار ما يُنعَى عليه منه أبلغ شيء في بسط لسان القادح فيه والمُنْكِر لفضله، وأحْضَر حُجّةً للمتعصّب عليه، وذلك أنه لم يُبالِ في كثير من مخاطبات الممدوح بتحسين ظاهر اللفظ، واقتصر على صميم التشبيه، وأطلق اسم الجنس الخسيس كإطلاق الشريف النَّبيه، كقوله:
|
وإذا ما أردتُ كنتَ رِشاءً |
|
وإذا ما أردتُ كنتَ قَليبَا |
فصَكَّ وجهَ الممدوح كما ترى بأنه رشاءٌ وقليبٌ، ولم يحتشم أن قال:
|
مازَال يهذِي بالمكارِم والعُلَى |
|
حتى ظَنَنّا أنَّه مَـحْـمُـومُ |
فجعله يهذي وجعل عليه الحُمَّى، وظنّ أنه إذاحصلَ له المبالغة في إثبات المكارم له، وجعلها مستبدّة بأفكاره وخواطره، حتى لا يصدر عنه غيرُها، فلا ضير أن يتلقَّاه بمثل هذا الخطاب الجافي، والمدح المتنافي. فكذلك أنت هذه قِصّتك، وهذه قضيّتك، في اقتراحك علينا أن نسلك بالليل في البيت طريق المبالغَة على تأويل السُّخط. فإن قلت أَفَتَرَى أن تأبَى هذا التقدير في البيت أيضاً حتى يُقْصَر التشبيهُ على ما تُفيده الجملة الجارية في صلة الذي، قلتُ إنّ ذلك الوجهُ فيما أظنُّه، فقد جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لَيدخُلنَّ هذا الدينُ ما دَخَل عليه الليلُ، فكما تجرَّد المعنى هاهنا للحكم الذي هو لليل من الوصول إلى كل مكان، ولم يكن لاعتبار ما اعتبروه من شبه ظلمته وجهٌ، كذلك يجوز أن يتجرّد في البيت له، ويكون ما ادَّعوه من الإشارة بظُلْمة الليل إلى إدراكه له ساخطاً، ضرباً من التعمّق والتطلُّب لما لعلّ الشاعر لم يقصده، وأحسنُ ما يمكن أن يُنتصَر به لهذا التقدير أن يقال إن النهارَ بمنزلة الليل في وصوله إلى كل مكان، فما مِنْ موضع من الأرض إلا ويُدركه كلُّ واحد منهما، فكما أن الكائن في النهار لا يُمكنه أن يصير إلى مكان لا يكون به ليل، كذلك الكائن في الليل لا يجد موضعاً لا يلحقه فيه نهار، فاختصاصُه الليلَ دليلٌ على أنه قد روَّى في نفسه، فلما علم أن حالَة إدراكه وقد هربَ منه حالةُ سُخْطٍ، رأى التمثيل بالليل أولَى، ويُمكن أن يزاد في نصرته بقوله:
|
نعمةٌ كالشَّمْس لمَّا طَلعَتْ |
|
بَثَّتِ الإشراقَ في كلِّ بَلَدْ |
وذاك أنه قصد هاهنا نفس ما قصده النابغة في تعميم الأقطار، والوصول إلى كل مكان، إلاّ أن النعمة لما كانت تَسُرُّ وتُؤنِس، أخذ المثلَ لها من الشمس، ولو أنه ضرب المثل لوصول النعمة إلى أقاصي البلاد، وانتشارِها في العباد، بالليل ووصوله إلى كل بَلَدٍ، وبُلوغه كلَّ أحد، لكان قد أخطأ خطأً فاحشاً، إلاّ أن هذا وإن كان يجيء مستوياً في الموازنة، ففرقٌ بين ما يُكرَهُ من الشَّبه وما يُحَبُّ، لأن الصفةَ المحبوبة إذا اتصلت بالغَرَض من التشبيه، نالت من العناية بها المحافظة عليها قريباً مما يناله الغَرَض نفسه، وأّما ما ليس بمحبوب، فَيَحْسُن أَن يعْرض عنها صفحاً، ويدَع الفكر فيها، وأما تركُه أن يمثَّل بالنهار، وإن كان بمنزلة الليل فيما أراه، فيمكن أن يُجاب عنه بأنّ هذا الخطابَ من النابغة كان بالنهار لا محالة، وإذا كان يكلّمه وهو في النهار، بَعُدَ أن يضرب المثل بإدراك النهار له، وكان الظاهر أن يمثِّل بإدراك الليل الذي إقباله منتظَر، وطَرَيانه على النهار متوقَّع، فكأنّه قال وهو في صدر النهار أو آخره لو سرتُ عنك لم أجد مكاناً يقيني الطلبَ منك، ولكان إدراكُك لي وإن بعُدت واجباً، كإدراك هذا الليل المقبل في عَقب نهارِي هذا إيَّاي، ووصوله إلى أيِّ موضع بلغتُ من الأرض. وهاهنا شيء آخر وهو أنّ تشبيه النعمة في البيت بالشمس، وإن كان من حيثُ الغرضُ الخاصُّ، وهو الدِّلالة على العموم، فكان الشَّبه الآخرُ من كونها مُؤْنسةً للقلوب، ومُلبسةً العَالَم البهجةَ والبهاءَ كما تفعل الشمس، حاصلاً على سبيل العَرَض، وبضَرْبٍ من التطفُّل، فإنّ تجريدَ التشبيه لهذا الوجه الذي هو الآن تابعٌ، وجَعْلَهُ أصلاً ومقصوداً على الانفراد، مألوفٌ معروفٌ كقولنا نعمتك شمسٌ طالعة، وليس كذلك الحكم في الليل، لأن تجريدَه لوصف الممدوح بالسُّخْط مُسْتَكرَهٌ، حتى لو قلت أنت في حال السخط ليلٌ وفي الرّضى نهارٌ، فكافحتَ هكذا تجعله ليلاً لسخطه، لم يحسُن، وإنما الواجب أن تقول: النهار ليل على من تغضبُ عليه، والليل نهار على من ترضى عنه، وزمانُ عدوِّك ليلٌ كله، وأوقات وَلِيِّك نهارٌ كلها، كما قال:
|
أَيَّامُنَا مَصْقولةٌ أطرافُها |
|
بك واللَّيالي كُلُّها أَسْحَارُ |
وقد يقول الرجل لمحبوبه أنت ليلى ونهارى، أي بك تُضيء لي الدنيا وتُظلم، فإذا رضيتَ فدهري نهارٌ، وإذا غضِبت فليلٌ كما تقول: أنت دَائي ودَوائي، وبُرْئٍي وسِقامي، ولا تكاد تجد أحدا يقول أنت ليل، على معنى أن سخطك تُظلم به الدنيا، لأن هذه العبارة بالذمِّ، وبالوصف بالظُلمة وسواد الجلد، وتَجهُّمِ الوجه، أخصُّ، وبأن يُرَاد بها أخلق، وهذا المعنى منها إلى القلب أسبق فاعرفه.
فصل
اعلم أنك تجد الاسم وقد وقع من نظم الكلام المَوْقعَ الذي يقتضي كونَهُ مستعاراً، ثم لا يكون مستعاراً، وذاك لأن التشبيهَ المقصودَ مَنُوطٌ به مع غيره، وليس له شَبَهٌ ينفرِدُ به، على ما قدّمتُ لك من أن الشبه يجيء مُنْتَزَعاً من مجموع جملة من الكلام، فمن ذلك قول داود بن عليّ حين خطب فقال شُكراً شكراً، إنّا واللَّه ما خرجنا لنَحْفِر فيكم نَهَراً، ولا لنَبْنِيَ فيكم قَصْراً، أَظَنَّ عدوُّ اللَّه أن لن يُظفَر به، أُرخيَ له في زِمامه، حتى عَثَر في فضل خطَامه، فالآن عاد الأمرُ في نِصابه، وطلعت الشمس من مَطْلعها، والآن قد أَخذ القوسَ باريها، وعاد النَّبْلُ إلى النَزَعة، ورجع الأَمر إلى مستقَرِّه في أهلِ بيت نبيّكم، أهلِ بيت الرَّأْفَة والرَّحْمة، فقوله الآن أخذَ القَوْسَ بَاريها، وإن كان القوس تقع كنايةً عن الخلافة، والبَاري عن المستحقّ لها، فإنه لا يجوز أن يقال إن القوس مستعارٌ للخلافة على حدِّ استعارة النور والشمس، لأجل أنه لا يتَصَوَّر أن يَخرج للخلافة شَبَهٌ من القول على الانفراد، وأن يقال: هي قوس، كما يقال: هي نور وشمس، وإنما الشَّبَهُ مؤلَّفٌ لحال الخِلافة مع القائم بها، من حال القَوْس مع الذي بَرَاهَا، وهو أن البَارِي للقوس أعرفُ بخيرها وشرّها، وأهدَى إلى توتيرها وتصريفها، إذ كان العاملَ لها فكذلك الكائنُ على الأوصاف المعتبرَة في الإمامة والجامعُ لها، يكون أهدى إلى توفية الخلافة حقَّها، وأَعْرَفَ بما يحفظ مَصارفها عن الخَلَل، وأن يراعَي في سياسة الخلق بالأمر والنَّهْي التي هي المقصودُ منها ترتيباً ووزناً تقع به الأفعالُ مواقعَها من الصواب، كما أنّ العارف بالقوس يراعي في تسوية جوانبها، وإقامة وَتَرها، وكيفيةِ نَزْعها ووَضْعِ السهم الموضعَ الخاصَّ منها، ما يوجب في سهامه أن تصيب الأغراض، وتُقرطس في الأَهداف، وتقع في المَقاتل، وتُصيب شاكلة الرَّمِيّ. وهكذا قول القائل وقد سمع كلاماً حسنا من رجلٍ دَميم: عَسَلٌ طيّبٌ في ظَرْفِ سَوْءٍ، ليس عَسَلٌ هاهنا على حدِّه في قولك ألفاظه عسل، لأجل أنه لم يقصد إلى بيان حال اللَّفظ الحسن وتشبيهه بالعسل في هذا الكلام، وإن كَان ذلك أمراً معتاداً، وإنما قصد إلى بيان حال الكلام الحَسَن من المتكلم المَشْنُوء في منظره، وقياسِ اجتماع فَضْلِ المخبر مع نَقْص المنظر، بالشبه المؤلَّف من العَسَل والظَّرْف، ألا ترى أن الذي يقابل الرجل هو ظَرْف سَوْءٍ وظرفُ سَوْءٍ لا يصلح تشبيهُ الرجل به على الانفراد، لأن الدَّمامةَ لا تُعطيه صفة الظَّرف من حيث هي دمامةٌ، ما لم يتقدم شيءٌ يُشبه مَا في الظرف من الكلام الحسن أو الخُلقِ الجميلِ، أو سائر المعاني التي تجعَل الأشخاصُ أوعيةً لها. فمن حقك أن تحافظ على هذا الأصل، وهو أن الشَّبَه إذا كان موجوداً في الشيء على الانفراد من غير أن يكون نتيجةً بينه وبين شيء آخر فالاسمُ مستعارٌ لما أخذ له الشَّبه منه، كالنور للعلم والظلمة للجهل، والشمس للوجه الجميل، أو الرجل النبيه الجليل، وإذا لم تكن نسبةُ الشَّبَه إلى الشيء على الانفراد، وكان مركَّباً من حاله مع غيره، فليس الاسم بمستعار، ولكن مجموع الكلام مَثَل. واعلم أن هذه الأمور التي قصدتُ البحث عنها أمورٌ كأنّها معروفة مجهولة، وذلك أنها معروفة على الجملة، لا ينكر قيامَها في نفوس العارفين ذَوْقُ الكلام، والمتمهّرين في فصل جيده من رديئه، ومجهولةٌ من حيث لم يتفق فيها أوضاعٌ تجري مجرى القوانين التي يُرجَع إليها، فتُستخرج منها العلَل في حُسن ما استُحْسِن وقُبح ما استُهْجن، حتى تُعْلَم عِلْمَ اليقين غيرَ الموهوم، وتُضبَط ضبطَ المزْموم المَخْطومِ، ولعلَّ المَلال إن عرض لك، أو النشاط إن فَتَر عنك، قلتَ ما الحاجة إلى كل هذه الإطالة? وإنما يكفي أن يقال الاستعارة مثل كذا، فتُعَدُّ كلمات، وتُنْشَدُ أبيات، وهكذا يكفينا المَؤُونةَ في التشبيه والتمثيل يَسيرٌ من القول، فإنك تعلم أن قائلاً لو قال الخبر مثل قولنا زيد منطلق، ورضي به وقَنِع، ولم تطالبه نفسُه بأن يعرف حدّاً للخبر، إذا عرفه تَميَّز في نفسه من سائر الكلام، حتى يمكنهُ أن يعلم هاهنا كلاماً لفظُه لفظُ الخبر، وليس هو بخبرٍ، ولكنه دعاءٌ كقولنا: رحمةُ اللَّه عليه وغفر الله له ولم يجد في نفسه طلباً لأن يعرف أن الخبر هل ينقسم أو لا ينقسم، وأنّ أوّل أمره في القسمة أنه ينقسم إلى جملة من الفعل والفاعل، وجملة من مبتدأ وخبر، وأَنَّ ما عدا هذا من الكلام لا يأتلف، نعم ولم يُحبَّ أن يعلم أن هذه الجملة يدخل عليها حروفٌ بعضها يؤكّد كونها خبراً، وبعضها يُحدث فيها معاني تخرُج بها عن الخَبَرية واحتمال الصدق والكذب. وهكذا يقول إذا قيل له: الاسم مثل زيد وعمرو، اكتفيتُ ولا أحتاج إلى وصفٍ أو حدٍّ يُميّزه من الفعل والحرف أو حدٍّ لهما، إذا عرفتهما عرفتُ أن ما خالفهما هو الاسم، على طريقة الكُتّاب، ويقول لا أحتاج إلى أن أعرف أنَّ الاسم ينقسم فيكون متمكّناً أو غير متمكّن، والمتمكن يكون منصرفاً وغير منصرف، ولا إلى أن أعلم شرح غير المنصرف، الأسباب التسعة التي يقف هذا الحكم على اجتماع سببين منها أو تكرُّر سببٍ في الاسم ولا أنه ينقسم إلى المعرفة والنكرة، وأن النكرة ما عَمَّ شيئين فأكثر، وما أريدَ به واحدٌ من جنس لا بعينه، والمعرفة ما أيد به واحدُ بعينه أو جنس بعينه على الإطلاق ولا إلى أن أعلم شيئاً من الانقسامات التي تجيء في الاسم، كان قد أساء الاختيار، وأسرف في دعوى الاستغناء عما هو محتاج إليه إن أراد هذا النوع من العلم ولئن كان الذي نتكلّف شرحَه لا يزيد على مؤدَّى ثلاثةِ أسماء، وهي التمثيل والتشبيه والاستعارة، فإن ذلك يستدعي جُملاً من القول يَصْعُبُ استقصاؤها، وشُعَباً من الكلام لا يستبين لأول النظر أنحاؤها، إذ قولُنا: شيء يحتوي على ثلاثة أحرف، ولكنك إذا مددت يداً إلى القسْمة وأخذت في بيان ما تحويه هذه اللفظة، احتجت إلى أن تقرأ أوراقاً لا تُحصَى، وتتجشّمَ من المَشقَّة والنَظرِ والتفكير ما ليس بالقليل النزر، والجزء الذي لا يتجزّأ، يفوت العين، ويدقّ عن البَصَر، والكلام عليه يملأ أجلاداً عظيمة الحجم، فهذا مَثَلك إن أنكرت ما عُنيتُ به من هذا التَتبُّع، ورأيتُه من البحث، وآثرتُه من تجشُّم الفكرة وسَوْمها أن تدخل في جوانب هذه المسائل وزواياها، وتستثير كوامنَها وخفاياها، فإن كنتَ ممن يرضى لنفسه أن يكون هذا مَثَله، وهاهنا محلُّه، فعِبْ كيف شئتَ، وقل ما هَويتَ، وثقْ بأن الزمان عونُك على ما ابتغيت، وشاهدُك فيما ادّعيت، وأنك واجدٌ من يصوّب رأيك ويحسِّن مذهبك، ويخاصم عنك، ويُعادِي المخالف لك.
 |
|
| دلَّت كلمة (نقد) في المعجمات العربية على تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها ، ولذلك شبه العرب الناقد بالصيرفي ؛ فكما يستطيع الصيرفي أن يميّز الدرهم الصحيح من الزائف كذلك يستطيع الناقد أن يميز النص الجيد من الرديء. وكان قدامة بن جعفر قد عرف النقد بأنه : ( علم تخليص جيد الشعر من رديئه ) . والنقد عند العرب صناعة وعلم لابد للناقد من التمكن من أدواته ؛ ولعل أول من أشار الى ذلك ابن سلَّام الجمحي عندما قال : (وللشعر صناعة يعرف أهل العلم بها كسائر أصناف العلم والصناعات ). وقد أوضح هذا المفهوم ابن رشيق القيرواني عندما قال : ( وقد يميّز الشعر من لا يقوله كالبزّاز يميز من الثياب ما لا ينسجه والصيرفي من الدنانير مالم يسبكه ولا ضَرَبه ) . |
 |
|
| جاء في معجمات العربية دلالات عدة لكلمة ( عروُض ) .منها الطريق في عرض الجبل ، والناقة التي لم تروَّض ، وحاجز في الخيمة يعترض بين منزل الرجال ومنزل النساء، وقد وردت معان غير ما ذكرت في لغة هذه الكلمة ومشتقاتها . وإن أقرب التفسيرات لمصطلح (العروض) ما اعتمد قول الخليل نفسه : ( والعرُوض عروض الشعر لأن الشعر يعرض عليه ويجمع أعاريض وهو فواصل الأنصاف والعروض تؤنث والتذكير جائز ) . وقد وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي للبيت الشعري خمسة عشر بحراً هي : (الطويل ، والبسيط ، والكامل ، والمديد ، والمضارع ، والمجتث ، والهزج ، والرجز ، والرمل ، والوافر ، والمقتضب ، والمنسرح ، والسريع ، والخفيف ، والمتقارب) . وتدارك الأخفش فيما بعد بحر (المتدارك) لتتم بذلك ستة عشر بحراً . |
 |
|
| الحديث في السيّر والتراجم يتناول جانباً من الأدب العربي عامراً بالحياة، نابضاً بالقوة، وإن هذا اللون من الدراسة يصل أدبنا بتاريخ الحضارة العربية، وتيارات الفكر العربية والنفسية العربية، لأنه صورة للتجربة الصادقة الحية التي أخذنا نتلمس مظاهرها المختلفة في أدبنا عامة، وإننا من خلال تناول سيّر وتراجم الأدباء والشعراء والكتّاب نحاول أن ننفذ إلى جانب من تلك التجربة الحية، ونضع مفهوماً أوسع لمهمة الأدب؛ ذلك لأن الأشخاص الذين يصلوننا بأنفسهم وتجاربهم هم الذين ينيرون أمامنا الماضي والمستقبل. |
|
|
|
|
صنع الذكريات والتفكير يدمر الدماغ.. دراسة تشرح السبب
|
|
|
|
|
|
|
الصين.. عودة كاسحتي الجليد إلى شنغهاي بعد انتهاء بعثة استكشافية إلى القطب الجنوبي
|
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل سنّ التكليف الشرعي المركزي لطالبات المدارس في كربلاء
|
|
|
|
العتبة العباسية تكرم المساهمين بنجاح حفل التكليف الشرعي للطالبات
|
|
|
|
ضمن فعاليات حفل التكليف الشرعي.. السيد الصافي يلتقط صورة جماعية مع الفتيات المكلفات
|
|
|
|
حفل الورود الفاطمية يشهد عرضًا مسرحيًّا حول أهمية التكليف
|